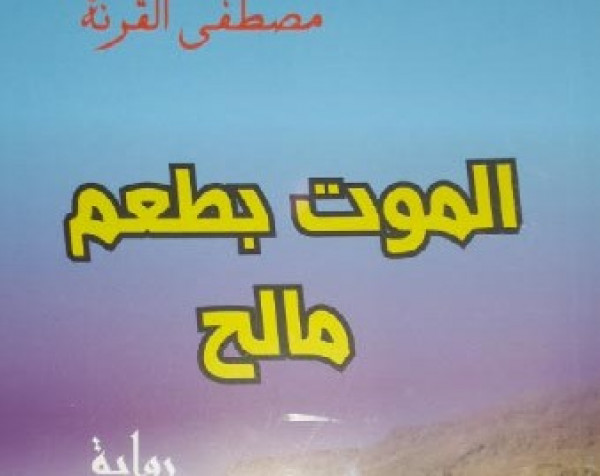إنه العنوان الذي يجعلك تطرح السؤال ، كيف يكون الموت بطعم مالح ؟ كيف للموت أن يكىن بالمذاق الذي طرح كعنوان للرواية ؟ ما علاقة ذوق الملح بطعم الموت ، لماذا ربط بينهما الكاتب ؟ و أما صورة الغلاف التي يظهر عليها البحر وعلى أطرافه أو شاطئه الملح مرصوص فهي تطلب منك أن تتعمق في البحث عن الغوص في بحر عنوان الرواية ، علما أن العنوان في العمل الروائي هو المفتاح ، وهو سر نجاح الكاتب في جدب القارئ إلى عالم وضع أسسه وضوابطه إبتداءًا من العنوان ناهيك عن الجماليات والآليات الضرورية لنجاح العمل .
إنه البحر الذي يعتبر الملجأ للفقراء ، فقراء مدن فلسطينية جعلتها ظروف الحياة القاسية تبحث عن لقمة العيش بكل الطرق الممكنة وفي أي مكان ، فيلجؤون إلى البحر الميت لإستخراج الملح وبيعه في الأسواق ، مذاق الملح لا يشبه مذاق السكر ، مذاق شبهه الكاتب بتعقد الحياة ، متعقد ذوقه وليس سهلا تحمله ، لا يتحمل الإنسان مذاق الملح إلا بنسبة قليلة ، ظروف الحياة القاسية ، والفقر الذي ينهك كاهل هذا الإنسان الذي سكن المنطقة وعلى جميع الأصعدة . هذا البحر الذي يرمز إلى المجهول ، كيف للإنسانية أن تقدر على صراع الأيام القاسية والبحر الذي يعدها بمجهوله و بالغد الغامض .
جاء عنوان الرواية كما ورد في مقدمة الدكتور مصطفى خضر الخطيب ليضيف للكاتب نجاحا مميزا (لقد أحسن الكاتب في اختيار العنوان لأنه يجسد مرارة الحياة وشظف العيش التي عاشها في طفولته ،ورسم صورة حية وأمينة و صادقة لتفاصيل الحياة في منطقة واسعة من الأرض الفلسطينية ).
سطور الرواية تحاكي تجربة ذاتية ، محاكاة لذكريات تمكن من خلالها الكاتب مصطفى القرنة من وضع صور لا ترتبط بالخيال بقدر ارتباطها بالواقع ، ليست قصة حب ولا هي مغامرة بوليسية ، إنها تاريخ لمنطقة جد مهمة في عالمنا العربي ، نظم من خلالها مظاهر الحياة على أصعدة مختلفة ، بلغة جميلة مزج فيها بين العربية الفصحى واللهجة الفلسطينية ليظهر الحضور النفسي للكاتب من خلال لغة طفولته التي تحدثت بها صوره المخزنة في دواليب الذاكرة .
عندما نسافر إلى مدينتنا ، مدينتنا الأولى سنتذكر كل خصائصها وسنرى كل ما حدث فيها بعيون لا يمكنها أن تجد تفسيرا لكل ما حدث إلا في إطار ما عايشناه فعلا من لغة وأحاسيس وسلوكيات .
هكذا نقل لنا الكاتب مدينة صباه ، حيث تغلغل في أعماقها بحس وإدراك ، ما مكنه فعلا من استخلاص زبدة واقع تلك الحقبة من التاريخ التي تعود إلى بدايات القرن العشرين .
البحر الميت و بيت لحم ومدينة النخيلة ، يعبر الكاتب هذه المدن وغيرها من الأماكن الثانوية التي تتفرع منها لنصل إلى عالمه المعقد بأحداثه المتنوعة وشخصياته التي ساهمت بشكل فعال في رسم خريطة واقع مدينته سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا .
بأسلوب رائع من حيث السرد والحوار تمكن الطفل العملاق من نقل الأحداث على لسان جواد أحد أبناء الأسرة ، من ذكرياته الأليمة سيؤسس لمدينته حضورا في عالم الوعي ، في أواخر حقبة العهد العثماني الذي انتهى رسميا سنة 1917 يحيي الكاتب قريته القديمة ، يضيء ذكراها تحت قناديل القلم ومصابيح الذاكرة ، ذلك الصيف الذي ساهمت فيه فاطمة رفقة زوجها في جمع الحصاد ونقله عبر الحمار ، تشعر بالسعادة في عملها هذا الذي يغنيها عن عملية بيع الملح في سوق بيت لحم ، تشعر بالراحة وهي تمد يدها لمساعدة زوجها وفي هذا إشارة إلى تعاون الرجل والمرأة فيما بينهما للخروج من أزمة التحصيل الغذائي للعائلة .
على لسان إبنها الأكبر جواد تأتي الرواية لتفتح شهيتنا على السفر إلى قلب الحياة في قرى فلسطين ، مستخدما الضمير المتكلم الأنا ، في قالب أدبي جميل سردا ولغة وحوارا .
سيروي لنا البطل قصة كفاحه التي ستبدأ مع رحلته نحو البحر الميت لاستجلاب الملح رفقة قافلة من الشباب ، لكن هذه الرحلة لم تصل إلى هدفها بسبب عدم تفاهم أفرادها كما هو الشأن في زمننا هذا ، مازالت الإختلافات حول القرارات المصيرية موجودة لحل أزمات المنطقة ، مازال العرب متفرقين في كل شيء ولم تتغير نزعتهم تلك إلى يومنا هذا .
سيذهب البطل مثل غيره للبحث عن سبل العيش في اتجاه آخر غير الذي رسم في الأول ، حاول ممارسة عملية بيع الماء في مدينة القدس إلا أن هذه الوسيلة لم تكن ناجعة ، وظل تائها في رحلة البحث الشاقة لإيجاد عمل مربح إلى أن إلتقى بأحد السكان الذي عرض عليه مهنة الحوذي الذي يقود العربة ، وخلال ممارسته لهذه المهنة دهس رجلا وصبيا فما كان له إلا ان سلم نفسه للسلطات رغم أنه كان قادرًا على الهروب وعدم تحمل مسؤوليته ، أحب الكاتب هنا أن يجعل من بطله رمزا عربيا لفضائل الأخلاق وآحترام لروح المسؤولية ، كانت السلطة آنذاك بيد الدولة العثمانية وهنا يسلط الكاتب الضوء على الوضع السياسي والإداري للمنطقة في ظل حكم تلك الدولة ، وقد يقذف بِنَا هذا في عمق الطرح الفكري المعروف عن مدى مصداقية السلطة العثمانية كحضور له رمزية الخلافة .
وتسلسل الأحداث سيجعلنا نكتشف على لسان جواد الحياة بمختلف أوجهها .
في صعوبة الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، نجد في طبيعة المسكن الذي كان يأوي إليه السكان ما يفسر قساوة أيام المواطن (مازالت العمة صبحة تسكن المغاور ) وإذا تمكن الفرد من بناء غرفة صغيرة من الطوب فقد يعتبر منزله قصرا بالمقارنة مع الذين يسكنون المغاور وبيوت الشعر .
يواصل جواد في تفصيله لصعوبة الوضع .
-قلت لوالدي :كيف تنامون في تلك المغاور ؟
-رد :لو تدري أننا كنا ننام مع البهائم فهي تعطي الدفء في الشتاء وأنفاسها حارة .
كان السكان يحصلون لقمة العيش بأنفسهم ويتخذون الأسباب بوسائلهم الخاصة في سبيل العيش الكريم وهذا ما يتضح في رحلة جواد باحثا عن العمل . حيث كانوا يمارسون الزراعة وتربية الماشية أيضا وهذا يبدو واضحا في شرح الكاتب لعمل فاطمة مع زوجا أثناء جني الحصاد . ويظهر مقطع يصور فيه كيفية تحضير الخبز مدى سوء الحالة الإقتصادية للقطاع في تلك الفترة ،(قامت وأحضرت بعض خبز الصاج الذي تصنعه بيدها ويبدو أنها خبزته منذ أسبوع لأنه إنكمش بشدة )
طال غياب جواد حتى ظن أهله أنه مات لكنه تمكن من الخروج من سجنه مقابل تقديم رشوة للضابط العثماني والتي تتمثل في عنزة ، وأدخل السجن ثانية بعد فشله في تقديم هذه الرشوة الغالية ، ثم يخرج بعد أن قدم الخروف للضابط . وعند خروجه من السجن لن يعود جواد إلى قريته ، لقد سئم الحياة وفضل الذهاب إلى الجبال . ففي هذا رمز إلى توجه الشاب إلى الكفاح المسلح بعد اشتداد الظلم وفساد أنظمة الحكم وفعلا في هذه الإشارة يرمز الكاتب إلى حتمية سقوط الدول الظالمة كما هو معروف تاريخيا فقد تم سقوط الدولة العثمانية في وقت قريب .
فقد عانت المنطقة العربية بأسرها ظاهرة لها أوجه سياسية واخلاقية في ظل انعدام التوازن الإجتماعي وعدم قيام أجهزة الدولة بوظائفها المنوطة بها ، فغابت الرعاية الصحية والتعليم وانتشرت الخرافات المضللة للوعي آنذاك .
في الرواية كانت شخصية الطبيب حاضرة في شخصية الحاجة سعدى ، الذي كان يتولى الإشراف على المرضى هم أشخاص ليست لهم خبرة علمية ، بل اكتسبوا خبراتهم من الموروث الثقافي السائد في أعماق المجتمع ، عندما هجمت الدبابير على جواد خلال بحثه عن النحل أصيب جسده بالتورم وقامت سعدى بمداواته . الحاجة سعدى هي التي تجبر المكسور وتداوي المريض .
غنية الرواية بالتفاصيل التي تنقل لنا طبيعة الحياة في بيت لحم وقرية النخيلة وبيت جالا والقدس ، كلها تجعلنا نكتشف طبيعة المجتمع الفلسطيني وشخصيته وعاداته وموروثه الثقافي ، ورغم انعدام وجود المدارس النظامية في القرى أشارت الرواية إلى كيفية تعلق المجتمع بروح العلم عن طريق الكتاب الذي كان الشيخ إبراهيم هو الملقن للأولاد اللغة العربية وتعاليم الدين الإسلامي ، كان الطلاب يجتازون المسافات البعيدة للوصول إلى مركز الكتاب ،
كما أن الرواية لم تنس الإشارة إلى التطرق لبعض خصوصيات المجتمع السلبية المتمثّلة في انتشار المعتقدات والخرافات التي يسببها الجهل بصفة عامة المتعلقة بحضور الغيلان وعالم الجن ، (الغيلان تنتشر في الليل وتلقي القبض على من يمر وتأكل لحمه الشهي ، وتخطف الغيلان الشيخ إبراهيم لتحاكمه في محكمة الجن في منطقة البحر الميت ، فعلا تتشابه المدن في عالمها الخفي ، من بابل ما قبل الميلاد مازالت تحمل المدينة في صدرها شيئا من أحلامها الغابرة .
الرواية عين حقيقية على تذكار تاريخي صمم إطاره وعمقه حضور قوي للذاكرة والإحساس في عمق التاريخ .
عتبات النص في رواية الموت بطعم مالح للكاتب مصطفى القرنة بقلم حياة قاصدي
تاريخ النشر : 2020-07-26