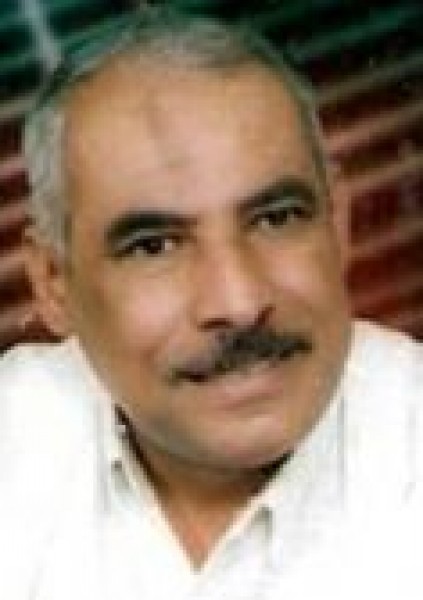قارب الموت والظمأ العظيم
تحليل طبي نفسي ونقد أدبي لقصص مجموعة "أوان الرحيل" للدكتور علي القاسمي (13) (فصل جديد)
____________________________________
حسين سرمك حسن
بغداد المحروسة - أواخر 2014
(13)
"مقاومة شعريّة"
تحليل قصّة "المدينة الشبح"
"مدينة يكذب كل من فيها على أنفسهم ، وتقول في أسوأ أوضاع لها : لابأس ، تموتُ فيها الشمس"
"مظفر النواب"
في قصّة "المدينة الشبح" لا يسعفك العنوان كثريّا للنّص كما يُزعم ، بإدراك شيء مُحدّد ونوعي يكشف الثيمة الأساسية للنصّ أكثر من الإيحاء بمدينة متهالكة شبحيّة ماتت فيها الروح وفي طريقها للانقراض أو تستولي عليها الأشباح أو غير ذلك من الإيحاءات ، التي لا يمكن أن تنتزع دورها وتكتسب دلالاتها الأصلية إلّا بعد إكمال "الصورة الكلّية" للنص . وعندما أقول "الصورة الكلّية" للنصّ لا اقصد من ذلك الوصول بالتحليل إلى الإحاطة بالمضمون المركزي للقصّة حسب ، بل التقاط المضمون ملتحماً بـ "شكله" وعبر الأخير . نتساءل دائماً : أينَ نرى الابتسامة ؟ هل نراها "أمام" الوجه أم "خلفه" ؟ والجواب المنطقي برغم مسحته الفلسفية – هو أننا نرى الابتسامة " في " الوجه .
وفي هذه القصّة يضعنا الراوي – والحكاية تُسرد بضمير المُتكلّم – ومن ورائه القاص في مركز الحدث بدءاً من لحظة الاستهلال الأولى ، مكسّراً قواعد السرد الخطّي :
(أتفرّس في الحروف المتراصّة ، أفترسها ... أتتبّع معاني العبارات المُنسابة ، أُدركها . فيتملّكني العجب لما حدث وكيف حدث . أُلقي نظرة متسائلة عبر النافذة المُغبرّة ، فلا تصافح عيني سوى كثبان رمليّة صفر ، تنداح مترامية ، حتى نهاية الأفق ، حيث تلتصق بوجنة الشمس الغاربة ، فتعفّرها) (ص 289) .
ويمكننا – وبثقة معقولة – اعتبار هذه الخاصيّة من سمات القاسمي الأسلوبيّة في أغلب قصصه القصيرة ليس في هذه المجموعة : "أوان الرحيل" حسب ، بل في مجموعاته القصصية الأخرى التي ضمّها هذا الجزء من أعماله الكاملة . فهناك إحساس مباغت بالتوتّر وبأنّ "شيئاً ما" غير طبيعي يقع أو سيقع قريباً ، يحقّقه في نفس القارىء منذ الأسطر الأولى في الحكاية . ويتعضّد هذا التأثير بسمتين أسلوبيتين أخريين هما : وحشة المكان ، وقلّة عدد الشخصيات في الحكاية ، وعزلتهم الفعليّة أو النفسيّة . ففي "ما يشبه القصّة" الافتتاحية في المجموعة :
# "ما يُشبه القصّة" الإفتتتاحية "البحث عن قبر الشاعر البياتي" : وبالرغم من استهلالها الوصفي المُتعادل نفسيّاً إلّا أنّ الحكاية تضم شخصية واحدة مركزية هي الراوي ومسرحها هو "مقبرة" .
# قصّة "جزيرة الرشاقة" : فيها شخصية مركزية هي الراوي ، ومكانها الأساسي بلدة بائسة تلفظ أنفاسها ، في حين أنّ مكانها المُتخيّل هو جزيرة في طريقها نحو الخراب .
# قصّة "الكومة" : استهلالها اكتئابي شبحي ، وبطلها شخصية واحدة مع "كومة" يتكشّف لاحقاً أنها امرأة عجوز ميّتة ، ومسرحها حديقة عامة خالية تلفها العتمة في جو عاصف جليدي .
# قصّة "الحمامة" : استهلالها يقبض النفس في طريق أجرد وأرض كالحة عجفاء ، وشخصيّتها الرئيسية واحدة هي الراوي مع شخصية مساعدة هي ابنته الصغيرة .
# قصّة "الكلب ليبر يموت" : استهلال عن أنفاس كلب يُحتضر ومشاعر شاب متغرّب ساخط في بيت أرملة وحيدة مستوحشة ، شخصيتان فقط . والمكان : شقّة منعزلة .
# قصّة "الساعة" : استهلال موجز صادم "الغرابة مُجسّدة في رجل" ، شخصيّتان : الراوي وزميله "الغريب" ، والمكان بيت "الغريب" الأكثر غرابة وعُزلة .
# قصّة "المُشاكسة" : استهلال هادىء مُريح يُمهّد لكارثة فاجعة ، شخصيّتان : فاطمة والغريب المُشاكس ، مشاعر الوحدة وسط صخب الشارع .
# قصّة "النجدة" : استهلال صادم لشخص جريح مشوّش ، المكان طريق ريفي مُنعزل ، شخصية واحدة .
# قصّة "القارب" : استهلال صادم "قاربٌ صغير توقّفت عليه حياتي وتعلّق به وجودي" .. والمكان شاطىء موحش قصيّ ومنعزل ، شخصيتان : الراوي وصديقه الرسّام .
# قصّة "الظمأ" : استهلال صادم عن شخص تسقط سمّاعة الهاتف من يده ويهرول بعد تبليغه بموت صديقه الرسّام ، المكان طريق المطار في غروب عاصف ممطر خطير ، ثم شقّة معزولة . والشخصية الرئيسية واحدة .
# قصّة "الغزالة" : استهلال هادىء ، في صحراء شاسعة ، وشخصية واحدة هي الراوي الضائع المهدّد بالجوع والعطش ، وبالذئب المُفترس .
# قصّة "الخوف" : استهلال مستفز نسبيّاً عن رجل عاطل يأتي الشاطىء بحثاً عن الهدوء ، شخصيّة مركزيّة واحدة ، والمكان ربوة عالية على شاطىء منعزل خال.
# قصّة "الرحيل" : استهلال عن زيارة امرأة لرجل مريض في الأسبوع الأخير من نزاعه الخاسر مع الموت .. شخصيّتان : المرأة والرجل المريض .. والمكان غرفة في مشفى مطلّة على شاطىء أجرد .
# قصّة "النهاية" : استهلال مكتفٍ بنفسه : "قرّرتُ مساء أمس أن أحدّد تاريخ وفاتي بنفسي ، وأشيّع نعشي بنفسي" .. شخصية واحدة هي الراوي الوحيد المتشائم .. المكان "شقّة ضيّقة حقيرة" .
# "ما يُشبه القصّة" الختاميّة "هل تداوي الكتابة الطفولة الجريحة ؟" وهي القصّة الأخيرة : استهلال عن رجل مُتعب ومُنهك يبحث عن الراحة من كوارث العالم .. شخصية مركزيّة واحدة هي الراوي .. المكان قاعة عروض أو محاضرات .
ولا يخرج الأمر في هذه القصّة : "المدينة الشّبح" عن هذا الإطار الأسلوبي المقصود طبعاً ، فالإستهلال – كما قلنا – يثير التوتّر في نفس المتلقّي ، ويحفزه لبناء توقّعات سلبيّة ، والتوقعّات السلبيّة – وليست الإيجابية كما يرى البعض - هي روح الحكاية ، الحكاية تموت مع اتفاق توقّعات القارىء مع التحوّلات المستقبلية الجارية والمتوقّعة على أرض الحكاية . الحكاية تُبنى على اساس لعبة "الغرفة المُقفلة المحظورة" كما في حكايا ألف ليلة وليلة ، والتي – أي الغرفة – يُحذّر منها ، وعلى القارىء أن يتجاسر ويفتحها لتحلّ عليه لعنة السرد المُبهرة . والكاتب المُقتدر هو الذي يستمر - حتى قريباً من نهاية الحكاية حيث تكمن – في أغلب الأحوال - لحظة التنوير كما يُصطلح عليها عادة – في استدراج القارىء ، و"تحذيره" ، من مغبّة فتح الغرفة المحظورة ، عبر "الجرع" السرديّة المُنذرة التي يقدّمها له ويحقن وعيه بها في الطريق إلى فكّ "عقدة" القصّة . وهذا ما يقوم به القاسمي عبر راويّه في هذا النصّ . فلم يكشف لنا الراوي ما هي طبيعة الحروف التي يفترسها . ففعل "الافتراس" يرتبط في أذهاننا بعمليّة نهش وفتك تتوّج بالقتل العنيف . ويتضمن الافتراس كسر عنق الضحيّة قبل موتها ولهذا نهى الإسلام عن فرْس الذبيحة . والقاسمي نفسه تحدّث في أحد حواراته وبصورة موفّقة عن جهده في أن يكون انتقاؤه للمفردات دقيقاً ، واختيار التراكيب النحويّة معتنى به :
(أنا ممن لا يقرّون بوجود الترادف الكامل بين الألفاظ ، ولهذا أتوخّى استعمال كل لفظ للمعنى الذي وُجد من أجله . فمثلاً كثيراً ما تُستعمل الأفعال (لسع) و (لدغ) و (نهش) كما لو كانت مترادفات تامّة الترادف ، في حين أن الأصل غير ذلك . فـ (اللسع) للعقرب وكلّ ما يضرب بذنبه ، و(اللدغ) للحيّة وكلّ ما يضرب بفيه ، و(النهش) للسبع وكلّ ما يعضّ بأنيابه) (44) .
والافتراس يتضمّن أيضاً النهش الذي هو التقطيع بالأسنان .
كما لم يكشف لنا الراوي أيضاً طبيعة "أصوات الكلمات المتعاقبة" ، التي كان "يلوكها" تعبيراً عن التلعثم والتلجلج في الكلام ، وهما : الافتراس واللوك ، استخدامان مُفرطان أراد منهما الراوي كشف حدّة وقع مفاجأة الكلمات في نفسه ، وشدّة الانفعال الذي اثارته في أعماقه ، ليعود ويطفىء جذوة الانفعال التي أثارها من خلال التسلسل "الهادىء" للعمليّة الإدراكيّة :
(أتتبّع معاني العبارات المُنسابة ، أدركها)
ويضاعف القاص انشدادنا ، ويؤجّج تعلّق أنفسنا بالغرفة المحظورة الخاصّة بهذه الحكاية من خلال إعلان عدم قدرة الراوي نفسه على معرفة ما يجري فيها :
(فيتملّكني العجبُ لما حدث وكيف حدث)
ثمّ يأتي توظيف المكان – وهذا مخطّط القاسمي في رسم هيكليّة وقائع حكاياته عادة – ليصعّد فعل السرد ويعضّد وقع مفردات اللغة ، مثلما يؤثّث المكان بالمكوّنات و "الإكسسوارات" المطلوبة الكفيلة بتدعيم الفعل التوتّري المطلوب :
(ألقي نظرة متسائلة عبر النافذة المُغبرّة ، فلا تصافح عيني سوى كثبان رمليّة صفر ، تنداح مترامية ، حتى نهاية الأفق ، حيث تلتصق بوجنة الشمس الغاربة ، فتعفّرها . كثبان صامتة ناطقة في آن ، كثبان تفوح بعبق الصحراء بجميع أسرارها الدفينة ، وبكلّ تاريخها الموغل في قلب الزمن ، الغائر في خاصرة الغرابة) (ص 289) .
ولو توقّفنا قليلاً عند استخدام الفعل "تعفِّر" الذي وصف به القاسمي الكيفية التي تلتصق بها كثبان الرمال بـ "وجنة" الشمس ، لأدركنا الدقّة الهائلة من ناحية الاستخدام اللغوي أوّلاً ، فالتعفير من العفر أي التراب ، والفعل "خاصّ" بتمريغ شيء ما كالوجه مثلاً في التراب ، ولإدراكه هذه الحقيقة اللغويّة جعل الرمل يلتصق بـ "وجنة" الشمس وليس وجهها كلّه . وثانياً ، فإنّ الكثير من المشاهد التي "يرسمها" القاسمي هي "لوحات" بحق ترتّب جهداً مُضافاً على القارىء في التخييل لتركيب الصورة بعد استحضار مكوّناتها بخواصها اللونيّة المعروفة . فقط ، أغمض عينيك لحظات لتتصوّر الكيفية التي تلتصق بها كتلة الرمل البيضاء بوجنة الشمس الغاربة الحمراء .
وفي أوّل حركة حوار بين الراوي وزوجته الأمريكيّة ، يستمر القاص بلعبة الاستدراج والمراوغة وتأجيج نزعة الفضول لدينا ، ونستمر في وقفتنا أمام باب الغرفة المحظورة المُغلق :
(أُديرُ وجهي إلى زوجتي الأمريكيّة المتسمّرة أمامي المحدّقة بي ، وأترجم لها ما وعيتُ ، فتُبرقُ الدهشة في عينيها وتقول :
- عجيبٌ ، هذا أمرٌ هائل ! الآن لستُ نادمة على الرحلة ) (ص 289) .
لقد حاولتْ – في البداية – ثنيه عن القيام بتلك الرحلة للعثور على المدينة التي هاجر منها جدّه إلى أمريكا ، فهي ترى أنّه يرمي بنفسه في لجّة الخطر ، حين يجوب مجاهل الصحراء ، وأنّ الماضي لا ينفع من الناحية العمليّة ، ونحن نخطو حثيثاً نحو عتبة القرن الثاني والعشرين . كانت تدعوه إلى أن يكون ابن يومه ، وينظر إلى الأمام ، ويتطلّع إلى النجوم الشامخة ، ولا يلتفت إلى الوراء (ص 289) .
وسيلفت نظر السيّد القارىء – حتماً – تعبير حاد ونابٍ ، يحمل معاني الخشونة ، وذلك حين استعاد الراوي ما ختمت به زوجته الأمريكية حديثها ، وهي تحاول صرفه عن الرحلة :
(لا تحدّق في حضيض الوحل)
إذ تعكس وجهة نظرها هذه موقفاً حضارياً من مسألة التاريخ والعودة إليه وإلى استكشافه ، محكوماً بثقافتها التي شكّلت وعيها في مجتمعها الأمريكي ، وهي نظرة تخالف موقف الزوج / الراوي الذي نشأ في بيئة عربيّة صاغت وعيه وطريقة إدراكه لقيمة الماضي . الزوجة انحدرت من بلاد تجوس في لاوعيها "عقدة التاريخ" ، فهي بلاد حديثة النشأة كلّما أدارت راسها نحو تاريخها رأت بدايته على مبعدة خمسة قرون ، في حين أنّ أمم العالم تتحصّن بنرجسية تاريخية مديدة . عقدة التاريخ هي جرح نرجسي غائر في شخصيّة الأمريكي يحاول ترميمه بنجاح من خلال الانشغال بالحاضر . لكنّه خلق نقمة لاواعية على الأمم ذات العمق التاريخي الهائل والحضارات العملاقة . لهذا لا تمدّ الولايات المتحدّة يدها إلى اي أمّة إلّا لتحوّلها إلى هشيم ، وتحيل أبناءها خدماً وبغايا . ثمّ إنّ الإلتفات إلى نقطة الماضي يثير مكامن "الشعور بالذنب – Guilt Feeling" بسبب إبادة "الآخر" البرىء ، إبادة وحشية مسعورة ارتبطت بالنشأة وفق شعار "شعب بلا أرض ، لأرض بلا شعب" ، والذي ورثته الصهيونية وكان – مع النشأة الدمويّة - واحداً من أهمّ عوامل التطابق النفسي بين الجانبين ، كانت نشأة شبيهة بالمجزرة ، أو هي مجزرة فعليّة قتل الروّاد فيها أكثر من (100) مليون مواطن أصلي (هندي) حسب المؤرّخ "نعوم تشومسكي" .
ومن الجائز أن يكون هذا الإعجاز التكنولوجي العظيم الذي يتحقّق كلّ لحظة في هذه القارّة ، محاولة لمراكمة الزمان في الحاضر ليُصبح تاريخاً ! ، أو للهروب نحو المستقبل بكل قوّة في نوع من الفرار العصابي الخلّاق من الماضي إذا ساغ الوصف ، إعجاز من نتائجه – مثلاً – هذه السيّارة الكهربائية المجهّزة خصيصاً للسير في الصحراء ، تنساب بهما – الراوي وزوجته – على الرمال مثل ضبّ مرتعبٍ هارب :
(وكان طنين محرّكها يتلاشى في فضاء الصمت المطبق حولنا . وراحتِ الشمس تدلقُ أشعتها الذهبيّة الساطعة على الصحراء المتموّجة أمامنا ، فتكرعها الرمال العطشى ، ولا تذر في قرارة الكأس شيئاً ، ما عدا سراباً تلمحه عيوننا ، وهو يرتفع وينخفض مثل ماء بحيرةٍ نائية) (ص 289 و290) .
ولله درّك يا علي القاسمي كيف ركّبتَ هذه الصورة الباذخة !
لاحظ الاتساق الحركي داخل هذه "اللوحة" التي رسمها القاسمي ، والتي لا يكتمل إدراكك الشافي لها وتتحقّق متعتك العالية بها إلّا إذا أغمضت عينيكَ هنيهةً ، وتصوّرت حركة طرفيها : الشمس وهي "تدلق" أشعتها الذهبيّة ، والرمال العطشى وهي "تكرع" الأشعة . فلكي يشرب الإنسان الماء برغبة زائدة وبشغف شديد ، يمدّ عنقه ، ويشرب بفيه (بفمه) مباشرة من موضعه من غير أن يشربه بكفّيه أو بإناء ، وهذا هو معنى "الكرع" أو "الكروع" ، يجب أن يُسكب له الماء ويُصبّ بسرعة ، متوالياً ، أو دفعة واحدة ، وهذا هو معنى "الدلْق" أو "الدلوق" . فتخيّل ! وأيّ تناسق حركي هذا ، وأيّة دقّة لغويّة هذه !
وبنظرة تراجعيّة سريعة إلى الشوط الذي قطعناه من القصّة ، سوف نجد أنّ أغلب الافعال والصفات التي استخدمها الكاتب جاءت متّسقة ومتكاتفة لتشيع جوّاً حركيّاً وفعليّاً متفجّراً وعنيفاً ، بدءاً من لحظة افتراس الحروف ، ولوك الكلمات ، واندياح الكثبان ، وتعفير وجنة الشمس ، مروراً بوصف الكاتب لطبيعة نقاش زوجته معه : "ارتطمت كلماتها وتوسّلاتها بجدار إصراري الصلد" .. ووصولاً إلى هذا الموقف الذي تنساب فيه السيّارة الكهربائية كضبّ مُرتعب هارب في الصحراء حيث الشمس تدلق والرمال تكرع . وليس انتهاء بهذه الفقرة ، فهذه السمة سوف تستمر حتى نهاية القصّة كما سنرى . وهذا الاستخدام اللغوي المُعجمي محكوم بالموقف النفسي للشخصية – بتصميم الكاتب طبعاً – ، وبالمناخ النفسي العام للحكاية ، وليس بفعل "بنية" اللغة الحاكمة وسلطتها الجائرة التي لا تُرد . ومن بين عشرات الكلمات التي "تبدو" مناسبة لوصف الكيفية التي تظهر فيها المعلومات على شاشة حاسوب السيّارة استخدم الكاتب لفظة "المُنثالة" لتعبّر عن الطريقة التي تتابع فيها المعلومات وتكثر وتتجمّع ، فلا يدري المرء بأيّها يبدأ .
ها هو الراوي ، وزوجته ، يصلان مقصدهما ، مدينة الجدّ ؛ جدّ الراوي . كانا يعتقدان ، كما هو متوقّع من عودة إلى مدينة قديمة اندثرت في عمق الصحراء ، أن تقابلهما الأطلال والخرائب ، خصوصاً أن مفردة "الصحراء" تثير في الذهن – ذهن الغربي الأمريكي بشكل خاص – رسوم الخيام والجمال . ولكن ما حصل كان أمراً مثيراً للدهشة والعجب ، فقد ضمتهما مدينة ذات شوارع عريضة فارهة ، وعمارات كبيرة فخمة . مدينة قائمة بكلّ مبانيها ومرافقها ، لم يصبها زلزال ولم يجتحها طوفان . ولكنّها كانت مهجورة خالية ، لا إنسان فيها ولا حيوان ولا نبات . وهنا يبرع القاسمي – وبعينه "السينمائية" – في تقديم جوانب من حركة الاشياء المُرهبة وبقاياها المتآكلة في المشهد الموحش :
(كانت بعض أبوابها ونوافذها تتحرّك بفعل الريح الخفيفة ، فيصدر عنها صرير يبذر الرهبة والتوجّس في نفوسنا . وعلى الطرقات ، تناثر زجاج بعض شبابيكها المتهشّم ، مُختلطاً مع أكوام الرمل التي تجمّعت هنا وهناك) (ص 290) .
مدينة كاملة بكافة مستلزماتها المادّية المتطوّرة لكنها بلا بشر .. مدينة الجدّ بلا الجدّ . وفي الأحياء الغربيّة الفاخرة المهجورة عثر الراوي على منزل عليه اسم أُسرته . وفي المنزل يجد الأثاث بكامل عدّته والستائر المُسدلة مرتعشة كأنّ أصحابه غادروه ذلك الصباح . وعندما يرتقيان السلّم إلى الطابق العلوي ، يجد مكتبة جدّه ، ويعثر على دفتر مذكراته . وهنا يتمّ فتح باب الغرفة المحظورة لتنفلت منها غيلان اللعنة ، ويعيدنا الراوي بحركة دائرية إلى "التفرّس" و"الافتراس" في السطر الأوّل من الاستهلال وكأنّه يغلق الأبواب علينا ، لكن مع غيلان اللعنة ، هذه المرّة ، لتولغ في دمانا ، وتهيج ضمائرنا ، وتُشعل مخاوفنا ، مفتتحاً هذه المواجهة بشطرة شعريّة شديدة الأذى :
(قبضتُ على جمر الحنين بمهجتي) (ص 291) .
والأسلوب اللغوي التعبيري للقاسمي عربيّ الوجه واليد واللسانٍ ، ليس في سرده الوصفي المباشر حسب ، بل في صياغاته الشعريّة بدءاً من أعلاها تصويراً وكأنّه شطرة من شعر التفعيلة : "وكدنا نرفع راية اليأس على سارية الإعياء" ، إلى أبسطها سبكاً كسجع من سجعات ألف ليلة وليلة : "انتقلنا من غرفة إلى أخرى ، وقلبي يحدوهُ الحنينُ ، فيذوبُ خفقاناً ، ويحرقهُ الوجدُ ، فيذوبُ ذوباناً" (ص 291) .
واعتباراً من لحظة عثور الراوي على مكتبة جدّه ، يختفي صوت الزوجة الامريكية ، ويتلاشى حضورها تماماً ، فالأمر الآن لا يخصّها ، وليس من بين انشغالات وعيها الجوهرية مراجعة تاريخ جدّ الراوي المُسطّر في دفتر مذكراته . وهو في الحقيقة تاريخ نهايات مدينة الجدّ التي تعود ، كما تشير الفقرة الأولى من المذكّرات ، إلى عام 2081 ميلادي ، أي أننا أمام نوع من فنّ الخيال العلمي والتاريخي ؛ الخيال العلمي متمثّلاً في السيارة الكهربائية التي كانت تنساب بسرعة على الرمال والتي لم تُطرح للاستعمال العام في زماننا هذا . أمّا الخيال التاريخي فهو هنا نقلة في الزمان يعالج فيه القاص وقائع "حصلت" في زمان بعد زماننا ، زمان هو ماض بالنسبة لشخصيات النصّ (أعتاب القرن الثاني والعشرين كما تقول الزوجة وعامي 2081 و2082 كما تشير مذكرات الجدّ) ، لكنّه مستقبل بعيد نسبيّاً بالنسبة للمتلقّي . لكن حوادث النصّ المستقبلي هذا واقعة في الحقيقة في حاضرنا - بل هو يجري ويا للمصادفة !! في أيامنا هذه - وفي ماضينا القريب ، ولكن الفارق الحاسم هو في وصول هذه المتغيّرات والوقائع إلى نهاياتها القصوى التي ما زالت في إطار النُذر والتخييل والتحذير المستقبلي . وهذه أهميّة الفن العظيمة حيث يصوّر لنا عمليّاً ما يستحيل تصوّره ، ويّربك اشتراطات الزمان الذي اعتدنا على أن نقسّمه إلى ثلاث ابعاد : ماض وحاضر ومستقبل ، الماضي ما عشناه ، والحاضر ما نعيشه ، والمستقبل ما سوف نعيشه . أي أننا إذا عشنا المستقبل فسوف لن يصبح مستقبلاً بل حاضراً ثم – بعد لحظات – ماضياً . النصّ في الواقع يجعل كل الأبعاد "حاضراً" نعيشه حتى لو كان مطروحاً بصيغة الماضي أو المستقبل . وعام 2081 بالنسبة للراوي وزوجته هو ماضٍ مرّ عليه أكثر من عشرين سنة (هما الآن – لاحظ مفردة "الآن" – على عتبة القرن الثاني والعشرين - ، ولكنّه بالنسبة لنا "حاضر" على الرغم من أنّ هذا العام – تقويميّاً – هو مستقبل بالنسبة لنا . مثل ذلك نقوله عن العام 2082 بالنسبة للزوجين ، فهو ماضٍ بالنسبة للزوجين ، ولكنه حاضر لهما في النصّ / دفتر المذكّرات ، وهذا جانب آخر يجعل من الإبداع عموماً ، والحكاية خصوصاً ، دفاعاً للحياة بوجه الموت ، وواحداً من أهمّ الإمتدادات الخلوديّة لدى الإنسان ضد الفناء .
وبأناملَ مرتعشةٍ ، ومثلما يفتح طفلٌ كتابه الأوّل في المدرسة بدأ الراوي بمراجعة مذكّرات جدّه :
(20 أبريل 2082
اقتصادنا راكدٌ تماماً مثل مُستنقع آسن .
25 أبريل 2081
البترول الذي ننتجه ، هو السلعة الوحيدة في العالم التي ينخفض ثمنها باستمرار ، خارقاً بذلك جميع المبادىء الاقتصادية . منذ أربعين عاماً ، وسعر البرميل في انخفاض دائم ، هبط أكثر من مائة وعشرين دولاراً إلى أقلّ من دولار واحد.
3 يونيو 2081
مصادر الطاقة البديلة تجعل من بترولنا سلعة بائرة ، شيئاً تافهاً لا قيمة له .. إنّه فخم القرن الحادي والعشرين . حتّى في بلادنا لا نستطيع الاستفادة من البترول . فجميع الآلات والمحرّكات والسيّارات التي نستوردها ، لا تعمل بالبترول مطلقاً) .
وتشاء الأقدار الأمريكية الغربيّة أن أقرأ هذا النصّ وأحلّله ، والرعب يجتاح الناس في بلادي ، التي دمّرت الولايات المتحدّة الأمريكية كل إمكاناتها واحرقت كلّ ثرواتها وذبحت شعبها (مليوني قتيل حتى الآن) ، لأنّ أسعار النفط تنخفض بشكل سريع ليست له أي صلة بوضع السوق العالمي ، فالشتاء يضاعف الطلب ، والصناعات الغربية في نمو ، والعمليات العسكرية التي تحتاج البترول متأجّجة بتخطيط الغرب للربيع العربي الذي أصبح خريفاً دامياً ، وبإرادة الولايات المتحدّة التي اعترفت هيلاري كلنتون بإنشائها منظمة داعش لتمزيق الوطن العربي وفق سياسة سايكو بيكو جديدة لا تجزّىء الدولة الواحدة إلى مقاطعات بل إلى دويلات أحياء وحارات ، وإشعال حروب دامية تستمر لثلاثين عاماً باعتراف وزير الدفاع الأمريكي . ومنذ عقود وكل المُراقبين المُنصفين كما يقول راوي القصّة منصدمين من حقيقة أنّ كل سلع الغرب .. حتى الأحذية ، ترتفع اسعارها إلّا سعر برميل البترول فهو ينخفض . وهذا ليس مُرتبطاً كما يقول الراوي باكتشاف أو اختراع مصادر طاقة بديلة كالسيّارة الكهربائية التي جاء بها مثلاً . أبداً . يجوز أن يحصل ذلك في نهاية القرن الحادي والعشرين ، أي في التواريخ التي ثبّتها الجدّ في مذكراته وهي 2081 و2082 وغيرها ، ولكن الآن وسعر البترول ينخفض ، هل هناك مصادر طاقة بديلة اكتشفها أو اخترعها العالم الغربي لتحلّ محلّه ؟ وهل يمكن "ضغط" الطاقة النوويّة في قدّاحة لإشعال سيجارة مثلاً ؟
وحسناً قام القاسمي – وبجرأة نادرة بعد عمليّة "الإفساد الثقافي النفطي" حسب تسميّة الراحل الكبير "عبد الرحمن منيف" والتي قامت بها الثروة النفطيّة التي درّبت الكثير من المثقفين العرب – حتى الثوري المُناضل منهم - و"علّمتهم" ما المطلوب منهم "كتابته" في "ثقافة" النفط ليكافأوا عليه – بالإشارة إلى تسميات أصحاب المنازل في مدينة الجدّ النفطيّة :
(كان بعضها [= المنازل] موصداً ، وبعضها الآخر مغلقاً ، وبعضها مفتوحاً على مصراعيه (ولاحظ دقّة الكاتب في استخدام مفردتي الموصد والمغلق لوصف أبواب المنازل بصورة ليست مترادفة – الناقد) . وكلّها تحملُ قطعاً نحاسيّة أو خشبيّة كُتب عليها اسم الإقامة . وأغلب الأسماء مؤنّثة على غرار (فيلّا حصّة) و (فيلّا جوهرة 2) .. ) (ص 290) .
وتتعزّز هذه الإشارة بالفقرة التالية التي يطالعها الراوي من مذكّرات جدّه :
(العمال والمستخدمون الأجانب يغادرون البلاد بكثافة ، لا لتمضية العطلة الصيفيّة مع أهاليهم ، وأنّما إلى الأبد ، بسبب انخفاض الأجور التي لم يقبضوها منذ شهور . قبل عشر سنوات ، كنّا نسعى إلى طرد العمّال الأجانب الذين لا يتوفّرون على رخصة إقامة صالحة ؛ أمّا اليوم ، فيصعب علينا استقدام العمّال . لقد نضب المال الذي كان يجذبهم . أمّا نحن ، فجذورنا جذور نخلة تضرب بعيداً في أعماق التربة ، وليس في مقدورها أن ترحل مع الريح كالأشنات) (ص 292) .
إنّ قيم البداوة التي تحدّث عنها ، كثيراً جدا ومنذ أكثر من ستين عاماً ، عالم الإجتماع العراقي الراحل "علي الوردي" ، المكينة والكامنة عميقاً في لاشعورنا هي التي تتحكم بسلوكنا تجاه ثروات "نزلت" كالغيث الذي ترسله السماء للبدوي بعد انتظار .. فيأكل هو وقطيعه حتى يُتخم ويقضي على ما موجود فيه من كلأ ، ويرحل بحثاً عن مرعىً جديد (مرعى وليس مصدر طاقة بديل) . وها هم سكّان مدينة الجدّ ، وبعد أن قضوا على الكلأ النفطي ، ينامون في العراء ليلاً ، ليصيبوا شيئاً من النوم . فقد بلغت درجة الحرارة اليوم – كما يقول الجد في مذكراته – أكثر من خمسين درجة مئوية . وأجهزة التبريد في عدد كبير من العمارات مُعطّلة .. وأمست الصناديق الإسمنتية المُسمّاة بالشقق ، قِطَعاً من جهنم لا تُطاق (ذكريات يوم 25 يوليو 2081) (ص 292) .
لقد بُنيت حياتنا كلّها على اساس ثروة ليس لنا يدٌ فيها أبداً . حتى الذين اكتشفوها واستخرجوها وكرّروها كانوا أجانب .. كانوا يقومون حتى ببيعها ووضع المال في جيوبنا وافواهنا فـ "قطعوا" ألسنتنا !.. هم كانوا يريدون ذلك ، ونحن كنّا ، وما زلنا ، لدينا "الاستعداد" النفسي الكامل للعيش الطفيلي المُرفّه . والرفاه يقتل الشجاعة حسب قول أحد الحكماء ، ولكنه – في مدينتنا - قتل "العقل" أيضاً ، و (إنّ الذي يحزّ في نفوسنا ، هو الجفاف الذي اصاب عقولنا . لم يخرج أيٌّ منّا بأيّ بدائل مقبولة) (ذكريات يوم 30 يوليو 2081) .. لقد جفّت العقول ورُفعت الصحف ! وها هي الصحيفة المتبقّية الوحيدة في المدينة التي كان يكتب فيها الجدّ تواصلاً مع الآخرين ، قد توقّفت عن الصدور ، فأحجم عن الكتابة ، ولم يعد يدوّن سوى مذكراته الحميمة التي بين يدي الراوي "الآن" . ولكن حتى في هذا النشاط بدأ يستولي عليه الإحساس بالخواء واللاجدوى ، وصار يتساءل : لمن أكتب ؟ غداً ستذروا الرياح أوراقي ، وتطمس الرمال كلماتي . لقد أوهم الغربيون المرجعيات السياسية الحاكمة في مدن البترول بأنّ "الحداثة – Modernism " هي في هذه الكتل الكونكريتية الهائلة وليست في بُنى "العقل" ، في حين أنّهم أوقعوهم في مصيدة "التحديث - Modernization" الإسمنتي .
لكن البترول مهما كانت أهمّيته ، لا يشربه الإنسان ، ليس البترول هو فيصل الحياة والموت ، هذا بالنسبة للغرب ولشركاته العابرة للجنسيات التي أبادت الملايين من سكّان مدن البترول من أجله ، الماء هو فيصل الحياة والموت بالنسبة لأهالي مدن البترول ، خصوصاً وهم يؤمنون بـ (وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّ) . أهالي هذه المدن أقنعوهم بزراعة الحنطة وريّ مزارعها الشاسعة من المياه الجوفية وهي مصدر ماء الشرب الوحيد الذي سوف ينضب ليبدأوا بشراء الماء من تركيا ! :
(5 يناير 2082
تواترت الإشاعات حول احتمال انقطاع الماء من محطّة تحلية مياه البحر بصورة نهائيّة . والآبار لا تسدّ حاجتنا من الماء . شبح العطش يطلّ علينا مع مطلع العام الجديد) .
أوهام وأوهام وأوهام قاتلة وخطيرة زرعها خبراء الاقتصاد الغربيون في عقول أهالي مدن البترول الذين ساعدت التركيبة القدريّة العقلية على سقوطهم في شباك تلك الأوهام ضمن لهاث مُنسعر نحو "تحديث" انتفاخي يداري النرجسية الجريحة التي تسلّط عليها "أبٌ" عصيٌّ على القتل ، سدّ على الأبناء كل منافذ الاستقلالية والإبداع . أبٌ يتغنّى مثل الجدّ والجدّ رمزه ، بالتمسّك بالجذور والصمود حتى الموت . ففي نهاية أغلب الذكريات كان الجدّ يردّد :
(أمّا نحن ، فجذورنا جذورُ نخلةٍ نضرب بعيداً في أعماق التربة ، وليس في مقدورها أن ترحل مع الريح كالأشنات) (ذكرى 30 يونيو 2081) .
(وسنبقى هنا متمترسين في مواقعنا ، حتى بعد أن يتفتّت المرمر ويتهرّس الإسمنت) (ذكريات 30 يوليو 2081) .
(أمّا نحن فباقون هنا . جذورنا ملتحمة مع تربتنا التحاماً لا فكاك له) (ذكريات 30 نوفمبر 2081) (ص 293) .
وهذه هي "العقليّة الشعريّة" التي حذّر منها أيضاً الراحل "علي الوردي" منذ أكثر من ستّين عاماً . هذه " العقلية الشعرية " التي تقوم على التفكير المجازي ، والأحكام العاطفية ، والتعريفات الفضفاضة ، كان للوردي فضل ريادي كبير في التنبيه إلى الجوانب السلبية في هذا النمط من التفكير . يقول الوردي :
(إني في الواقع لا أحب أن أزهد الناس بالشعر أو أصرفهم عن دراسته فالشعر حقل مهم من حقول المعرفة ، ولا غنى للباحث في المجتمع العربي وتاريخه عن دراسة الشعر . ولكن الذي أريد من الناس هو أن يدرسوه دراسة حياد وإنصاف ، لا دراسة حب وتعصّب . إذا كان للشعر منافع ، فله مضار أيضا ، وربما ضرره بالأمة العربية أكثر من نفعه لها . لست أنكر على أي حال ما احتوى عليه الشعر العربي من حكمة وروعة ، إنما لا يجوز أن يمنعنا هذا من النظر في سخافاته وأباطيله في الوقت ذاته . إن الشعر كأي شيء آخر في هذه الدنيا يحتوي على المحاسن والمساويء معا . وعلى الباحث أن ينظر فيه من كلا الوجهين إذا أراد أن يكون باحثا حقا . أما التأكيد على أحد الوجهين وإهمال الوجه الآخر ، فهو أمر لا تستسيغه طبيعة البحث الحديث) (45) .
كما قال أيضاً في مؤلّف آخر :
(إن زمان السلاطين قد ولى وحل محله زمان الشعوب . وقد آن الأوان لكي نحدث انقلابا في أسلوب تفكيرنا . فليس من الجدير بنا ، ونحن نعيش في القرن العشرين ، أن نفكر على نمط ما كان يفكر به أسلافنا في القرون المظلمة . إن الزمان الجديد يقدم لنا إنذارا . وعلينا أن نصغي إلى إنذاره قبل فوات الأوان . إنه زاحف علينا بهديره الذي يصم الآذان . وليس من المجدي أن نكون إزاءه كالنعامة التي تخفي رأسها في التراب حين تشاهد الصياد . فهي لا تراه وتحسب أنه لا يراها أيضا . الأفكار كالأسلحة تتبدل بتبدل الأيام . والذي يريد أن يبقى على آرائه العتيقة هو كمن يريد أن يحارب الرشاش بسلاح عنترة بن شداد) (46) .
والجدّ ، جدّ الراوي ، وكما يتّضح من ذكرياته ، مازال مصرّاً على محاربة كلّ تلك المخاطر الجسيمة التي توشك على اجتثاث كلّ مظاهر الحياة في مدينته ليس بسيف عنترة بل بمعلّقته . فالناس تهرب من المدينة بلا رجعة بسبب نضوب البترول ، وتوقّف محطة تحلية المياه ، وقرب جفاف البئرين الوحيدين .. وهو مابرح يتغنّى بالجذور والولاء للمدينة والتمترس في المواقع والصمود حتى النصر .. نعم ، هذه الروح المقاومة مطلوبة ، لكن الكلمات لا تؤكل خبزاً . مع هذه الروح يجب أن يتحسّب الإنسان ، ويخطّط ، ويعمل . لم يخبرنا الجدّ ماذا كان يعمل ؟ وما هو سبب الخراب ، ومن الذي يتحمّله ؟ لقد اكتفى بدور المراقب السلبي الذي ينفعل ثمّ يصوغ انفعالاته بعبارات شعرية خلّابة تأخذ بالألباب ، ومن يؤمن بها ستتخدّر إرادته عن ردّ الفعل الصحيح ، ويغفو ، ليصحو ، وقد بركت على صدره غولة الكارثة المميتة ! غادر المدينة جيرانه دون أن يودّعوه ، حتى أخوه غادر المدينة ، بعد أن حذّره من أنّ الخوف يتراقص على شفتيه وأصابعه ، ولا بدّ من الخروج من مملكة الخوف والقلق ، فأجابه بأغنية :
(إنّ سعفات النخلة قد تهتزّ مع الريح ، ولكن جذورها ثابتة في الأعماق .
قال : "سنرى" . وانصرف) (ذكريات 18 فبراير 2082) .
نعم ، الشعر عظيم ، وقد وفّر للجدّ ، وسط العزلة ، وتهديدات الموت ، واحتضار الحياة ، فرصة عظيمة للإحساس بالديمومة والقدرة على البقاء ، متعالياً على أهم الشروط المادّية للعيش وهو : الماء . وفّر له ذلك حتى من خلال "كتابة" أتفه الأمور وأكثرها ابتذالاً :
(أبثُّ مذكراتي أشياء لا قيمة لها ، اشياء تافهة ، أشياء لا تغيّر المصير المترصّد بنا ابداً ، ولكنها تمنحني فرصة للثرثرة مع نفسي فتعوّضني عن الصديق والرفيق ، وتجعلني أتأمّل في مشاعري وسلوكي ، فأشعر أنّني ما زلتُ حيّاً) (ذكريات يوم 20 فبراير 2082) (ص 295) .
ولعلّ أخشى ما أخشاه كقارىء هو أن تنتقل هذه "العدوى" الشعريّة إلى الحفيد القادم من أمريكا ، فهو – أوّلاً – لديه الاستعداد المُبكّر لهذا النمط من السلوك اللاعقلاني (أو لنقل العقلاني شعريّاً لأنّ للعقل الشعري محدّداته وموجّهاته التي تختلف عن العقل الواعي المنطقي ، وهو مرتبطٌ بدرجة أكبر بالتفكير اللاشعوري كما هو معروف) . لقد جعل عائلته مُختلفة عن عائلات المدينة الأخرى . وقد وقف أمام باب المنزل الذي حمل اسم أسرته ، فعجب لأنّه يختلف عن أسماء المنازل الأخرى ، فأحال ذلك إلى ميل الجدّ للتفرّد ، وعدم الإنجرار مع "الجموع" ، هذا الميل الذي انتقل إليه من جدّه كما قال له أبوه في صغره على سبيل الّلوم :
(- تخالف الآخرين دوماً فلا تفعل ما يفعله الناس جميعاً . هكذا كان جدّك) (ص 291) .
ثم يأتي عامل مهمّ آخر يشدّد من توجّسنا حول نوى الروح الشعريّة الكامنة لدى الراوي – هل للوراثة الجينيّة أثر في ميولنا الشعريّة ؟! – ويتمثل في هذه الانفعالية العالية ، وهي "شعريّة" بطبيعتها ، التي أظهرها – منذ بداية القصّة – والتي عبّر عنها في الاستهلال ، وهو يتصفّح دفتر مذكّرات جدّه ، بمفردات حادّة وشديدة الوقع بلغت حدّ : "الافتراس" ! مثلما ظهرت في طبيعة أحاسيسه المُفرطة وهو يمسك بدفتر مذكرات الجدّ لأوّل مرّة حيث تحوّل أوّلاً إلى شاعر عبر شطرة البيت الجميلة التي صاغ بها شعوره :
(قبضتُ على جمر الحنين بمهجتي)
وصار حاله ، ثانياً ، كـ "طفل" يفتح كتابه الأوّل في المدرسة .
لكن مع اقترابه من نهاية دفتر مذكّرات جدّه ، فإنّ الراوي – ونحن معه – سوف نكون ضحايا لعبة "شعريّة" مدويّة . وهذا وجه من وجوه رسالة المبدع علي القاسمي التي عبّر عنها في إعلانه في حواراته بأنّه يضع إبداعه وإمكاناته المعرفية في خدمة الإنسان عموماً ، والإنسان العربي خصوصاً . فالراوي المنسحر بذكريات جدّه التي تعرض كفاحه ، جعلنا نتعاطف مع هذا الجدّ في موقفه المشرّف والبطولي حقّاً في التمسّك بتراب مدينته ، والولاء لمهد ذكرياته كما وصفه . أغلب سكّان المدينة فرّوا ، وحتى العائلات التي أصرّت على البقاء ، وسمّوا الشارع الذي تجمّعوا فيه بـ "شارع الصمود" ، هؤلاء الصامدون بدأوا يتحدّثون عن التوجّه إلى الخارج لتمضية العطلة الصيفيّة . ولكن الجدّ كان يدرك أنّها مجرّد ذريعة للفرار وعدم العودة . لم يبق غير الجدّ صامداً وثابت الجذور في رحم أرضه . لكن تأتي ذكريات الأيّام الثلاثة الأخيرة لتكشف لنا اللعبة المدويّة التي كنّا ضحاياها :
(8 يوليو 2082
لم تبق في شارع الصمود إلّا عائلتنا . إنّه سجن انفرادي قضبانه مُشرعة على الصحراء ..
11 يوليو 2082
ما فائدة انغراز جذور النخلة في أعماق التربة ، عندما ينقصم جذعها ، وتهوي إلى الأرض ؟ الجفاف يطلُّ علينا بوجهه الكالح ، من كلّ حدب وصوب .
14 يوليو 2082
الجفاف يغيّض آخر قطرة في آخر بئر . الجفاف يشربُ دماء قلبي . الجفاف ينشّفُ مداد قلمي . إنّي راحل) (ص 296) ..
هل كان ضرورياً أن يبقى الجدّ صامداً ، ويموت من أجل ولائه واحتراماً لمبادئه وجذوره ؟
هل كنّا سنختلف حول نهايته ، كما نختلف الآن على خيانة الأوطان ؟ وهل هي جريمة كبرى أم وجهة نظر ، ونتجادل مسترخين : هل كان موته انتحاراً وتدمير ذات أم شهادة ؟
قال القاص علي القاسمي في أكثر من مناسبة أنّه حينما يكتب قصصه ، فإنّه يصوغها بطريقة تجعلها قابلة لأكثر من قراءة :
(أميل شخصيّاً إلى كتابة قصّة تحتمل أكثر من قراءة إذا أسعفني الحظّ . فالقصّة الجيّدة في نظري هي تلك القصة التي يمكن أن يقرأها القارىء العام على المستوى الظاهر فيستمدّ منها المتعة والثقافة ، ويقرأها القارىء المتمرّس أو الناقد على المستوى العميق أو الباطن فيتلقّى منها رسالة اجتماعية أو سياسية تحمل وجهة نظر الكاتب . فالكاتب ليس مجرّد بهلوان أو مهرّج يحاول إضحاك المتفرّج فقط ، وإنما هو مثقف ذو رسالة يقدّمها إلى المتلقّي متسربلة في ثوب جنس أدبي يجمع بين التسلية والفائدة . وأنا أطمح إلى كتابة قصّة قابلة للتأويل والقراءات المتعدّدة . والتأويل هنا لا يقتصر على تأويل قولٍ معيّن أو حدث بذاته ، وإنّما يشمل جميع عناصر القصّة ؛ فهو تأويل بنيوي يستغرق بنية القصّة برمّتها) (47) .
فهل يقع ضمن مستويات القراءة تبرير هذا الانقلاب الجذري الذي اصابنا جميعاً بالإحباط ؟ ..
كم هو خطيرٌ دور الأدب ، وكم هو حجم المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق الأديب خصوصاً والمثقف عموماً ؟ المثقف الذي يعتقد القاسمي إنّه في مقدّمة المقصّرين في حقّ أمّتهم ، فهم مع المتعلمين والسياسيين ، كلّهم يعلمون أنّ يوم الجفاف قريب ، ولكنهم يكتفون بتدبيج القصائد وحتى المعالجات الشعريّة في أبراجهم العاجيّة ، أو كتابة دفاتر مذكرات يبحث عنها الأحفاد بعد رحيلهم أي بعد فوات الأوان ، أو يتهيّأون للفرار إلى أحطّ البلدان التي دمّرت مدنّهم وامتصّت ثرواتهم .
لكن هل يبقى المثقف ممسكاً بأرضه ، ومراهناً على جذوره ، والحياة كلّها من حوله قد خذلته ، والموت جفافاً قد صار قاب قوسين أو أدنى منه ؟
هل في موقف المثقف حيرة تكتنفه وتشوّش عليه الرؤية الصافية برماديّة اختياراتها ؟! أم أنّ المواقف واضحة قاطعة فهي إمّا سود أو بيض ؟
أعتقد أنّ القاسمي قد عبّر عن التجاذبات التي تعصف بالمثقف صاحب الضمير الحيّ – وأؤكّد على "صاحب الضمير الحيّ" – بأبدع صورة ، بليغة وجارحة ، تغور كنصل صغير في خاصرة الروح حين قال :
(وهناك حالة نفسيّة غريبة تصيبني لم أستطع التخلّص منها ، فأنا لا أستمتع حقّاً بإمكاناتي المادّية المتواضعة ، إذ كلّما تناولتُ طعامي تذكّرتُ علماء العراق الذين لا أستحق أن أكون تلميذاً من تلاميذهم ، وهم يجلسون على قارعة الطريق عارضين كتبهم للبيع لإطعام أطفالهم ، وشعرتُ بالذنب . وكلّما جلستُ في دارتي المطلّة على البحر الشاسع ، تذكّرتُ أحرار العراق وفلسطين المُسترقة حرّيتهم ، وهم يئنّون تحت التعذيب في معتقلات المستعمر وسجونه ، وشعرتُ بالذنب . وكلّما مررتُ بسيّارتي على أناس ينتظرون ، في الشمس المُحرقة أو تحت المطر ، وسائط النقل العامة السيّئة التنظيم ، شعرتُ بالذنب . وكلّما رأيتُ متسوّلاً أو شخصاً يبحثُ في قمامة عن طعام ، شعرتُ بالتعاسة والذنب . فأنا منغَّص طوال اليوم تقريباً . وقد حاولتُ أن أعالج نفسي بنفسي بفضل الرصيد الذي أمتلكه من دراساتي النفسيّة . فأنا أعرف مثلاً أن الناجين من كارثة يشعرون بالذنب وكأنّهم مسؤولون عن هلاك الآخرين . حاولتُ أن أتعالج بالإيمان ، فأخذتُ أذكّر نفسي بأن الله مقسّم الأرزاق ، وأنني لم يكن لي يدٌ في ما يحدث في العراق أو فلسطين ، وأنني لم أسرق ولم أختلس مالاً وإنما امتلكتُ ما امتلكتُ من متاع متواضع بالعمل الجاد المخلص . بيد أني سرعان ما أتذكر بلداناً كانت أفقر بكثير من بلادنا العربية في الستينيات ، مثل كوريا وماليزيا وسنغافورة وفنلندة ، ورأيتُ بأمّ عيني أن الله قد أغدق عليها موفور الرزق فلا يوجد بين أهلها عاطلٌ عن العمل ولا فقير ولا متسوّل ، ولا في طرقاتها قمامة ولا أزبال ، وإنما رزق الله أناسها الغنى والصحة والمعرفة . ثمّ أعود فأقول (إنّ الله لا يغيّر ما بقومٍ حتى يغيّروا ما يأنفسهم) . وعند ذاك اشعر بالذنب مرّة أخرى ، لأنّنا – نحن المتعلّمين أو المثقفين أو المسؤولين العرب – لم نستطع التغيير ولم نخدم بلادنا حقّاً بسبب طمعنا في التشبّث بالسُلطة ، وجشعنا في جمع الأموال .
كلّ هذه ، جراحٌ غائرة فاغرة في حنايا الروح . ولا أستغرب الأمر إذا كتب كثيرٌ من النقّأد قائلين إنّ قصصي تنتهي بالخيبة والفقدان ؛ ولعلّها كذلك بلا إرادة منّي ، فعقلي لا يتحكّم بكلّ ما أكتب ، بل للروح نصيبٌ كبير في كلماتي . ألا يكفيكَ فقداناً أن يفقد المرء وطنه وأهله وأولاده وأحلامه ؟! ) (48) .
ذيل عن : الموقف من الولايات المتّحدة .. ونظريّة استجابة القارىء :
منذ نهاية الستينات وبداية السبعينات بدأت ملامح مدرسة "استجابة القارىء – Reader Response" بالتبلور . وخلاصتها الانتقال من التاكيد – لفهم النصّ الأدبي – على النص نفسه أو كاتبه ، إلى القارىء ، والكيفية التي يؤوّل بها النص الذي يقرأه . ومن المعروف أنّ هذه المدرسة قد نشأت ردّاً على تركيز المدرسة الشكلانية على النصّ والتأويل الموضوعي له على أسس محدّدة . هنا يتمّ التأكيد على تجربة القارىء مع النصّ ، واستجابته له ، المقترب الذي يحدّد علاقته به ، التأويل الذي يطرحه له ، ما يضيفه إليه ، والاستجابات التي يحدثها النصّ في فكره ونفسه . هذا ببساطة . فارجو أن تأخذوا حديثي عن الولايات المتحدة والغرب وفق هذه النظرة . إنّها استجابة قارىء من العراق لنصٍّ عن محنة مدينة وجد فيها محنة وطنه الذي قتله الأمريكان . نعم أيّها الأخوة ، لقد قتلت أمريكا العراق .. قتلته في الشارع الدولي العام ، وأمام أنظار العالم الذي بلا ضمير . وتشاء الصدف – وأنا في غمرة هذه الكتابة – أن تصلني قصيدة من الشاعرة العراقية "فليحة حسن" التي هاجرت من وطنها إلى المنافي هرباً من جحيم أمريكا .. ولكن إلى أين ؟ إلى جحيم أمريكا . فلنقرأ هذه القصيدة سويّاً ، والشكر لعلي القاسمي ونصّه الذي خلق هذه التداعيات الموجعة :
لو لم يكتشف كولومبس أمريكا!
فليحة حسن
(لو لمْ يكتشفْ كولومبس أمريكا
لكنتُ الآن ألعب (الغميضة)* مع بناتي
وعند العصر نجتمع حول صينية الشاي المهيل والكعك
ولكان أخي يتسلل بهمس أصابعه
يطرق باب البيت قائلاً هل من أحد هنا ؟!
وهو المتيقن تماماً بأننا في انتظاره
نضحك ونضحك على (نكات)* طالباتي في المدرسة
ورائحة البخور تعج بالمكان
لو لم يكتشف كولومبس أمريكا
لما كنتُ الآن
أغلق نوافذ شقتي احتراساً من تسلل رائحة (الأفيون)* إليها
الناجم من تدخين الجارة !
لو لم يكتشفها لشبعتُ من رائحة الخبز
وما كنت الصبح
اقطع غابة بأكملها كي اصل الى (الولمارت)* لاشتري خبزاً وبعض الجبن!
أقول له ( أحمد)* رافقني ؟! يقول أخشى السير في الغابات،
وأسير لوحدي
لو لم يكتشف كولومبس أمريكا
لما كنتُ ذهبت لجامعتي بقطارين وباص ، وعدتُ بمثلهما
ولكنتُ اكتفيتُ باجرة (كيا)*
تأخذني الى حيث أريد!
لو لم يكتشف كولومبس أمريكا
لغفوتُ طوال الليل على تهدج أنفاس أولادي
ولم أعاني الأرق منذ وصولي إليها قبل عامين وأكثر
لو لم يكتشفها فعلاً
لاستلمتُ مجموعتي الشعرية بعد شهر واحد،
ولما انتظرتُ عاماً كاملاً كي تصلني بالبريد!
لو لم يكتشفها
لما خاتلتُ (ساندي)* ثلاثة أيام
هو يحاول أن يقلع سقف شقتي بكلّ ما أوتي من موج وريح
وأنا أثبتهُ بالدعاء !
و................
..................
...............
الهي ما آن لي أن أستريح ؟!
عشرون عاماً
وأنا أقاتل على جبهات عدة
الم يحن النصر بعد ؟!
.............
ناوحتُ الحمام
شرقتُ بدمعتي
نبحتني الكلاب
تدثرتُ بقصائدي خوفاُ وبرداً
علّقتُ أيامي على مسامير الصبر فتساقطن
نقعْتُ بأمطار اليأس
تجرعتُ كأس الغدر مراراً
و........
عساك بهدم يا سور المنافي ! )
********************
هوامش القصيدة :
.* الغميضة / لعبة يلعبها الأطفال تقوم على الاختفاء والبحث
* نكات / مزاح
* ألأفيون / نوع شائع من المخدرات في أمريكا
* الولمارت / سوق كبير له فروع في كل أمريكا
* أحمد / ولدي الصغير
* كيا / باص صغير شائع الاستعمال كواسطة نقل عامة في العراق
*ساندي / إعصار هاجم ولايات عديدة في أمريكا ومنها ولاية نيوجرسي التي اسكن فيها
القصّة التي تمّ تحليلها :
المدينة الشبح
_________
د. علي القاسمي
أتفرّسُ في الحروف المُتراصّة، أفترسها. ألوكُ أصوات الكلمات المتعاقبة، ألفظها. أتتبَّع معاني العبارات المنسابة، أُدركها. فيتملَّكني العجب لما حدث وكيف حدث. أُلقي نظرةً متسائلةً عبر النافذة المُغبرَّة، فلا تصافح عينيَّ سوى كثبانٍ رمليَّةٍ صفراءَ، تنداح متراميةً، حتّى نهاية الأفق، حيث تلتصق بوجنة الشمس الغاربة، فتعفّرها. كثبانٌ صامتةٌ ناطقةٌ في آنٍ، كثبانٌ تفوح بعبق الصحراء بجميع أسرارها الدفينة، وبكلّ تاريخها الموغل في قلب الزمن، الغائر في خاصرة الغرابة. أُدير وجهي إلى زوجتي الأمريكيّة المتسمِّرة أمامي المحدِّقة بي، وأترجم لها ما وعيتُ، فتُبرِق الدهشة في عينيْها وتقول:
ـ عجيب، هذا أمر هائل! الآن لستُ نادمةً على الرحلة.
كانتْ قد حاولتْ أن تثنيني عن القيام بتلك الرحلة مُجادِلةً:
ـ إنّكَ ترمي بنفسكَ في لجَّة الخطرِ، حين تجوب مجاهل الصحراء. لأجل ماذا؟ لمجرّد العثور على المدينة التي هاجر منها جدُّك إلى أمريكا. وبمَ يفيدك هذا؟ وماذا ينفع الماضي من الناحية العمليّة؟ إنّنا نخطو حثيثاً نحو عتبة القرن الثاني والعشرين، وأنتَ ابن يومكَ. انظر إلى الأمام، وتطلَّع إلى النجوم الشامخة، ولا تلتفت إلى الخلف، وتحدّق في حضيض الوحل.
وعندما ارتطمتْ كلماتُها وتوسُّلاتهابجدار إصراري الصلد، عدلتْ عن رأيها، وقرّرتْ أن ترافقني في سفرتي، وأخذتْ تساعدني في الإعداد لها.
راحت سيَّارتنا الكهربائيَّة، المجهَّزة خصيصاً للسير في الصحراء وهي تجرّ عربة المؤونة المُلحقة بها، تنساب على الرمال مثل ضبٍّ مرتعبٍ هارب. وكان طنين محرِّكها يتلاشى في فضاءِ الصمت المطبق حولنا. وراحتِ الشمس تدلق أشعتها الذهبيّة الساطعة على الصحراء المتموّجة أمامنا، فتكرعها الرمال العطشى، ولا تذر في قرارة الكأس شيئاً، ما عدا سراباً تلمحه عيوننا، وهو يرتفع وينخفض مثل ماء بحيرةٍ نائية.
كانت المعلومات المنثالة على شاشة حاسوب السيّارة، بجانب المِقود تشير إلى دنوّنا من مقصدنا، ولكنَّنا لم نتبيّن شيئاً. لم تطالعنا أيّ أطلال أو خرائب. وكدنا نرفع راية اليأس على سارية الإعياء، حين بزغت في الأفق البعيد قدامنا، أعمدةٌ رمليّةُ اللون تطاول عنان السماء. حسبناها، أوَّل وهلةٍ، أشباحاً هائلةً متراصّةً، مثل صفٍّ من الكائنات الخرافيّة، القادمة من كواكب أُخرى. ثمَّ ما فتئت أن تبدّت لنا على هيئة عماراتٍ شاهقةٍ، أخذت تزداد ارتفاعاً كلّما اقتربنا منها.
وأخيراً ضمّتنا المدينة وعانقنا أوَّل شارعٍ من شوارعها. شوارعٌ عريضةٌ فارهة، وعماراتٌ كبيرةٌ فخمة. مدينةٌ قائمةٌ بكلّ مبانيها ومرافقها، لم يُصِبْها زلزال ولم يجتَحْها طُوفان. ولكنَّها مهجورةٌ خالية، لا إنسان فيها ولا حيوان ولا نبات. وكانت بعض أبوابها ونوافذها تتحرَّك بفعل الريح الخفيفة، فيصدر عنها صرير/أنين يبذر الرهبة والتوجّس في نفوسنا. وعلى الطرقات، تناثر زجاجُ بعض شبابيكها المُهشَّم، مختلطاً مع أكوام الرمل التي تجمَّعت هنا وهناك. وثمَّة مساحاتٌ فارغةٌ بين العمارات، لا بدّ أنّها كانت منتزهات، أو مواقف للسيّارات، ذات يوم. وبقينا وقتاً طويلاً، ونحن نتوجّس خروج إنسان أو حيوان من أحد الأبواب.
واخترقنا وسط المدينة متّجهين إلى أحيائها الغربية حيث انتشرتِ الإقامات السكنيّة الفاخرة المهجورة. أوقفنا سيارتنا وسط الشارع الرئيس وهبطنا راجلين وسِرنا على الرصيف المُدثَّر بالرمل، بمحاذاة الأبواب. كان بعضها موصَداً وبعضها الأخر مغلقاً وبعضها مفتوحاً على مصراعيْه. وكلّها تحمل قطعاً نحاسيَّةً أو خشبيَّةً كُتِب عليها اسم الإقامة. وأغلب الأسماء مؤنَّثة على غرار (فيلا حصّة) و (فيلا جوهرة 2). ندلف إلى بعض المنازل، فنلقي على جنباتها نظرةً بلون الحزن. وفي كلِّ منعطفٍ، شهقةٌ ودهشة. ووراء كلِّ بابٍ، يتلفَّع سرٌّ لا يخلع رداءه للتاريخ. وعلى كلِّ قطعةِ أثاثٍ فاخرةٍ، غفتْ بردة أسى.
تسمّرتُ في مكاني فجأةً، وأخذتُ أحملق في القطعة المُثبَّتة على أحد الأبواب، وأنا لا أصدّق عينيّ. لقد كانت تحمل اسم أُسرتنا. عجبتُ لكونها تختلف عن أسماء المنازل الأخرى. وتذكّرت ماكان يقوله لي أبي في صغري أحياناً على سبيل اللوم:
ـ تخالف الآخرين دوماً فلا تفعل ما يفعله الناس جميعاً. هكذا كان جدُّك!
وينفذ صوت زوجتي إلى أُذني مقاطعاً تجليات طفولتي:
ـ ماذا دهاك؟ ما لكَ ذاهلٌ هكذا؟
ـ لقد بلغنا مقصدنا، بكلّ بساطة، أكاد لا أصدق نفسي!
دلفنا إلى المنزل، فألفينا أثاثاً بكامل عُدّته، حتّى الستائر المرتعشة بفعل النسيم على الشبابيك، كأن الأهل غادروه ذلك الصباح، لولا غلالةٌ رمليةٌ استوتْ على الأسرَّة والجدران. انتقلنا من غرفةٍ إلى أُخرى، وقلبي يحدوه الحنينُ، فيزداد خفقاناً، ويحرقه الوجد فيذوب ذوباناً. ثمَّ ارتقينا السلَّم إلى الطابق العلويّ. وهناك وجدتُ مكتبة جدّي برفوفها الأنيقة وكتبها المُسفّرة، يتوسّطها مكتبه الذي دوّن عليه معظم مؤلَّفاته، التي من أجلها علّمني والدي العربيّة. وعلى الجانب الأيمن من المكتب، كان دفتر مذكراته. قبضتُ على جمر الحنين بمهجتي، وفتحتُ الصفحة الأولى، بأنامل مرتعشة، مثلما يفتح طفلٌ كتابه الأوَّل في المدرسة. وأخذتُ أقلّبُ صفحاته، وأتفرّس في الحروف المتراصة، أفترسها، والدهشة تجلّل وجهي:
20 أبريل 2021
اقتصادنا راكدٌ تماماً مثل مستنقعٍ آسن.
25 مايو 2021
البترول الذي ننتجه، هو السلعة الوحيدة في العالم التي ينخفض ثمنها باستمرار، خارقاً بذلك جميع المبادئ الاقتصادية. منذ أربعين عاماً، وسعر البرميل في انخفاضٍ دائم، هبط من أكثر من مائة وعشرين دولاراً إلى أقلَّ من دولار واحد!
3 يونيو 2021
مصادر الطاقة البديلة تجعل من بترولنا سلعة بائرة، شيئاً تافها لا قيمة له، مادة قذرة تتجنبها الأيدي، إنّه فحم القرن الحادي والعشرين. حتّى في بلادنا لا نستطيع الاستفادة من البترول. فجميع الآلات والمحركات والسيّارات التي نستوردها، لا تعمل بالبترول مطلقاً.
30 يونيو 2021
العمال والمستخدمون الأجانب يغادرون البلاد بكثافة، لا لتمضية العطلة الصيفيّة مع أهاليهم، وإنّما إلى الأبد، بسبب انخفاض الأجور التي لم يقبضوها منذ شهور. قبل عشر سنوات، كنّا نسعى إلى طرد العمّال الأجانب الذين لا يتوفرون على رخصة إقامة صالحة؛ أمّا اليوم فيصعب علينا استقدام العمّال والتقنيّين اللازمين للتسيير. لقد نضب المال الذي كان يجذبهم إلى المدينة، فغادروها. أمّا نحن، فجذورنا جذورُ نخلةٍ تضرب بعيداً في أعماق التربة، وليس في مقدورها أن ترحل مع الريح كالأشنات.
25 يوليو 2081
اضطر كثيرٌ من الناس إلى تمضية الليل في العراء، ليصيبوا شيئاً من النوم. فقد بلغت درجة الحرارة اليوم ،أكثر من خمسين درجة مئوية. وأجهزة التبريد في عددٍ كبيرٍ من العمارات معطَّلة، بسبب انعدام الصيانة. فأمست الصناديق الأسمنتية المسماة بالشقق، قِطعاً من جهنم لا تطاق.
30 يوليو 2081
الشباب الذين تهاطلوا على المدينة أيامازدهارها، قادمين من الواحات القريبة والقرى البعيدة، طمعاً في حياة أفضل، شرعوا بالعودة إلى منابعهم. لم يعُد بوسع المدينة أن تقدّم لهم أحلامهم على طبقٍ من ذهب، فتخلّوا عنها. أمّا نحن، فلن ندير ظهورنا إلى مدينتنا. كنّا هنا عندما كانت بيوتنا مبنيّة من الطين قبل خمسين عاماً، وبقينا هنا عندما تحولت إلى إقامات من المرمر والإسمنت، وسنبقى هنا متمترسين في مواقعنا، حتّى بعد أن يتفتت المرمر ويتهرَّس الإسمنت. إنَّ الذي يحزّ في نفوسنا، هو الجفاف الذي أصاب عقولنا. لم يخرج أيٌّ منا بأيِّ بدائل مقبولة.
20 أغسطس 2081
لقد وقع ما كنتُ أخشاه. المياه التي تصلنا من محطة تحلية مياه البحر، أخذت في التناقص، ثمّ في الانقطاع ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع. نلجأ الآن إلى تخزين الماء في صهاريجَ منزليّةٍ احتياطاً.
15 سبتمبر 2081
ها قد تغيّر طعم الماء كثيراً. إنّنا نشرب ملح البحر في قهوتنا، ولم يعُد بمقدور السكّر تلطيف مذاقها. ولكنَّ الأمرَّ والأدهى هو انقطاع الماء عنا لفتراتٍ أطول فأطول. لا ماء كافٍ للشرب، بله سقي الشجيرات اليتيمة الذابلة في المدينة. إنّها تموت واقفة. إنّه انهيار سدِّ مأرب الجديد.
10 أكتوبر 2081
مئات من الشقق التي غادرها ساكنوها، فارغة؛ وعشرات من العمارت مغلقة بكاملها، لا تجد من يستأجر شققها أو يشتريها بأبخس الأثمان. أزمةُ السكن التي عالجتها صحافتنا بإطناب قبل أربعين عاماً أمست نكتةً قديمةً مؤلمة.
30 نوفمير 2081
لم يعُد هنالك عمّال أجانب في المدينة ليغادروها. ولم يبقَ فيها من المهاجرين إليها ممن لم يعُد إلى واحته أو قريته. لذلك جاء دور أهلها الأصليِّين. فقد سمعتُ أن صديقنا عبد الله قد رحل وعائلته الأسبوع الماضي، دون أن يحاول بيع منزله أو أثاثه ودون أن يودّعنا. أمَّا نحن فباقون هنا. جذورنا ملتحمةٌ مع تربتنا التحاماً لا فكاك له.
31 ديسمبر 2081
غادر جارنا عبد المجيد وعائلته المدينة بسيّارته قبيل الفجر. لم يحتمل رؤية عيوننا وهي تشيّعه. ولم يحتمل الجفاف ونقص الخدمات التي اعتاد عليها. فاختار أن يتلفَّع بسواد الليل خارجاً من المدينة. بيدَ أنّا سنبقى، وستمتد جذورنا إلى أعماق الأعماق باحثةً عن قطرة ماء، ولتتساقط الأوراق الصفراء من أعالي الأغصان.
5 يناير 2082
تواترت الإشاعات حول احتمال انقطاع الماء من محطة تحلية مياه البحر بصورة نهائيّة. والآبار التي ما زالت في أطراف المدينة لا تسدُّ حاجتنا من الماء. شبح العطش يطلُّ علينامع مطلع العام الجديد.
1 فبراير 2082
منذ شهر جفّ مداد قلمي بصورة مريعة، لأنّ الصحيفة اليومية المتبقية الوحيدة توقّفت عن الصدور في آخر يوم من أيام السنة المنصرمة. كنت أظن أنّني أكتب إشباعاً لحاجة ذاتيّة، أو رغبة في التعبير عن أحاسيسي، أو للهروب من واقعي الخانق إلى عالم متخيل أرحب. ولكنَّني اكتشفت اليوم أنّني كنت أكتب للتواصل مع الآخرين. وعندما انقطعت جسور التواصل معهم أحجمتُ عن الكتابة، أو بالأحرى أحجمتْ عني. لم أعُد أدوّن إلا مذكّراتي الحميمة بين الفينة والفينة. لِمن أكتب؟ غداً ستذرو الرياحُ أوراقي، وتطمسالرمالُ كلماتي.
18 فبراير 2082
أَسرَّ إليّ أخي الكبير اليوم أنّه وأفراد أُسرته عازمون على الرحيل قبل حلول الكارثة، ونصحني بمصاحبته، قائلاً إنّه على الرغم من إصراري فإنّ دودة القلق تمتصّ الدم من وجهي، وإنّ الخوف يتراقص على شفتي وأصابعي، ولا بدّ من الخروجمن مملكة الخوف والقلق. أجبتُه قائلاً إنَّ سعفات النخلة قد تهتز مع الريح، ولكنَّ جذورها ثابتة في الأعماق. قال: "سنرى"وانصرف .
20 فبراير 2082
لم تبقَ لي سوى المذكّرات، هي ملاذي الوحيد. ألجأُ إليها هروباً من الصمت. أحتمي بها من العزلة التي تخنقني، العزلة التي يفرضها الجفاف، العزلة التي تُحكمها الصحراء على خناقي، العزلة الناتجة من تلاشي الحياة الاجتماعيّة في هذه المدينة المُحتضِرة. أبثُّ مذكّراتي أشياءَ لا قيمة لها، أشياءَ تافهة، أشياءَ لا تغيّر المصير المُترصِّد بنا أبداً، ولكنّها تمنحني فرصةً للثرثرة مع نفسي فتعوضني عن الصديق والرفيق، وتجعلني أتأمّل في مشاعري وسلوكي فأشعر أنّني ما زلتُ أحيا.
21 مارس 2082
يا لسخرية القدر! لقد اقتحم مدينتنا مسخ الجفاف ممتطياً صهوة الربيع. اليوم انقطع الماء من محطة تحلية مياه البحر بصفة نهائيّة. وهكذا يتضافر جفاف صنابيرنا مع جفاف أرواحنا.
22 أبريل 2082
أهالي المدينة يغادرونها جماعاتٍ جماعاتٍ كالطيور المهاجرة. إنّه موسم الهجرة إلى جميع الاتجاهات.
5 مايو 2082
درجة الحرارة تتمادى في الازدياد، والماء الذي نستدرُّه من البئريْن المتبقييْن، يوشك على النضوب. والصيف على الأبواب.
6 يونيو 2082
العوائل القليلة المتبقيّة في المدينة تجمّعت في شارعنا، وانتقت الإقامات التي تناسبها فيه، وأطلقنا عليه شارع الصمود.
1 يوليو 2082
معظم الصامدين يتحدّثون الآن عن التوجّه إلى الخارج لتمضية العطلة الصيفية. إنَّها مجرد ذريعة. ولكنّني لا أستطيع التخلّي عن مهد الذكريات.
8 يوليو 2082
لم تبقَ في شارع الصمود إلا عائلتنا. إنّه سجن انفرادي قضبانه مشرعة على الصحراء، وعزيمتنا يحملها صاروخ منطلق إلى تخوم الاستسلام.
11 يوليو 2082
ما فائدة انغراز جذور النخلة في أعماق التربة، عندما ينقصم جذعها، وتهوي إلىالأرض؟ الجفاف يطلّ علينا بوجهه الكالح، من كلّ حدب وصوب.
14 يوليو 2082
الجفاف يغيّض آخرَ قطرة في آخر بئر. الجفاف يشرب دماء قلبي. الجفاف ينشّف مداد قلمي. إنّي راحل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
قارب الموت والظمأ العظيم للدكتور علي القاسمي 13 بقلم: حسين سرمك حسن
تاريخ النشر : 2017-06-18