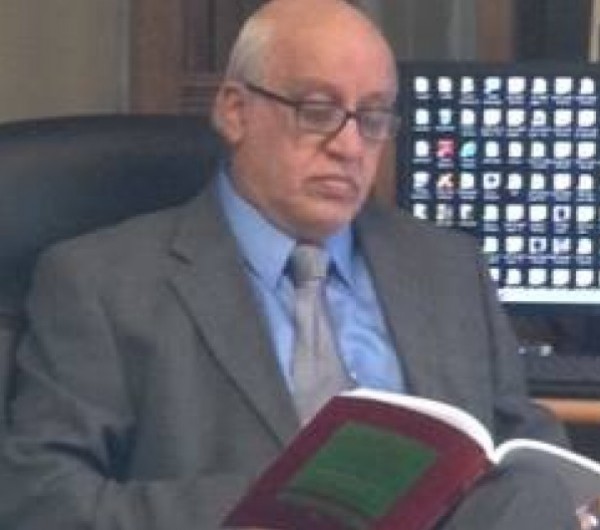كريم مرزة الأسدي
أقيموا بني أمّي صدورّ مطيــــكمْ *** فأنـّي إلى قوم ٍ ســـــواكمْ لأميلُ
فقدْ حُمّتِ الحـــــــــاجاتُ والليلُ مقمرٌ *** وشـُدّتْ لطيّاتٍ مطايا وأرحلُ
وفي الأرضِ منأ ًى للكريم عـن الأذى** وفيها لمنْ خــــافَ القِلى مُتعزّلُ
لعمركَ ما في الأرضِ ضيقٌ على أمرىءٍ*سرى راغباً أو راهباً وهو يعِقلُ
إذا كان قد طـُعِن دعبل بنسبه لتمرده وتجرأه على مقام الخلافة ، ومعالي الوزارة ، وأبو نؤاس لمجونه وشعوبيته ، وبشار لعبثه وزندقته - كما قيل ظلماً أو حقاً في هذا وذاك - والمتنبي لشموخه واعتداده ...!! وابن الرومي قد لصقت به روميته دون الاهتمام بثقافته وبيئته ولغته ، وهو بغدادي المولد والنشأة والمدفن ، ولم يغادر بغداد طيلة حياته سوى ثلاثة أشهر ، لقد وقع الرواة والأخباريون القدماء بخلط كبير ، دفعتهم إليه دوافع عديدة ، ولم يكن الصراع الحضاري قائماً حينئذٍ ، وكان أفقهم يتسع للعالم الإسلامي ، وأينما تمطرالسماء فالخراج لهم ! ومن ثم طلّ كتاب معاصرون معروفون ، ونقاد أدب متميزون وساروا على النهج القديم ، وتأثر بعضهم بآراء وأجندة ثلة من المستشرقين ، فشكّكوا ورموا وقذفوا تحت ستار النهج العلمي ، والحقائق الموضوعية - وسنأتي على الأمر فيما بعد - فما بال الشنفرى الذي سبقت وفاته ( 525 م) (1) ولادة النبي الكريم (ص) ( 570 م) (1) ، وكنيت لاميته بـ (لامية العرب) ، والتي تعدُّ من أروع و أقدم القصائد في التراث العربي ، بل هنالك مقولة متواترة للخليفة عمر بن الخطاب ( ت 23 هـ / 644 م ) - وتروى بسند ضعيف كحديث للنبي ( ص ) (ت 11 هـ / 632 م) - يخصها بنعت فريد ، ويلحق العرب بها كمضاف إليه ، ويحث على تعلمها ، لأنها تمثل مكارم الأخلاق ، قائلاً :
" علـّموا أولادكم لامية العرب ،فأنها تعلمهم مكارم الأخلاق " ، والخليفة الراشدي - بالرغم من منزلته الإسلامية الرفيعة - هو الأقرب لعصر الشاعر وأحداثه ممن نقل إلينا أخباره أمثال حمّاد الراوية (ت 156 هـ/772 م) ، والمفضل الضبي ( 178 هـ /794 ) وخلف الأحمر (ت 180 هـ/796 م) ، والنسابة محمد بن حبيب (ت 245 هـ / 859م) ، والأصفهاني صاحب الأغاني (ت 359 هـ /967 م ) ، وبالتالي تعتبر المقولة أكثر صدقاً ، وأقرب واقعاً ، وأحسن أثراً ، والشعر يمثل الشاعر، فهو جزء من شخصيته ، ويعكس أخلاقيته ، وما يعتلج من أحاسيس في شعوره ومشاعره ، والا كيف نتعلم الأخلاق ممن لا أخلاق عنده ؟! وكيف نتكرم بمن لا كرامة له ؟ وكيف نعتزُّ بغير العزيز ؟ّ! دلـّوني بربّكم على شاعر أو إنسان ، يعقد مثل هذا العقد الفريد ، أو يتفوّه بمثل هذا الكلام السديد ، إذا لم يكن ذا عزّة وجذور عميقة عتيدة ، وحكمة وأخلاق رفيعة حميدة ، اقرأ رجاء بشموخ وتعقل :
أقيموا بني أمّي صـــــــــدورّ مطيـــــكمْ *** فأنـّي إلى قوم ٍ ســـــواكمْ لأميلُ
فقدْ حُمّتِ الحـــــــــاجاتُ والليــــــلُ مقمرٌ *** وشـُدّتْ لطيّــــاتٍ مطايا وأرحلُ
خاطب بدايةً ًأهله ، وخصّ بالنداء بني أمّه من أخوانه الأشقاء آوغير الأشقاء ، وتعدُّ رابطة الأمومة أقوى الصلات الإنسانية عاطفة ً ، وأكثرها مودةً وقرباً ، مبتعداً عن النزعة القبلية والعشائرية الذكورية ، وشدَّ رحال مطاياه لمبتغاه مسافرا بليل سافر ، ومن الجدير ذكره أنّ الشاعر الأموي المقنع الكندي ( ت 70 هـ / 689 م) ، قد وجّه لبني أبيه أبياتاً موجعة متشحة بخيبة الأمل والقنوط في قصيدته الدالية الأطول لديه :
إنَّ الذي بيني وبيــــن بني أبي *** وبيــــــن بني عمي لمختلفٌ جدا
إذا أكلوا لحمي وفرتُ لحومهمْ ***وإنْ هدموا مجدي بنيتُ لهم مجدا
أما المسكين المخمور طرفة بن العبد وقد ولد بعد وفاة شاعرنا الشنفرى بما يقارب العقدين ، وتوفي شاباً صغيرا (543 - 569 م) ، قد ذكر عشيرته بعد أنْ تحامته منبوذاً طريدا ، فتلاقفه بنو غبراء شفقة وعطفاً :
وما زالَ تشرابي الخمور َ ولذتي**وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي
إلى أن تحامتني العشيرة كلـّها *** وأفردتُ إفـــرادَ البعير ِ المعبّدِ
رأيتُ بني الغبراء لا ينكرونني *** ولا أهل هذاك الطرافِ الممــدّدِ
ما كان هكذا العداء البارع , الشنفرى الرائع - رغم أنّ كلّ قصيدة تؤخذ حسب ظروفها الذاتية والموضوعية لحظة إبداعها - بل شجاعاً حكيما ، أبياً عزيزاً , صبوراً جميلا، وإنّ الجمال جمال الروح لا الجسد ، نواصل معه لاميته :
وفي الأرضِ منأ ًى للكريم عـن الأذى** وفيها لمنْ خــــافَ القِلى مُتعزّلُ
لعمركَ ما في الأرضِ ضيقٌ على أمرىءٍ*سرى راغباً أو راهباً وهو يعِقلُ
ولي دونكمْ أهلونَ ســــــــيدٌ عملـّسٌ ***وأرقط ُ ذهلولٌ وعرفــــاءُ جيألُ
همْ الرهط ُ لا مستودعُ الســـرّذائعٌ *** لديهمْ و لا الجــاني بما جرَّ يُخذلُ
وإنْ مُدّتِ الأيدي إلى الزّادِ لـــمْ أكنْ *** بأعجلهمْ إذْ أجشـعُ القوم ِأعجلُ
وما ذاكَ إلاّ بسطة ٌ عــــــــنْ تفضل ٍ *** عليهمْ وكـــانَ الأفضلِ المُتفضّلُ
ولستُ بمهيافٍ يُعشي ســــــــوامهُ ***مجدّعةً ً ســــــــقبانها وهي بهّلُ(2)
أديم مطــــــــالَ الجوع ِحتى أميتهُ***وأضــــربُ عنهُ الذكرَ صفحاً فأذهلُ
وأطوي على الخُمص الحوايا كماانطوتْ *** خيوطة ُ ماريٍّ تغارُ وتفتلُ(3)
واستفُ تربَ الأرضِ كيلا يـــرى لــــهُ ** عليَّ من الطـــولِ أمرءٌ متطولُ
ولولا اجتنابُ الذام ِ لــــــمْ يلفَ مشربٌ *** **يٌعــاش ُ بهِ إلاّ لديّ ومآكلُ
وإنـّي كفاني فقدَ مَــــــــــنْ ليسَ جازياً *** بحُسنى ولا فـي قربهِ متعلـّلُ
ثلاثة ُأصــــــــــــحابٍ فؤادٌ مشيعٌ *** وأبيضُ إصليتٌ وصفراءُ عيطلُ
هتوفٌ مـن الملس ٍ المتون ِيزينها *** رصائعُ قـــد نيــطتْ إليها ومحملُ
إذا زلَّ عنها السّـــهم حنـّتْ كأنـّها *****مُرزّأة ٌ عجلى تُرنٌّ وتـٌعـــــــولُ
إذا الأمعزُ الصوانٌ لاقى مناســـــــــمي *** تطايرَ منهُ قـــــــادحٌ ومُفلـّلُ(4)
الرجل كما أرى - وربما ترى معي - يشعر بالتمايز الطبقي والقبلي والعنصري - لفقره وربما لجذوره الحبشية ، ولقب بالشنفرى لغلظ في شفته -، إنّه لشعورٌ قاس ٍ مرير يأباه الحر الأبي ، فيرفض الضيم طبعاً ، ومن مثله لا يُسام الخسف ، وفي الأرض متسع لكلّ عزيز نفس ، آلا تتذكر قول المتنبي إبان ثورته في غربته ، ونفوره من ثلـّته :
رأيتكم لا يصون العرضَ جاركمُ ***ولا يدرُّ علـى مرعاكمُ اللبنُ
جزاءُ كلّ قريـــب ٍ منكـــــــمُ مللٌ*** وحظُ ُكـلّ محبٍّ منكمُ ضغنُ
وتغضبون علـــــى من نال رفدكمُ * حتى يعاقبهُ التنغيصُ والمننُ
أما أنا فيذكرني هذا أيضاً بدعبل حين داهمته الهموم ، ونغصت حياته الأحقاد والبغضاء، ففرّ منها إلى معتزله قائلاً :
ويكَ أن القعود يلعب بالقعـــ *** ــددِ لعب الرياحِ بالبوغاءِ (5)
ما دواء الهموم ِ الا المهارى*** تـُعتلى في التنوفةِ الملساءِ (6)
الشنفرى شدَّ رحاله شدَّ الفقير الجريء المتعقل ، والمتنبي شدّه بشدة الثائر المتمرد المتطلع، أمّا دعبل فاعتلى ومن هؤلاء ( الأهلون ) ؟ الذئب السريع الأرقط الخفيف ، والضبع الطويلة العرف
لست أنا بصدد شرح القصيدة ونقدها ، الآ بما ألطـّف جوّ مقالتي، وأبثّ الروح فيها عندما توشك على الملل الرتيب ، فسأشرع الآن بالبيت الثالث ، الذي يتضمن كلمة (أهلون) وهو جمع شاذ ملحق بجمع المذكر السالم ، لأن (أهل) اسم جنس جامد لا يستوفي شروط هذا الجمع ، ومن هؤلاء ( الأهلون ) ؟ الذئب السريع الأرقط الخفيف , والضبع الطويلة العرف (7) ، وعاملهم الشاعر معاملة العقلاء الذين لا يذاع سرّه عندهم ، ولا يخذلونه على جريرته ، وهذا يذكرني بالأحيمر بن فلان السعدي ( ت 170 هـ / 787 م) ، والقصيدة التي مرت بمقالة سابقة لمخاطبكم ، ومطلعها :
عوى الذئبُ فاستأنستُ بالذئبَ إذعوى ***وصوّتَ إنسانٌ فكدتُ أطيرُ
فلا غرابة إذن أن يستأنس شاعرنا بالحيونات الكاسرة والأليفة نكاية بالإنسان المتعالي المتغطرس المنافق ، فهي خير صديق في البيت والطريق ، آلا ترى ابناءالأمم المتحضرة شرقاً وغرباً في أيامنا الحاضرة ، كيف يألفون حيوانتهم من قطط وكلاب ... ويصاحبونها دون ناسهم وأهلهم !! ويزيد هو عليهم ، بأنه يعشي سوامه خيراً ، كي يقتات من حليبها حرّا ، ومع كل هذا هو( صعلوك) بالدلالة السلبية للكلمة ! (8)
ربما فرضت عليه هذه الصعلكة المزعومة كوسيلة للدفاع عن النفس والكرامة الإنسانية ، فأين الغرابة يا هذا وذاك ؟! ولا تتخيل هذا العداء الجاهلي المشنفر يستغل هذه المخلوقات الضعيفة ، وإنما هو ليس بالمهياف الذي يبعد أبله على غير هدى، فيجعل مواشيه جائعة ، وبالتالي سقبانها ( أولادها) من غير رضاعة ، بل هو لا يشاركها شرب الحليب حتى تشبع رواء ، لأنه درّ لأجلها ، لا لأجله ، ولا بأس من الجوع الكافر، فهو يطيل أمده حتى يميته ، فيضرب عنه صفحاً ، وعندما تُمدّ الأيدي، لم يكن عجولا ولا جشعاً ، ولا يؤمن (عند البطون تُعمى العيون) ! ولا ينطبق عليه القول :
" لا تسأل رجلا عن حاجة ، وهو موعود على غداء ) ! اسأله ولا تبالي ، فهو قادر على أن يطوي حواياه ( أمعاءه) جوعاً ، وإن فتلت وغارت فتل الخيوط .
وأحياناً الرجل الرجل يستاف التراب لكي لا يتطاول عليه متطاول لئيم , ليس كل هذا عجزا أو ضعفا أو خوفاً في عصر لا يسود فيه قانون إلا قانون القوي المقدام ، وأعراف القبيلة ، وشيوخها الضخام ! وأنت تعرفه من هو؟ ! ولكن الأخلاقيات الإنسانية الفطرية الخالصة تردعه ، وحتى لا يذمه ذام ، ويُرمى بالسحت الحرام :
ولولا اجتنابُ الذام ِ لــــــمْ يلفَ مشربٌ ***يٌعـــــــــــاش ُ بهِ إلاّ لديّ ومآكلُ
أعود لأقول ، ومع كل هذا يُرمى صاحبنا بالصعلكة بدلالتها السلبية ، فمن هو الصعلوك ؟الصعلوك لغة هو الفقير الذي لا يملك المال كي يساعده على العيش ، وتحمل أعباء الحياة ، واطلقت - بصيغة الجمع - على الخلعاء الشداد ، وهم الذين خلعتهم قبائلهم بسبب أعمالهم التي لا تتوافق مع أعراف القبائل ، أو على أبناء الحبشيات السود ممن نبذهم أباؤهم ، ولم يلحقونهم بأنسابهم ، أو على من احترف الصعلكة احترافاً ، وحولها الى ما يفوق الفروسية ، كل ما سبق ينطبق على شاعرنا الشنفرى تماماً ، ولا بأس في ذلك مطلقاً ، ولكن تجاوزت الكلمة من بعد دلالتها,وأخذت معاني أخرى ، فاطلقت على قطاع الطرق ، أو للذين يقومون بعمليات السلب والنهب ، وهذا ما نـُبرىء الشنفرى منه ، ولا نميل للإتهامات التي وردت حوله في هذا الشأن في كتب التاريخ والأدب ، فمثلا يذكر حنا فاخوري ، كان الشنفرى " يغير ، وحده أو بقوم من أصحابه العدائين، متنقلاًمن حيٍ الى حيٍ ، مروعاً التساء والأطفال، باعثاً الرعب والأضطراب في الرجال.." (8)
هذا الكلام نـُقل من كتب التاريخ للرواة والإخباريين، ولم يخضع للتمحيص والتحليل والتدقيق ، لذلك لا أميل إليه كثيراً، وأنا في شك كبير من قبوله ، لأن ببساطة قصائد الشاعر وهي تعكس شخصيته بصدق ، تقول عكس هذا تماماً ، ولا يمكن للشاعر أن يكذب لحظة ابداعه الشعري - وإن قال البحتري الانتهازي : أعذب الشعر أكذبه !! - ، وللرواة أن يخترعوا ما يشاءوا من قصص وأقوايل ، وأن يجعلوا من الحبة قبة !
والآن نبدأ مع البيت البادىء بـ (ثلاثة أصحابٍ) ، فمن هم هؤلاء الأصحاب الثلاثة ؟ !! فؤاد قوي بشيعته المشايعة له ، وسيف مسلول من غمده المغمود , والصفراء العيطل تعني القوس الطويلة من شجر النبع (9) ، وفي البيت التالي يمعن متماهيا برمحه الأملس الصلب المرصع المحمول الصائت ، وإذا انطلق السهم من القوس، كأنما استل الجنين من رحم أمه، فتكثر المصائب على القوس المسكينة (الثكلى) - في رواية أخرى - فتولول ونصرخ وتعول على فقدان ولائدها ، ويذكرني أصحاب الشنفرى بأصحاب المتنبي ( ت 354 هـ / 965 م) :
الخيلُ والليلُ والبيداءُ تعرفني ***والرمحُ والسيفُ والقرطاسُ والقلمُ
أكتفي بها القدر من القصيدة الفريدة غير المعلقة ، وإن علقت في الفكر العربي والإنساني ، ونفذت إلى قلوب العرب وعقولهم ، وهي تتضمن ثمانية وستين بيتا من البحر الطويل ، وأروم - لسبب ستعرفه بعد قليل - أن أعرج لمحة على قصيدته التائية بحق زوجه ، ولك أن تقرأها كاملة في ديوانه (10) ، وتتفكر في مدى احترامه لحقوق المرأة وعفتها ، القصيدة التي عدّها الأصمعي أحسن ما قيل في خفر النساء وعفتهن :
ألا أم عمرو أجمعتْ فاســـتقلتِ *** وما ودّعتْ جيرانها إذ ْ تولـّتِ
وقد سبقتنا أم عمرو بأمــــرهـا ** وكانتْ بأعنــــاق المطي أظلـّتِ
بعيني ما أمستْ فباتتْ فأصبحتْ *** فقضّتْ أموراً فاســــتقلتْ فولّتِ
فوا كبدا على أميمةَ َبعدمــــــــا *** طمعتُ فهبها نعمةَ َالعيشِ زلّتِ
لقد أعجبتني لا سقوطاً قناعهــا *** إذا مـــــا مشت ولا بذاتِ تلفّتِ
زوجه (أميمة) هجرته ورحلت دون أن تخبر أي أحد حتى جيرانها ، الرجل لم يغضب ، ولم يسخط , ولم تأخذه الحمية الجاهلية أبان جاهليتها , بل كافأها بأروع رائعة , وأرق الكلمات ..(بعيني)...( فواكبدا ) ، ثم (لقدأعجبتني) ...أعجبته بماذا؟ إنها لا تسقط قناعها تعمداً لإبداء حسنها ، ولاتتلفت لكي لا تجلب الريبة لعفتها وخدرها , يقول الأصمعي معقباً : وقد تلقي المرأة خمارها لحسنها وهي على عفة ، وأنشد قول الشماخ "أطارت من الحسن الرداء المحبرا ".
وكما لا يخفى هذه نظرة خاطفة جداً على الأبيات ، وأحلتك لقراءة القصيدة كاملة ( 36 بيتاً) ، والتمعن في أبياتها ، أما انا المسكين المندهش ، فغايتي التعقيب على قول المستشرق الأسباني هنري بيريس ، كمثال على بعض العقليات الإستشراقية المتعصبة - بعد مروري على هاتين القصيدتين الإنسانيتين بكل ما للكلمة من معنى لشاعر يعد من أوائل الشعراء العرب ، إن لم يكن أولهم .
يقول السيد هنري : " وعبثاً تبحث في أدب المشرق عن فكرة إنسانية واحدة كتلك التي عبر عنها الزبيدي ، أبو بكر محمد بن الحسن (ت 379هـ / 989م) , وهو شاعر نحوي أسباني ، وكان مؤدب الحاكم الثاني :
والأرض شيءٌ كلـّها واحدٌ *** والناس اخوانٌ وجيرانُ
وهذه الفكرة نفسها تجدها عند تيرنس ,وهو كاتب لاتيني من القرن الثاني قبل الميلاد ، فهو يقول في بيت له :
كلُ ما هو إنساني ليس غريباً عليّ " (11)
المستشرق الأسباني ما أراد بأدب المشرق إلا أدب العرب ، ونسى أن الزبيدي نفسه هو عربي الثقافة واللغة والجذور، وإن عاش في الأندلس ، ومنحه الهوية الأسبانية غصباً ، وقارنه بشاعر لاتيني من القرن الثاني قبل الميلاد نكاية بهذا المشرق ، وتكلم عن أدب المشرق كأنه عرف جميع أسراره، وغاص كلّ أعماقه ، ولم يجد حتى لؤلؤة إنسانية واحدة في محاره ! وكأنما الإنسان يكون إنساناً إنسانياً بجسده وشكله ، لا بمعانيه السامية ، وسلوكه الأخلاقي الرفيع ، مع جلّ أحترامي ، وعمق تفهمي لبيتي الزبيدي العربي وتيرنس اللاتيني .
نعود للشنفرى الإنسان ، والعود أحمد , فالحقيقة لم يكن لـّلامية شأن في القرنين الأول والثاني للهجرة ، ولكنها قفزت كقفزة الشنفرى في القرن الثالث ، فشرحها المبرد وثعلب وابن دريد والتبريزي والزمخشري ، والعكبري ...وابن أبي علي النجار ، وابن أبي لاجك التركي ، وابن زاكور الفاسي ، وعطاء الله المصري (12) ونقلها أصحاب المختارات الشعرية أمثال ابن طيفور، وأبي علي القالي ، والخالدين، وابن الشجري ، ولكن أبا علي القالي (280 هـ - 356هـ / 893 م - 967م) فجّر في (أماليه) إشكالية نقلها عن أستاذه ابن دريد تقول : إنّ لامية العرب " لخلف الأحمر وليست للشنفرى" (13) ، ومما يضعف هذه الإشكالية العابرة - وإن كانت للقالي العالي ! - شهرتها عبر العصور للأزدي الصعلوك جبراً ! ، بل قد صدر كتاب بتحقيق الدكتور محسن فياض تحت عنوان " المنثور والمنظوم..." لأبي الفضل أحمد ابن أبي طاهر طيفور(204 -280 هـ ) ، أي ولد بعد وفاة خلف الأحمر (180هـ) بزمن قصير ، وهو ثقة ، مشهود له بالعلم والدقة ، أشار إلى اللامية وشنفرها ، ولم يأتِ لا من قريب ولا من بعيد على الخلف الأحمر، أماأبو العباس المبرد (ت285 هـ) فأثبت بما لا يدع الشك أن لامية العرب إنما هي للشنفرى وليست لخلف الأحمر(14) .
لم يكتفِ هذا الشنفرى المسكين بعد وفاته بمحاولات نحل لاميته ، بل استلابها لصالح (الأحمر) ، وما (الأحمر) الا راوية وعلامة ولغوي ونحوي وشاعر من الطبقة الثانية في عصره العباسي ، لا يتمتع بأخلاقياتها وبداوتها ، ولا يستطيع انتحال عصرها لعصره ، ولا يتمكن من وضع قصيدة بمثل هذاالمستوى الرفيع - قد لا تجاريها بعض المعلقات سباكة وقوة لو قامت الدنيا وقعدت مع إقرارنا بعبقرية الأحمر الخلف ،
إن كان (الهنري) قد منح الجنسية الأسبانية للزبيدي ، فقد اختلف العرب بنسب الشنفرى واسمه ومكان ولادته ونشأته وحتى لقبه (15) ، ولا يعرفون متى ولد؟ ..ولم يحددوا سنة مقتله ، وهل هو عربي أم عبد لأبوين عبدين مملوكين؟! وهل هو أسير أم حر؟ وهل هو أزدي من السلامان أوالزهران ؟ وكم كان عمره حينما قُتل أبوه ؟ وما اسمه وما اسم أمه؟...ثم لماذا لم يختلفوا في معاصره امرىء القيس ، الملك الضليل ، حامل لواء الشعراء إلى النار ، على حد تعبير الحديث النبوي(ص) الشريف...الحقيقة الشنفرى ذنبه وجريرته قد خرج على تقاليد القبيلة ، وسلطتها الجائرة ، وأعرافها السائدة ، ثم أنه ضعيف النسب أو دخيل , ومن أم حبشية ، فلا فصل ولا أصل , ولامية العرب الى الجحيم ! وهل تعقل أنها تعلق عل أستار الكعبة ، رموه على الأزد قاتلي أأبيه ، وحاضني نشأته ، وقدموه لنا باسم (ثابت بن أوس الأزدي) على أغلب الروايات ، وجعلوه صعلوكاً قاتلاً ، قرر أن يقتل مائة من بني سلامان ، ثأراً لمقتل أبيه ، أولأبي زوجته ، وربما لاستعباده وإخفاء السر، لان الأصفهاني يذكر في (أغانيه) عنه : " .. ثم قدم منى وبها حرام بن جابر ، فقيل له : هذا قاتل أبيك ، فشد عليه فقتله.." (16) .
لم يذكرلنا أحد من النابهين كيف تعلم ؟ وأين تثقف ليتفلسف ؟ وما سرّ الأخلاق الرفيعة التي كان يتحلى بها ؟ المهم عندهم قتل تسعة وتسعين رجلاً ، وعجز عن اتمام المائة حتى قتله أسيد بن جابر السلاماني ، ومن بعد سنتين على وفاته ، عثر أحدهم بجمجمته فمات ، وتم بحمد الله اكمال العدد , هل تصدق هذه الرواية العجيبة الغريبة ، وهل تعقل يمر عليها الباحثون دون تعليق أو تفنيد،إنا لله وإنا إليه راجعون ، وعلى ما يبدو لي أن العرب مغرمون بالتسعة والتسعين ، لأنها أكبر من المائة ، أما أنا فاتعب في لفظها ، وأعجزعن كتابتها !! لا أعلم كيف طرقت على ذهن امرىء القيس ، والعصر العصر نفسه :
وقبلتها تسعاً وتسعين قبلة ً*** وواحدة ً أخرى وكانت على عجل !!
وحبكوا حوله الأساطير الأخرى غير قتله المائة الأشداء الأقوياء ، فخطواته الجبارة تقارب العشرين مترا ، لا تلحق به الخيول الأصيلة ، وضرب به المثل " أعدى من الشنفرى" ، اترك هذا الأمر ، إشكاليات أخرى وقع فيها الرواة الأعزاء ، فمثلاً حماد الراوية وخلف الأحمرخلطا بين شعره ، وشعر المسكين الصعلوك الآخر تأبط شرّا ، مع إن إسلوبيهما مميزان كما يبدو لي ، وأكثر من هذا زعم بعضهم ، إنهما شخصية واحدة ، وهذا لا ريب غير صحيح ، فالأخير اسمه (ثابت بن جابر الفهمي ) من قبيلة قيس غيلان بن مضر بن نزار (17) ( ت 530 م) ، ثم أن تأبط شرّا قد رثى الشنفرى - يقال أن الأول خال الثاني والله أعلم- بقصيدة منها:
على الشنفرى ساري الغمامِورائحٌ ***غزيرُ الكلى أو صيّب الماءِ باكرُ
عليك جزاءٌ مثل يومــــــك بالجبا **وقد أرعفت منك السيوف البواترُ(18)
لئن ضحكت منك الإماء لقد بكتْ *** عليك فاعولنَ النســــــاءُ الحرائرُ
وإنك لو لاقيتني بعد مـــــــا ترى *** وهل يلقينْ من غيبتهُ المقــــــابرُ (19)
مهما يكن من أمر ، لقد وقع الرواة والأخباريون والمؤرخون في خلط كبير ، ونقلوا إلينا الأخبار دون تمحيص دقيق ، أو تحكيم لعقل سليم ، سوى الأعتماد على سند يحسبونه ثقة ، وعلى الحقيقة العفاء ، وقد تدخل الوجاهة والكسب المادى والمباهاة والخيال لاختلاق أو تحوير الأخبار ، وركزوا على النسب كثيراً لرفع شأن رجال ، أو الحط من أقدار آخرين ، ولو على حساب العبقرية العربية ، ولابد أن يخطر على بالك وبالي ، لا يعقل لم يكن هنالك شعراء قد سبقوا هذاالعملاق الشنفرى ، ولم توجد ثقافة واعية ، وربما دراسة منهجية ...ضاعت كلها في ذمة التاريخ .
وقبل أن أختم موضوع التعصب للنسب ، وأخذت الشنفرى أنموذجاً للعصر الجاهلي ، وتوسعت قليلا في البحث عنه ، لأنه من أوائل الشعراء العرب الذين وصل شعرهم إلينا ، ولأهمية لاميته ، واختلاف الرويات حوله حتى اختلطت الحقائق بالأساطير، ولا بأس أن نختم البحث بعنترة العنترة (ت 615) ، وهو ابن شداد العبسي ، فأبوه كان من علية القوم ، ولكن أمه (زبيبة) أمة حبشية ، سباها الوالد فانجبت له الولد ، ونعم الولد ، رغم أنه قد عانى في بادىء أ مره من أحكام تقاليد الجاهلية الجائرة كالأستعباد ، ولكن استطاع بفروسيته وشجاعته وذكائه أن يشق طريق التحرر ، فمن يستطيع أن يتجرأ عليه ، ويعبث به , وأصبح في حرب داحس والغبراء قائداً شهيراً ، يلمح لابنة عمه الحبيبة ( عبلة) في معلقته التي نظمها كما يبدو لنا لأجل عينيها :
يخبركِ من شهد الوقيعةَ َأنني *** أغشى الوغى وأعفُّ عند المغنم ِ
ولقد ذكرتكِ والرماحُ نواهلٌ *** مني وبيضُ الهندِ تقطرُ من دمي
فوددتُ تقبيلَ الســيوفِ لأنها *** لمعتْ كبـــــــارقِ ثغركِ المتبسم ِ
هل هذا العنتر التي حبكت حوله القصص والأساطير والسير ، تخلص ونف بجلده من حساده ومناوئيه ومعيريه ؟! كلا ..!! الطبع الإنساني هو هو ، متى ما وجد ثغرة تسرب منها للطعن والنيل من الآخرين - والعياذ بالله - وخصوصاً المتفوقين في أي مجال ، والفارس العنتر تحسس بذلك ، ولا تعوزه الفطنة والفراسة والحدس ،إقرأ :
إنْ كنتُ في عدد العبيدِ فهمتي *** فوق الثريا والسماكِ الأعزلِ
وبذابلي ومهنـــدي نلت العلى *** لا بالقرابة ِوالعـــديدِ الأجزلِ
وكأن دعبلاً كان يخاطبهُ حين قال :
لو لم تكن لك أجدادٌ تبوء بهم ****الا بنفسكَ نلتَ النجمَ من كثبِ
وإلى الحلقة الثالثة ، إن شاء الله ، " وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة " والسلام !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هنالك رواية تجعل وفاته (510 م) ، وأخرى تزعم قبل الهجرة بسبعين عاماً.
(2)المهياف : هو الذي يبعد بأبله طالباً المرعى على غير علم ، السوام : الماشية التي ترعى ، مجدعة : سيئة الغذاء , السقبان : جمع سقب ، وهو ولد الناقة الذكر ، بُهل : جمع باهل وباهلة ، وهي الناقة التي لا صرار عليها ، والصرار ما يصر ضرع الناقة كي لا تُرضع .
(3)الخَمص : الجوع ، الخُمص : الضمر ،الحوايا : جمع حوية وهي الأمعاء ، خيوطة : خيوط , ماري : ربما اسم شخص اشتهر بصناعة الحبال وفتلها ، تغار : يحكم فتلها.
(4) الأمعز : المكان الصلب الكثير الحصى ، الصوان :الحجارة الملساء ، المناسم : جمع منسم وهو خف البعير ، شبّه قدميه بأخفاف البعير ، مقلل : متكسر.
(5) القعدد: الجبان القاعد عن المكارم ، والبوغاء : التراب الناعم
(6) التنومة : الأرض القفر.
(7) راجع : شرح لامية العرب للتبريزي ، ت د.محمود محمد العامودي ، شرح مفردات الكلمات ص 140 - 174 ، ويذكر التبريزي ص 137 "لا أعلم أحداً وصف القوس بهذه الصفة غيره" .
(8) راجع : حنا فاخوري : (تاريخ الأدب العربي ) - ط 11 - بيروت - 983 - ص 72 ، وراجع تعريف : الصعلوك : د. شوقي ضيف في كتابه ( العصر الجاهلي ) .
(9) شرح لامية العرب للتبريزي - المصدر السابق
(10) راجع (ديوانالشنفرى) : ثابت بن أوس الأزدي -تقديم واعداد طلال حرب- ص 35 - دار صادر - 1996 بيروت -
(11) راجع : هنري بيريس : (الشعر الأندلسي في عصر الطوائف ) ص 31 - ترجمة الطاهر أحمد -
(12) شرح التبريزي : المصدر السابق ص 136
(13) راجع : أبو علي القالي : الأمالي ج! ص 156 ، واعتمدعلى هذه الرواية بعض المحدثين في شكهم ، أمثال :
كرنكو في مفاله بدائرة المعارف الإسلامية م 13 ص 396 ، وتستطيع أن تجده في الدائرة بطبعتها الفرنسية :
F.KRENKOW: AL -SHANFARA, IN ENCYCL, DE I ,ISLAM,IV,321 - 322.
والدكتور يوسف خليف في كتابه الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ص 172 ، والدكتور شوقي ضيف في (عصره الجاهلي) ص 380 ، ولا أميل لهذه الشكوك المشكوك في أمرها كثيراً ، راجع المتن .
(14)راجع لمزيد من المعلومات ( أعجب العجب في شرح لامية العرب ) للزمخشري - الطبعة الثالثة 1324 هـ ، غير مفهرس 160 صفحة ، ( شرح لامية العرب ) للخطيب التبريزي ، تحقيق الدكتور محمود محمد العامودي، (نهاية الأرب في شرح لامية العرب ) : للأزهري ..عطاء الله بن أحمد - 30 ورقة - من مخطوطات الأزهر الشريف تحت رقم : 324660 آدب ، وممن ترجمها إلى اللغة الانكليزية وشرحها المستشرق الانكليزي ردهوس ( ت 1892 م) ، وترجمت للفرنسية والألمانية .
(15) يقول الدكتور يوسف شكري فرحات في (ديوان الصعاليك ) ط1 - دار الجيل - بيروت - 1992 :يكاد يجمع المؤرخون عل أن الشنفرى لقب ( الغليظ الشفتين ) الا أن عبد القادر البغدادي يؤكد في كتابه خزانة الأدب أن الشنفرى هو اسمه الحقيقي وهو قحطاني من الأزد .
(16)أبو الفرج الأصفهاني : ( الأغاني ج21 ، ص 207 - دار الثقافة - بيروت - 1981- الطبعة الخامسة.
(17) راجع أبو العباس المفضل بن محمد الضبي : ( ديوان المفضليات ) - شرح أبي القاسم ابن الأنباري - ص 14 - الثقافة الدينية - 2000م - بور سعيد.
(18)الجبا :: شعبة من وادي الجي عند الرويثة بين مكة والمدينة - ياقوت الحموي :معجم البلدان ج2 ص 97 - يذكر بعض أبياتها.
(19)أبو الفرج الأصفهاني : ( الأغاني) ج 21 / ص 188 - دار الفكر - بيروت - ط 2- تحفيق سمير جابر.