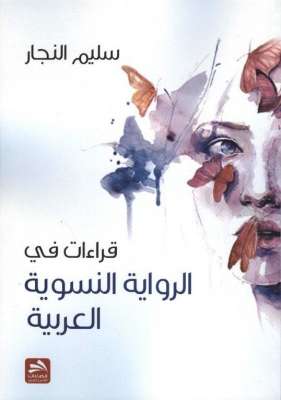كتاب نقدي
الرواية في الأردن بين الشكل والمضمون
قراءات في الرواية الأردنية
سليم النجار
قيل في الرواية: "مثل الخروب... قنطار خشب ودرهم حلاوة".
كلما دار حديث عن الأستاذ العقاد ذكرت قوله هذا في الرواية، وذكرته لكن لا في ندواته أو جلسات صالونه، لأني لم أحضر منها شيئاً، وقد ذكر عنه أثناء جلسته المعروفة في المكتبة التجارية في مقرها القديم بشارع محمد علي قرب ميدان العتبة، أنه كان يصرح علناً بهذا الرأي حول الرواية، فأثار رأيه ذلك في نفسي عجباً وإنكاراً شديداً يوم سمعته، إلا أني في هذا الرأي أنظر للقراءة من أوسع أبوابها، والرواية العالمية ما هي إلا نافذة على التجربة الإنسانية جمعاء، فإذا بالعقاد يشبه الرواية بالخروب: قنطار خشب ودرهم حلاوة! فأي روايات قرأ هذا الأديب الكبير حتى يصدر حكمه هذا؟
كل من زار القاهرة يعرف جيداً أنه، على بعد خطوات من مجلس العقاد في المكتبة التجارية عند التقاء شارع محمد علي بشارع عبد العزيز، كانت روضة الخيال التي نهل منها توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويحيى حقي، وسواهم ممن شغفوا في صباهم الباكر بالروايات المترجمة في أغلفتها الزاهية معلقة على أعمدة البواكي في ذلك الشارع مطروحة على الرصيف.
وإلى جانب السلاسل البوليسية الشهيرة (أرسين لوبين وشارلوك هولمز والزهرة القرمزية) كانت الروايات تباع في المكتبات في مدينة الفحاحيل في الكويت على أيامي بمئة فلس للنسخة الجديدة وخمسين فلساً للنسخة المستعملة وتشمل عيون الرواية العالمية في ترجمات لعلها لم تكن دقيقة ولا كاملة ولكنها تفتح أمام القارئ أفاق عوالمَ آسرة ومختلفة.
وعشت التجربة الإنسانية كلها في بيت صغير في حارة سوق الصباح، أنا الفتى الصغير قعيد البيت فيما عدا الذهاب والإياب من المدرسة وإليها.. عشت التجربة: تجربة آنا كارنينا ورؤياها المضيئة في طريقها إلى الموت، تجربة إيما بوفاري وجين إير واليزابيث بنيث وماجى تليفر ودورثيا بروك ودافيد كوبر فيلد وأليفر تويست.
عرفت اليتم والنجاح، والحب، والوطنية والخيانة، وتقلبات الروح، وهويت إلى الخطيئة، وتمرغت في الرذيلة، وعانيت اليأس والإحباط، وأشرقت نفسي بنور الأمل ونصوع الإيمان، عرفت دقائق النفس البشرية وطبائع الشعوب، وجلت في مدن العالم وتسلقت جبال الألب، وسعدت بدفء الشمس في غابات باردة وقيظها في صحاري لاهبة.
وغرقت في عذابات جين إير، أو معارك صلاح الدين وقلب الأسد، أو ضربات قلب آن إليوت وهي تسمع من وراء ستار كلمات خطيبها سابقاً عن ضعف المرأة في مقاومة ضغط أسرتها في مواضيع الحب والزواج!
وأذكر أن جين أوستن قال في الرد على من يقللون من شأن الرواية: ( هي عمل إبداعي يكشف عن قدرات عقلية فائقة، مع معرفة تامة بالطبيعة الإنسانية والبشرية وتصوير بارع لتنوعها واختلافها، وتعبير حي عن بديهة لماحة وفكاهة راقية تنقله الرواية للقارئ في لغة طلية منتقاة!).
وعندما حصلت على الشهادة المتوسطة وقُبلت أوراقي في مدرسة المعري المتوسطة قال لي والدي: "الدراسة الثانوية دراسة صعبة ويلزم لها مجهود كبير، أتضيع وقتك في قراءة المجلات والروايات؟"، وكان اعتراضه على الرواية لا يقتصر على تشخيص العقاد عن قنطار الخشب ودرهم الحلاوة، بل يمتد إلى ما تطرحه في ذهن الشباب من أفكار محرمة عن الحب والغرام، ولم يدرك، رحمه الله، أن الوقت قد فات، وأنني بالتحاقي بتلك المدرسة سأفلت تماماً من رقابة الأسرة عليّ وعلى ما أقرأ.
كانت ثانوية الفحاحيل مدرسة ممتازة ومجهزة بالمعامل والملاعب والمكتبات حتى المسرح، وكانت مكتبة المدرسة تحوي آلاف الكتب ويشرف عليها مدرِّس"مصري" لم يكن يتأنق في ملبسه، الأمر الذي جعل الطلاب يسخرون منه، ولكنه كان في نظري أجمل وأحب مدرِّس في ثانوية الفحاحيل، لأنه فتح لي أبواب المكتبة وأختار لي ما يناسب قدراتي في البداية من قصص وكتب رحلات وكتب مصوّرة عن بلدان العالم المختلفة، حتى أصبحت بعد سنتين قادراً على قراءة الرواية بكل نضج ووعي.
وقتها، تعرفت على كاتيين من الأردن، كان اللقاء الأول في المكتبة، تفاجأت في بداية الأمر، لكن لم أعرف حتى يومنا هذا السر الذي جعلني بعد لحظات أتعاطى مع الأمر بشكل سلس.
الرواية الأولى التي تلقفتْها يدي كانت: "أنت منذ اليوم" للكاتب تيسير السبول، والرواية الثانية: "أوراق عاقر" للكاتب سالم النحاس.
بدا لي أن الروائيين اللذين كتبا الروايتين عمد كلاهما إلى تثقيف نفسه بنفسه، فتعلقا بالقيمة الكبرى التي تمتع بها الكاتبان، إذ أخذا يتجاوزان ذاتهما وأطلا على أفاق واسعة أشعرتني وطبعت في ذهني أن لكل منهما رؤية ممتدة، فقد حرصا على أن يقيما واقعاً فنياً موازياً للواقع الحياتي نتيجة لتلك الرؤية الممتدة والفكر الفلسفي والموقع القوي والمواقف المتقدمة والوعي على علاقات الواقع والتمرس بالأصول الجمالية والسردية التي يقيمان عليهما عملهما الروائي: من شخوص، أو بعد إنساني وزماني، أو بعد زماني فلسفي ومكاني، أو بعد مكاني اجتماعي، ولغة فنية، أو فن من القول، وأحسست أنه لم يعد بمقدور القارئ الناقد في كثير من هذه الأعمال الروائية المتفوقة أن يفصل أي بعد عن الأخر أو يفكه منه.
ثم دارت الأيام دورتها، وعدت إلى عمان عام 1990 بعد أحداث ما عرفته الصحافة العالمية والعربية بأحداث الكويت، آنذاك بدأت أتلمس طريقي قي قراءة الرواية الأردنية، فاكتشفت أن هذه الرواية لم تقم بمعزل عن الروايتين: العربية والعالمية، بل هي نشأت في خلالهما وتطورت بمقتضى التطور الذي أصاب الحياة، لأنها تأثرت بكل ما نشأ واستجد في تلك الحياة وأصبحت متناول يد الإنسان وأمام بصره، فأخذت بكل أسباب المعاصرة واستفادت من التحولات: السريعة والبطيئة في نشاطات الإنسان، سواء كانت نشاطات اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية.
وبهذا، فقد مثلت الرواية الحياة تمثيلاً واقعياً، وعبرت عن هذا التمثيل في زج نفسها داخل المعترك، فتلونت اتجاهاتُها بتلون البيئة التي تفاعلت مع مكوناتها، وأنتجت من داخلها أعمالاً روائية كانت موضع اهتمام ودراسة من المدارس النقدية.
إن تطور الرواية الأردنية، وتعدد النوع فيها، ارتبط بالأحداث الساخنة التي شهدتها الأرض العربية: حرب فلسطين عام 1948، نكسة حزيران، حرب أكتوبر، الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، أحداث الكويت عام 1990... إلخ، وتفاعل الإبداع الأدبي بشكل عام والرواية بشكل خاص مع قضايا الشعب والأمة جراء الأوضاع النفسية التي خلقتها أحداث تلك الصراعات، لأنها عبرت عن صور التفاعل إيجابياً أو سلبياً مع تلك الأحداث، فأصبح الروائي الأردني لا يُـقبل على الإبداع في روايته إلا بعد أن يمتلئ ثقة برؤيته الفنية الممتدة، و(بمغامرته) الجديدة المتقدمة، وبتجربته المتفردة التي لا تشكل تكراراً لما سبق. ولعل أبرز ما أنتجه الأدب الروائي الأردني من نصوص سردية في سياقها الاجتماعي تلك النماذج التي نجدها في طيات هذا الكتاب.
وانشغل السرد الروائي، المحتوى في النماذج المطروحة في الكتاب، بالفكرة على حساب الصنعة اللغوية، وعلى أساس تقديم المضمون والحكاية، حتى قاد الإفراطُ في العناية بالفكرة في مراحل مختلفة إلى (حساسية فنية) مرتبطة بالشكل بحيث باتت الفكرة في الرواية الأردنية هي أساس الذائقة الفنية.
والعلاقة بين السرد العربي وتطوره علاقة متداخلة ومتأثرة بالأدب الإنساني، ومن ثم فإن المؤثرات الأجنبية نجدها في تكوين ما تقرأه من سرد وما يسايره من نقد.
ليس العمل الروائي الأردني بعيداً عن المتغيرات: الاجتماعية والسياسية العالمية، وخصوصاً في خضم ظروف عالمية متفاعلة تتجاوز أبعادَها السياسية، لتحيل التفاعل الثقافي وتعبيراته الإبداعية إلى كتاب مفتوح يقرأ فيه كل مبدع ما يريد ويتعرف أشكالَ الفن والتجارب الإنسانية، ولكن، في الوقت نفسه، يخط بقلمه سرداً ذاتياً يضيف به مسحة إلى التجربة الإنسانية.
وهكذا انتشر السرد الروائي في الأردن باعتباره سجلاً للحراك الاجتماعي والسياسي وتعبيراً عن التجارب الإنسانية في أبعادها المختلفة.
ويمكننا التأكيد على أن السرد في المشهد الإبداعي الأردني بات اليوم نصاً مميزاً، وما العناية به نشراً لنصوصه والاحتفاء بنقده إلا دليل على أهمية السرد في حياتنا الثقافية، ولهذا نخصص له هذا الكتاب لقراءات نقدية لنخبة من الروائيين والروائيات الأردنيين.
أحمد الطراونة:
وادي الصفصافة
روح الصحراء!
العلاقة بين الشكل والمضمون في الرواية، كالعلاقة بين الخيط والإبرة، لذا فالرواية الحديثة تتركز على هندسة المكان، وعلى محطات كثيرة، تبرز بروزا ًواضحاً في معظم الأبحاث النقدية التي كتبت في هذا المجال، ولعل أبرز هذه المحطات:
- أن الرواية الآن بالنسبة للعالم الثالث، تعتبر أقوى سلاح في أيدي مبدعي هذا العالم، إن هم أحسنوا استعمال هذا السلاح، فقد أغنت تجربتهم الإنسانية كثيرًا، واستطاعوا من خلال هذا الفن، أن ينفذوا إلى سمع وأبصار العالم الآخر.
ومن خلال ذلك نرى، أن هناك اعتبارات فنية على كافة الروائيين في العالم الالتزام بها، ومن ضمنهم روائيو العالم الثالث بشكل خاص، وعلى رأس هذه الاعتبارات:
- إننا بحاجة إلى أدنى حد من الكلمات، واقصى حد من الفن.
- إن الرواية، هي الفن الذي لا يمكن، ولا يجب ان نثرثر فيه.
- إن الكلمة التي ليس لها وظيفة في الرواية، مثلها كمثل قشة التبن في وسادة القطن، فلا هي أراحت النائم، ولا هي استراحت في مكانها.
- إن التجربة الشخصية هي أهم ما تعالجه الرواية الحديثة، والتجربة الشخصية ـ كما يقول هنري جيمس- يجب الا تنقل نقلا ًمباشراً سطحياً، وإنما الاساس هو تحويلها الى رواية فنية، وهنا تكمن مزية الفنان وعبقريته، وذلك في كونه ينقل الانطباع الشخصي المباشر ويحوله الى نمط يتجاوز كل ما هو فردي وذاتي، ان الفنان يحول الافكار إلى صور ملموسة، تنتج الحقيقة، ومن هنا كانت العلاقة بين الرواية وموضوعها علاقة عضوية، فكلاهما يتمازجان في كيان عضوي واحد.
فأين موقع رواية "وادي الصفصافة" لأحمد الطراونة مما سبق؟
بسبر القيم الفنية للرواية، نستطيع ان نحلل الهندسة الروائية التي أخذ بها الطراونة في روايته، فمن هذه القيم:
- جماليات المكان.
- تشكيلات الزمان.
- معمارية الخلايا التعبيرية.
- بنائية الملحمة الروائية.
- مواجهات الانسان (الانسان في قلقه، وفي غربته) (1).
1. جماليات المكان وتشكيلات الزمان
الأمكنة هي البشر، والناس هم الزمن، والحركة هي المكان والزمان.
اذن، فالإنسان هو المكان، والزمان، والحركة، وقبله وبدونه، لا مكان ولا زمان، ولا حركة.
يمثل المكان والزمان في الرواية وحدة عضوية لا تنفصم، ثم تأتي الحركة بعد ذلك، لتكمل هذه الوحدة، وتضفي عليها الحياة.
فالمكان بدون حركة لا يصبح مكانا ًوإنما قطعة ارض صماء. فالذي يعطي المكان حياته هو الحركة، والمكان هو تلك البقعة من الارض او المبنى الذي يمكّن الإنسان على الأرض، أي يجعله مكانا قادرا ًعلى الحياة على الارض.
واذا كانت هناك علاقة قوية بين المكان والحركة من جهة، وبين الزمان والحركة من جهة اخرى، فإن هناك علاقة قوية أيضًا بين المكان والزمان. فالمكان لا يمكّن إلا بالزمان، والزمان لا يزمّن الا بالمكان، بمعنى ان المكان الذي لا يزمّن، لا يعد زمانا، والمكان يكتسب كينونته من الزمان الذي تدب فيه الحركة، والزمان يكتسب زمنيته من المكان والحركة التي في داخله.
يلعب المكان في رواية أحمد الطراونة، دور البطل، ويقوم بالمساعدة على التشكيل العام للحدث الروائي، سواء كان هذا المكان مخلوقا ًاو مختلقاً، وهما نوعان وحيدان من انواع الأمكنة في رواية الطراونة، فإما ان يكون المكان مخلوقا اصلا قبل كتابة الرواية، فيأتي الروائي ويحدد ديكوراته من جديد، بما يتناسب واحداث روايته، وإما ان يكون المكان مختلقا، غير موجود في الواقع، ولكنه من صنع المبدع من ألفه الى يائه، يهندسه، ويبنيه، ويزينه، ويؤثثه، بما يتفق وأحداث روايته، مثله في ذلك مثل المخرج في الفيلم السينمائي، الذي يختار من واقع النص اماكن تصوير فيلمه، وديكورات هذه الاماكن.
ثمة ملاحظة نود من قارئ رواية احمد الطراونة ان يلتفت اليها، وهي أن الطراونة، كان قروي الاماكن، فقد انصب اهتمامه في وصف القرية، دون الاماكن البيتية، فقد كانت معظم اماكنه، بلا حدود، واسعة الفضاء، ممتدة متغيرة.
(عادت الارض تجتر احزانها، كما الشاة في ليل كان الطويل.
تسللت الى تلك الصخرة الكبيرة التي تمتد على وجه القرية البائس، جلست وحيدا حينها اسرح في وجه الشرق مع بعض ذكريات، لمحته يخرج كعادته يلف يديه خلف ظهره وهو يمسك عصاه.... الرواية، ص 197).
من خلال الاشارة السابقة، نستطيع استخلاص التجليات التالية للمكان في هذه الرواية:
- ان رواية (وادي الصفصافة) رواية ذهنية، غايتها الكشف عن وجوه قمع الفقر، والاضطهاد الذي يعاني منه الانسان في مجتمعه.
لذا، فإن الطراونة لم يكن بحاجة الى رسم الامكنة في روايته على النحو الذي يفضله الروائيون الواقعيون، لا سيما وانه يكتب رواية ذهنية ليخدم وصف المكان فيها أي جانباً من الجوانب الفنية الاخرى، فيما لو أصرَّ الروائي على وصفه وصفاً تاماً أو تخيل هذا الوصف تخيلاً تاماً.
إن الروائي يقدم لنا المواصفات اللازمة للمكان بما يتناسب وموضوع الرواية وطبقاً لما تحتاجه تقنيات الرواية نفسها، وبالقدر الذي تستطيع هذه المواصفات المكانية ان تخدم الرواية.
2. تشكيلات الزمان.
إن ظاهرة الزمن المرتبطة بالمكان والحركة في رواية الطراونة ظاهرة زمنية من النوع البسيط، وليست من النوع المركب، ونعني بالزمن البسيط الزمن الذي يقسم الى مستويات اربعة:
ـ الزمن الاسترجاعي الذي يعود دائماً من الحاضر الى الماضي.
ـ الزمن الاستباقي، وهو الزمن الماضي نحو المستقبل والذي يتقدم مع تقدم الاحداث، ويطلق عليه بعض النقاد الزمان المتقدم او العائد.
ـ الزمن المتنوع، وهو الزمن الذي يجمع عدة ازمنة في حدث واحد، وينوع بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويخلط بينها ولا يخضع لزمن الساعة الذي يتقدم دائما الى الامام.
ـ الزمن النفسي وهو الذي يلغي الازمنة التقليدية الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل كما يلغي تكتكات الساعة، ويحل محلها تكتكات القلب، وتجليات النفس.
وفي (وادي الصفصافة) كان الزمن زمناً استرجاعياً في معظم الاوقات. فقد كان الروائي يعود من الماضي الى الحاضر، ومن الحاضر الى الماضي، لكي يساعد الحدث على النمو والتقدم. ويستطيع القارئ، ان يكتشف اشارات كثيرة لهذا الزمن الاسترجاعي في الرواية، فهو زمن بسيط وواضح. (توالى النهار، وتوالت الاستفسارات، وتوالى دخول الثوار الى المحكمة، وما ان غابت الشمس حتى سقطت اوراق المحكمة واحكامها في جرابها لتحمل في اليوم التالي مع اجساد المحكومين الى دمشق مودعين ارواحهم التي لم تفارق المكان...الرواية، ص211).
3 ـ معمارية الخلايا التعبيرية
الخلية التعبيرية هي وحدة بناء جسم الرواية، وتتكون من قول وفعل مسرود.
من اهم عناصر الهندسة الروائية (الخلية التعبيرية)، والتي هي وحدة البناء الهندسي في جسم الرواية الذي يتكون عادة من عدد من هذه الخلايا على اختلاف انواعها وأشكالها، والخلية التعبيرية تتكون من قول وفعل.
فإما ان يكون هذا الفعل مسرودا أو ان يأتي على شكل فردي او ثنائي تناوبي او ثلاثي.
والخلايا التعبيرية في رواية الطراونة تنقسم الى قسمين:
1 ـ الخلية التعبيرية الجوانية الكاملة، وتأتي على شكل حوار جواني فردي مع (الانا) وتقوم ببنائها احدى شخصيات الرواية ووظيفتها اتاحة الفرصة للشخصية للتعبير عن افكارها وبث مشاعرها.
2 ـ الخلية التعبيرية النصف جوانية وتأتي على شكل حوار جواني ولكن ليس مع (الانا) الانسانية وانما مع الحيوان او النبات او الجماد الذي يعتبر (انا) خارجية، ووظيفتها تفريغية اي تفريغ المشاعر والاحزان المكنونة داخل النفس.
(كم بنت عندك؟)
ـ (خمس بنات)
ـ (كم ولد ؟)
ـ (سبعة)
ـ (وين هم)
ـ (مع هالناس اللي وراك)
ـ (قلت لك كم واحد فوق العشرين سنة؟)
ـ (ولا واحد)
(أنت كذاب يا حماد)
يقترب حماد من الكاتب رافعا يده: (احترم حالك يا أفندي عشان نحترمك ونكون صادقين معك)...(الرواية، ص 113).
ونخلص من هذا كله إلى أن أحمد الطراونة جرب واستعمل معظم الخلايا التعبيرية التي من الصعب لأي روائي أن يستعملها.
4ـ بنائية الملحمة الروائية
الملحمة هي شعر القلب ونثر العلاقات الاجتماعية.
السؤال الذي نبحث عن إجابة له هنا هو:
ـ هل أحمد الطراونة في روايته (وادي الصفصافة) روائي ملحمي أو في بعضها توجد تجليات ملحمة معينة؟
هناك مفهومان للملحمة: الأول قديم والثاني حديث، أما القديم فكانت الملحمة في البدء تؤرخ لانتصارات وأفراح النبلاء والطبقة الارستقراطية وتسجيل أيامهم السعيدة وبطولاتهم الخارقة لذا فقد كانت الملاحم القديمة تحقق تحالفاً عفوياً بين نظامين ـ كما يقول أراغون ـ هما الأرضي والإلهي. والنظام الإلهي لم يكن منفصلاً عن النظام الاجتماعي، ومن هنا كان أبطال الملاحم القديمة إسقاطا ميثولوجيا للحياة، والجماعة، وكانوا يجسدون أخلاقاً عالية لكي يعترف بطابعهم البطولي الخارق.
والملحمة الحديثة حافظت على هذه الروح وأصبحت عبارة عن حدث واحد تتولاه أجيال متعاقبة، وربما ينتهي أو لا ينتهي بانتهاء الرواية الملحمية ولكنه غالباً ما لا ينتهي، إذ يظل ينتظر الأجيال القادمة لكي تكمله، فالإنسان كالشجرة، يروي مستقبله على أمل البقاء والعطاء، ومن هنا يتخذ هذا الحدث طابعه الملحمي.
(لم تختف ظلال الأشياء بعد ….
ما تزال الشمس تغذ الخطى نحو منتصف السماء
تمتمات نساء طاعنات في السن.
أطفال علت الأحزان وجوههم يجوبون باب الدار العتيقة يمتطون خيالات جياد من خشب يقصفون أعمارها من شجرة (أم احمد). كان الجميع يرحلون إلى الماضي) ص223.
5 ـ مواجهات الإنسان في قلقه وغربته
إن الإنسان وقضاياه هو البداية والنهاية في رواية (وادي الصفصافة) لأحمد الطراونة. وهو العنصر المستهدف في هذه الرواية التي هي عبارة عن سفر للإنسان في غربته، وجنونه، وفي حزنه، وفي قلقه وفي رفضه، وفي أحلامه وفي آلامه وعذاباته، في طموحاته وخيبة آماله، في جلد ذاته، في حاضره وماضيه ومستقبله، وهكذا تظل إشكالية الغربة سمة من ابرز سمات الحياة العربية المعاصرة التي تناولتها الرواية العربية تناولا جادا وهادفا.
بلاغة الحزن في الرواية
مفهوم الحزن في الرواية العربية شديد القصر، فمفهوم الحزن في الرواية أرحب من اختزاله في جملة مقولات مجردة تحمل بوصفها معايير تقليدية تنفي حق الباحث في إخضاعها للمقارنة النقدية المستجيبة للتبدلات في المواقف الجمالية تجاه هذا الفن.
فعلينا أن نتعامل مع روايتنا العربية بوصفها إنتاجاً إبداعياً يحمل قيماً تتفق مع القيم الجمالية للرواية المعاصرة في بعض جوانبها وتفارقها في جوانب أخرى، كحال الرواية نفسها في مراحل تطورها المتعددة دون أن تتخلى عن انتمائها المفهومي إليها لتغدو هذه الأحزان إحدى حلقات الفن الروائي الحاضر بحضور الإنسان الساعي إلى التعبير عن ذاته والتواصل مع الآخر والتأثير فيه التي تمد الحيوية في شرايين هذا الفن وتحفظ له شبابه الدائم.
ونلاحظ أن الشخصية الحزينة في رواية "وادى الصفصافة" ذات طابع نمطي، بمعنى أنها عملية ترميز تضع صفة ما بطريقة مكثفة في هيئة إنسانية، أي عين الراوي تتحول إلى عدسة تسلط الضوء على خطوط محددة في ملامح ذات فتبرزها كما يحدث في "الكاريكاتير" المرتبط بمصطلح الشخصية. ويبدو طبيعياً تجلي الحزن في أفق المجال المفهومي للنموذج المحتال مع ملاحظة أن ((البحث عن النموذج الإنساني يعني أن السرد العربي قد وصل إلى مرحلة عالية يستطيع القاص فيها أن يشكل شخصياته لتعانق التصور الذهني للمتلقي في عصره وفي كل العصور))"6".
ويصير استقطاب قطب الضحية للشخصية التي تتعرض للخداع من قبل الحزين أمراً متناسقاً مع الطبيعة البنائية للنص وبوصفنا متلقين في مواجهة قرائية مع بنية مكانية تتأسس روافدها الدرامية على الصراع الذهني بين هذين القطبيين أو بالأحرى تستند كفاءتها السردية إلى المواجهة بين الخصوبة الذهنية الاحتيالية لشخصية الحزين والممارسات الدفاعية الارتدادية للشخصية المستقبلية لحيل الحزين:
((فنوم الظالمين عبادة ونوم المظلومين راحة...))
أسئلة تسقط دونما وعي بها أم أنه الوعي المطلق؟... لا يعرف ما الذي أنساه اجتماع المزار وقد ساقته الخطى نحو العرب دون أن يشعر حين قابله حسين قال ذلك هو يرمي برأسه فوق يديه على حبل البيت الطويل.
((يا حسين يا ا خوي حامل هم ها الدنيا .. إن شاء الله اجتماعكو اليوم خير)) .
((ومن وين يجي الخير يا حسين))"7".
تطرح شخصية حسن الحزين نفسها داخل نص أخبار الرواية بوصفها شخصية ملتبسة ويتأسس هذا الطابع الإلتباسي عندما يجد المتلقي نفسه مضطر إلى عقد مقارنة بين المساحة التي تشغلها الشخصية داخل النص السردي والمساحة التي تشغلها داخل وعي السياق المحتضن لها على المستوى المرجعي فإذا كانت شخصية الحزين حاضرة في وعي جماعته الإنسانية بوصفها شخصية هامشية يتم التعامل معها عبر منظور استعلائي تسليبي ـ والتسليب ((عمل ذهني قوامه رفض قضية أو فكرة))"8".
فإن الأمر يتباين على مستوى وعي النص الإبداعي ـ الأكثر بقاء وخلود ـ الذي يمنح الأفضلية النصية لكي يغازل وعي المتلقي وينتهك بسلاسة الرؤية النمطية النافية له والمتعاملة معه بدونية لا تتوازى مع إمكاناته المميزة وقدراته الحقيقية فالإشكالية هنا تتبدى((بالمطابقة بين الشخصية التي هي كائن اجتماعي يتمتع بوجود واقعي وبين الشخصية بما هي تشيد نص أو بنية جزئية ضمن مكونات البنية الكلية للخطاب)) "9".
" و" تلاشي هذه الإشكالية الالتباسية بممارستها التشريحية التي تقربنا من "شخصية الحزين"مما يسهم في الكشف عن تواطؤ النص معها وعن تعمد السارد نحيل هذا التباين/ المفارقة بين مظهري حضور الشخصية على المستويين الواقعي والمتخيل بغية إحداث خلخلة في مرتكزات الوعي المستقبل كخطوة مهمة في سبيل تصدير رؤاه الأيديولوجية عبر شفرات إبداعية تنطوي على مؤشرات دلالية ذات أبعاد منفتحة تحقق هذا التماس بين المرجعي والفني دون أن تتخلى عن دورها في إعادة تشكيل وعي جماعتها ((فتحويل الحكايات المتداولة ذات الأصل الواقعي حيناً والمتخيل حيناً أخر إلى تشكيل ممعن في مفارقته للتجربة المباشرة أدخل في الميثولوجيا والوعي الجماعي المتوارث))"10".
ومن ثم ينبغي التعامل مع هذه الصورة المفارقة للشخصية الحزينة باعتبارها صورة مفعمة بالخصوبة الدلالية الكاشفة عن معطيات المنظور الأيديولوجي للنص ((ويمثل هذا المنظور بناء القيم التحتي الشامل للعمل الأدبي الذي يبرز من خلال مستويات القيم المختلفة التي تطرح فيه))"11".
وعندما نتعامل مع الحزن بوصفه شخصية محتالة فإن هذا التعامل يكتسب مشروعيته التداولية من الاتساع الدلالي لمفهوم الاحتيال المستقطب للعديد من ممارسات الحزن هذه الممارسات المنبثقة من بؤرة مفهومية ثابته وإن تباينت مظاهر حضورها فالشخصية الحزينة قد تحتال بغرض الدخول إلى البيت أو بغرض الإستزادة في الطعام أو بغرض الاستطالة في مدة الإقامة أو غيرها من الأغراض التي ينظمها خيط تحقق أكبر قدر ممارسته الاحتيالية المتعددة ومن ثم يمكن القول إن شخصية الحزين تحركها في الفعل الدرامي ((الرغبة في اختيار العالم وقراءته)) "12".
((انفرجت أسارير الحج وراح يلظم ما تهاوى من عمره ويرمم ما تشظى من ذاكرته.. فقد أعاد حديثها ذاكرته إلى أكثر من عشرين سنة.. ويبدو أن الليل قد أطال الفراق لتبدو مشرقة كالشمس ورغم بعض خصل من الشيب تسللت من تحت عصابة رأسها ورغم سني عمرها التي تجاوزت الأربعين إلا أنها بدت في ذلك الصباح في زهوها تتهاوي كما لغزال في عين أبي محمد على الأقل.
مد يده إلى غليونه المركون بجانب النار وهو ينظر إلى أم محمد أخرجه من لجة الذاكرة التي اشتاقت فجأة صوت القهوة التي اندلعت على النار وأفسدتها.))"13".
يبدو النص مفعماً بالحس الحزائني الذي هو استجابة معقدة لا يمكن اختزال مسبباتها بسهولة لتكون سمة واحدة أو مجموعة صغيرة من السمات الناتج عن الحالة الانفراجية التي تطرح نفسها على النص كفعل ختامي لحالة التوتر الدرامي الناتجة عن تباين مصالح الشخصيات الحكائية وتعارضها فالحزن يتولد من حالة التوتر في المواقف الهزلية التي عادة تتصاعد حتى تفرج فجأة عن طريق الانفجار مصحوبة بالحزن بصفة عامة فالشخصية الحزينة التي تتفيأ التذكر بغية إشباع رغبته في جسد زوجته يجد نفسه في صراع مع الزمن ووهن الجسد هذا الصراع الذي يسهم في تكوين الموقف الدرامي الناضج الذي يمثل أعلى درجات التوتر للشخصية الحزينة فتأتي تصرفاته منفعلة.
فالسارد هنا يستغل العلاقة الطردية بين التوتر والانفراج فكلما تضاعف الإحساس بالتوتر نتيجة ما يحيط بالشخصية من خطر كانت الحالة الانفراجية التابعة لحالة التوتر هذه ذات تأثير فعال على مستوى استقبال المتلقي لها كأحد حوافز الحزن واستطاع الطراونة تحقيق التناغم بين المأساوي والفعل المتوتر إذ من خلاله تدمج المأساة بالحزن ويحدث انقلاب في الدلالة وتؤدي هذه المفارقة دوراً بالغ الأهمية على صعيد جماليات التلقي وتجسيد رؤية الراوي.
وهكذا يتبين لنا النضج الفني الذي وصل إليه السارد ووعيه شبه الكامل بمقتضيات فعل السرد ومفرداته مما مكنه من توظيف الحزن في النص بهذا الشكل البارع.
المثقف والاستبدال الوظيفي
واليوم إذ نعيش تراجعاً في الفحولة وضموراً في الجسم الثقافي وحيرة في التفكير وقلقاً وتلعثماً في العبارة نصف حالتنا بأمانة ليست تلتبس على لبيب على ما يحاول المثقف من إبداء مكابرة سياسية هي ممانعة لغوية في المقام الأول والاعتراف بهذه الحالة هو سعي إليه أحمد الطراونة في روايته "وادي الصفصافة" التي سلط الضوء على تلك الشريحة من المثقفين التي التزمت طويلاً خط التنوير الثقافي فانقسمت شريحتهم إلى أبعاض: بعضٌ يشايعها على ما هو عليه أمرها من سوء حال مصراً على تعطيل حاسة النقد في رؤيته إليها وبعضٌ يشيعها إلى دار البقاء فيرتجل مقالة من الشماتة فيها وبعضٌ ثالث عنها بتقديم خبرته لولي نعمته ابتغاء مرضاته والتماساً لشفاعته يوم لا يشفع إلا من اشتدت وطأته! هذا الرهط من تلك الشريحة. وكلما أمعن أحمد الطراونة في الكتابة البوح إنفرط عقد الأسرار الثمين ودخلت الحقيقة طور الكشف فهذه "الصفصافة" لم تبقى سر في سرد أحداثها وسر أمدادها وأهلها من قبلها.
إذن هو النبض الكركي وأشجان "الأرواح المضطربة" في ليالي إلهية التي تمردت على الحكم العثماني الجائر. لقد تعدّدت عملية نسج الأسرار ومن ثم تفكيكها أحداث الرواية لتطال عملية الكتابة الروائية نفسها فـ "الصفصافة" تقدم كل أسرارها إلى الصحافي أحمد الطراونة لكي يبوح بها بوحاً ينتهي إلى الثورة أو الموت أو الكتابة الأدبية الملتزمة لصحافي مثقف.
وهكذا تصبح حادثة السرد نفسها وعملية الكتابة أخر مراحل الدعوة الباطنية وأولى علامات ظهورها إلى العلن.
لقد جعل الكاتب الداعية أحمد الطراونة الباطنية تنفي نفسها وأراد بالسر أن يهتك بمثله كاتبنا إذن كان في الرواية ما أرد أن يكون في الواقع: مئذنة الوعي التنويري الممنوع وجدانه المبتور. وكان من أهم ما حققه الطراونة أن أظهر لنا ألية الاستعمار العثماني الداعي إلى "تغييب" الأماكن والتواريخ التي قامت بها الثورة الكركية:
((القرية يا بن أخوي ما عادت قرية والناس ما عادت ناس كل واحد بنهش في لحم أخوه وأنت العين عليك..)) "14".
كان أقصى غاية الكاتب أن يعطي قراءة الشجاعة لنشر دعوة واقعية ذات رؤيا إنسانية لا تتناقض مع التجربة الإنسانية لأهل الكرك لكن تهزأ من أوهام البطولات في مخيلة البعض كما صوّرها الكاتب في رواية "وادي الصفصافة" يقول في الرواية ((ترك الشبان وراءهما ضجيج وأصوات الاتهامات المتبادلة في من هو المسؤول عن الهزيمة النكراء وكان احميده منتشياً)).
لقد صارت رواية "وادي الصفصافة" مسودة لرؤيا جديدة وبسيطة: الذات الجماعية تؤكد ديمومتها ليس ببطولة خارقة بل بشيء من الصمت أو الألم أو التمرد .. الذاكرة المشتركة للكركي باقية عن تماسكها الوجودي تحت مطرقة التغيب العثماني الذي قام به وجعل أهلها يعيشون على ذاكرة الأوجاع يقول في الرواية:
((تغفو الحياة على وجع أهلها وهم يبحثون عن ظلال الفرح على وسائدهم وسجن الظلام تتساقط من جوف السماء لتجهز على ما تبقى من ضوء وتغادر الأرواح أجسادها .. وكلما اذلهم الظلام زادت فرص التعارف والالتقاء بين هذه الأرواح))"16".
تعرب ظاهرة الأرواح عن نفسها في شكل انتاج متواتر لنمط من "النقد الذاتي" يفيض عن أية وظيفة طبيعية محتملة من جنس تلك التي تجند موضوعات ذلك النقد الذاتي في مشروع تصحيح معرفي لمنطلقات التفكير أو في مشروع تزويد الممارسة الفكرية بفرضيات وإشكاليات جديدة يعتقد في أنها تفيد "مغامرة التفكير" أو قد تفتح أمام الممارسة مجاهل كانت ممتنعة كما فعل الطراونة في بوحه عن الأرواح المهزومة.
يسعى الطراونة في هذا البوح الكشف عن انحياز المثقف التائب انتقاله الفجائعي من توسل المعرفة إلى تسول ولي " النعمة " بكثير من الادعاء وقليل من الحياء: لا يجرؤ أن يقول لجمهوره الجديد أنه يقدم نفسه له مجدّداً في صورة رسولٍ صاحب رسالة فلا يخجل من أن يكرر في الحاضر ما ادعاه في الماضي وثبت بطلانه! لقد كان بالأمس داعية للثورة أو للفكرة القادرة على إلهاب النفوس وتجييش الناس أما اليوم فهو فقيه ولي النعمة الذي يؤجر لساته لتحصيل عائدات ذلك بعض مالٍ وجاه ونفوذ. هل تغير شيء إذاً ؟ نعم تغير المعنى وإن ظل المبنى على حاله ظل في الحالين يقدم نفسه أسطورياً : مالك الحقيقة الذي تنغلق المجاهل انغلاقاً أمام ضربة عالمه السحرية فيقشع الناس أسراره المكنون بفضله: شعباً كانوا أم أهل مدينة وولي نعمة ! غير أنه ـ وهنا المتغير ـ لم يكن يطمع في ما مضى من أدوار إلى أكثر من الشعور المريح بأداء الواجب التاريخي وحتى في الأحوال التي يقع فيها تحت وطأة الشعور بالذات وهي في أخلاقه السابقة ورمٌ خبيث وفعل شائن ممجوج لم يكن يطمع إلا في رضا الجمهور وثنائية. أما اليوم فهو لا يقبل من وظيفته تأجير اللسان أقل من ثمن مجز يبرر "تضحيته" الجسيمة بالتخلي عن ملكوته "الجماهيري" ثمن الدور الأول رمزي أما الثاني فمادي ثمنه بلا زيادة ولا نقصان! عند هذه النقطة بالذات يدخل أهل خطاب التوبة بضاعتهم الثقافية مجال السوق فيتقاسمون مع أهل التجارة قيمهم مع حفظ القارئ بين أخلاق الفريقين.
هل في وسعنا أن نفكر في الأسباب التحتية العميقة التي تصنع ظاهرة التوبة لدى المثقفين بعيداً عن حكم القيمة الأخلاقي؟ يقول في الرواية:
((المتصرف يقول لصالح أفندي وشاكر بك: حانت ساعة المتردين. اراهم يندحرون.. انظر واسمع فزع الأهالي أمام القلعة.
شاكر بك: هذا ولا سيدي مجرد حشرات ورايحين يندعسوا بالرجلين.
ـ الرجل حين خدرنا كان صادقاً لكن إحنا تخاذلنا))"17".
لم يخرج خطاب المهادنة للسلطة العثمانية من جوف الفقر فحسب وعلى نحو حصري بل خرج أيضاً من جوف ضعف وهشاشة المقاومة المعنوية لدى قسم من الأهالي لم تكن تحصيناته ودفاعاته الأخلاقية من القوة بحيث تزوده بأسباب الحماية من غارات الجاه والمال والنفوذ واغراءات التسلق والوصول السهل ! ولا يعتقدن أحد أن الفاقة والحرمان ما صنعا حالة الرضاوة المعنوية تلك.
خطاب المهادنة هو اليوم أعلى مراحل الانفضاح في الثقافة العربية هو لحظة الاختبار المثلي لقدرة المثقف على أن يكون ما يعنيه حدُّه: مثقفاً من سوء حظنا أن قسماً من الممتحنين ما زال يقاوم .
قد يكون قليل الأفراد، واحداً من هذه القلائل وغريباً في مجتمع الاستهلاكي الثقافية الجديدة ليكن طوبى لغرباء "وادي الصفصافة" .
أزمة الحداثة في الرواية
الحضارة الحديثة في الاقتصاد والسياسة والثقافة والفن أدباً ورسماً وموسيقى ونحتاً وعادات وتقاليد كلها ذات منشأ غربي . هذا ما قرره التاريخ رغماً عنا يوم خرج العرب من التاريخ "18" وقضوا مرحلة "الكمون" في سبات من الانحطاط والحكم العثماني حتى قرعت طبول الحرب ودوت مدافع نابليون في أسماعنا واستيقظنا مذعورين ولا نزال حتى اللحظة نعيش الوهلة وكأنها الغزو الثقافي والحضاري ونمضي في مواجهة الغزو هنا بعدة طائفية في قيمها ورباط خيلها عدة التشرنق على الذات طوائف ومذاهب وبطوناً وأفخاذاً؟!
والغرب قال : كل فات فات وكل ما هو آت آت. شرّع الابواق على المستقبل لكنه بنى لكل عبقري قديم تمثالاً وأسس باسمه مدرسة ومركزاً للبحث العلمي وفي محراب عقله القديم صلى بإيمان راسخ بالعقل لا يوازيه فعل الخمول. ولأنه فعل ذلك أبدع لم يوصد الباب على مسرح راسين وشكسبير لكنه افتتح حقلاً جديداً من الكتابة فقامت الرومنطيقية كتعبير سياسي عن وجع العصر في الشعر كما سائر في الفنون وخرجت الرواية بمثابة ملحمة للبرجوازية حسب تعبير لوكاتش وتناسلت من هذه وتلك أشكال من الإبداع لا نعرف مآلها.
نسوق هذا القول لأن الروائي أحمد الطراونة في روايته "وادي الصفصافة" يتفتح على سؤال كبير هو: أين نهضتنا نحن من هذه النهضة الغربية؟
الطراونة في نصه الروائي أكد، لقد نهضنا وقدمنا الشهداء، والنهضة لغة نقيض العقود ودماء الشهداء خير دليل على هذا النهوض. واستيقظنا واليقظة لغة نقيض النوم وهذا ما حصل معنا فقام أهل الهية في الكرك واستيقظوا لكن ماذا حصل؟ بعد استيقاظنا من النوم ما زلنا نتنقل إلى أخرى قبل أن نستوعب سابقاتها فلم يمضى وقت طويل على مدافع نابليون حتى جاء الاستعمار في صورته الأولى ثم تلته صورة جديدة قد لا يكون آخرها الربيع العربي ولا السلام القادم.
كل نص جميل يثير فينا غبطة نسميه حداثياً، الحداثة تاريخنا ومجدنا، فالرواية وحدها بوسائل دفاعها الذاتية تتقن نحت التماثيل للخالدين في "وادي الصفصافة" وصياغة التاريخ من نصوص الذين صنعوا تاريخه.
الهوامش
2 ـ وادي الصفصافة ـ أحمد الطراونة ـ أزمنة ـ عمان ـ ص "197" عام 2008
3ـ مصدر سبق ذكره ص "211"
4 ـ مصدر سبق ذكره ص "113"
5 ـ مصدر سبق ذكره ص "223"
6 ـ بناء الشخصية في القصص التراثي: د. سيد محمد السيد قطب ـ ود. عيسى مرسي سليم ـ ود. جلال أبو زيد ـ كيلوباترا للطباعة ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ـ 2001 ـ ص"96"
7 ـ مصدر سبق ذكره ص"89"
8ـ معجم المصطلحات العربية في الأدب واللغة : مجدي وهبة ـ كامل المهندس ـ مكتبة لبنان ـ بيروت الطبعة الثانية ـ 1984م ص "285"
9ـ حي بن يقظان ـ تحليل بنيوي ـ ص" 189" ـ د. علاء عبد المنعم إبراهيم.
10 ـ الرواية الجديدة: د. صلاح فضل ـ الهيئة العامة للكتاب ـ مكتبة الأسرة ـ القاهرة الطبعة الأولى ـ 2002 ص"87"
11 ـ بناء الرواية ـ دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ: د. سيزا قاسم ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ مكتبة الأسرة ـ القاهرة ـ 2004م ص" 188"
12 ـ الذات والعالم ـ دراسات في القصة والرواية ـ د. صلاح السروي ـ سلسلة كتابات نقدية ـ العدد 126 ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة ـ الطبعة الأولى ـ 2002م ـ ص "129"
13 ـ مصدر سبق ذكره ص "67"
14 ـ مصدر سبق ذكره ص" 75"
15 ـ مصدر سبق ذكره ص"75"
16 ـ مصدر سبق ذكره ص" 77"
17 ـ مصدر سبق ذكره ص" 162"
18 ـ انظر كتاب ـ د. فوزي منصور: "خروج العرب من التاريخ " ـ دار الفارابي ـ بيروت 1991 ـ وفيه يفسر الظروف التاريخية التي حالت دون قيام الرأسمالية في الشرق العربي بدل قيامها في الغرب.
جمال ناجي
الشخصية القلقة
في رواية "عندما تشيخ الذئاب"
إن قراءةً عميقة لرواية جمال ناجي "عندما تشيخ الذئاب" تكشف أنها رواية تغترف من قلق مبدعها، حيث يقدم صياغات متعددة لهذا القلق، فهو لا يكتب بحثاً عن قيم جمالية أو بلاغية، وإن كان هذا يتم في سياقات كتابية، واستعراض أساليب، وهو لا يولي اهتماماً بالإبداع المجرد، فشاغله الأساسي هو قضايا مجتمعه وهموم الإنسان بصورة عامة، وهذا ما يفسر غلبة ما هو اجتماعي في نصه... ومن ثم فإن العائد الإبداعي غالباً ما يحمل مضموناً سياحياً، فلطالما حاول جمال ناجي من خلال أعماله الإبداعية طرح قضايا اجتماعية، ويدعونا إلى أن نعيش معه رحلته في البحث عن إجابات عن الأسئلة التي من خلالها تم طرح هذه القضية.
لا يتحدث جمال ناجي في روايته "عندما تشيخ الذئاب" عن التاريخ الاجتماعي، لأنه يدرك مركزه من الأحداث، ويلاحظ اقتحامها مما هو أيديولوجي وامتزاجه بها لدرجة تكاد تطمس معالمها وحقائقها، لذا فإن التساؤلات الكثيرة الواردة على لسان شخصياته في رواية "عندما تشيخ الذئاب" كانت تنقل أصداء تلك الحيرة واهتزاز القيم وما هو معياري من حولها... لذا فهو لم يتناول التاريخ الاجتماعي لزمن الرواية، وسعى إلى التقاط مظاهر القلق ورصد التشظي الذي أصاب السلوكات والعلائق. فالرواية منشغلة بالحاضر وتحرص على تَبيُّن امتداداته ولم تهتم بالماضي بنفس القدر من الاهتمام الذي أولته للحاضر.
لقد جاءت أسئلة "جمال ناجي" معبرة عن قلقه الذي كان يبثه في نصه الروائي تعبيراً عن هم اجتماعي عام تشكّل في مأساة اجتماعية طبعت الرواية بطابعها الخاص وعبرت عما هو جوهري في حياة الإنسان، وعن الصراع والتناقض حيث التحولات والترابط بين الأحداث والمصائر.
وهي في كل هذا تعبير عن التطلع إلى المستقبل، إلى الوضوح في ما هو أكثر إنسانية وإيجابية، إنها تجسيد وتصوير لنماذج مختلفة ومتنوعة فيها الأخلاقي وغير الأخلاقي فيها الإيجابي وغير الإيجابي فيها المنتمي وغير المنتمي، فيها الواعي واللامبالي.
وهكذا فإن الطابع العام لبناء الشخصيات هو التناقض والتنوع والنمو وتطوير الاستجابات والسمات، وهذه الثنائية هي التي تلح إلحاحاً فاعلاً لتخرج من الحدود النفسية إلى الحدود الفكرية وتشكل موقفاً مزدوجاً في رواية جمال ناجي من قضية الانتماء، وكل هذا ساعد على إيجاد هذا الخيط المتين الذي يربط بين نصه والحياة الواقعية والفكرية في جيله وعصره الذي اتسمَّ بالقلق إلى أبعد الحدود، فهو يموج بتيارات وأفكار وصراعات ويتوقف على مشارف مفاهيم جديدة وتحولات اجتماعية جذرية. لقد انعكس هذا القلق في نَصِّهِ بحيث نستطيع القول: إن الشخصية الرئيسة في رواية "عندما تشيخ الذئاب" هي الشخصية القلقة المتسائلة المترددة المأزومة.
وهذه الشخصية تتحدد ملامحها ومعاناتها في مراحل مثلتها أعمال جمال ناجي الروائية بدءاً بالمرحلة الاجتماعية التي قدم لنا فيها "ليلة الريش" و"الحياة على ذمة الموت" و"وقت". وفي هذه المرحلة نجد كذلك تجسيداً لهذه الشخصية القلقة التي ترتبط إلى حد كبير بعصرها ومجتمعها فأزمتها وقلقها ومأساتها هي أزمة العصر الذي تعيشه والمجتمع الذي يشهد تحولات تعكس كل هذا القلق والتوتر وسط تأثيرات الحروب التي شنتها القوة الغاشمة في أكثر من مكان في العالم وما أحدثته من هزات وتخلخل واضطراب وتمزق وانحلال وتصدع في الحياة والعلاقات الاجتماعية.
لقد عكف جمال ناجي على كتابة روايته "عندما تشيخ الذئاب" وهو يرصد فترة تاريخية واجتماعية قلقة وشديدة الاضطراب بفعل الأحداث الجسام، وينتقل خلالها الإحساس بالتحدي الحضاري إلى تجسده الموضوعي حيث الإحساس بالأزمة اجتماعياً، أزمة التيارات السياسية المتأسلمة ثم بدرجة أقل، أخذت تتزايد تدريجياً، الإحساس بالأزمة الطبقية وفي نفس الوقت تصاعدت تأثيرات التوجهات الفاعلة في تشكيل الموقف (بوادر الوعي العلمي، نظرية التطور، منهج الشك العقلي والتيارات الحديثة كافة في علم النفس وعلم الاجتماع وباقي العلوم الحديثة كافة التي تشكل ملامح مصير الإنسان).
وهذه التيارات بقدر ما تدعم الإحساس بالتحدي وضرورة التغيير فهي في الوقت ذاته تخضع لما يمكن وصفه بـ "ـظاهرة الثنائية في تركيب رواية جمال ناجي" كالثنائية الفكرية بين رجل الإيمان ورجل العلم، رجل المثالية ورجل المادية وما تفرضه هذه الثنائية في الموقف الفكري من تشكيل خاص لبناء الرواية، ويكاد عالم جمال ناجي يقوم باستمرار على هذه الثنائية، حتى كأن مأساة عالمنا تكمن في الخروج عن واحد من طرفي هذه الثنائية.
ولذلك، فإن شخصيات جمال ناجي في رواية "عندما تشيخ الذئاب" غالباً ما تعيش في تجاذب عاطفي، فكثيرون منهم لا يتزوجون ولا يرتبطون ارتباطاً عميقاً بالحياة الواقعية ويكتفون بالحياة داخل مشاعرهم وأفكارهم الخاصة وبذلك تقع مأساة الجفاف والغربة والوحدة في حياتهم. وخير مثال على هذا النموذج من الشخصيات: شخصية "سندس"، إذ تمثل حالة شديدة الوضوح فيما عبر عنه الروائي جمال ناجي، في قلقه، وفي طرح ملامح المرحلة القلقة التي أخذت تخلق جدلاً صاخباً بين القديم والجديد، بين الأخلاق واللا أخلاق، بين السلبية والإيجابية، بين الجمود والتغيير.
وتبدأ الرواية بتغير يطرأ في نفسية "سندس" كمقدمة لبناء شخصية أكثر إحساساً بعمق الأزمة، شخصية معذبة قلقة.. تلك هي شخصية "سندس" في الرواية، والتي يمكن القول بشأنها: إن أزمة سندس الوجودية في الرواية، كانت أزمة جيل بكامله.
لقد نشأت هذه الشابة في بيئة تقليدية محافظة، ولكنها آمنت بحقها في اختيار زوجها، فوقع بينها وبين أبيها انشقاق وتصدع في مكونات العلاقة الأبوية، ثم أرادت رجلاً من محيط اجتماعي مختلف، كانت صفاته من خلال ثقافتها أقرب إلى مزاجها ولكنها كانت تفكر في إنسان آخر يلائمها، من طبقتها ومستواها الاجتماعي، وهكذا كانت بداية أزمتها حين تكتشف الازدواج في عالم أسرتها التي تمثل نموذجاً لتمزق المحيط التقليدي في هذه المرحلة باعتباره بؤرة الأزمة في الواقع المحلي.
إن رغبتها في أبو عزمي الموظف العادي، ليست مجرد تجربة عاطفية فاشلة ولكنها انعكاس لأَزمة اجتماعية، ومن نتائجها، وهذا ما يقودها بعد ذلك إلى اللحظة التي أدركت فيها ما يعنيها، أنها مجرد رغبة تتفتح على أزمة الواقع الاجتماعي والسياسي ولا تمنحها القدرة على التحديد والوضوح والانتماء.
وبقدر ما يصبح هذا الوعي مدخلاً لازمة متراصة الأطراف فهو في الوقت الذي يكشف فيه فساد الواقع يعبِّر وعيها عن شك في كل شيء، مما يجمد قضية التغيير، تغيير الواقع. ولكن ما علاقة كل ذلك بـ "العقلية إذا كانت أزمة جيل بأكمله"؟
لقد عكف جمال ناجي على كتابة روايته بعد أن تكاملت لديه الأبعاد السياسية والاجتماعية والتاريخية للمجتمع الأردني فيما بين الأعوام 1975 – 2011 من خلال ثلاثة أجيال: جيل عزمي الوجيه الزوج الأول لسندس، الذي شهد بدايات التحول في المجتمع الأردني، وتعلق بالمفاهيم الاجتماعية التي برزت من رسم المجتمع التقليدي.
والجيل الثاني الذي أفرزته القيم الاجتماعية في تحولها، نتيجة التوسع الاقتصادي في منتصف السبعينات، وهو جيل سندس، هذا الجيل الخائر الممزق القلق.
والجيل الثالث وهو جيل الأحفاد حيث الشيوعي والإخواني والانتهازي، وحيث الحدود التاريخية لدورةٍ تقع ما بين الأعوام 1975 – 1989.
إلى الجيل الثاني ينتسب جمال ناجي، ولو تأملنا خارطة الواقع خلال الفترة التي ترصدها رواية "عندما تشيخ الذئاب" لوجدنا أن أزمة جيل جمال ناجي أو "عزمي الوجيه" لها ما يبررها، فقد كانت فترة تاريخية واجتماعية قلقة وشديدة الاضطراب مثقلة بالأحداث الجسام وينتقل خلالها الإحساس بالتحدي الحضاري، حيث تجسده الموضوعي عَبْرَ الإحساس بالأزمة داخل المجتمع، أزمةُ اختلال القيم ثم بدرجه أقل تزايد الإحساس بالصراع الاجتماعي. وفي نفس الوقت أخذت تدعم التيارات الرئيسية المؤثرة في تشكيل الموقف، بوادر الثقافة المتدنية، دلالات هذه الثقافة كافة التي أدت إلى طغيان مفاهيم قيمية، لا علاقة لها بالثقافة الحديثة. ومع شيوع بوادر هذه الثقافة في المجتمع الأردني نشب صدام، يتردد في صدى تصدع كلي حيث يلوح عالم بأكمله آيلاً للسقوط، ونسمع "سندس" تردد:
(أمي امتلكت حصانة ضد توبيخات أبي وألفاظه في سنوات عمره الأخيرة، لأننا كنا نعيش على مساعدات إخواني الثلاثة المتزوجين الذي يعملون في دول الخليج، تلك المساعدات التي يحولونها باسم أمي لا باسم أبي الذي يبدد النقود) ص 13.
هنا نجد خطوة كبيرة في ربط الاغتراب بقضية معنى الحياة، ومثل هذا الربط يشكل بداية لما هو عبثي، ويأتي موقف الأب ليحدث شرخاً أخر يزلزل قناعات "سندس" التقليدية تجاه الحياة.
لكن، هنا وفي الوقت الذي يحدث فيه السقوط، يتكشف الشر في الواقع عاتياً ويصبح مطلب التغيير مُلحاً، ففي الوقت الذي تعيش فيه "سندس" هذه الأزمة، تتكشف أزمة الواقع الاجتماعي بكل دلالاتها، ومثلما تتكشف التيارات التي حطمت الحس الديني وكافة الارتباطات المطلقة، تتكشف عن مطلب تغيير الواقع في آن واحد، مثلما يتكشف إخفاق الأمل بموت (بطلاق سندس) عن أزمة الحرية على مستوى الواقع...
ولكن ماذا يعني التغيير في الواقع والارتطام يودي بملامح كل شيء ولا معيار؟
لا سبيل إلى التغيير إلا بأن يعاد بناء العالم كاملاً وأن ينقذ النور من ظلمة ابتلعت كل شيء بشكل مطبق، فالمطلب الداخلي هنا يتعارض مع مطلب الواقع، المطلب الداخلي هبط في هاوية الشك دونما قرار، حيث يتعمق موضوع قلق "عزمي" كلما توغلنا فيه، وإزاء ذلك يبدو كل فعل وكل حقيقة موضوع قلق وتساؤل وحيرة، فالشر مبهم والخير لا ملامح له ولا فاصل ولا إدانة.. الموقف يتلخص إذن في أن "عزمي" سقطت إرادته في الشك المطلق وسيطر عليه إحساس يرفض الحياة، حيث تجرد العالم من مقومات وجود الإنسان فيه، على أن الدنيا كما يردد "عزمي" نفسه قال: (لكنك تظلين من المحارم على الرغم من أنه طلقك، ثم إن ما ترينهُ مخالف للقانون) ص 100.
على أنه لا بد من ملاحظة أن هذا الرفض الذي ينقاد إليه "عزمي" ليس مطلقاً، ليس هو الرفض العدمي، رغم تردد النغمة العدمية على لسانه، ذلك أن الرفض العدمي يتم من داخل الذات في عزلتها، أما الرفض الذي نتعرف عليه من خلال شخصية "عزمي" فهو رفض يواجه ضرورة تغيير الواقع ويرتبط بأزمة الواقع... رفض مأزوم ليست نهايته العجز عن اتخاذ موقف، "وإن تبدى ذلك" إنما هو رفض يحتم التجاوز... ما تقدمه لنا رحلة "جمال ناجي" الروائية، فليست "عندما تشيخ الذئاب" سوى الجانب الأول منها، وكل قضية فكرية، كما سبق أن أشرت، تنبض وتلح في مرحلة من مراحل الكتابة الروائية، تتحرك ظلالها على المرحلة التالية لها أو تمد جذورها إلى المرحلة السابقة عليها.. وهكذا نجد أن شخصية "عزمي" ابن رباح الوجيه: "أبو عزمي"، تأتي كإشعار بأن "عزمي" يتجاوز نفسه... فالشخصية القلقة لا تموت وإنما يتواصل حوارها وأسئلتها حتى تصل إلى ما تعتقده المرفأ أو المستقر. ولذلك فإن شخصية "عزمي" الذي يعتقد أن (الإٍسلام السياسي) هو الجواب، يأتي خلفه الروائي لمحاولة تجاوز "عزمي" لأزمته، وهو بذلك تمهيد للمرحلة التالية في رحلة القلق، مرحلة الالتحام بالواقع من ارتباط بالخرافة، كما تمثله رواية "عندما تشيخ الذئاب".
إن رواية "عندما تشيخ الذئاب" تحيلنا منذ البدء إلى (المناخ الكافكوي) عبر فضائها الاندماغامي الذي تماوج فيه الحلم والواقع، وتتداخل الأمكنة وتتكرر الأسماء، إضافة إلى تهشيم مفصلية الزمن الميكانيكي بين الماضي والحاضر والمستقبل، حيث تتخلق أحداث المستقبل في الراهن. ورواية "عندما تشيخ الذئاب" حول موضوعة القلق (قلق من الهوية- من الفكر- من المكان) عبر فضائية شجية تفضي إلى ما هو عبثي ولا معقول مما يجعل السيطرة على قاعدته السردية صعبة وغير قابلة للقبض على أسئلته منذ القراءة الأولى، لأنه حسب التمهيد الذي أدرجه الروائي ثمة رواية داخل الزاوية، وهو منذ اللحظة الأولى يوهمنا بأننا إزاء مذكرات شخصية قلقة ذات نمط غريب يصعب تحديد معرفتها وفقاً لثيمات الفضاء الروائي ما إذا كانت امرأة أم رجلاً، آلة أم شبحاً.. لأن استخدام الفنطازيا الشبحية سيطر على تقنية الخطاب الروائي وانسحب على الشخوص والمكان والزمان.. وعلى مجمل ثيماته السطحية والعميقة، ومن هنا اندرج حوار الشخصيات وفق ما هو استيهامي وغرائبي في آن.
لكن يا ترى ما هو السؤال الذي يسعى إليه (جمال ناجي) عبر روايته هذه؟
هذا السؤال ربما انطرح في شيء من التعسف، فالروائي قد تعمد إقلاقنا ودهشتنا حيال صعوبة التقنية التي استخدمها في توزيع شخصيات مشروعة الروائي، وهو لا يفتح أمامنا أفقاً لانتظار ما سيحدث، وربما هذا هو مبررنا في صياغة السؤال بهذه الكيفية.
وعلى الرغم من ذلك فإننا قد حاولنا وفق ممكنات القراءة المتاحة استنطاق الحقل الدلالي لـرواية "عندما تشيخ الذئاب" والبحث عن السيميائي في الكلام كاستعارة وظفت في الخطاب الحكائي بنحو انزياحي مقلق ذابت في فضائه اللحظة الاجتماعية ببعدها الأكثر قلقاً، الأمر الذي لا يتيح النظر إلى هذه الأشياء منفصلة بعضها عن بعض لأنها محكومة بقلق الروائي، زيادة على أنه قد استفاد من طريقة (التهوية) مما ساعده على خداعنا، أي أننا كنا ومنذ البدء بإزاء رواية كتبتها الشخصية المحورية في النص، ومن هنا أراد (جمال ناجي) أن يتيح لنفسه الحرية الكافية لبناء الأسلوب الذي يناسب شخصياته التي ربما هي مريضة، أو مصابة بلوثة الخيال الخرافي بحيث يبرر تفكك معمارية اللغة ممعناً في الاستخدام الإشاري أو اللاعقلاني، متوخياً الوصول إلى شيء من التجانس بين حالة الكلام وحالة الراوي الذي هو "البطل" في المتن، وهي لعبة تعمد إلى إثارة اللاوعي في أهمية القلق كمدخل للهروب من الهوية الاجتماعية والتاريخية للشخصيات، وكأن هذه الشخصيات ولدت بلا تاريخ، أو في مكان بلا جذور!
يجب التنويه أن فضاء الرواية هو (عمّان) على اعتبار أن شخصيات (الذئاب) التي عنونت بها الرواية هي شخصيات عمّانية حسب تأكيد هذه الهوية أكثر من مرة في متن الرواية، وهي شخصيات حاضرة في الموت الذي تتكرر ثيمته وفق جوها الكابوسي، وهذا الموت الذي يتكرر داخل الحياة هو الموت الآلي الذي يتشكل من كيمياء القطع التاريخي للشخصيات، وانحدار علاقات المجتمع المكاني الذي جاء على حساب قيم الإنسان ومبادئه السامية حيث يخضع الإنسان لآلة القطع التاريخي، فاقداً الصلة بكل جذوره التاريخية والسياسية.
ورواية كهذه، هل بالإمكان تصنيفها، في انتسابها، إلى الواقع الاجتماعي؟ (نعم) على الرغم من كل هذه التوهانية الموغلة في هذيانها، إلا أنها أعمق التزاماً، في إعلان موقفها من العالم، كذلك إن الالتزام الوحيد والممكن هو الأدب والأدب نفسه.
إن غموض هذه الرواية ربما يقود إلى وصفها، مغالطةً، بأنها خطاب منغلق قياساً باشتراطات الوظيفة الجمالية في التنظير الواقعي الضيق إلا أننا في حقيقة الأمر يمكننا إدراجها في الأعمال الملتزمة، ولأن غموضها قابل للتأويل وليس منغلقاً على نفسه فهي رواية عدائية وحادة في مواجهتها للسلطة الاجتماعية على الرغم من ايغالها في انزياح عالمها إلى الاستفزازي النقدي، للقيم الاجتماعية، التي تولدت من الظروف الاقتصادية. كما تعكس الرواية المرايا صوراً كابوسية تحتاج إلى جهد غير عادي لفك طلاسم حركة مسرحها الاجتماعي، وقد اقتضت مسألة الصراع النفسي تتابع ثيماتها اعتماداً على وجعها السيكولوجي، أي أن المرجعية الاجتماعية التي ينطلق منها الخطاب، هي التي اقتضت استخدام هذا الأسلوب وما اكتنفه من وضوح العبارة.
التغريب وانحراف المكان:
ثمة رغبة منذ بدايات الرواية العربية، لدى الروائي العربي، في أن يكون مغايراً، أن يكون، هو، في مكانة الروائي، هكذا فعل نجيب محفوظ، إميل حبيبي، خيري شلبي، أحمد المديني، الطاهر وطار، عبد الرحمن الربيعي، حنا مينا، جبرا إبراهيم جبرا وغيرهم، كما كان لكل عنصر حساسيته المكانية والذوقية التي تغنّى الروائيون في استخدامها والانحراف بها لجهة تميزهم وبتأثيرات الإبداع والابتكار وإجلال روح الروائي وأدائه الفني الخاص في جسد المكان.
ويمكن لهذه النظرة أن تتجوهر، وتتعمق، وتتطور بوتيرة أعلى إذا أخذنا بالاعتبار الخط التصاعدي الذي يسير عليه الروائيون المعاصرون، حيث يقف كل واحد منهم، على الدوام، على ركام فني وكيفي متزايد من التجارب الروائية السابقة فالروائي يستند إليها ويغايرها في آن واحد وهذا يعني شيئاً هاماً، وهو أن الرواية بناء حضاري، لذلك لا يجب أن تفهم مغايرة للحداثة في هذا بالذات، على أنها نوع من الانبتات عن الجذور، بل على العكس تماماً، احتضان مبدع لهذه الجذور حتى وهي "تتغرب عنها"، لأن مجرد الغربة عنها ومغايرتها بعد وعيها، يعني "وجودها" ويعني أنها قائمة أساساً للتقابل حيث لا يتم توليدها من فراغ، كما نجدها في رواية جمال ناجي "عندما تشيخ الذئاب"، لأن الروائي مهما حاول الانفكاك من جذور المكان الاجتماعي، للشخصيات الروائية، فإنه لا يستطيع التفلت من بنيته الزمانية وبنيته المكانية اللتين تعتمد عليهما تركيبته الفنية الجديدة التي تغدو بنية جديدة، قائمة بخصوصيتها. ومما تجدر الإشارة إليه هنا، أن الإحالات الفنية إلى طرق مختلفة في الأزمنة المتعاقبة تختلف من فرد إلى فرد، كما قد تتجه إلى فوق مثلما قد تنزل إلى أسفل؛ وقد تخرج عن حساسية أهل زمانها الأدبية، وتساير عادتهم في الكتابة الروائية أو تنكص راجعة إلى الوراء، وما يهمنا هنا أن نكثف الضوء عليه، هو!
إن محاولات التغيير والخروج عن المألوف والرغبة في معانقة حداثة المكان، لا يمكن أن تتوقف عند حد معين، إلا أن هذه الحداثة موجودة دائماً في مسيرة التاريخ الاجتماعي لدى الجماعات والأفراد، وهذا ما لم تحققه إبداعياً رواية "عندما تشيخ الذئاب"، وفضلت المكان المختلط، بمعنى حداثة المكان اجتماعياً، وحداثة الشخصية الروائية، التي جاءت إلى هذا المكان اضطرارياً، أي تهميش الزمان الاجتماعي الضارب في عمق التاريخ، لصالح حداثة المكان زمنياً. كما أن الروائي الحديث يقف على جبال من الثقافة العامة والتجارب الروائية من الإضاءات الأجنبية، والحداثة بصورة عامة معينة يأخذ دورها في التجديد وتمثيل روح العصر واستشراقاته، لا أن ينحاز لروح المكان، الذي قد يبدو في تجلياته الاجتماعية، غير واضح، في تعريف الهوية الاجتماعية، ومضطرب على صعيد القيم السياسية الاجتماعية، كما فعل جمال ناجي في تأكيده على هذا الاضطراب، الذي بدا واضحاً، أنه قد يستطيع تسويق قيم بعينها، على سبيل المثال، أن الإنسان في حاضره، منقطع عما فيه، يبدو غائباً تماماً عن مخيلة الروائي جمال ناجي في روايته "عندما تشيخ الذئاب". وعلى هذا فإن التجربة الروائية الحديثة، على مستوى الهم الفردي والهم الاجتماعي والهم الإنساني، في غمرة تلك الاضطرابات والتحولات، تحاول أن تبني مكاناً روائياً جديداً تعبيراً عن هذه المعاناة، أن تكسر تشكيلها المؤطر في البنية المكانية الاجتماعية وتخلق شبكتها الدلالية الخاصة بها، دون أن تخرج بطبيعة الحال على أسياسيات التاريخ الاجتماعي، والمكان التاريخي، وإنما تخرج على العادة في الاستعمال.
وهذا ما لم نلاحظه في رواية "عندما تشيخ الذئاب"، التي أكدت على غموض المكان التاريخي لشخصياتها الروائية، وابتعدت عن كشف المكان المعاصر لتلك الشخصيات.
وهكذا فمن الطبيعي أن يواكب الغموض مثل هذا الاشتغال في الرواية ما دام في الذاكرة التاريخية الاجتماعية فرجات لصالح الذاكرة المستهلكة وسفر إلى فضاءات جديدة حتى وإن كانت تركيبة هذه الفضاءات وسائط "انتقال" معروفة.
إن من حق الروائي علينا، أن يكون نصه موحياً ومعانيه كالسحر بشرط أن يكون التواصل "مأموناً".
جميلة عمايرة
"بالأبيض والأسود"
... لعبة تكرار الحياة
فرش
أحب الحرية، أحب أن أكون مسؤولاً عن تصرفاتي، أريد أن أفهم العمل الذي أقوم به، ومع ذلك وافقت على خوض غمار هذه المخاطرة الغريبة.
حين شرعت في قراءة رواية "بالأبيض والأسود"(1) للروائية جميلة عمايرة، حاولت قدر الإمكان قراءتها خارج الإطار الإعلاني الذي أراده المثقفون كتقديم للرواية لأنني أكره مثل هذه المقدمات التي تسهم في مصادرة أفق التخيل لدى القارئ وتسهم في توجيه حالة التأمل لحمة المقروء وفق الخطة القراءة وما يكتنفها من خزين (سيكولوجي) وثقافي في آن.
إن هيمنة المقدمات.. وخاصة للعمل الإبداعي يعطل ملكة الاستقبال لدن القارئ كطرف ثالث في علائق العمل الإبداعي، على اعتبار أن المتلقي هو جزء من حلمة الإبداعي وليس خارجه، ومن هنا يعد مشروع القراءة الحقيقي محاولة لإعادة إنتاج المقروء وفق إمكانات التمثل.
إن رواية "بالأبيض والأسود" منذ البدء إلى مناج الكافكوى، عبر فضائها الاندغامي الذي يتمازج فيه الحلم والواقع، وتتداخل الأمكنة وتتكرر الأسماء، إضافة إلى تهشيم مفصلية الزمن الميكانيكي بين الماضي والحاضر والمستقبل، حيث تتخلق أحداث المستقبل في الراهن.
و"بالأبيض والأسود" حول موضوعة الرفض، رفض لسلطة المكان، وللعلائقية التي تتحكم في مسلكية الإنسان عبر فضائية شجية تفضي إلى ما هو عبثي ولا معقول مما يصعب معه السيطرة على قاعدته السردية، كذلك غير قابل للقبض على أسئلته منذ القراءة الأولى، لأنه حسب السطور الأولى للرواية ثمة رواية داخل الرواية، وهي منذ اللحظة الأولى توهمنا بأننا إزاء مذكرات...
كتبتها شخصية ذات نمط غريب في مسلكها النفسي والفكري، وهذه الشخصية يصعب تحديد معرفتها وفقاً لتيمات الفضاء الروائي ما إذا كانت امرأة أم رجلاً، آلة أم شبحاً، لأن استخدام الفنطازيا الشبحية سيطرة على تقنية الخطاب الروائي انسحب على الشخوص والمكان والزمان، وعلى مجمل تيماته السطحية والعميقة، ومن هنا اندرج حوار الشخصيات وفق ما هو استبهامي وغرائبي في آن، لكن يا ترى ما هو السؤال التي تسعى جميلة عمايرة لتفجيره عبر روايتها هذه؟
هذا السؤال ربما انطرح في شيء من التحسن، فالمؤلفة قد تعمدت إقلاقنا ودهشتنا حيال صعوبة التقنية التي استخدمتها في توزيع شخصيات مشروعها الروائية، وهي لا تفتح أمامنا أفقاً لانتظار ما سيحدث، وربما هذا هو مبررنا في صياغة السؤال بهذه الكيفية.
وعلى الرغم من ذلك فإننا قد حاولنا وفق ممكنات القراءة المتاحة استنطاق الحقل الدالي لـروايتنا "بالأبيض والأسود" والبحث عن السينمائي في الكلام كاستعارة وظفت في الخطاب الحكائي بنحو انزياحي انذابت في فضائه اللحظة الاجتماعية في بعدها الأسطوري الأمر الذي لا يتيح النظر إلى هذه الأشياء منفصلة بعضها عن بعض لأنها محكومة بفنطازيا الخيال الاجتماعي، زيادة على أن المؤلفة قد استفادت من طريقة (الانحراب) مما ساعدها على خداعنا، أي أننا ومنذ البدء إزاء رواية كتبتها الشخصية المحورية في النص، ومن هنا نجحت (جميلة عمايرة) في أن تتيح لنفسها الحرية الكافية لبناء الأسلوب الذي يناسب شخصياتها التي ربما هي مريضة، أو مصابة بلوثة الخيال الاجتماعي بحيث تبرر تفكك معمارية اللغة ممعنة في الاستخدام الإشاري أو السحري متوخية بذلك الوصول إلى شيء من التجانس بين حالة الكلام وحالة الراوي الذي هو (البطل) في المتن، وهي لعبة جميلة لإثارة الإغراب ولرفع درجة الخيال لدن المتلقي.
يجب التنوية بأن فضائية الرواية في بعدها (الزمكاني) تفضي بنا إلى عمّان، على اعتبار أن شخصية البطل التي عنونت بها الرواية هي شخصية عمّانية حسب تأكيد هذه الهوية أكثر من مرة في النص، وهي شخصية حاضرة في الخيال الذي تتكرر تيمته وفق جوها الكابوسي، وهذا الخيال الذي يتكرر داخل الحياة هو الموت الآلي الذي يتشكل من كيمياء القمع المجتمعي وانحدار علاقات المجتمع الذي جاء على حساب قيم الإنسان ومبادئه السامية، حيث يخضع المواطن لآلة سلطة المجتمع بكل شمولياتها العلائقية، سواء في علاقة الإنسان بعالمه الخارجي أو الداخلي، وفي آخر الأمر ينشأ الإنسان وتتأنس الآلة. إنه مأزق الحضارة المعاصرة، مأزق علاقة الإنسان مع نفسه والآخرين، من هنا لا غرابة أن يتمفصل الفضاء الروائي تبعاً لحركية الخارج، كذلك تبعاً لحركية اللغة في النص: لغة الغرابة والسحر، وتظل الصدمة الكبرى في النص هي (البطل) أهو كائن أدمي أم كائن مكاني، واقع أم خيال، رجل أم امرأة؟ ثم ماذا عن شخصية "الراوية" التي يتبدل اسمها إلى أسماء مختلفة؟ هكذا تتساوق سديمة هذا الفضاء الفنطازي عبر أحداث غاية في الغرابة وكأنها التقطت من أخر المدى في طريق الانقراض الإنساني.
إزاء هكذا رواية، هل في الإمكان تضيف نصفها، ما إذا كانت ملتزمة بواقعها الاجتماعي؟ (نعم) على الرغم كل هذه التوهانية الموغلة في هذيانها وغرابتها الشبحية إلا أنها أعمق التزماً في إعلان موقفها من العالم.
لعبة تكرار الحياة
إن اندغام الحلم في الواقع، أي اندغام الممكن في الكائن للحد الذي ينهدم فيه الجدار الفاصل بينهما، كذلك اندغام الموت في الحياة والحياة في الموت، هو السؤال الخطير الذي يفجره النص الروائي لرواية "بالأبيض والأسود"، ويدعو للتأمل عن ماهية الحياة التي تبحث عنها الروائية في روايتها. وتتأكد هذه الفكرة عندما تسرد التالي:
(سأعرفك من جديد. وألتقيك رجلاً من لحم ودم، وليس كائناً على الورق الذي حبّرته خلال خمس سنوات!)(2)
الأمر واضح ولا يحتاج إلى مواربة، إن تكن صعلوكاً وباستحقاق عليك أن تستحث الخطى في طريق النبذ الرابض خلف الحلم الجميل وقد تركت شيئاً منك على مقربة من لحظة ازدرائك ليشهد على وقاحة السائد مبتسماً، أو مبتسمة:
(نجلس ولا يفصل بيننا سوى طاولة صغيرة من خشب البلوط، في زاوية نصف معتمة، نصف مضيئة (هذا النص أحبه كثيراً). أخلع حذائي، وتبدأ قدماي بالتحرّك يميناً وشمالاً من تحت الطاولة لتستقرا أخيراً بين فخديك. تكون أصابع يدي قد امتدت نحو ذراعك القريبة لي، وتبدأ حركتها العكسية من أعلى إلى أسفل، لتستقر أخيراً في راحة يدك أو بين أصابعك)(3).
لا أحد يصون الظلام ويحمي هدوءه سوى تعب النهار، توسد الجميع قداسة الأشياء الغابرة ورتابة الحياة المضجرة، فاختلطت الأشياء ببعضها وصار كل شيء هادئاً وقاتماً وبارداً ولا صوت تسمعه سوى "هرير" الأحلام المتصارعة في فضاء الليل البارد الكسول. هكذا تفعل بنا عمايرة عندما تصف هذه الحالة:
(أرى امرأة تذرع المسافة في ضوء الشمعة، بين الباب والنافذة، بلا توقف. تظهر أحياناً، وهي تفرك أصابعها كمن يعدّ شيئاً ما.
أحياناً نتوقف أمام النافذة المغلقة، دون أن تفتحها، تتطلع للخارج، وتتابع سيرها من جديد.
تقف أمام الساعة المعلقة على الجدار. أنا أتطلّع للساعة، وأتحقق من الوقت: الثانية عشرة. تماماً منتصف الليل. تعود لتذرع المسافة من جديد)(4).
هذا الرقص الحقيقي التي تمارسه الروائية، هو التوافق، مع إيقاع نبض القلب المتلهف للحرية والحب، إنها هواية الصعاليك التي تصرخ في وجه الزمن، فالصعلوك ليس سارقاً، ولكن حين يبحث عن حريته، ينسى بساطته معلقة في الهواء المسموم: (فصار في عالم الصعاليك أشهر من نار على علم)، نقدر أن الصعاليك لا يجيدون علم الحساب، ولكن بالفطرة لا يخطئون تقدير المسافة: ما بين الرضا والبذخ، أي ما بين ممارسة حقه والاعتداء على حقوق الآخرين، ما بين الرواية والراوي، أي ما بين معايشة الرواية والعيش على الرواية، ذاكرة الصعاليك موشومة بأختام الزمن، ولكنهم أحرار لا يتبعون خطوات أحد.
هؤلاء الصعاليك البسطاء الخالون من مشاعر القلق، يرون أنفسهم مسحوقين بآلة غير إنسانية ضخمة، حبيسة ليس لها مكان في كيانهم، ولا يستطيع أحد أن يفهمها، وكل ما يعرفونها عن أنفسهم، والحفاظ على مشاعرهم خوفاً من سطوتهم على مشاعرهم المتفجرة لتدمير كل ما هو عزيز عليهم، وهي حريتهم، فالقانون والنظام هو فلك رحيب متفكك من المسدسات والمؤسسات الاجتماعية وحارسها. يجسدوها بــ "جماجم الذكرى".
(لي الحق، كل الحق، في أن أكون محبوبة لذاتي .
لي الحق، كل الحق، بأن يكون لي فضائي الخاص بي، مثلما لي الحق بأن يكون لي عدمي الخاص بي.
هكذا، أشكله كما أريد، وأضيء عتمته بلوني، وأقفز عن تفاصيل تخصك دوني، وأتسامي عن الاختلافات القائمة بيننا، منذ الأزل، وأتغاضى عنها، دون أن أنسى أنه وبسببها لن تكون لي قط.
وجهك ليس لي، اسمك ليس لي.
الصورة بين يديّ
الأسود معتم، لا يعكس سوى العتمة، ولا ينعكس منه شيء.
ينوس ضوء الشمعة)(5).
الفجر إذا هو جوهر الحياة، وسكبه هو جوهر الموت، إن أغلب أعمال الإنسان الحافلة بالمعنى هي التي تحددت في الفجر، حيث أنه العامل الذي يوطد الإرادة والفعل معاً. والتعبير (الفجر الساخن) يستعمل في الوقت نفسه للشهوة الجنسية والعنف النفساني وسكب الضجر مصاحباً للحياة والموت معاً.
لقد أقامت (عمايرة) بناء للضجر قوياً، حول رمز (الحياة) الذي استخدمت فيه هذه القيمة الإنسانية لمعناها البيولوجي الخالص. ولكن بنعوت وخصائص جمالية ميتافريقية. في بعض الأوقات كان استعمال رمز الضجر، له أسباب اجتماعية كرغبة لتوصيل لمسة انطباعية لأي صورة معطاة، ولكن حتى في هذه الحالات فإن الضجر يتضمن في نفسه جوهر الصورة، بينما الموضوع، الذي يبدو فوقه القيمة الاجتماعية، يتحول إلى مجرد حدث طارئ.
(الأسود دائماً.
لونك يا حبيب، يمتد ليصبح الألوان كلّها.
لونك يأكل لوني، فيبهت ويضيع في ظلال لونك، فأحستني ظلاً يبحث عن جسد، وصوتاً يطلع في داخلي يقول بأنني لا أريد أن أكون المرأة التي أتعاطف معها دائماً)(6).
عمايرة، هذه المسافرة " تهفو" من سفر الحبيب الخرافي إلى الكشف عن المساحات الرخوة فيها، وبعد العودة إلى الواقع المحصن والزمن العربي الهلالي، إن جاز لنا التعبير، تتحرك من جديد خارج عالمها الأرضي الملموس، أما الوصول إلى "وادي الحبيب الافتراضي"، ففيه معنى التحرك والتحريك والاستبشار بالغيث الذي يجلبه هذا العالم "الافتراضي"، فتطوي في خفقها دلالات الثورة والقيام والتخطي بعد الهمود والجحيم ثم تبرز مقدرة الروائية على خلق الصورة الروائية.
(انطفأ ضوء الشمعة بهدوء، هجمت العتمة مرّة واحدة، كل شيء يسقط في الظلام.
تعتاد عيناي الظلمة)(7).
يبدو في المقطع الروائي السابق، "الموقف الفكري" الذي تبنى عليه الصور والرموز، حيث تطبقها بحسها الوجداني الذي ينبع من تجربتها الخاصة، وبوعيها الفكري في الحياة التي تملؤها.
هذا الموقف لا يذهب مذهب المفكر أو الفيلسوف في نشاطه الذي تتكون فيه نظرته من خارج، بل تتجسد في بيانها الروائي الذي له نظامه الداخلي في الرواية.
وروعة أي روائية، تكمن في هذه الظاهرة، وهي أنه كلما وصلنا إلى أعماق عالمها الروائي، نجد أنفسنا على الفور، مأخوذين بعديد من إمكانيات التفسير، يحتاج كل منها عناية دقيقة، وفي اكتشاف بعضها نقبل مهمتنا في هذه القراءة.
الهوامش
1. بالأبيض والأسود، جميلة عمايرة - دار الشروق للنشر والتوزيع - عمان - 2007.
2. مصدر سبق ذكره ص 9.
3. مصدر سبق ذكره ص 15.
4. مصدر سبق ذكره ص50.
5. مصدر سبق ذكره ص 37.
6. مصدر سبق ذكره ص 52.
7. مصدر سبق ذكره ص 54.
هاشم غرايبة"
القط الذي علمني الطيران
"انتصار على صمت الأموات"
القضية السردية التي تنهض عليها الرواية في الأردن في منظورها العام تحيل على قضية ثقافية خطيرة تعد من أهم القضايا ذات البعد الثقافي في الرواية الأردنية وهي إعادة الاعتبار للنسق التنويري بأسلوب مكافئ للنسق الإبداعي في سعي لإنقاذ صوت المكان من انسحاقها تحت وطأة النسيان الضاغط وإظهاره بلغة روائية تنويرية وشكل إبداعي وحساسية روائية تكرس وضعاً جديداً في المشهد الروائي الأردني الراهن.
وبالقدر الذي تعبر فيه القضية عن إدراك حضاري عالٍ لقيمة المشكلة فإنها ليست بمنأى عن الوقوع في شرك الحماس والاندفاع أبعد من هدف الوصول إلى التكافؤ لتستخدم الآليات المضادة ذاتها وهي تقود إلى دفع النسق المكاني نحو الهيمنة على حساب تضئيل النسق الإبداعي وتهميشه.
ونقترح هنا معاينة رواية (( القط الذي علمني الطيران))"1" للروائي هاشم غرايبة وفحص مكوناتها السردية انطلاقاً من رؤية نقدية تجتهد في تحليل النص سردياً وتأويله ثقافياً على النحو الذي يستجيب للمنطلقات والرؤى المشكّلة لهذه القضية.
واستناداً إلى هذا المنهج فإن قراءتنا النقدية سوف تدخل إلى أهم المناطق السردية الساخنة التي تكمن فيها خصوبة هذه القضية وتعبر بشكل ما عن فلسفتها وطموحاتها محاولة الكشف عن حقيقة المشهد بحركة فعالياته وامتداد مقاصده وأهدافه.
تنشطر الحكاية في رواية (( القط الذي علمني الطيران)) شطرين يعمل أحدهما في الفضاء الواقعي للمحكي وهو الفضاء السلبي (فضاء الأزمة: السجن)، إذ تجتهد الشخصية المناضلة لمغادرته والرحيل عنه ولا تتوانى أبداً عن نقده والامتعاض منه والضيق به..
وهذا الفضاء المتركز في المكان هو فضاء طارد جغرافياً وحسياً .
ويعمل الآخر في الفضاء المتخيل للمحكي وهو الفضاء الإيجابي الملجأ، فضاء الانطلاق والإحساس بالحرية وتحطيم القيود، يمتاز بالطابع الرومانسي الحلمي لكنه لا ينجح في تحقيق نتائج إيجابية مفيدة في عملية التحولات التي نخضع لها وحدات السرد لأنها سرعان ما تهبط إلى الفضاء الواقعي وتصطدم بمادية الجغرافيا المكانية لفعاليات الرواية.
تنهض فكرة السرد العنقودي في ((القط الذي علمني الطيران)) على سرود مقطوعة تتناوب العمل في الفضاءين وتقود الشخصيات المتواجدة في السجن فعاليات الحكي وأنشطته في كل حكاية منعقدة على بؤرتها السردية بأسلوب مقطوع سردياً ودلالياً لأن ثمة "تابو" مهيمناً على العقل السردي في كل حكاية جزئية يمنع وصولها إلى مرحلة "الإفضاء والبوح" ليبقى احتمال التبرير الدلالي بعيداً عن عقدة الحكي، وهذه المشكلة السردية بحد ذاتها مشكلة حرية/ ثقافية يسعى الإطار السردي إلى التعبير عنها بالشكل أولاً وبحشد الدلالات المتبقية والمتساقطة جرّاء الإقفال السريع لحبات العنقود الحكائية المتعلقة بصمود السرد ثانياً. إن طريقة الراوي/ الواقعي في التفوه بالمسرود ووصف مكوناته الضمنية تحقق إيهاماً كبيراً في تداخل الشخصيات المناضلة وتماهياً وانفصالاً على نحو ما يتيح للمتلقي الجزم بالانتساب إلى طرف معين في الحالين "التماهي والانفصال" وهذا جزء من لعبة الدفاع عن النموذج التنويري في الرواية وتصفية حسابات قاسية مع الآخر تتجاوز حدود العقاب إلى تدمير غير مقصود للذات ومعاقبتها "مازوخيًا" بسبب استسلامها وإضرارها بالنموذج طيلة فترة الانسحاق تحت وطأة النموذج المركز.
ينشغل المكان في الرواية بآلية الحاضنة الدّالة، فهو مكان ناطق، "لغة"، يعفي فعاليات السرد من عبء الشرح والتحليل والاستغراق في الوصف، لذا فهو يتحرك فنياً وجمالياً أبعد من الحدود التقليدية التي يعمل المكان الروائي داخل إطارها لأنه يتدخل في توجيه آليات السرد ويضخها بطاقة أكبر على الفعل والإيحاء مما يجعل منه بؤرة مركزية للصراع السردي بين نسخة الراوي والتنويري، وقد قدمه الوصف تقديماً إيجابياً، ونسخة "المناضل" السلبية المكتوبة بالإحساس ذي الرؤية الزمنية الخاصة للمكان.
ويمكن معاينة هذه الرؤية المكانية من خلال ما يقوله الراوي:
((صباحاً عندما رأى المساجين يتجمهرون على شبك الساحة الداخلي فيما قلم السجن يقوم بإجراءات تسجيله نزيلاً موقوفاً على ذمة المخابرات تذكر السيرك الذي أقيمت خيمته على الملعب البلدي في إربد قبل سنوات وألهمه رسوماً زاهية نالت إعجاب معلميه..)) "2".
لا شك أن وضع المكان تحت طائلة الصراع يخلق بنية فضائية قلقة تحيله إلى ثنائية الانفتاح والانغلاق بطريقة التماس بين طرفي الثنائية لا التداخل مما يحرم عناصر السرد الآخر إمكانية الاستقرار على مكان سردي يتمتع بقدر مناسب من الثبات ويسمح بحركة العناصر وتفاعلها.
وفي معاينة تحليلية لأسلوبية الاستهلال عبر منظوماتها الفعلية والوصفية والمكانية والاسمية نجد هيمنة واضحة للغة حزينة متحركة في المكان من خلال مغالبة السكون وتمرد الجسد على الثبات فضلاً عن ارتداد المكونات السردية إلى الفضاء الداخلي في السرد.
إن أزمة كل شخصيات الرواية ((القط الذي علمني الطيران)) هي أزمة وجود ناقص ويقترح العقل السردي في الرواية إمكانية التعويض عن النقص بالانتقام من الجسد وتحريض الممكنات المتاحة الأخرى لتنفيذ هذا الانتقام بأشكال مختلفة.
ويظهر الحل في آلية "التذكر" بمستوى ثان يقترحه المتخيل السردي الفنتازي للهرب بعيداً في المجهول كما يقترحه للّغز السردي ويفعّل الراوي رحلة تذكره على الشكل التالي:
((تذكّر السيرك الذي أقيمت خيمته على الملعب البلدي في إربد قبل سنوات وألهمه رسوماً زاهية نالت إعجاب معلميه))"3". إن الوحدات السردية المؤلفة من استهلال الرواية تعمل أسلوباً ودلالياً على تكريس الأزمة لإظهار حجمها بشكل مبكر، لذا فإن الطابع السلبي لعمل هذه الوحدات بمختلف أنشطتها السردية يهيمن على فضاء السرد ولغته هيمنة تكاد تكون كلية.
إن ما يميز هذه الصورة امتلاؤها برغبة دفينة في فقدان هذه المحبة، ودون تصريح أو إفصاح يتسرب ذلك الشوق للمحبة، وحينما نقول: المحبة أو نبوح بها فهي تعبير عن وجود علاقات بين البشر، فالمحبة لن تتكون من فراغ أو في الفراغ أو بعيدة عن الناس أو مع فرد واحد منعزل إلا إذا كان في عزلة صوفية تتجلى مطلقة أو يتواصل مع خيالاته وأحلامه ويكوّن معه أو معها علاقة حب، أما غير ذلك فإن فقدان المحبة يعني فقدان الاتصال والعلاقات الإنسانية، بل إن الروائي وهو يتواصل في إلقاء كل الكائنات والمكونات في هذه الرواية يعطيك صورة واضحة أن كل هذه الأشياء كانت محاطة بالحب والشوق والحميمية والمحبة فإذا بها تتحول إلى خواء: ((توجد على كوكب الأمير الصغير أعشاب صالحة وأخرى غير صالحة وتوجد بالتالي بذور طيبة وبذور غير طيبة ولكن البذور غير مرئية إنها تنام في باطن الأرض حتى تحس إحداها بالفنتازيا فتسقط))"4" .
كل هذه الذكريات التي تبرزها الصورة المكانية تكشف أمامك وجوداً سابقاً للأمل والحب المخفيين وراء هذا الوصف لعزلة الأشياء وتبخرهما، وتعلن ذلك صراحة بأن سبب كل هذا الموت والسكون والتخيل: ((تخيل عماد "الشاعر عرار" مثالاً مع قصيدته ليلة عيد الفطر يكتب بيده اليسرى من اليمين إلى الشمال، تصوّر "عرار" أعسر مع أن أحداً لم يقل عنه ذلك.. بدا عرار للرفيق مثل عرار: أسود العينين حادّ النظّرات يبدو في مطلع العشرين من العمر بسيط المظهر قليل العناية بهندامه بريئاً من التكلف إلى أقصى حذر
ـ هل هذه صورته أم صورتي؟!
صوت "غرامفون" ناءٍ في مكان ما حول تل إربد يطلق صوت أم كلثوم:
حديثُ الروح للأرواح يسري..
وتُدركه القلوبُ بلا عناءِ..
هتفتُ به فطار بلا جناحِ..
وشق أنينُه صدرَ الفضاء))"5".
إن لذة الصورة في هذا المقطع السردي يتجلى بعد انتهائك من تلك الفقرات ودخولك الفقرة الأخيرة منها حيث تبرز اللحظات القصيرات لغة أخرى نقيض البداية بل نقيض بدايتها الأولى، حتى إنك تشك في قراءتك، فهل بعد الإحباط والتشاؤم من الممكن أن يفجر الروائي أمامنا صور الأمل والحب وهنا وعند هذه اللحظة تبرز لذة الصورة، فالمحبة التي حينما غادرت أسرعت قد عادت مسرعة أيضاً وبعودتها خلا الفضاء وخرج من قاموس اللغة تلك التركيبات والشحنات والدلالات الجميلات المفقودات دائماً في هذه الرواية.
ويبدو أن الروائي استهوى لعبة المتناقضات وخلق الصدمات للمتلقي لتشويش انسيابية المشاعر والعواطف المكنونة وراء الكلمات والدلالات، فالصمت نفسه يشعل الجسد ومع هذا الجسد تتكشف الرغبات والأحاسيس والنظرات والمواقف المرتبطة بحالة العزلة والوحدة والإحباط، بل هو تعبير عن رغبة جامحة وتمنّ فاضح للحصول على سبيل الانطلاق والحرية وفك القيود، إنها حقاً مفتاح هذه الرواية في بعده النفسي والمكاني:
((أتذكر أن "عماد" تعرف على العرب قبل عام ونصف من اعتقاله خلال نشاطه من أجل تأسيس اتحاد طلبة الجامعة.. فوجد في الحزب مثقفين يجادلهم في البنيوية والوجودية ويختلف معهم حول السبيل إلى الوحدة العربية وتعريف الاشتراكية .. وتعرّف على مناضلين أججوا أحلامه بالحرية والتحرير والعدالة الاجتماعية .. ورافق "أبو موسى" فوضع إصبعه على معنى أن يكون...))"6".
إذن هي للهجرة والرحيل نحو الذات كملاذ لإنقاذ الروح وتحقيق الذات بعيداً عن الواقع الممتلئ فقط بالموروث، وهي رغبة تمكنت هذه الرواية بجدارة أن تعبر عن مكنوناتها ضمن رؤية ممتلئة بالأمل من تغيير الواقع.
ولكن ما نتيجة هذا القرار؟ وقبل هذا كيف عبر الروائي عن البرزخ ذلك الخيط الرفيع في الإحساس بين لحظة الرحيل وتركيز التفكير نحو المستقبل المجهول وبين جذب الماضي بذكرياته وحياته؟ كيف عبرت الكلمات والدلالات عن هذا الحضور والتلاشي للوطن وكائناته ومكوناته؟
لقد فجرت الذات المناضلة التي اعتبرت المكان مقدساً ويستحق كل هذا الرحيل والهجرة نحو الأمل كصورة مبعثرة عن اللحظة الإنسانية، فالإحساس بالوحدة والعزلة أصبح يطغى والإحساس بغياب المكان أخذ يبرز والأرض تمايلت والسجن ابتعد وجدرانه تغلي وكذلك الشوق ذاب. هجع عماد، كان النحيب وأخذت الذكريات الماضيات تنفجر، فأسوة بالرفاق الذين تلاشوا والمكان أخذت الأشياء كلها تتلاشى (إربد، السيرك، الباص، الحب، الأسرة، الأصدقاء، الحلم، التسابق، الاختباء، المطر).
صورة جميلة كثفت فيها كل كائنات ومكونات الوطن والذات منذ الطفولة واللعب والأسرة ولغاية سنوات النضج، وحينما تنفجر كل هذه الأشياء المخفية فيما وراء الذاكرة في لحظاتها الراهنة نتيجة لسرعة الحياة وتبرز بهذا الوضوح بل يتذكر المرء ألعاباً ماضية، فهو إذن الشوق قد طفح وخرج من قمقمه ولا وسيلة بعد ذلك لمنعه من السيطرة عليه، ذلك أن الذي يتلاشى هو البارز للإنسان في حاضره من أمور ومواقف وأحداث وقناعات وشخصيات وأشياء، لأن الجزئيات الصغيرة من حياته الطفولية أو في مرحلة ما قبل القفزة المدنية هي في الواقع متلاشية منذ أمد طويل ومركونة في الدماغ في صندوق الذكريات، أما وقد برزت بهذا الوضوح فإن ذلك يعني عكس التلاشي وان نطقت الكلمات بعكس ذلك.. وما يؤكد ذلك تلك الحالة الثانية أو الصورة الثانية التي عبرت عنها الرواية، فهي الهجرة حيث الذكريات والأوراق وصغير الندم مرافقاً وظلاً وحسرات متتالية متهاوية والعمر ما زال صغيراً وحزيناً، متهاوياً مهزوزاً مندفعاً:
((أنا الراوي"هاشم غرايبة" كنت أقلب أوراق كُناش مصفرة كتبها قبل ثلاثة وثلاثين عاماً، فطارت من بينها زهرة ياسمين مثل فراشة بلون التبن لتحط على كفي وتصل روحي بخيط شذى الياسمين مع زهو الشباب وزمن الإلهام ودفء الحلم وقدسية الكرامة الشخصية، فسطع حبر الكوبياء موقظاً الذكريات الغافية في كف الزمن))"7".
في مقطع سردي "صعب" وبلغة انتهت فيها كل دلالات الذات الواحدة واندمجت مع الجموع فتكلمت بقوة عبرت دون تردد عن الأمل وأنكم أزهار الروح وفرحتها، جباهكم قبلة القلب وكل الذي يخفق أنتم وما يستيقظ أنتم وما يأتي والكف ممدودة ترتجي.
يكمن الشيء الجديد في هذا السرد في رفضه إسناد السرد إلى المفاهيم التجريبية للذكريات المهيمنة على الفكر العربي طوال هذه المرحلة التي عاشها الراوي، وبدلاً من ذلك فإن الصدق والكذب لا يمكن أن يكونا هما الاصطلاحين الصحيحين للسرد الروائي، فالروائي عكس الآراء المعاصرة حول السرد التي تشكك في إمكانية معرفة الماضي بدقة، لذا وظف الروائي تقنية الذكريات ليؤكد على هذه الرؤية التي تعتمد على الدلالات.
لقد أبدع هاشم غرايبة في توظيف الأنواع القصصية في السرد السياسي وتوصل إلى نتيجة هي أن حبك الأحداث السياسية في السرد الذي يحوي القص يتداخل مع حقيقته السياسية ولهذا علاقة وطيدة بحقيقة أن:
البنى السياسية لم تنشأ فيها معانٍ داخلية بطريقة النصوص الأدبية.. المواقف السياسية ليست تراجيدية أو كوميدية أو رومانسية أساساً، كل ما يحتاجه الروائي هو تحويل وجهة النظر أو تغيير مدى تقبله.. إن كيفية تجسيد موقف سياسي معين يعتمد على مهارة الروائي في إنشاء حبكة محددة من مجموعة الأحداث السياسية التي يرغب في منحها معنى من نوع معين، وهذه أساساً عملية تكوين قصصي.
أدرك غرايبة أن توظيف الأنماط القصصية في كتابة رواية سياسية يولد تنوعاً في التأويلات المأخوذة من الحدث السياسي نفسه والتي تحول الحقيقة المطلقة إلى حقيقة نسبية، أي أن السرد السياسي يصبح قادراً على إطلاق مستويات مختلفة من المعنى استناداً إلى توظيف الروائي الكوميديا أو التراجيديا أو الرومانس، وهذه المستويات كلها تنتمي إلى حقل المجاز، وهذا الأخير موضوع اشتغل فيه العديد من منظري ما بعد البنيوية المهتمين بالمجاز.
ودافع غرايبة في روايته ((القط الذي علمني الطيران)) عن موقفه الروائي فيما يتعلق بحبك الأحداث السياسية داخل روايته، إذ بدا أن النزاع الحقيقي بين السياسي والمبدع بإصرار الأخير على أن الأحداث يمكن أن تحبك في شكل قصة واحدة فقط وأن الكتابة السياسية الروائية تزدهر باكتشاف كل بنى الحبكة الممكنة التي يمكن أن تستحضر لمنح مجموعات من الأحداث معاني مختلفة، لكن يبقى السؤال: هل الخطاب السياسي هو أساساً نتاج الإيديولوجية أو خيال إذا ما قبلنا الموقف بأن مسؤولية التفوه تمر عبر لغة الخيال من كيان لغوي صرف إلى كيان سيكولوجي أو إيديولوجي؟
غرايبة يجيب عن هذا السؤال روائياً:
((داهمته موجة سوداوية من الأسى الكرّار التي تلم به وبغيره من السجناء بمبرر أحياناً وبلا مبرر أغلب الأحيان.
بكى بلا سبب واضح .. قام إلى بنطاله المعلق على مسمار فوق رأسه ينبش جيوبه، أخرج ورقة الاستنكار قرأها.. أستنكر: الإذاعات العربية تغص ببيانات الشجب والاستنكار.)) "8" .
وفي هذا السياق تناول ميشيل فوكو مسألة الخطاب بالورقة والبحث، وبعد عمله حول الإيديولوجيا فقد حلل في كتابه "الجنون والحضارة" دور المؤسسات التي همشت وباسم العلم غالباً المجنون والمريض والمجرم والفقير والمنحرف، وفي الوقت نفسه يصر فوكو على أن الخطاب هو تمظهر للسلطة لا يقبل الفصل بين القوة وذلك لأن الخطاب يحدد القول ومعايير "الصدق" ومن له حق الكلام مع السلطة ومكان حصول الكلام، وهو رأي ناتج عن نظرية فوكو في التشكيلات الاستطرادية .
خلاصة القول أن ثمة تواصلاً بين النص والعالم، ولا يعود السبب في ذلك إلى أن النصوص تعكس أو تحاكي الواقع وإنما الواقع يتم تجريبه بشكل حتمي بوصفه منصعاً ،
وهذا يعني أنه مؤوِّل في إطار بناء اجتماعي وثقافي لما هو العالم وكيف يعمل: كما أن الثقافة المعاصرة قد شهدت عملية لا مركزة تمظهرت في غياب الوحدة في نصوص "ال" السياسي مما يؤدي إلى عدم تكامل العالم والذات إلى حد أن العالم قد أصبح غير مترابط وغير ذي معنى. كما أن عدم تكامل الذات يظهر في عدم قدرة المرء على فهم الموضوعات الأنطولوجية.. أو السيطرة على مصيره.
إن رواية ((القط الذي علمني الطيران)) نص حي وثري ممتلئ، فإذا حككته ازداد لمعاناً وتوهجاً وعطاء.
الهوامش:
1 ـ رواية "القط الذي علمني الطيران" ـ هاشم غرايبة ـ دار فضاءات، عمان ـ 2011م.
2 ـ مصدر سبق ذكره ص "7".
3 ـ مصدر سبق ذكره ص "7" .
4 ـ مصدر سبق ذكره ص "102".
5 ـ مصدر سبق ذكره ص"109".
6 ـ مصدر سبق ذكره ص "111".
7 ـ مصدر سبق ذكره ص"111".
8 ـ مصدر سبق ذكره ص" 110".
هزاع البراري
تراب الغريب
((بقايا سؤال))
سعت رواية ((تراب الغريب)) "1" للكاتب هزاع البراري وعلى امتداد المتن السردي إلى أن تقيم نوعاً من المعادلة بين الحياة والكلمة، وركزتّ على خصوصية الكلام باعتباره نتاجاً فردياً تتخلى من خلاله خصوصية الفرد. وأبرزت في سياق أخر الكتابة وسحرها كما في مفتتح قصة ((هذا صبري))"2"، ففي كل حكاية هناك حكاية أخرى تنمو في الوقت نفسه عندما تقوم بسردها لتبقى حبيسة إلى حين. وعليه يمكن القول: إن عنوان الرواية وبناءها يوحيان بارتباط حميمي بآليات الحكي. ولكن الكتابة حاولت أن تفرج بين سحر الكتابة كما تجلت عند الإنسان منذ الأزل وواقعية الحدث، لتشكل في نهاية المطاف ما يمكن أن نسميه الواقعية الغرائبية.
ويمكن أن نسجل في هذا السياق هذه الملاحظات :
1 ـ تم توظيف البنية العامة لتراب الغريب، ولم تقف الرواية عند التقليد بل أجرت تغييرات عليها بهدف خلق حكايات جديدة في المدن العربية لا تنسخ الأصل عن واقع هذه المدن بل تتواصل معها.
2 ـ الاستعانة بالحكاية لتصوير الواقع ورصد معاناة الفقراء والمقهورين في كل زمان ومكان، والتعبير عن الراهن من خلال العودة إلى الماضي، وتخمين الحكاية للإيهام بواقعية الأحداث.
3 ـ ثمة علاقة حميمية بين المرأة والكلمة والحب، لأنهم ينشدون التواصل، فما يجمع بين هذه الثلاثية الجمال والتجاوز والتواصل بغض النظر عن طبيعة الثوابت بالنسبة للمرأة أو الكلمة أو الحب.
4 ـ نحن أمام أنموذج جديد يمكن أن نسميه ((غرائبية التراب)) أمام الواقعية الغرائبية. لذا حظي نص ((تراب الغريب)) باهتمام مميز في الجزء الغرائبي من عالمنا العربي، ويعبر التفاعل مع هذا النص عن استيعاب حقيقي لرسالته الإنسانية الممتدة زماناً ومكاناً، ويعبر في سياق أخر عن خطاب مضمر بعكس ظروفاً متمايزة عاشتها شخصيات الرواية على مستوى المتخيل وعاشتها الجماهير في عالمنا العربي .
يتضح مما سبق أن هزاع البراري حاول تقديم أنموذج غرائبي يعبر عن آمال العالم العربي وآلامه، وقد أوضح الكاتب من خلال الاستلهام أهمية المرأة والكلمة في تغيير الأوضاع، وحاول الروائي الجمع بين الشرق والغرب من خلال الروح الشرقية التي تسرى في الرواية موضوعاً وشكلاً.
لذا أعاد الكاتب صياغة الحكاية كإنتاج لنص روائي جديد يستند إلى نص الغريب في بنيته الشكلية وبعض موضوعاته ولكنه يختلف عنه في طريقة تقديمها وتنويع الحكايات والتركيز على البعد الواقعي للحكاية، وقد تمكن الروائي من استخدام كل التقنيات في روايته، ويمكن أن نوضح ذلك على الشكل التالي:
1 ـ مستوى تجلي نص تراب الغريب: تتجلى العلاقة بين الرواية ونص الغريب.
2 ـ العنوان بين سلطة الحكاية والمرأة: اختار الكاتب عنواناً مميزاً... حكايات الغريب يحرك في القارئ مخزون ذاكرته ويربطه بنص روائي متخيل، فهو يتكون من شقين:
حكايات واسم شخصية "الغريب" وإن كان التجلي غير مباشر لكنه يتضح من خلال الشق الأول "الحكي" وإسناده في الشق الثاني إلى غريب. وعليه فنحن أمام علاقة غير طبيعية تجمع بين هذا النص ونص الغريب، وسرعان ما ينمحي الغموض عند قراءة بداية الرواية وخاتمتها حيث نجد إحالة مباشرة على نص الغريب، وإذا عدنا إلى عنوان الرواية التي أختارها الروائي نجد تجلياً صريحاً بين بداية الرواية وخاتمتها اللتين يربط بينهما خيط دقيق في التعريف عن قيمة الكلام وفاعليته، وما يمكن ملاحظته بالنسبة إلى عنوان الرواية أنه يحمل في طياته إشارات إلى مجموعة شخصيات غريبة في سلوكها وتفكيرها ونمط حياتها وهي في مجموعها تحيل على هذه الموضوعات ((المرأة والكلمة والحب والرحلة)) .
3 ـ بناء الرواية الفني:
تتكون الرواية من قصة (إطار) وتتوالى بعدها الحكايات خلال تدخل الراوي أو أحد الشخوص المرتبطة بها "الغريب"، وقد أطر الكاتب حكاياته بإحالة مباشرة على الليالي العربية في بنية الافتتاح والاختتام التي اقتطعها من الواقع العربي الغرائبي.
أما القصة الإطار فهي قصة الراوي والغريب حيث يقدم في إطار حميمي يجمع بين الشخصيتين، ويتحول الغريب إلى راوي مطالب بالحكاية، ويتحول البطل إلى راوي حكايات جيدة لم يستمع إليها الغريب.
وعادة ما تنتهي الحكاية الإطار في هذه الرواية بإمضاء سردي غرائبي لتبدأ حكايات الغريب في موضوعات مختلفة، حيث يختفي الراوي وراء ضمير الغائب ليروي مجموعة من الحكايات الواقعية والعاطفية والخيالية، ويحاول أن يقوم بالوظيفة نفسها التي قام بها الغريب أي أن يشفي الغريب من العنف الذي عرفه في حياته .
ويؤدي صوت الغريب وظيفتين، فهو صوت يحكي من جهة ويهدئ من جهة أخرى. ويتضح ذلك جلياً في أخر الرواية عندما تتداخل الرواية ويتمنى أن يستفيد بطله من هذه الرحلة ويشفى من كل جراحه القديمة.
((هسيس حياة الليل والعتمة حين يحاصرنا الفقر يشوهون أيامنا بحضورهم الذي لا ينتهي وحين نموت لا نستريح .. بل نشقى بنهاياتنا التي تأتي قبل أوانها، فنموت ولا نموت. "هذا كل ما وجدناه .. وآخر ما تركه لكم". "نقش على شاهدة قبر وحيد")).
هناك علاقة بين النص الأصلي والنص الجديد "القبر"، في بناء الحكايات وتناسلها والتداخل بين السارد وأبطال الحكايات، فكما تتماهى شخصية وحيد مع بعض الشخصيات الأنثوية في حكاياته، تتماهى الأنثى مع بعض أبطالها :
((هذا عبد الله .. وهذا صقر .. وهذا فهيد.. كل واحد نايم بجنب غرفته..
لو كنت بوعيي كان نيمتهم بغرفهم .. يا ويلي عليهم نايمين برا والبيت فاضي .. في الصباح تناديهم للإفطار ثم تجلس وحيدة هي والطعام .. والقبور))"4".
قد استفاد الكاتب من مرونة الشكل الروائي وبنى روايته على نسق الرواية العربية التي تعيش حياة القبور، كما استفاد من جو الحكي في مثل هذه الأجواء وموضوعاته وبدا جو الشرق واضحا في حكيه، لذا ضمن الناحية الفنية يجد القارئ نفسه امام حكايات تشبه حكايات الخوف وراو يشبه راوي الخوف .
يقدم الكاتب علاقات جديدة من خلال فكرة الخوف في سياق مختلف لا يوحي بالتذمر بل ينسجم مع الظروف الجديدة حيث يتجاوز فكرة الخوف والإغواء والعقد والانتقام ويعوضها بموضوعات جديدة هي الحب في مواجهة الظلم والمنفى هو الموت :
(( اسمع يا خوري.. إنت رجل دين وخالي شهوة .. يعني ما لك مصلحة مع ناس ضد ناس .. والمرة عندنا .. ذبحها حرام وما يحل مشكلة .. أنا أقول عندي صعب تضل لأني حليف لجماعتك، خذ ثرية وابتعد بها للقدس حتى تهدا النفوس)).
يستطيع الكاتب رصد العلاقات بين الحب في الليالي العربية وفي حكايات الخوري، وهو إمر طبيعي لأن ما يحكم هذه العلاقة هو جملة من الركائز البيولوجية والنفسية والاجتماعية، وهي تكاد تشتبه في كل مكان وزمان. وعموما فإن (الشيفرة الأخلاقية) كما قدمت في النص تؤدي وظيفة اللذة او العلاج او التغيير ومن هذا المنطلق برز نوعان من الحكايات : الحب الجسدي حيث يكون فيه الطرفان ضحية وضع اجتماعي او مرض نفسي، والحب العفيف حيث يكون بديلا للقهر والعنف والمنفى، وقد ابان الكاتب من خلال هذه الشيفرة ان الأزمة الحقيقية في المجتمع هي ازمة حب لا جنس، أي نقص في التواصل، وأن جميع انواع الحب لا يبرر القهر المفروض على الأنثى فحسب بل هو قاسم مشترك بين الطرفين سواء اكان جنسيا او اجتماعيا او سياسيا.
وتتضح سلطة الكلمة في القصة الإطار عندما تتوجه الانثى الى الراوي بهذه العبارات : ((أمعن في جرحها، حتى أحست بمخالب الكلمات تمزق أحشاءها ورأته يتشوه امامها يتحول الى وحش بشع، ادركت ان حياتها تنهار بسرعة كبيرة، لم تستطع الرد عليه. قضمت سيل بركان غضبها وقالت بأسف:
ـ أنا اصلي كل يوم حاسه ان الرب يسمعني .. بس كيف واحنا .. شلون يجينا الولد وانت تنام بعيد عني؟))"6".
ويحرص الراوي على تأكيد فاعلية الكلمة وسلطتها عندما يشرع في سرد حكاياته. تبيع الانثى الحكايات من اجل الولد، الحياة تمكن الكاتب من خلال هذا الوصف ان يطرح شخصية الانثى وان يقدمها في صورة جديدة تختلف تماما عن تلك الصورة التي تشع في ثقافتنا العربية. وبدا الاختلاف واضحا عندما اسند الحكي الى شخصية انثوية تبحث في الحياة من خلال رحم القهر، وحاول ان يكسبها بعض خصائص القديسة كالقدرة على الحكي والثقة بالنفس، ونستطيع القول: انه اراد من خلال هذا النموذج ان يرسم صورة المرأة العربية القديسة، ومع ما يبدو من أختلاف كبير بين شخصية الذكر وشخصية الأنثى إلا أن الاستدعاء يقع في ظل ظروف جديدة اجتماعية تميز هذا الجزء من عالمنا العربي، ولا شك أن اختيار الأنثى بهذا الشكل، وأنها تنتمي إلى طبقة عادية وتمارس الحياة، سهّل مهمة نقل الواقع وتصويره، فإذا كانت الأنثى ترصد الوقائع من برج الوجه والقهر، فإن الرجل يرصده بمعاينة مباشرة:
((يقهقه بوحشية ويقول:
ـ كيد النسوان ما أريده. أنت طلعتي من نفسي .. لو دينا يسمح ما بتي ليلة في هالبيت))"7" .
استطاع الكاتب إحداث صورة اجتماعية واسعة في اتكائه على نص التمرد والقهر الذي يمارسه الرجل ضد المرأة، ويتضح ذلك في محاولة تقديم تجربته في الكتابة الروائية الذكورية التي تفضح هذا الجزء من التراث الإنساني الراهن في نوع من الواقعية تشيع في أدب هذه المنطقة هي الواقعية الموضوعية، ويؤكد الروائي من خلال بطلتها على قدرة الحكاية على تغيير الواقع إذا كانت صادقة ومتميزة وكانت مصدراً للمعرفة بالذات والجماعة إذ يتحول الواقع إلى حكاية ثم تعود الحكاية لتغير الواقع فسؤال الكلمة الذي طرحه الكاتب هو في حقيقة الأمر سؤال الكاتبة ومن خلال هذا السؤال تتضح المفارقة بين النصين والشخصيتين: نص متمرد ونص متجاوب مع الاعتياد للقهر، شخصية تحاول الثورة وشخصية تتلذذ بالقهر. يحاول الكاتب من خلال هذا الرصد أن يقدم أنموذجاً في الكتابة يبدو من عنوانه أنه قديم ولكن عندما نقرأ الحكايات نحس بواقعية الكتابة وتماهيها مع فنون كثيرة .
ما يزيد في متعة متابعة الرواية هو سخرية الكاتب من الموت ، فهو يصوره على أنه سارق فاشل للحياة شأنه شأن أمثاله من الفاشلين في كل زمان ومكان. إن توظيف السخرية في الرواية يولد انطباعاً لدى المتلقي أن الرواية ما أن تموت حتى تولد من جديد، وهو يبتكر نوعاً جديداً من الخيال الروائي وفهماً جديداً لطريقة تنفيذ هذا الخيال روائياً، فقد أصبحت السخرية المقوم الأساسي للرواية.
أدرك هزاع البراري أن المشكلة التي تعترضه في خلق الشخصية القوية الصلبة في عالم تتعرض فيه الانسانية للتهديد ويحتاج المرء لمعونة الكثيرين ليقوم بدوره، وهنا تحديداً بدأ السؤال المعرفي والشكلي يفرضان نفسيهما على الرواية وعلى ماهية دور السرد ومشاكل الراوي وسلطته المفروضة على النص؟
البراري حاول الإجابة عن هذا السؤال الإشكالي من خلال نصه، عبر انسحاب روايته من طريقة الإنشاء المرجعي وعن الواقعية والابتعاد عن التنظيم المخطط للشكل وتخطيط وجهات النظر وأنساق الوعي المتشابك، فاتجه نحو تقديم (مساحة معجمية) لمفردات النص نفسه: نص من انتاج وعي مؤلفه مشروط ومحكوم ليس بالشخصيات أو بأبعاد مخططة مسبقاً ولا بأنساق من القيم والتعاطف ولكن بإيقاع الإنشاء نفسه بحيث يصبح النص حدثاً مكتفيًا بذاته، واستطاع البراري في هذا السياق أن يقنع المتلقي أنه أمام بنية روائية تشبه الدمية يمكنه أن نقوم بها بالإبدال والتبديل، ورأينا الكاتب والشخصية والحبكة والقارئ قد أصبحوا جزءاً من موضوع الرواية، وأصبح الخيال الإدارة التي من خلالها يمكن اللعب باحتمال وقوع أو حدوث التجربة، سواء أكان أم لم يكن لها معنى، وسواء وصفت أم لم توصف بالواقعية. ومن خلال العمل على هذا التوصيف قام البراري بالكشف عن معنى الازدحام في حياتنا فكانت رواية ((تراب الغريب)) محاولة أكثر جدية لتخطي الحقيقة والكشف عما وراء الحقيقة كحالة إنسانية معاصرة، فهل يدفعنا الروائي هزاع البراري للتقرير من خلال نصه أن الرواية كالفلسفة وكلتاهما دليل ومرآة لعصرها؟ هذا ما يتسنّى للقارئ أن يكتشفه.
الهوامش
1 ـ رواية تراب الغريب ـ هزاع البراري ـ دار ورد ـ عمان ـ 2009.
2 ـ مصدر سبق ذكره ص 13.
3 ـ مصدر سبق ذكره ص 220.
4 ـ مصدر سبق ذكره ص89.
5 ـ مصدر سبق ذكره ص149.
6 ـ مصدر سبق ذكره ص109.
7 ـ مصدر سبق ذكره ص109- 110.
ليلى الأطرش
امرأة للفصول الخمسة
"لون الإنسان ... مشكلة الحياة"
تشكل "المرأة" في رواية "امرأة الفصول الخمسة" للكاتبة ليلى الأطرش كما في الرواية العربية المعاصرة محوراً هاماً ورئيسياً وتكاد لا تخلو رواية عربية من هذا المحور الهام، وذلك انطلاقاً من معطيات اجتماعية وأخلاقية وفكرية وكذلك سياسية، فالمرأة كما ينادي المحافظون والتقدميون تبقى نصف المجتمع، تلك العبارة التقليدية التي لا يخلو منها أي خطاب سياسي واجتماعي واقتصادي يتحدث عن هموم الحاضر وآمال المستقبل، وتكاد طبقاً لذلك تبدو أي رواية عربية معاصرة رواية مستهجنة لو أنها خلت من محور المرأة وما تلعبه من دور جليل في حياتنا العربية وفي الحياة الإنسانية عامة، فكيف يمكن أن يكون طعم رواية ما وهي خالية من الحب والجنس..؟
قد يكون تموضع المرأة وما تمثله من حب ونماء وجنس محوراً هاماً ورئيسياً ولكن ما هو أهم من ذلك هو كيفية طرحنا هذا الموضوع ومن أي نافذة ننظر إليه، فنحن لن نأتي بجديد ولن نضيف جديداً ولن نخدم قضية المرأة إن كان هناك قضية في الرواية العربية ما لم نستشرف مستقبل المرأة استشرافاً حضارياً متقدماً من خلال ماضيها التعيس وحاضرها المتأرجح بين أن تكون أو لا تكون.
ومن هنا يتبين لنا من خلال واقع الرواية العربية المعاصرة أن الإضافات الإنسانية الحقيقية التي أضيفت إلى تموضع المرأة العربية في المجتمع العربي المعاصر كانت إضافات محدودة إلى حد كبير بعد إسقاط كل الروايات العربية المعاصرة التي اتخذت من المرأة موضوعاً مجانياً أو حلية من حلي معصم الرواية العربية، ذلك إننا كقراء علينا أن نسأل أنفسنا دائماً هذا السؤال الموجه للمرأة الروائية:
ـ قولي لي من أنت ومن أي نافذة تطلين على المرأة حتى أستطيع أن أقرأك..؟
إذاً ماذا يفيد قضية المرأة العربية إذا لم تكن هناك معالجة روائية تفتح للمرأة نوافذ حاضرها المغلقة وتدفعها إلى الأمام خطوة أو نصف خطوة..؟
ألا يكفي المرأة العربية أن تكون مقهورة ومحبطة في المجتمع العربي وأن معظم حقوقها الإنسانية مسلوبة بل هي زيادة على ذلك تحملها بعض قطاعات المجتمع العربي تبعة أعباء قهر الرجل أو إحباطه وسلب حقوقه الإنسانية؟
وهي في هذه الحال تحمل تبعات وأعباء قهر وإحباط وسلب حقوق المجتمع بأكمله: رجلاً كان أم امرأة، وقدر صبور! هذا كله في روايات كل من نجيب محفوظ في ((نهاية وبداية)) وفتحي غانم في ((زينب والعرش)) والطيب الصالح في ((موسم الهجرة إلى الشمال)). وقد ساهمت الأوضاع السياسية المتردية جداً في العالم العربي إضافة إلى الاستغلال المادي والانغلاق الاجتماعي إلى تنامي هذه الظاهرة في المجتمع العربي وبالتالي فإن الرجل العربي لم يلق متنفساً يفرغ فيه همومه وقهره غير متاع بيته، فكانت المرأة العربية هي المتنفس. وتزداد تبعات وأعباء المرأة العربية نحو ذلك كله كلما ازداد القمع والقهر والظلم والإحباط السياسي والاجتماعي والفكري في العالم العربي.
ويبقى الكف الذي يتلقاه ويأكله الرجل العربي في الشارع السياسي العربي وفي الحياة العربية كفاً مجيراً لأمه أو زوجته أو أخته أو ابنته تأكله في نفس اليوم وبنفس القسوة..!
وقد كانت ليلى الأطرش من الروائيات اللواتي أبرزن هذا الجانب في حياة المرأة العربية في روايتها ((امرأة الفصول الخمسة))"1" كما سنرى بعد ذلك، كما أن الكاتب الجزائري الطاهر الوطار كرس هذه الصورة الجهنمية للمرأة في عدة قصص مما كتب"2".
أما الصورة الواقعية للمرأة في هذه الرواية فتبدو في حاجة الرجل إليها، حاجته إلى جسدها وعدم استطاعة الرجل الاستغناء عن المرأة.
والأطرش في هذه الرواية تحاول أن تبرز مدى الحرمان الذي يعيشه الرجل من المرأة نتيجة للظروف الاجتماعية التي يحياها الرجل العربي، ولكن الأطرش من خلال "إحسان" بطل الفصل الأول والثاني من هذه الرواية أن الظروف الاجتماعية هذه يمكن تجاوزها بالعدد الكبير الذي حظي بمعرفته "إحسان" وتساعده على "تسكين عجزه" وتجاوز المحن التي تعترضه أو الواقع السيىء الذي يعيشه.
((نادية .. اتفقنا. ستذهبين؟
ـ ستكون هذه المرة الأخيرة.
ـ صاح جذلاً:
ـ حبيبتي..))"3"
المرأة حاضرة دائماً في كل تحول من تحولات إحسان، فإحسان ينتقل دائماً من فكرة إلى أخرى ويتحول من حال إلى حال، وهو في تحولاته الحياتية يتحول أيضاً من عالم إلى أخر، وكأن هذا التحول عند إحسان يساعده على التغلب على مشاق التحول الحياتي والمهني، إذن فالمرأة في حياة إحسان هي بالتالي عامل مساعد على تخطي الصعاب وتقلبات الدهر.
والمرأة في ((امرأة الفصول الخمسة)) تكتسب قوة ذاتية أكثر منها قوةً روائية، بمعنى أن شخصيات الرواية تشعر بقوة المرأة أكثر من شعور القارئ بهذه القوة.
يقول إحسان:
((هذه المرأة من نوع جلال لو تزوجها لقضيا الساعات يفكران كلٌّ في ملكوت))"4".
تلك كانت المرأة في الواقع.. في واقع شخصيات الرواية ولكن المرأة من ناحية أخرى كانت في هذه الرواية رمزاً من الرموز.
فالمرأة تبدأ بالصعود من الواقع إلى الرمز .. تبدأ من كونها امتحاناً صعباً للرجل على مواجهة الحياة مواجهة صحيحة من حيث اختبارُها للرجل ولقدراته على مواجهة الحياة سواء على صعيد العمل أو على صعيد التفكير، تبدأ من كل هذا وتنتهي إلى أن تتحول إلى رمز حين توحد الأطرش بينها وبين الفصول على لسان إحسان:
((استظرف فكرته، خرجت ضحكته مبسترة وساخرة، ما تبقى في كأسه منتشياً بالرضا عن نفسه.))"5". ونلاحظ أن رمز المرأة الحياة هو رمز اجتماعي في إطاره العام تتداخل حدوده جداً بحيث تغيب حدود كل رمز مع الآخر.
فتشاؤم الأطرش الكاتبة هو في الواقع الذي تصوّره ويجب أن تهرب منه وأن الكذابين المستغلين أصحاب الضمائر الميتة هم الذين يسيطرون على الحياة في مجتمعه، كذلك المرأة تختلط مع الكذب مع المال بكل وسائله القذرة باعتبارها جزءاً من الحياة الواقعية .
وبهذا نرى المرأة تمثل نوعين متضاربين من الرموز : فهي الخير والشر لا من خلال ممارستها العملية في الحياة العامة ولكن من أسوار بيتها، فهي مرة أخرى الأم والابنة والزوجة فقط ومن خلال هذه الوظائف الاجتماعية التقليدية تقوم المرأة بممارسة هاتين القيمتين.
فالمرأة حين تكون رمزاً للشر واللعنة، تكون عائقاً في وجه طموحات الرجل، حتى أن الحب والعواطف الإنسانية النبيلة تستحيل إلى عائق يعيق طموحات الرجل ويحد من حركته الطبيعية في الحياة العامة.
فها هي نادية إحدى بطلات الرواية تكون سبباً في سقوط قيمة الصداقة عند الرجل، خاصة عندما يتحدث زوجها إحسان عن صديقه جلال:
((ارتشف جرعة ثانية بتلذذ أوضح وظّل ممسكاً بالكأس:
ـ بعض الناس لا يعرفون اقتناص الفرص خاصة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مثقفين، تصوري يا نادية... جلال وشلته كانوا يتسابقون في استعراض ما قرأوا .
أقسم لك بالله، الواحد منهم كان يقرأ من أجل الآخرين والتفوق عليهم والاستعراض أمامهم، هل تصدقين كنت أجلس إليهم ساعة، ساعةً واحدة فـأعرف منهم ما قرأوه في أيام. لم يكن عندي وقت أضيعه في القراءة))"6".
إن المرأة الشرقية لها عالمها الخاص والغريب إذ بمقدار ما تبدو شديدة الرغبة في إظهار مفاتنها وإن كان بشكل فج فإنها تخاف نفسها وتخاف الآخرين كثيراً، لذا تظهر شديدة التردد ميالة إلى الصمت، وحين تتحدث إليها عن أي أمر من الأمور تصاب بحالة من الارتباك أقرب إلى الخوف وتتلفت حواليها باستمرار وكأنها تحس أنها تقوم بعمل فاضح وان الآخرين يراقبون كل كلمة وكل تصرف.
وهي لكثرة تفكيرها بالجنس ورغبتها الهائلة في ممارسته تعرف كيف تكون فاتنة لدرجة الإثارة.
إن قدرة المرأة الشرقية في السيطرة على الرجل ليست ناشئة عن قدرتها الجنسية فقط، إذ يضاف إلى ذلك عنايتها الزائدة بمعدة الرجل وبذلك يكتمل الطوق حول الرجل ولا يستطيع الفكاك منه.
مشاركة المرأة في الحياة العامة محدودة وغير فعالة وأغلب الأحيان غير ظاهرة، فهي ظل للرجل وبما أن أهم القرارات تتخذ دائماً في الخفاء أي في مخادع النوم، فإن المرأة من هذه الناحية اكتسبت قوة وسلطة.
ويستطيع القارئ لرواية ((امرأة الفصول الخمسة)) أن يلحظ بسهولة أن الأطرش قد أبقت المرأة العربية داخل بيتها ولم تستطع أن تخرجها من بيتها هذه المرة، لا لأنها لا تريد لها ذلك ولكن طبيعة الرواية الصحراوية التي قدمتها لنا هي التي فرضت عليها هذا المجلس.
إن الأطرش من خلال رواية ((امرأة الفصول الخمسة)) تصور لنا مجتمعاً منحطاً أخلاقياً واجتماعياً وسياسياً، لا يؤمن بالحرية، يفتقد إلى الديمقراطية، ينقصه العلم وتنقصه المعرفة، لا يجيد استخدام ثرواته، تحكم معظم أجزائه فئة من المنتفعين والنصابين واللصوص والمحتالين الأفاقين، لا يفكر في المستقبل وليس لديه أي استشراف مستقبلي، يسجن المرأة في بيتها ويحجبها عن الحياة الواسعة، يقتل الإرادة في الإنسان ويقتل الإنسان كذلك، مثل هذا المجتمع لا تصور فيه المرأة على النحو الذي صورت فيه وما عدا ذلك سوف يكون تزييفاً للحقائق القائمة في هذا المجتمع، فمن أين تأتي لنا الروائية بالصور الجميلة عن هذا المجتمع وخاصة صورة المرأة؟ وكيف تريد من الروائية أن تطلق المرأة وهي سجينة وتحررها وهي عبدة وتعلمها وهي جاهلة وتعطيها ما للرجل من حقوق وواجبات والرجل نفسه في العالم العربي محروم من هذه الحقوق والواجبات..؟
مع ذلك استطاعت الأطرش رسم المرأة شبه الراعية محاولة قدر الإمكان تجاوز هذا التنميط للمرأة. تقول الرواية:((بل تشتري العقار في الصفقة القادمة وسأحتفظ بالذهب.
ـ لا يا نادية .. العقار أو الذهب ..فقط.
ـ كلاهما .. يا إحسان .. فالذهب والعقار لن يصلا إلى عشرة في المئة .. يبقى لك واحد وتسعة أعشار من الرأس .. وإلى أن تحقق لي ذلك سننام في غرفتين منفصلتين.
عادت إلى كتابها .. وظل محدقاً فيها بغير تصديق.)) "7".
والسؤال:
هل يتركز دور المرأة على مساحة الحب والجنس والعواطف الإنسانية في رواية الأطرش؟
إن السطور التالية سوف تكشف مزيداً من الحقائق وتضيء جوانب أخرى من إشكالية المرأة والحب والجنس.
((يقال: إن العرب في قديمهم فرقوا بين الحب والجنس ولم يخلطوا بينهما، فقد ظل الحب عاطفة تقوم على الميل القلبي المقرون بالإيثار، ميل يتنفس في اللقاء والعنف والتأمل في حركة النفس والرغبة في توحد الشعور نحو الأشياء، لقد كان العرب في قديمهم أيضاً يعتقدون أن النكاح يفسد الحب ويقضي عليه وقالوا: إن التواصل الجسدي ليس من مسابر الحب)) "8" .
فهل حقاً إن التواصل الجسدي في القرن العشرين لم يعد من "مسابر الحب"؟ هناك أكثر من عشرة قرون تفصل بيننا وبين مفهوم العرب القديم للحب والجنس تغيرت خلالها مفاهيم كثيرة وجاءت نظريات وذهبت نظريات وحدثت تغيرات كثيرة ومخيفة في العلاقات الإنسانية وفي العواطف الإنسانية عموماً أدت إلى سلوكيات أخلاقية جديدة في كافة المجتمعات وفي تلك المجتمعات التي ما زالت في القرن الواحد والعشرين تعيش بمنطق القرن السابع أو الثامن الميلادي. ذلك أن رياح التغيير كانت أقوى وأشد من أن يصدها صاد أو يدفعها مدافع.
وكانت النتيجة أن التواصل الجسدي أصبح من "مسابر الحب" وأن ما يقال عن الحب العذري في القرن الواحد والعشرين ما هو إلا في خيال الشعراء الذين يحلمون بعودة مجتمع القرن السابع أو الثامن الميلادي. ولعل المجتمع العربي الذي بين أيدينا الآن والذي صوّرت ما بنا منه ليلى الأطرش يشير إلى أن الفاصل الذي كان يفصل بين الحب والجنس لم يعد قائماً لأن الإنسان العربي قد تغير نتيجة لتغير أدوات الحياة وتفاصيلها ومنهجها.
إن قراءة سريعة لبانوراما الرواية العربية المعاصرة تشير إلى أن الفاصل بين الحب والجنس قد تلاشى كليةً ولم يعد الجنس وسيلة الروائيين لكي يوقظوا القراء من نومهم أثناء قراءة الروايات المملة، لقد أصبح الجنس في الحياة ـ وكان كذلك منذ الأزل ـ جزءاً من الحياة نفسها كالموت والميلاد على حد تعبير هنري ميللر.
إن الإحساس بالمرأة وممارسة الحب والجنس لدى أبطال رواية الأطرش شيء فطري لا يتعلمه هؤلاء الأبطال، كما أنه شيء فطري بالنسبة لكل الناس.
إن مشكلة الجنس تتعمق أكثر كلما ازداد الجهل الاجتماعي والكبت السياسي والخيانة الوطنية. إن الأطرش ترى أن التدهور الاجتماعي والانهيار السياسي في المجتمع العربي كان سبباً في أزمة الجنس في هذا المجتمع وليست هي وحدها القائلة بذلك بل هناك مجموعة من الروائيين يشاركون الأطرش هذه النظرة ومنهم نجيب محفوظ ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس وغادة السمان والطاهر وطار وغيرهم من الروائيين المعاصرين"9".
كيف يمكن للحب أن ينمو ويترعرع وينبت ويزهر ويثمر بين الخيانات..؟
إن الخيانات لا تنبت غير خيانات مرادفة لها..!
والسؤال
- هل تعمدت ليلى الأطرش أن تقدم لنا موضوع الرواية وشخوصها على هذا النحو لكي تعمق المأساة والمعاناة التي تواجهها شخوص هذه الرواية؟
لا شك أنها قامت بذلك متعمدة لكي تلقي بنا نحن القراء في هذه النيران الصحراوية دون أن نستطيع الاستجارة بعرق أخضر.. بامرأة.. بموقف حب..
تقول الرواية: ((نحن من شعب قدره يا نادية أن يتعرض للمؤامرات.. ومحاولات التشويه من الأقربين والأبعدين، هذا هو قدرنا ولهذا فنضالنا صعب ومختلف عن نضال الآخرين، وكثيرا ًمما يقال تشويش على ما نفعل، شيء في داخلي يكبر مع انفعاله، ألا تدري يا جلال الناطور أنني اعرف؟ مستر غونز آليس ألم يخبرك إحسان أنني سمعتك؟ جزء من وجهك الحقيقي بات مكشوفاً أمامي وأريد أن أتيقن مما بقي من تفاصيله:
- مستر غونز اليس !
- اسمي جلال يا نادية
- مستر جلال غونز أليس لكما حديث إلا عن المؤامرات والدسائس التي تواجهون؟ ألم تكن هذه كافية لتوحيدكم؟ ألم تكن كافية لتصبح مطهراً للخلافات والتجاوزات والأخطاء التي نسمع عنها؟
ألا تكفي هذه كلها لتحاسب الثورة كل من يخطىء ويتجاوز ويتسلق أياً كان... وبقسوة؟))"10".
حتى شخوص الرواية يبدون غلاظًا قساة لا مكان للمرأة بينهم ولا أثر للحب في قلوبهم، كما تبدو العلاقات الإنسانية ذات الصبغة العاطفية علاقات تفترسها الخيانة.
اعتمدت ليلى الأطرش على تقنية الحوار لتوصيف الخيانة. كأن المسافة بين المتحاورين تزداد قرباً كلما ازداد بعدهم، لا عن بعضهم، بل عن ذواتهم، كل متحاور يزداد قرباً من الآخر، كلما ازداد بعداً عن نفسه، ذلك أن النقاط التي يتبلور عندها التعثر و"يتوقف" الحوار أو على الأقل يتأزم لا تفرق بين المحاورين إنما بين الراوي وبداهاته، بين الراوي ومسبقاته أو لنقل: بين الراوي وبين نفسه وهو يسعى للانفصال عنها. فكأن الالتقاء بين أطراف الحوار لا يتم إلا عند نقاط افتراق، وكأن الاتصال بينهما لا يتم إلا عند نقاط انفصال: نقاط تأزم، والتأزم التي تتحرر عندها الرؤية من يقينياتها وتخفف من "حقائقها"، إنها النقاط التي يغدو عندها أطراف الحوار "في الهم سواء" وليس أي هم بل الهم الفكري ((الذي تتحول فيه الأشياء التي تبدو معروفة إلى أشياء تبدو أهمل للمساءلة)) على حد تعبير هايد غر.
وهذا ما سعت إليه ليلى الأطرش في روايتها "امرأة الفصول الخمسة" وهي صور أكثر قسوة وأشد فظاعة من الصور التي شاهدناها في الروايات التي سبقت هذه الرواية "امرأة الفصول الخمسة".
الهوامش
1. رواية امرأة لكل الفصول ـ ليلى الأطرش ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشرـ بيروت ـ 1990.
2. لمزيد من التفاصيل حول تموضع المرأة العربية في الصالونات العربية يراجع كتاب د. لطيفة الزيات ((من صورة المرأة في القصص والروايات العربية)) ـ دار الثقافة العربية ـ القاهرة 1989.
3. مصدر سبق ذكره ص "50" .
4. مصدر سبق ذكره ص "54" .
5. مصدر سبق ذكره ص "54".
6. مصدر سبق ذكره ص "53".
7. مصدر سبق ذكره ص "94".
8. راجع كتاب الحب في التراث العربي: د. محمد حسن عبد الله ـ عالم المعرفةـ الكويت 1980 ـ ص111 وما بعدها.
9. راجع: أزمة الجنس في القصة العربية، د. غازي شكري ـ دار الآفاق الجديدة ـ 1987.
10. مصدر سبق ذكره ص "116".
مؤنس الرزاز
جمعة القفاري
يوميات نكرة
(فرح القارئ تجربة في تأويل الطريق)
إن اللعبة أحادية الطرف ليست لعبة الواقع على الإطلاق، لأنها تفقد مرماها، وبذلك غرضها، هكذا يكون ثمة تبادل ينطوي على اللعب، وهو التبادل الذي ينطوي عليه المكان أيضاً، فالمكان لا يكف عن توسطه بين ما هو مألوف بالنسبة لنا وما هو غريب عناّ متيحاً لنا أن نوسع فهمنا ونزيده، وإن يكن ذلك فهو لا يعني أبداً بلوغ الحد الذي يتمكن فيه إخفاقنا أن يحيط بكل شيء، فالفهم يبقى على الدوام نتاج وجودنا المتناهي وعرضة للتغيير، من هذا الباب يقترن الفهم بلعبة حوار مفتوح بين طرفين، حوار قرنه جاد أمير بافتراضاتنا المسبقة أو تحيزاتنا التي تبعث الحياة في فهمنا الحواري، ذلك أن التحيزات كما يقول: (هي انحيازات انفتاحنا على العالم، وهي تشكلنا منذ الماضي ويمكن القول: إن تحيزاتنا تأتي مع كينونتنا ـ في العالم، ومن دونها ما كان العالم ليكون هذا التصور يجعل من عملية القراءة محاولة لفهم ما يتعلق بوجودنا الذي لا ينفصل عن وجود النص المقروء، بل إن عملية القراءة أو اللعبة ذات الطرفين تعمل أبداً على خلق حالة مرح متعالقة بهيبة الوجود في عالم ـ نص تتشكل ملامحه بواسطة فعل قراءة مفتوح."1"
لا يحيا العمل الأدبي إلا إذا قرئ، وبدون عملية القراءة هذه ليس هناك سوى تخطيطات سوداء على الورق كما لاحظ ذلك سارتر في بداية كتابه "ما الأدب"، غير أن القراءة عملية صامته لا تترك أثراً مكتوباً إلا ما ندر، وهي من صنيع أفراد معزولين وفي الغالب غير معروفين. يفسر هذا سبب بقاء القارئ لمدة طويلة مهملاً داخل النظرية الأدبية "2".
ويبحث فكرة القارئ الذي يتوسط بين وجود النص الحيادي الصامت ووجوده في العالم اللعبة ذات الطرفين، فإن هذا القارئ ـ المتوسط ـ يستدعي أسطورة "هرمس" رسول الآلهة إذ يتنقل هرمس بين عالمين: عالم الآلهة الغمض وعالم البشر الفانين محاولاً تفسير رسائل الآلهة التي يعجز البشر عن فهمها، وبحسب ما تقول الأسطورة فإن هرمس كان يرتدي خوذة تمكنه من الاختفاء والظهور أنّى يشاء.. وكان هرمس ألعباناً إله اللصوص وقطاع الطرق ويمكنه أن يأتي بخير مفاجئ أو بتعاسة مريرة، كما كان أيضاً إله الفارق والحدود ويقود الموتى إلى العالم السفلي "هادس" هرمس هو الإله الذي يتوسط أو يؤول حقيقة العالم في شكل متاح في شروط حياتهم العادية .
ومما كان ينسجم مع طبيعة هرمس أن المعرفة التي كان يأتي بها هي معرفة حاذقة وجزئية وضمنية تنير للبشر سبيلهم لكنها تقوم على الاكتمال، وهكذا في حين تُعنى الهرمنيوطيقا بكشف معنى الإنشاء، ذلك المعتى الذي يمكن أن يكون خفياً عن الأنظار أو محتجباً في النص، فإنها تقبل أيضاً أن هذا المعنى لن يتكشف للأنظار بصورة كاملة قط فنحن مخلوقات تاريخية يقيدنا "تناهينا" ولذلك فإن المعنى سوف يتنوع بتنوع ظروف الحياة التي نحياها. "3"
هذا "المعنى المراوغ الذي يتوسط بين عالم الآلهة الغمض (النصوص التي تحتاج إلى تأويل) وعالم البشر الفانين (القراء المؤوّلين) هو أحد المعاني التي يتساءل عنها نص (جمعة القفاري ـ يوميات نكرة). "4" لمؤنس الرزاز. يستدعي النص هرمس ـ ومن وراء السطور ـ ليسائله عن ارتباط المعنى بحياة البشر المقيدين بتاريخهم الشخصي المتجذر فيهم، فهل يمكن للمعنى أن يفارق جذره التاريخي؟ وهل يمكن للبشر الفانين تغيير مسار "جمعة القفاري" الذي جذبته الأيام الغامضة؟ من يملك المعنى إذا كان هرمس الألعبان يمرح مع عجز البشر عن فهم غموض لغة الآلهة في الوقت الذي يمنحهم هرمس وفي اللحظة نفسها المعرفة المتاحة بوصفها الحقيقة المفسرة؟ تستدعي مراوغة "جمعة القفاري" مراوغة "هرمس" في كون هذا الطريق ينطوي على متاهات بعضها مظلم وبعضها يومىء بالضوء ويضمر الظلام وبعضها يقود إلى الطرف الأمن، في هذا السياق تمنح مراوغة "القارئ" للعبة مرحها في خلق "جمعة القفاري"، ينشق بين النص الصامت ولحظة إنطاقه عبر فعل القراءة الذي يتقمص روح هرمس من جديد.
يستطيع القارئ لأدب مؤنس الرزاز أن يلمح ذلك البعد الإنساني الباحث عن مطلق الإنسان وعن المغزى من ذلك، "جمعة القفاري" الذي يتوسط بين عالم السماء الغمض وعالم الأرض المفعم بالمحن والابتلاءات والشفرة التي تستدعي أبداً حواراً تأويلياً مع الوجود ومع اللغة الواقعة في أحبال المجاز. يسعى السرد في نصوصه الروائية عامة إلى البحث عن المعنى الماثل وراء الوجود الإنساني بوصفه تجلياً للهبة الإلهية المتمثلة في الإنسان وفي الحياة، كما يتساءل ويلمح في السؤال عن النوازع البشرية التي تحسم مسير الإنسان عبر تاريخه .
السرد في هذا السياق حركة بحث وسؤال لا تكل ولا تهدأ من أجل مكاشفة الإنسان وعالمه.
تسعى سرود مؤنس الرزاز الروائية إلى التوغل في التجربة الإنسانية بغية " " حقيقة الفعل الإنساني المتوتر بين الحياة والسرد، يتحول النص إلى هرمس فيلعب دور المؤول لما غمض في الوجود المتعالي وأيضاً في التجربة الإنسانية المصحوبة بغيمات "جمعة القفاري" ثم يتحول هرمس بدوره إلى نص ويغدو القارئ هرمسياً. تُتبادل الأدوار وتتعدد الأطراف ليمرح (المعنى) وتزداد تشعبات "جمعة القفاري".
فهل ثمة قانون يحكم هذه اللعبة؟
تتشكل دلالات رواية (جمعة القفاري ـ يوميات نكرة) المحتملة عبر عنوانها الذي يومئ إلى فكرة البحث عن شيء ما وعلى السارد والقارئ أن يكتشفا كنه هذا الشيء.
ولنحاول إجراء حوار مع النص على سبيل المثال حيث يقبع فيها المجهول الذي لا يخلو من أمل مراوغ، والطريق محنة عليه خوضها وتجربتها، والبحث قدر لا فكاك منه، ويظل العالمان متمثلين ومتواتيين ومتجاذبين في دواخل وعي جمعة القفاري في سلوكياته، يحركانه ويتحكمان في صوغ رحلته وما يكتنفها من تفاصيل ترك جمعة القفاري عالم المدينة العزيزة الحرة:
(نعم. أنا جمعة القفاري "ماغيره" الذي عاش طوال حياته في عمّان الغربية لم يغادرها إلا في سفرات سياحية إلى أوروبا أو للعلاج في أمريكيا. نعم أنا نكرة، نعم أكاد أسمع أبا حيان التوحيدي يقول: "ما أقل حياءك وما أصلب وجهك وما أوقح حدقتك!) لماذا؟ لأنني صريح وأعترف. نعم بوسع الإنسان في الأردن أن يولد في عمّان الغربية ويموت فيها دون أن يكتشف مجاهل "جبل النظيف" الذي تحتاج شوارعه إلى حملة تنظيف ولا جبل "النزهة" الذي لا يصلح للنزهة.
لحظة التكليف ثقيلة مفعمة بالظلمات، والجنة تنسحب إلى نطاق الذكرى يخلفها الإنسان وراء ظهره متحسراً فتبدو مثل مدينة الأطياف مغروسة في حلم الخريف، ينتقل جمعة القفاري من عالم "فاتنة عبد الكريم" البهيج اللامسؤول إلى أرض عمّان:
(قالت ان اسمها فاتنة "حاف" حتى الأن. وحين تقابلني سوف تطلعني على اسمها الكامل. ارتعشت سماعة الهاتف في يدي وثار في أعماقي فضول حب المغامرة والاكتشاف وقلت في نفسي : لعل الحياة ستيسر لي مسألة تكيفي مع نفسي وتأقلمي مع المجتمع. لكن احساسي المزمن الغمض الخفي بالخطر ثار مرة أخرى:
قلت متردداً:
ـ لأقابل من لا أعرف اسماءهم كاملة.
قالت بعد أن أرسلت زفرة استنكار:
ـ فاتنة عبد الكريم. .
سبق لساني غريزتي وعقلي فقلت بلهفة من يتطلع إلى التكيف:
ـ موافق).
هذه طبيعة الأرض التي لا تعرف النعيم اللامسؤول بل تضج بالعمل والعرق والتكيفات الثقيلة على البدن والروح. لقد آن لأدم أن يعرف معنى الأرض ويشتم رائحة العرق بعد أن عاش بين ثمار الجنة وريحها الطيبة، يتغير المكان مؤذناً بعالم جديد على جمعة القفاري، عالم لم يعهده من قبل.
ويُبرز السرد مقارنة شديدة القسوة بين العالمين ليدرك القارئ أن ثمة تكليفاً ومعاناة هما سمة "جمعة القفاري يوميات نكرة" الذي لن يكون ناعماً نعومة الجنة، ولينتبه القارئ إلى أن النعيم يعرض السرد بينما المحنة أصل تجربة السرد وتجربة الحياة كليهما:
(دارت عيناي في المكان، ثمة شاب نحيل الظل معروق العظام يجلس إلى جانب فتاة أشبه ما تكون بعروس حلوة. إنه لا يستحقها. انهما لا يتبادلان الحديث. هي تحتسي الشاي بأناقة وهو يدخن بعصبية وشراهة، لقد قالا كل ما يمكن أن يقال في الشهر الأول من حبهما ... ثم استسلما للصمت.
اعتقد جازماً أنك لست بحاجة إلى أن تكون وحدك حتى تشعر بالوحدة.)"7".
اقترن عالم عمّان بالعمل وبذل العرق إيذاناً بالمهمة الصعبة التي سيقدم عليها جمعة القفاري الذي لم يعرف عملاً جاداً في عالمه الفائت المفعم بالنعيم. تقتضي طبيعة الأرض العمل بينما لا عمل في الجنة إلا تكرار السعادة. رحلة البحث تقتضي الجهد والعرق. والعمل هو أول ما كُلف به آدم عند نزوله إلى أرض المحنة والبلاء:
(نعم. أنا جمعة القفاري النكرة في عصر لم يعد فيه عمالقة. من كان آخرهم ؟ ديغول؟ ما وستي تونغ؟ طارق مصاروة كتب في إحدى الصحف المحلية عن نهاية عصر العمالقة. المهم انني عاجز عن التكيف والتأقلم لأسباب عصية على الفهم .انني لا أنسجم مع ذاتي فكيف انسجم مع المحيط؟)"8".
ولكن أين هو ذلك الإنسان؟ أين هو ذلك المعنى الذي يبرر عناء الحياة؟ يبحث النص عن الحقيقة التي تبرر محنة الوجود على الأرض، يبحث عن المعنى الذي يحرك مسير الإنسان ومسير تاريخه، يبحث عن الهدف الذي يتصور الإنسان أنه ينتظره دائماً في نهاية كل طريق يخوضه ويتساءل عن الشيء أو اللاشيء الذي يكلف عبئاً مضنياً في رحلة حياة إنسان تشكلها بالضرورة فكرة "البحث" وفكرة "خوض طريق ما" .
وفي سياق البحث عن ذلك المعنى أو الجوهر ينفلت السؤال :
(ومضى في خاطري تساؤل: هل هذا العالم عصي على فهم كل الناس أم أنه عصي على فهمي أنا فقط؟)"9".
ولنلاحظ أن السؤال لا ينفي المسؤول عنه بقدر ما يثبته. لم تكن رحلة البحث مقتصرة عل البحث عن الناس، بل امتد البحث ليشمل العالم ومن ثم هي رحلة بحث عن الذات والكينونة أيضاً. كان جمعة القفاري على حد تعبير الراوي يعيش في عصر ما قبل الانفتاح الاقتصادي، وكان عليه أن يكتشف بالتجربة أن ثمة تدبيراً يعلو فوق إرادته وثمة قوة تعلو فوق السرد الذي يخلقه ويحدد خطواته فوق "جمعة القفاري يوميات نكرة". يسعى النص في مستوى منه إلى أن يكون طريقاً للوطن ودائماً كان الطريق إلى الوطن محفوفاً بالمخاطر والألم. يقتضي الطريق الوجع والوجع يتجسد في صورة الماضي الذي يتجذر ويتمدد في الإنسان عندما يصعب على الإنسان أن يكون شيئاً أخر غير ماضيه، هنا تبرز شخصية "فاتنة عبد الكريم" محنة إغواء كبرى في سياق البحث عن المعاني الغائبة وبوصفها امتداداً لعالم "فاتنة" المثير للفضول والشك والانفلات والتأجج. أوغل النص أيضاً في السؤال عن النوازع الإنسانية التي يحركها ارتباط الإنسان بنشأته وحياته الأولى وصعوبة التمرد على التاريخ الشخصي للإنسان. لكن الرحمة تتمثل في أن طريق جمعة القفاري لا يمثل الطريق الأوحد ولا ينخلق السرد في معابر الطرق عند احتمال وحيد وتلك بشارة القارئ.
علينا أن نعاود السؤال: "هل ثمة قانون يشرِّع لعبة الوصول إلى المعنى المحتل؟ بمعنى أخر: هل ثم عناصر تشكيلية تتضافر وتطرح احتمالات المعنى في نص "جمعة القفاري ـ يوميات نكرة"؟ للإجابة عن السؤال يجدر بنا مناقشته بعد أزمة الفكر السياسي العربي ـ أزمة التطور وأزمة الوعي التي يمكن استثناؤها من شخصية القفاري في رواية "جمعة القفاري ـ يوميات نكرة" فالراوي انفتح في سرده على توصيف الحالة العربية وأزمة الفكر في بلداننا وحاول تفسير هذا التراجع المتواصل في اوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كيف نفسر هذه الهزائم المتكررة السياسية والعسكرية والفكرية؟ وكيف نفسر هذا التفكك الذي يصيب بلداننا ومجتمعاتنا ويصيب العلاقات فيما بينها؟ كيف نفسر هذه الظاهرات التي تنتشر مثل الفطر في حياتنا فتعرقل فعل الإبداع ودورة الإنتاج وتربك حركة التطور وتعطل دور العقل أو تكاد؟ كيف نفسر هذا الضمور في دور الأمة العربية ذات الحضارة الفائقة الغنية التي تمتد عميقاً في التاريخ وتنتشر في أرجاء واسعة من المعمورة وتمتلكها وتملك مخزناً من الثروات يتراجع حجمه ودوره وناتجه في شكل متواصل وبمقاييس مذهلة؟
كيف نفسر كل هذه الظاهرات وهذه الأحوال والأوضاع القديم منها والجديد والمتجدد؟
الراوي حاول الإجابة عن تلك الظاهرة بفعل روائي يستقرئ حال الأمة العربية عبر استذكارات تاريخية فيستلهم من أدب التراث إجابة ما لهذا الحال:
(سيقولون هذه الرواية تقليد فاشل لرواية "السندباد" في "الف ليلة وليلة" أو إن شخصية نعمان العموني تحاكي لشكل مبتذل شخصية دون كيتوث أو عون الكياشفة ولكن .. " " أراهن أن احداً من النقاد لن يقرأ رواية نكرة مجهول مثلي. هذه احدى ايجابيات كوني نكرة)"10".
ولكن هذا التوصيف للنكرة يتجلى في صورة أزمة، وتشير إليه هذه الأسئلة الكبرى، ولا ينحصر في الفكر وحده بل هو توصيف يشير إلى عمق الأزمة في الوعي وعي النخب الفكرية والسياسية ووعي الأحزاب والوعي الجماعي الشجي والفكر، هو بالتعريف انعكاس للواقع. ولكنه يتجاوز هذا الواقع أحياناً في محاولته استشراف المستقبل.
(حدث جمعة كثير الغلبة عن مشروعه الروائي الذي لم يكتبه فقال وهو يشرح بيديه ولسانه:
"نانسي تقرأ بنهم عن تاريخ الأردن المعاصر وتشكو من أن المصادر عزيزة نادرة. ونعمان العموني يقرأ "محمد عابد الجابري" ويقول ان محمد عابد الجابري يؤسس للنظرية التي سيبلورها هو. ونانسي تأخذ وجهها بين يديها مستاءة ترجم النعمان بالتهم وهو يسترق النظر إلى شاشة التلفزيون ويشاهد شباب الأرض المحتلة يرجمون الجنود الإسرائيليين بالحجارة فيشبك ساق بساق والسماء ترجم الأرض بمطر غزير لأن النعمان عاجز. هل تفهمني؟)"11".
إن صورة العالم التي صدرها الروائي الذي نعيش فيه آخذة بالتفكك والانهيار على نحو شرس وفاجع، ولئن كنا بحاجة إلى ان نبتكر له صورة جديدة فإن ذلك لن يتحقق إلا إذا اعطيناه معنى جديداً. ويبدو أن البحث عن هذه الصورة ضرورية وملحة أكثر من أي وقت مضى خصوصاً في هذا المفترق الحاسم في زماننا حيث ينتهي عصر ويبدأ عصر آخر، إنه المفترق الذي يوصل المبادئ والنظريات التي استلهمناها إلى نهاياتها والذي يكشف لنا بشكل واضح أن مؤنس الرزاز في روايته "جمعة القفاري ـ يوميات نكرة" ينطلق من الواقع المرئي والمحسوس ليبتكر ذلك المعنى وفقاً لرؤياه الخاصة وتجربته الخاصة، وهو يبتكر بوجع ينجس من الواقع الإنساني عائد إليه الوعي هنا بشمول وإحاطة النظر في الأشياء. هكذا تحتضن الرواية أفقية العالم. من أجل أن يحسن الهبوط أعمق فأعمق في عموديته . "إنها " إنسانية كونية، إنسانية الحضور البشري حيث الإنسان كل لا يتجزأ ماضياً حاضراً ومستقبلاً.
هكذا تتألف الذات والآخر وتتعانق الهوية والذات. وليست رواية "جمعة القفاري ـ يوميات نكرة" هنا وسيلة أو أداة، إنها وسيلة في كشف أوسع عن جمال الحياة في تحويل الحياة إلى رواية.
الهوامش
1 ـ انظر: ألن هاد: النظرية النقدية مدرسة فرانكفورت ت: ثائر ديب، القاهرة، المركز القومي للترجمة 2010، ص 181 ـ 178
2 ـ انظر "موريل: النقد الأدبي المعاصر : مناهج اتجاهات ققابا ث إبراهيم لحيان ـ محمد الزكراوي القاهرة. المركز القومي للترجمة 2008 ص 127
3 ـ ألن هو مرجع سابق ص 176.
4 ـ انظر مؤنس الرزاز رواية جمعة القفاري يوميات نكرة ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1990 .
5 ـ مصدر سبق ذكره ص 5 .
6 ـ مصدر سبق ذكره ص 23 .
7 ـ مصدر سبق ذكره ص 25 .
8 ـ مصدر سبق ذكره ص 7 .
9 ـ مصدر سبق ذكره ص 51 .
10 ـ مصدر سبق ذكره ص 141 .
11 ـ مصدر سبق ذكره ص 82 .
سالم النحاس
أنت يا مأدبا وتلك الأيام
"موازيك اجتماعي ورؤية
تعبيرية جريئة"
لا يحجب الغربال نور الشمس... هذه "الحقيقة" محيرة.
أعتقد أن "الحقيقة" غرقت في بحار الضلال والتضليل، فإذا هي في الأفق الأبعد تشير إلينا ببريق ضيائها.
الضلال يصنع الظلام، والخداع بنشر الغيوم السوداء، فنضل عن الاتجاه الصحيح ونمتطي اليأس إلى الانحراف أو الاستسلام، ونستكين إلى البلاء الأعظم، ونهاجر من جلودنا إلى وطن الاستغراب، ونعتقد أننا سنظل منفيين عن أنفسنا إلى الأبد.
هذا ما عرفته من طيات ما كتبه الروائي والشاعر والسياسي بحكم العادة سالم النحاس في نصه الرائع "أنت يا مأدبا وتلك الأيام" الصادر عام 1993.
النحاس يكشف عن حالنا اليوم في "أنت يا مأدبا وتلك الأيام" ويتساءل في رؤيته الإبداعية: هل نحن سيئون إلى هذا الحد؟ هل ما يكوِّن ذاتَنا الثقافية والحضارية يتناقض مع الحضارة الإنسانية؟ هل يجب أن نتعرى من نفوسنا لارتداء أثواب مستوردة يحاولون إقناعنا بأنها الثقافة وأنها الحضارة وأنها العصرنة وأنها المستقبل؟
تستحضر هذه الأفكار التي طرحها النحاس في نصه الإبداعي في محاكاة ما ذهبت إليه الثقافة الغربية التي تناولت المدن الصغيرة في أدبها بإيحاءات وإشارات بالضحالة الثقافية والكبت الاجتماعي، وهما سمتان متلاصقتان في الأدب الغربي والشرقي على حد سواء، فعندما نشر جو ستاف فلوبير رواية "مدام بوفاري" عام 1957 كانت مدينة روان ـ وهي مسرح غراميات إيما بو فاري ـ مركزاً إقليمياً هاماً يحوي مئة ألف نسمة، وهو تجمع بلغ في ذلك الوقت ضعفي عدد سكان ستراسبورغ وثلاثة أضعاف سكان مدينة جرونو، بينما كان ذلك يشكل عشر سكان باريس العاصمة فقط "1" .
وبالرغم من سعة المدينة حينذاك نرى أن تنشئ علاقة غرامية مع عشيقها الثاني المحامي ليون مما اضطرهما إلى استئجار عربة حوذي مغلقة للتستر على خلوتهما"2" .
تزورنا الحالة البوفارية في عالمنا العربي من خلال بطلة حنان الشيخ في "حكاية زهرة" حيث نشاهد هروب زهرة إلى بيروت من قفص زوجها الذي فرضته عليها عائلتها قبل مغادرة بلدة كانت تقطنها في غرب إفريقيا.
وفي بيروت تكتشف خلاصاً ونشوة مغتربة في جحيم الحرب الأهلية في علاقة شيقة عابثة مع أحد القناصة خلال الحرب الأهلية اللبنانية"3".
القاسم المشترك لهاتين الشخصيتين هو البحث عن حالة المجهولية والتستر، وهي مجهولية لا يمكن الحصول عليها إلا في حيز المدينة الكبيرة الخافي والمتخفي. نجد تحليلاً لطبيعة هذه المجهولية في أعمال ريموند وليامز حيث يعّرف الشروط الحضرية المطلوب توفرها لانبثاق الحداثة في أحشاء الثقافة التقليدية، ومن هذه الشروط: اندحار "العلاقات الطبيعية" التي تقترن في أذهاننا مع الحياة الريفية، اكتشاف الذات لإنسان تحت ظروف العزلة "غموض حياة المدينة" واستحالة سبر غورها، انبثاق فكرة "الجماهير" بمفاهيم العصبيات الاجتماعية الجديدة، وأخيراً "الحيوية والتنوع غير المحدود والحراك السريع" الذي تمثله أجواء المدينة"4" .
وفي نفس السياق يتحدث جونثان ربان عن الانسيابية في الأنماط السلوكية عندما تنعتق من أغلال القيم التقليدية في العوالم السحرية للحداثة الحضرية"5" .
والممكن للمرء أن يقرأ في هذا الوصف الأخير والمبالغ فيه حالات من الإنارة السلبية لثقافة المدينة الصغيرة، بمعنى أنه يقوم بتوضيح ما هو مفقود من أجوائها. وهذا ما فعله النحاس في الكشف عما هو مفقود في "أنت يا مأدبا وتلك الأيام"، ويتجاوز الحالة البوفارية في الغرب والحالة اللبنانية من خلال بطلة حنان الشيخ في "حكاية زهرة" كما أسلفنا سابقاً وقد أبدع نموذجاً أردنياً خالصاً قائم على الزعزعة الاجتماعية التي يحدثها الوعي المدني وتشمل هذه الحالات الاختلال في السلوك القيمي، والاغتراب الفردي والاجتماعي، وتفتت الوعي الحضري. وثاني ما ذهب إليه النحاس هو انبثاق إمكانيات متحررة في السلوك الفكري والاجتماعي تشمل العمل الثوري الجماعي والإبداع الفني والتمرد والتسامح، ما هو مستهجن اجتماعياً، والسلوك غير المنضبط كما هو الحال مع مدام بوفاري بين كل هذه الاحتمالات، يتواجد واحد منها فقط في البلدة العربية المعاصرة وهو بروز الثقافة الجماهيرية والحركات الشعبية التي تخلفت فيها وسائل الإعلام والأنماط الاستهلاكية ذات الطابع المعولم"6" .
في هذا المجتمع نشهد هيمنة الشعور العارم بالمحلية على نسيج الحياة اليومية، والسيطرة المستمرة لشبكة علاقات القرابة، وبالإمكان إضافة أن هذه العصبيات المحلية وأنماط السيطرة الاجتماعية المصاحبة لها نجدها أيضاً في أحياء المدن الكبيرة في معظم بلدان العالم الثالث، وهذا ما ذهب إليه النحاس في "أنت يا مأدبا وتلك الأيام" :
(لماذا سميت بهذا الاسم؟
لأنها أقرب الكنائس العامرة إلى مكان حادثة القطع.
من الذي أخبره بذلك؟
أحد أفراد طلبة اللاتين.
هل هو لاتيني؟
لا .إنه أرثوذكسي.
ماذا يقال عن الأرثوذكس؟
إنهم بدو المسيحيين.
هل الأستاذ سامي ارثوذكسي؟)
نرى هنا كما نرى في البلدات الصغيرة توظيفَ الترابط بين"الرصد الاجتماعي" والنميمة، بحيث يؤديان هدفين مزدوجين: فمن ناحية هناك هدف تعزيز التضامن العصبوي ضد" الغرباء"، ومن ناحية أخرى خبط الانحراف السلوكي الذي قد يخرج عن القيم السائدة.
وأفضل من استوعب ظاهرة المدن الريفية هو عالم الآنسة كليفورد جيركز حين صاغ هذا التعبير في إشارة إلى التغير الحديث في بلدة حفرو المغربية: (كانت المدينة تلتهم الريف من حولها والأن يقوم الريف بالتهام المدينة)"7".
ولا شك أن هذه المعادلة يتم تكرارها اليوم في معظم أنحاء العالم العربي، إذ إن العلاقة الاستغلالية التي عرفت تاريخياً روابط الريف مع المدينة والمبنية على استحواذ الفائض الزراعي من قبل رأس المال التجاري الحضري، وشريحة الملاكين الغائبين عن الأرض، تشهد اليوم صورة مغايرة تماماً، فالمراكز الإقليمية للارياف يجتاحها يومياً آلاف المهاجرين الريفيين بحثاً عن الرزق ومستقبل مغاير لأبنائهم، مصطلح "ترييف المدن" لا يعبر فقط عن الثورة الديمغرافية الجديدة ومحاولة إعادة صياغة تعريف ثقافة المدينة بل هو أيضاً التعبير السياسي لاندحار الترتيبات السياسية الهرمية السابقة والامتيازات الطبقية المغلقة، وهو يدل على دخول الجماهير الريفية إلى عالم المدينة.
وعلى الرغم من التحليل التجديدي المثير الذي يقوم به سالم النحاس لوصف السلوك المعياري للإنسان العربي الأردني إلا أن هناك بعض الجمود والكثير من الذاتية المغرقة في خلاصاته:
(كان يقف مع أخرين في حلقة .. دار خوالهم
ـ كيف فطنت لتسجيل ابنك؟
ـ لعبة لم تخطر بالبال
ـ فطزت؟!
ـ المختار يا عم لا يرفض لك أي طلب
ـ اطعم السن تستحي العين
ـ نحن أضعف من الحكومة والقمح هة.) ص "8"
وعلى الرغم من الثغرات فإن تحليل سالم النحاس حول أهمية السلوك التلقيحي الهجين وما يتوافق مع ذلك من تضامن قبلي خانق يعتبر نموذجاً لائقاً لتفهم الدينامية الثقافية في المدن الصغيرة للمشرق العربي، وعلى الرغم من الادعاءات اللفظية بالتساوي بين الجميع ظاهرياً إن كان ذلك على صعيد الرجل والمرأة أو الصغار والكبار أو الأغنياء والفقراء، إلا أن كل واحد من هؤلاء يعلم تماماً موقعه، وان لم يفعل ذلك فلأن هناك وسائل لإرغامه على إدراك ذلك.
وعلاوة على ذلك فإن الظهور المتواصل والتواصل بين الناس يمنحان هذه المدن جواً من التضامن والألفة الحميمية بحيث يصبح من المحال أن يتخفى أي كان في عالم خاص به، وفي هذا السباق فإن النقيض للتخفي لا يكمن في الاعتراف الاجتماعي كما قد يبدو الحال عليه لأول وهلة، بل فيما يصفه النحاس في الخشية من العزلة، ويتم التعبير عن هذه الخشية من خلال الحاجة الدائمة للتفاعل الاجتماعي مع ما يقترن بذلك من رقابة على السلوك الفردي المستهجن على الصعيد العام.
(أصبح شغله الشاغل مراقبة سيقان النسوة بدت له ملساء لامعة مشربة بالحمرة، كان يغتنم أية فرصة ويدقق النظر إن رأى إحداهن، وحين يتعب ينفلت الى ساحة الحارة، ولكن لا يلبث أن يشعر بالضيق ويختنق بضجيج الأولاد فيرجع إلى مكان هادئ يرى منه النافذة المثقوبة ويحلم: باطن فخذها يعلو وينخفض ببطء كأنه يتنفس، وحين " يتزعن العقيد" تتأوه: تتشنج الشمس وتزوغ الأزقة وتميد المنازل يخفض عينيه ويبتلع ريقه ويتحاشى الايكُح مخافة أن يُسمع صوته الطارئ"9".
وبالمقابل فإن المدن الساحلية شكلت منذ مطلع القرن العشرين مركزاً للطبقات التجارية وأصحاب البيارات وما ترافق مع ذلك من الحاجة إلى العّمال المقتلعين من جذورهم إلى جانب الملاحين وصيادي الأسماك، كما كان هناك المضاربون على بيع وشراء الأرضي والمبادرون إلى المباشرة في المشاريع الصناعية مع عملية شق السكك الحديدية وسط انتشار الموجات الداعية للديمقراطية والاشتراكية ذات الطابع العلماني.
ويضاف إلى ما سبق أن هذه المدن جنت ثروات جديدة تم توظيفها في مشاريع انتاجية مثمرة أدت إلى بروز البذخ في الاستهلاك، وتمثل ذلك في تشييد البيوت الفخمة واقتناء السيارات الفارهة إلى جانب انتشار المطابع والصحف اليومية والنوادي الاجتماعية. وبناء على ما سبق فإن الحياة السياسية عكست جملة من المفارقات والنزاعات التي نشبت في هذه المدن ووجدت وسائل التعبير عنها من خلال الأحزاب الوطنية والاشتراكية المتعددة ونقابات العمال وتنوع التشكيلات الإنشائية والأيديولوجية.
إنها ريح التغيير هبت على البلد فاقتلعت الماضي من جذوره وجعلتها مدناً "غبرا" بالنسبة لقاطنيها وجد فيها الروائي سالم النحاس مادة فنية نادرة وأخرج منها عملاً نصاً جريئاً يحمل كل مقومات الأدب الاشتراكي كما يحمل للأسف معظم عيوبه وكلها عيوب التصقت به لأسباب تاريخية ولا محل لها في طبيعة الأدب نفسه، فعمق النظرة الإنسانية لا يتناسب مطلقاً والبساطة التكنيكية. ومن التناقض العجيب أن يغفل المؤمنون بالعلم وبالتخطيط في حياة المجتمع قيمة التخطيط وإتقان الصنعة في العمل الفني، ومع ذلك فإن النحاس استطاع التقاط مشاهد اجتماعية تعكس حالات التخلف على الرغم من كل التطورات التي تعرضت لها المدن الساحلية والكشف عن العالم الرغبة المخبوء في عالم الذكورة الذي يبدو أنه لم يتعرض لأي تطور وبقي على حاله:
(كان ملقى على الشاطئ خائر القوى مبللا كالجديلة المغسولة في وهج الشمس. النسوة حوله صامتات. يجلسن في قاع الدار. تتوزع نظراته بين الجدران و"سيقانهن"، فهن وتنحسر عن صدورهن بقايا لهاث خافت مجهد: وهي تنكمش بعيدة في الركن تدير ظهرها للجميع وتنتحب بمرارة)"10".
هذا الاقتناص الذي قام به النحاس يعبر عن رؤية اجتماعية عميقة فاصلاً بين ما حدث من تطور في تلك المدن والرغبات المشروخة التي ما زالت تتعامل بعقلية القنص والافتراس من قبل الذكر للأنثى، هذا الفصل بين ما هو قيمي واستهلاكي يعكس حالات التشويه التي تعرضت لها المدن العربية سواء منها الساحلية والصحراوية والتجارية، فالمقصود بالتشوية هو اختلاط القيم بين ما استهلاكي أني يفضي إلى الاستخدام اليومي كإغناء للغريزة، أو ما هو قيمي يفضي إلى السمو ولا يصلح للتوظيف اليومي لكنه يفيد الإنسان على صعيد منظومته الأخلاقية التي تساعده على التواصل الإنساني مع تفاصيل الحياة بشكل معقول ومنطقي، وهناك فارق واسع بين ما هو غرائزي ورغبوي وما هو أخلاقي يدفع الإنسان إلى إعلاء قيمة الأخلاق المتساوية مع طبيعته.
تكشف أوراق سالم النحاس، بعد أن رتبها الراوي وبوبها، عن رواية من نوع كان في معرض معالجة الرواية التقليدية يسميها رواية التربية والتنشئة، وفي هذه الحالة تنشئة أديب ثم فنان سينما، يلعب بالصورة ثم الكلمات، يجربها يلتقط شواردها بحيث يضطر الصوتان المتحاوران إلى الرجوع إلى لسان العرب لتقصي المعنى في بعض شوارده.
وفي هذه السيرة إضافة إلى الرواية العبور إلى الغرب، وباريس بالذات التجربة التي سجلها الروائيون العرب مشارقة ومغاربة كمرحلة حاسمة في تنشئة بطل الرواية/ الكاتب الفنان وتحديد هويته، من توفيق الحكيم إلى سهيل إدريس إلى عبد الله العروي وغيرهم، على أن هذا الأخير لا يقدم مادة روائية في سرد تقليدي يقوم على التراتب الزمني البسيط كما نرى في "عصفور من الشرق" و"الحي اللاتيني"، فالأصوات المتعددة المتحاورة والمتنافرة والشدادات والقصاصات المجمعة من هنا وهناك تنعكس على ذهن القارئ في شكل موازييك أو مجموعة من الأحجار بألوان مختلفة يبرق كل منها على حدة، وتكون مجتمعة شكلاً فنياً مكتملاً ومبهراً حقاً، هكذا تحديداً فعل سالم النحاس في نصه "أنت يا مأدبا وتلك الأيام"، والتعبير الذي سعى له صاحب السيرة النحاس الذي لا نعرف كيف نسميه في الرواية الحديثة لأن صفة البطل: بطل الرواية بطل الفيلم أو المسرحية، لا تنطبق عليه، فهو مثله مثل غيره من الشخصيات المحورية في الرواية الحديثة لا يحقق بطولات أو مكتسبات مادية من ثروة أو منصب ولا ينقذ الفتاة العذراء من محنة ولا يتزوج بنت الوزير ولا ابنة صاحب المصنع، هدفه هو الرؤيا والتعبير، وهذا ما فعله سالم النحاس في نصه "أنت يا مأدبا وتلك الأيام" عبر عن موازييك مأدبا التي أخذت ثوب التاريخ تارة والتحرر الاجتماعي تارة أخرى بتقنيات الحداثة أو الحساسية الجديدة.
الهوامش
1 ـ حسب ما ذكره جوليان بارنس انه بعد انقضاء عام على نشر رواية مدام بوفاري دخلت تقليعة استخدام مقطورة العربات المجرورة بالخيول لممارسة البغاء في هامبورغ، وكانت هذه المقطورة تسمى بوفاري جوليان بارنس أو ببغاء فلوبير.
2 ـ سليم تماري ـ المدن الصغيرة وثقافتها القامعة ـ ص118 دراسات
3 ـ تقوم زهرة شأنها شأن يما بوفاري بالانتقال إلى بلدة صغيرة في ضواحي العاصمة "ابيدجان على الأرجح" بصحبة زوجها الجديد ماجد "رواية حكاية زهرة ـ حنان الشيخ"
دار الأدب بيروت ص 42 .
4 ـ مصدر سبق ذكره ص 179.
5 ـ مصدر سبق ذكره ص 179 .
6 ـ أنت يا مأدبا وتلك الأيام ـ سالم النحاس ـ ص 22 ـ 1993 .
7 ـ مصدر سبق ذكره ص 179 .
8 ـ مصدر سبق ذكره ص 38 .
9 ـ مصدر سبق ذكره ص 30 .
10 ـ مصدر سبق ذكره ص 32 .
سميحة خريس
"يحيى .. صورة التاريخ المذكر برؤية نسوية"
لماذا الاتجاه التاريخي؟ أو لماذا هذا الاتجاه متضمناً النزعة الإنسانية؟
الإجابة أنه على الرغم من الأهمية القصوى له في هذا العالم .. غير أنه لم ينل اهتماماً كبيراً على المستوى الثقافي، وبالتبعية لم ينل اهتماماً كبيراً أيضاً على المستوى الأدبي عامة والروائي منه على وجه الخصوص.
ويمكن القول: إنه لا يمكن فصل الذاتي عن الموضوعي في أي نص أدبي، ومن هنا من الصعوبة أن نتمثل هذا بمثال أو اثنين، فبقدر الصعوبة التي تواجه المتلقي حين يبتعد عن السياق يكون اقترابه من السياق العام للنص وفهم خطابه العام في الوعي أي فهمه والوثوق به.
فلنتمهل أكثر عند تمهيد نظري قبل أن نصل إلى فضاء النص عبر النموذج الذي انتقيناه هنا كمثال من الرواية التي كتبتها امرأة من الرواية المعاصرة.
وسوف يكون من السهولة أن نستبدل بالموضوعي الواقعي، في حين أن الذاتي يظل يراوح مكانه بين المثالي والرومانسي معاً فيدفعنا للانتباه إلى أننا حين نتحدث عن الموضوعي والذاتي نكون قد قصدنا الواقعي والذاتي في فضاء الرواية.
إن الواقعي أو الواقعية"1" هنا ليست بالضرورة فعلاً يحدث خارج الفكر فيعبر عن تكوين يتحول مع المرأة، بل هو الوعي الذي يتكون في مرآة الفنان أو الكاتب فيعبر عن تكوين يتحول مع المرأة التي هي ذاته إلى شيء حميمي ومعكوس عن الخارج، فالواقعية ليست هي بالضرورة انعكاساً للخارج، بل هي الوعي ذاته حين يتأثر بخارجه فيكونان معاً التعبير الدلالي لدى الكاتب.
ومن هنا نستطيع أن نقول: لا يوجد الأديب خارج الواقع، بل هو داخله بعد أن يصبح جزءاً منه تابعاً له في وعي الروائي.
ونستطيع أن نعيد نحت المصطلح باسم "الواقعية الذاتية" التي هي: امتزاج الواقع بعد تبلوره بالذات ليصبحا معنى واحداً لا يمكن الفصل بينهما لتصبح الدلالة الفنية حصيلة ما يعبر عنه، وإذاً فالواقعي هو المعرفة، والذاتي هنا هو التعبيري.
وهذا يعني في هذا السياق أن مشاعرنا الذاتية لدى المبدع/ المبدعة إنما تترجم الواقع في سياقه الشامل الجزئي العام لا الخاص، وذلك عبر "مصفاة" الوعي الذاتي وبعيداً في الوقت نفسه عن المثال، وهو ما يلتقي مع وعي ناقد مثل لوسيان جولدمان في البنيوية التكوينية"2" حيث يركز كما سنفعل هنا على النص أولا "الواقع في سياقه العام" ثم صاحبة هذا النص "الذات في سياقها الخاص" وهو ما سنقترب إليه مع تجاوز النظري إلى التطبيقي "في الفضاء الإنساني" عبر نموذج رواية (يحيى)"3" للروائية سميحة خريس.
وهذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نتعامل مع الحدث الواقعي بعزله عن الكاتبة، فالكاتبة الحاضرة لا يمكن أن تصبح كما تردد بعض المدارس غائبة خارج النص، والذاتي هنا لا يمكن إغفاله في السياق العام، إذ إنه يشكل في النص الروائي ملحمة ذاتية تنتمي إلى الذات الإنسانية المنطلقة من أسر الجغرافيا.
وعبوراً فوق تعريفات كثيرة للرواية فمن المفترض أن نجد في كل نص روائي الاثنين معاً: الواقعي والذاتي في الدلالة الإنسانية، وهذا ما سنحاول العثور عليه في هذا النموذج الذي بين أيدينا.
ولكن قبل الدخول في هذه التفاصيل يطرح القارئ المتأمل في هذا العمل الروائي كثيراً من الأسئلة من مثل الأسئلة الآتية:
ما المظاهر الواقعية السياسية والاجتماعية لهاجس الحرية في هذه الرواية؟ وما أصالة رؤى الكاتبة المتصلة بهاجس الحرية؟ وما قيمة تلك الرؤى؟ وما الإجراءات الجمالية التي اتخذتها الكاتبة في التعامل مع هاجس الحرية؟
إن رواية "يحيى" تتألف من ستة فصول وخاتمة، وهي على التوالي: جلجول، والتيه، والمحروسة، والكرك، والفيحاء، والزلزلة، و"يحيى" سميحة خريس وغيرها من المطولات الروائية العربية تسهم إسهاماً كبيراً في أصل الفن الروائي في الأدب العربي .
وبالرغم من كون هذه الرواية تنتمي إلى ما يمكن أن يسمى"الأدب التاريخي" الذي بدأ به عبد الرحمن منيف في أدب الخليج الذي أعاد صياغة الرؤية الفنية والفكرية لتاريخ الخليج العربي، فإن سميحة خريس في روايتها هذه تعنى بهاجس أعمق من الهاجس الذي شغل به عبد الرحمن منيف في روايته وهو هاجس الحرية، فإذا كان عبد الرحمن منيف قد عني بهاجس الحرية السياسية فإن سميحة خريس قد عنيت بإشكالية الحرية سياسياً واجتماعياً وميتافيزيقياً، وهو ما يضفي على عملها طابعاً فكرياً عميقاً.
المظهر الاجتماعي لهاجس الحرية
ويتراءى لنا هذا الهاجس من خلال الضغط العائلي والضغط الاجتماعي على بطل الرواية "يحيى" الذي كان يعاني من المراقبة الصارمة من قبل عائلته ومجتمعه المحلي كانت تراقب حركاته بدقة متناهية وتعاتبه بصرامة عندما يتجاوز تعليماتها ومجتمعة يكاد يكون صورة طبق الأصل عن "أحمد عبد الجواد" في ثلاثية نجيب محفوظ، ولعل الشيء الوحيد الذي يجعله يختلف عن "عبد الجواد" هو خروجه من مجتمعه المحلي إلى العالم.
إن "يحيى" يضيق ذرعاً بتلك التعليمات والقيم المثالية التي كانت تفرضها تقاليد المجتمع الذي يعيش بين ظهرانيه، ولذلك تراه يجنح إلى التمرد وكسر جميع القيود التي تكبله، ويخرج خارج هذا المجتمع الذي يعتبر ضيق الأفق. وإن كانت سميحة خريس بدأت ترسم ملامح تمرد "يحيى" منذ طفولته ((يا مخبوله.. ألم تبلغي بعد!! لماذا إذاً تكور نهدك مثل امرأة؟؟...
ترتمي هفوف على ظهرها ضحكاً:
ـ لأغيظ بهما الحساد.
تقهقهان بمجون والصبي الصغير ينظر سعيداً ثم ينفرط مشاركاً إياهما الضحك))
لم يكن "يحيى" مدفوعاً إلى ممارسة هذه التجارب المحرمة اجتماعياً وغريزياً بقدر ما كان مدفوعاً إليها رغبة في الاستقلال عن وصاية مجتمعه وإن تجلت صور التمرد منذ نعومة أظافره وكان يحس بوطأتها وتشرنقها حوله ورغبة في اكتساب خبرات حياتية يعتقد أنها سوف تخرجه من زمرة الأطفال المراهقين السذج وتدخله في زمرة الرجال.
وإذا كانت سميحة خريس لا تدفع "يحيى" إلى التعبير عن غبطته واعتزازه بخوض غمار هذه المغامرة الخطيرة فإنه يعبر عن ذلك تلميحاً بأسلوب غير مباشر من خلال الموقف الذي يستقبل فيه "عيسى"؛ ((انتبه عيسى لتلك العلاقة الوثيقة واكتفى بالهمس برزانة:
ـ يا بنت اتركي الولد في حاله، لا تسخطي رجولته، دعيه يشتد ويصير رجلاً بعد عام أو عامين أو ثلاثة))"5".
إن هذا الموقف كما يبدو بوضوح يفضح أكثر من أي كلام يمكن أن يسوغ سلوك"يحيى" وعبر عن اعتداده بمغامرته التي ستصنع منه في المستقبل رجلاً مهماً يختلف عن تربية "عيسى" الذي يريده رجل على طريقته. كما أن هذا الموقف يعبر كذلك عن رأي "سميحة خريس" ذاته واحتفالها الخفي بالتجربة، وهو ما يتراءى لنا في حرصه الواعي على تنمية هذا "الاعتزاز" في بناء شخصية "يحيى" على امتداد الرواية حتى يغدو هدفاً في حد ذاته بل يغدو فلسفة في الحياة بالنسبة إلى "يحيى" الذي كان في بداية الطريق يحس بشيء من تبكيت الضمير والندم المض جراء خروجه على النهج الذي رسمه له مجتمعه المحلي ولكن ما لبث أن استمرأ تمرده .
وهذا التحول في شخصية "يحيى" يجعله المتمرد الشامل لعالم قريته الصغيرة في مقابل عالم المدينة الكبيرة، وإذا كانت "قريته" التي عاش فيها ترمز إلى البراءة والبساطة والصفاء فإن "المحروسة" وهي القاهرة التي ذهب إليها ليسكن فيها ويستكشفها تعد رمزاً للعالم الجديد المناقض.
ومن براعة الكاتبة في هذه الرواية أنها تتخذ من المكان أداة للإيحاء بموقف "يحيى" من العاملين المتناقضين: عالم "القرية" وعالم "المحروسة" معبراً عن تطور موقفه من قيم ذينِـك العالمين.
إن "يحيى" يحن إلى عالم قريته طيلة أحداث الرواية، ولكنه يكتشف زيف ذلك الحنين عندما يتعرض لموقف خطير.
((أخرج يحيى من الحجرة الجانبية وبالغ الحارس في دفعه ليرضي الشيوخ ويفصح عن هيبته الخاصة، كان الحرس قد أعادوا ذراعيه وراء ظهره إلا أن ماء الوضوء القليل جلل وجهه بالرضا وعلقت قطرات منه في لبدة لحيته الكثة تبرق كحبات ماس غاب عينيه وضم النعاس بل فج من وجهه نور رائق لطيف ألم السياف بالنور في نظرة خاطفة لم يثمنها، غض نظره سريعاً وراح يتسلى بجر سيفه الأزرق الحاد المسنون من غمده وإعادته كأن ما يدور في المكان لا يعنيه وتكوم الساعور في مكانه فزعاً غير قادر على النظر إلى يحيى الذي وقف في منتصف القاعة.
لم يكن يسيراً سماع الكلمات التي تتردد بين شفاه الكركي، فهو يهمس بلطف وتندغم الأحرف في تعالق ويفوه مغمضاً عينيه بكلام مأثور عند المتصوفة:
ـ اقعد في ثقب الإبرة ولا تبرح، إذا دخل الخيط في الإبرة فلا تمسكه وإذا خرج فر اعده، وافرح فإني أحب الفرح وقل لهم : قبلني وحدي وردّكم، فإذا جاءوا معك قبلتهم ورددتُك، وإذا تخلفوا عذرتهم ولمتك فالناس كلهم براء))"6".
إننا نفضل أن ننقل هذه الفقرة على طولها كي نقف على أهمية التجربة بالنسبة إلى "يحيى" الذي لم يعد يثمنها بالمعايير الأخلاقية، وإنما أصبح يثمنها بمعايير علمية ومعرفية وسيكولوجية ذاتية، وكأن السلوك الأخلاقي بالنسبة إليه يستمد قيمته من الذات وليس من الموضوع أو يستمد قيمته من التجربة العلمية الواقعية وليس من المثال، وهو ما يجسد تطوراً كبيراً في رؤى "يحيى" المثقف الذي كان مولعاً بالترحال.
وفي "المحكمة" يعمق "يحيى" اعتداده بالتجربة وهو في السجن يعاني مرارة هذه التجربة فيتخذ منها سبيلاً إلى اللذة والجمال، وهنا يصطدم بالاختلال المنطقي في رؤيته الفكرية، إذ كيف يكون الضلال طريقاً إلى الهداية؟ وكيف يمكن للقبح أن يكون جميلاً؟
ولكنه ما يلبث أن يلتمس تسويغاً لهذا التناقض، سواء في التاريخ أو في طبيعة الذات البشرية، فيكتشف أن ((تبسم يحيى ابتسامة عريضة أجفلت الشيوخ وقطعت أقدام قاضي القضاة فتراجع إلى الوراء يطلب كوباً من الماء ويحيى يجيب ناظراً في وجه التاجي:
ـ الحياة التي أعرف تنقضي لكنها تتحدد كل يوم تولد بثوب تشيب هي ذات الحياة التي كانت وجوهها شتى وأسماؤها مغايرة وجوهرها واحد))"7".
ولعل اعتداد "يحيى" بالتجربة ليس مسّغاً بالميول الحسية والنزوات المدنسة بقدر ما مسوغ بالتوق إلى الحرية لأن التجربة بهذا المفهوم ـ مفهوم "يحيى" تذيب الأنماط السلوكية والقيم المسبقة التي تطوق الإنسان وتقيده وتضعه وجها لوجه أمام الفعل الحر الذي يصدر عن الذات الفردية الواعية.
ويبدو أن سميحة خريس تلتقط خيط هذه الفكرة من الفلسفة الوجودية التي تدعو إلى تحرير الفعل الإنساني من القيم المسبقة، والذي يمكن أن يستخلص من مثل هذه المواقف في رواية "يحيى"، يتصب دون ريب بفكرة التجربة التي بسطنا القول فيها في الفقرات السابقة، فالطريق إلى الحرية كما ترسمه الرواية لا يرصع إلا الفعل الحر الذي ينبع من الذات الفردية ولا يفرض قسراً، والتشدد المبالغ فيه قد يؤدي إلى نتيجة مناقضة للنتيجة المستهدفة.
المظهر التاريخي لهاجس الحرية
وإذا كان هاجس الحرية السياسية أو الاجتماعية يمثل فلسفة الحياة الواقعية المعيشة التي تعد معياراً أساسياً لقياس مدى سيادة الإنسان وحجم كرامته واستقلاليته وقدرته على العمل والفكر والحكم الحر وهو ما رأيناه في الرواية فإن هاجس الحرية التاريخية يمثل القضايا الواقعية التي تتصل بمستقبل الإنسان وإرادته وحدود الكائن البشري المحكوم بالضرورة الحتمية أخلاقياً وفلسفياً وتاريخياً.
وقد طرحت إشكالية الحرية التاريخية في هذه الرواية من خلال "يحيى" الذي يمثل مواقف متباينة في الموقف القومي والموقف الوجودي.
الموقف القومي :
ويمثله يحيى الذي نظر إلى الكون والحياة نظرة إيمانية مؤمناً بِإمكانية الحرية وقدرة الإنسان على أن يكون حرّاً من خلال معرفة طبيعة الضرورة أو طبيعة الحتمية، واصل يحيى قراءة ما خط على لوحات الرخام المتناثرة حادساً أنه سيظل عمره كله يفتش عمّا خط على بلاط الأضرحة وما خفي من حقائق حول رجال مروا ثم ّغابوا في حين بكت مريم وارتفعت نهنهاتها.
قرأ يحيى: ((بسم الله الرحمن الرحيم أنشأ هذه التربة المباركة العبد الفقير إلى رحمة القدير رجاء لرحمة القدير ورضوانه مستشفعاً عنده بجيرانه - " بهادر الملكي - الناصري نائب السلطة المعظمة بالكرك والشوبك المحروستين في ثاني ذي الحجة عام سبعة وعشرين وسبعمائة هجري تجدد في أيام الملك الصالح صلاح الدنيا والدين الملك الناصر محمد في نيابة العالي السيفي نائب السلطة الفقير إلى الله شمس الدين الهورني في اثنين وخمسين وسبعمائة))"8" .
الموقف الوجودي:
ويمثله يحيى أيضاً، في رواية "يحيى"، الذي يفتتن بوهم الحرية منذ نعومة أظفاره فيتمرد على السلطة التقليدية الاجتماعية ولكنه يكتشف زيف تمرده وعبثيته عندما يصطدم بجدران "السلطة" بالمفهوم الميتافيزيقي، ومن هنا يهتز إيمانه وينزلق إلى هوة الضياع والإحساس المضني بعبث الحياة ولا جدواها .
إن"يحيى" يحاول على طريقة الوجوديين أن يدرك معنى الوجود وأسراره جميعاً ولكنه يعجز ويتقهقر مندحراً معبراً عن يأسه وإحباطه لائذاً بالإيمان .
((حمل يحيى بين متاعه قطهة من جوخ لف بها كتبه الأثيرة بحرص ومضى))"9".
كان "يحيى" يحترق بنار البحث عن المعنى على غرار ما كان يحترق "غاوست" و"ميرسو" و"كير كجارد" إلا أن "يحيى" أخيراً يحاول أن يخرج من دوامة العبث التي ألقى بنفسه في أتونها فيتجاهل الأسئلة التي كانت تؤرقه ويلتمس تسويغاً للحياة على غرار ما فعلته الفلسفة السارتورية "نسبة إلى سارتر".
((يخجل يحيى حين يلتمس قوة نفسه، فلا يشعر بصلابته، ويدرك أن عوده قد اشتد في مواجهة الخطوب بعد، وأن طموحه بإجازة الأزهر اندحر كما لو لم يكن يوماً، وأن الشوق الذي غالبه إلى الديار و....وأن قلقه على الأهل يعصف به. فكر ملياً بمريم وحيدة في أرض بعيدة لا سند لها ولا نصير))"10".
وبهذا يرفع "يحيى" الراية البيضاء ويسلم بوجود قيود تحد من حرية الإنسان ولكن تلك القيود لا تحول دون ممارسة الحياة والتأثير فيها بشكل فعال يوسع دائرة تلك الحرية.
ولذلك، فإن إشكالية الحرية ليست مطروحة بالنسبة لباقي شخصيات الرواية الذين يرتعون في نعمة اليقين نائين بأنفسهم عن ضروب السجال البيزنطي .
وإذا أردنا أن نثمن الرؤى الفكرية التي طرحتها سميحة خريس في هذه الرواية فإننا نجد شيئاً من الاعتزاز بالتجربة، فإذا كانت التجربة مصدراً مهماً من مصادر المعرفة البشرية أو الخبرة الذاتية فإنه ليس من المنطقي أن نقفز على تلال التجارب الإنسانية العامة أو القومية الخاصة التي تشكل منبعاً لا ينضب للحكمة الخالدة التي يمكن أن تستثمر في كل زمان ومكان وهو ما يوفر جهوداً شاقة على الشعوب والأمم، ولو افترضنا أن كل فرد يرفض تجارب الأخرين ويصدر عن تجاربه وخبراته الخاصة لاختلت المعادلة التي تحكم العلاقة بين الأفراد والجماعات ولظل الإنسان يتخبط ويبدد جهوده على نحو ما كان يفعل "يسزيف" كما تحكيه الأساطير الإغريقية، ولكن هذا الاعتزاز بالرؤية الفكرية لا ينتقص من قيمة رواية "يحيى" بطبيعة الحال خاصة وأنه لا يشترط أبداً في الكتابة الروائية أن تكون فيلسوفاً أو مفكراً حريصاً على تقديم نسق فلسفي أو فكري أصيل ومتماسك.
ولعل أول ما يستحق التسجيل عند تثمين الأداء الفني في رواية "يحيى" هو كونها رواية فكرية تاريخية تستفز المتلقي وتحفزه إلى التأمل والتفكير وليست رواية عاطفية أو خيالية يقرأها المتلقي مسترخياً قبل النوم، ولذلك فإنها ينبغي أن توضع في خانة الرواية الجادة التي تطرح قضايا مصيرية محلية خاصة أو إنسانة، وهي بذلك توسم كما توسم أعمال كتاب من أمثال "عبد الرحمن منيف، ونجيب وحفوظ، ومحمود السعدني" وغيرهم ممن أرادوا أن يطوعوا الفن الروائي للتعبير عن رؤاهم الفكرية أساساً.
الهوامش:
1- انظر موسوعة لالاند الفلسفية – منشورات عويدات – بيروت. المجلد ط1/ ص"1175".
2- الاتجاه الإنساني في الرواية العربية، د. مصطفى عبد الغني- كتاب الرياض، العدد 141- يصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية- الرياض، 2006م، ص"189".
3- رواية "يحيى" سميحة خريس- دار الثقافة- بيروت، 2010م.
4- مصدر سبق ذكره، ص "38".
5- مصدر سبق ذكره ص "38".
6- مصدر سبق ذكره ص "438".
7- مصدر سبق ذكره ص "438".
8- مصدر سبق ذكره ص "68".
9- مصدر سبق ذكره ص "223".
10- مصدر سبق ذكره ص "220-221".
سناء أبو شرار
لأني أشتاق إليك
(( نهاية الحب نهاية الحلم تعني موت النفس))
إذا كان هناك فرق بين السيرة الذاتية ورواية السيرة الذاتية فهو يكمن ليس في مدى إخلاص كل منهما للحقائق بقدر الأصالة في فهم هذه الحقائق وإدراكها والإخبار عنها فالرواية توجد في المعرفة وتوصيل هذه المعرفة وليس في الحقائق.
غير أن فكرة الروائي كاتب السيرة حر في أن يغير ويضيف ويعيد تنسيق الحقائق وأن ممارسته لهذه الحرية ليست لمجرد حماية خصوصياته ولكن في سبيل القيم الأدبية مثل المعنى والترابط الشكلي وعند تجربة القراءة نادرا ًما يكون القارئ في موقع يستطيع فيه الحكم على مدى الإخلاص للحقائق في كل من السيرة الذاتية أو رواية السيرة الذاتية لكنه يتجاوب مع كل منهما بشكل مختلف ويحصل على نتائج مختلفة أيضا فرواية مثل (( لأني اشتاق إليك)) "1" للكاتبة سناء أبو شرار تعقد وتؤخر هذه العملية لاحتوائها على خصائص الشكلين لكن عاجلا ًأو آجلا ً يقرر المرء على ما اعتقد أن يقرأ السيرة الذاتية كرواية ورواية السيرة الذاتية كسيرة ذاتية.
ويمكن للمتلقي أن يكتشف في رواية ((لأني اشتاق إليك)) تأثير صمويل بيكت وكذلك تأثر ببعض الروائيين الفرنسيين من كتاب الرواية الجديدة ومع ذلك ففي التجربة الفرنسية في الرواية غير الخيالية فإن الخيال الذي ينبثق من الرواية ليس مسألة شخصيات مختلفة أو إحداث فلسفية خيالية أو مخادعة وهو ما تشجعه الرواية التقليدية بمعنى أن الكون يتأثر بالتفسير الإنساني له وذلك يظهر بشكل واضح جدا ًفي الكتابات النظرية لألان روب جربيه وبشكل خاص في حديثه حول أن الواقعية التقليدية قد شوهت الواقعية بفرض المعاني الإنسانية عليها ذلك أنه يوصفنا لعالم الأشياء لسنا على استعداد للاعتراف بأنها مجرد أشياء لها وجودها الخاص غير المبالي بنا نحن نؤكد الأشياء بإخفاء المعاني الإنسانية عليها وبذلك نخلق إحساسا ً زائفا من الوحدة بين الإنسان والأشياء .
في رواية (( لأني اشتاق إليك)) هناك وحدة تعبر عنها الروائية أبو شرار خلال البحث المنهجي للقياس أو للعلاقات المتناظرة إن الاستعارة ليست شكلا ً بريئا للكلام إن اختيار كلمات متشابهة مهما كانت بسيطة يتخطى دائما إعطاء أية دلالة طبيعية نقية تقيم علاقة دائمة بين الكون والإنسان أن كل اللغة الروائية يجب أن تتغير الصفة المرئية أو الوصفية ـ الكلمة التي تتضمن نفسها قياسا ً وتم وضوحا ً وتحديدا ً وتعريفا ًـ تشير إلى اتجاه صعب لكنه على الأرجح اتجاه رواية المستقبل :
((جميلة : المقيمة رقم 00745 العقبة .. شاطئ البحر .. ووالدي يستلقي على الرمال الدافئة يشرب قهوته العربية بصمت ويتأمل البحر بهدوء وكأننا لسنا موجودين حوله حتى حين تتحدث إليه والدته يجيب بكلمات مقتضبة كأنه يطلب منها أن نصمت وتدعه يراقب البحر))"2".
إن لغة التشابه التي وضفتها أبو شرار استخدمت بشكل معقول في السرد غير الواقعي "الرواية الوصفية مثلا". على اعتبار أن الاستخدام الوصفي خاصة في الرواية الواقعية يفترض علاقات ذات معنى بين الفرد والعالم الظاهراتي العام ومن وجهة نظرها فإن طريقة الواقعية التقليدية تكتم هذه العلاقة وتستغلها في الوقت نفسه ـ بتسلسل المعنى الاستعاري لوصف واقعي واضح للبحر والرؤية والطقس .. الخ .. مم يجعلها أكثر تدميرا.
ويمكن مقارنة رواية ((لأني اشتاق إليك)) برجل يقف في تقاطع طرق والطريق التي تقف عليها ـ تفكر مبدئيا ـ هي طريق الرواية الواقعية الحل الوسط بين الصيغ الخيالية والصيغ الاستقرائية ونقرأ ذلك :
(( وحين تنتهي تلك السلاسل الطويلة من الجبال تعود الصحراء من جديد ساكنة وهادئة ولكن نباتات دائرية تنبت من خلال الرمال الجافة)) "3".
يبدو أننا نعيش في رواية ((لأني اشتاق إليك)) من الثقافة الجماعية التي تسمح لكل الفنون ولتنوع المدهش في الأساليب أن تنتعش في الوقت نفسه ومع ذلك فإنها في كثير من الحالات تتعارض جذرياً مع بعضها على أرضية معرفية وجمالية مختلفة وبالتالي لم يستطع أسلوب معين أن يسطر أو تكون له الغلبة في هذه الحالة على الناقد أن يكون متيقظا تماما فهو ليس مضطراً بالطبع أن يعجب بكلل الأساليب بالدرجة نفسها لكن يجب عليه أن يتجنب الخطأ الرئيسي في الحكم على أسلوب ما بالمعيار يتعلق بأسلوب آخر هو يحتاج إلى ما يسميه سكولز " بالإحساس المتميز العالي للنوع الأدبي " "4" أما بالنسبة للروائي فإن وجود هذه الكثرة من الأساليب المحيرة يواجه بمشكل ليست سهلة الحل وينبغي ألا ندهش حين نرى كثيرا من الروائيين المعاصرين يظهرون أعرافا من الأمان الشديد والعصبية بل وأحيانا ً نوعا ًمن انفصام الشخصية .
ويمكن القول فيما اعتقد أن رواية((لأني اشتاق إليك)) تندرج تحت ما يمكن تسميته تنوع في الأساليب السردية الأمر الذي يؤدي إلى عدم أمان الموقف السردي الواضح في صياغة الرواية حيث هذا التنوع والكثرة في الأساليب يولد انطباع لدى القارئ انطباع بأن الفنتازية النزقة انغمست تحت مظاهر الإدعاء إلى صورة ساخرة أو عرض لبراعة الأسلوب فيما يسمى بالمحاكاة الساخرة أو التهكمية للأدب الأخلاقي المفرط في تنظيره نحو صياغة خطاب روائي يدعو للفضيلة !
هذا الخطاب يحاكي الفضيلة بنوع من السخرية التي توظف لقراءة الواقع المر التي تعيشه الشخصيات الروائية وكأن الأخلاق أشياء كلية تماما ً ولا تحتاج إلى إبداع خلاق يعرف جيدا ً أن القيم الأخلاقية ليست بالضرورة تصنع خطاب أخلاقي يمكن توظيفه في صياغة أسلوب روائي يؤدي الغرض التي تسعى إليه الروائية أبو شرار .
هذا النوع من الرواية سأسميه "الرواية الإشكالية" هو يأتلف مع الرواية غير الخيالية والرواية الخرافية لكنه يظل متميزا بدقة لأنه يستخدم كل منهما في اللعبة ويمكن الزعم أن الروائيين يمارسون الحيل على قرائهم يعرضون آليتهم الخيالية متباطئة وتناقضاتها الجمالية كي يسقطوا مصطلحات الواقعية المحدودة ويعطوا أنفسهم الحرية ليبدعوا ويكتبوا ببراعة.
أنها قضية تحول إحساس الروائية الخاص ((الذي قد يكون مرحا ً أو قاتلاً)) للطبيعة الإشكالية لمشروعها الروائي ـ وقد يكون شركاً لقارئ في كيفية تناوله القضايا التي تثيرها الروائية كالقضايا الجمالية والفلسفية التي تقدمها الكتابة الخيالية بتجسيدها مباشرة في السرد التي تميز الروائية أبو شرار في كيفية جعل الواقع استيعاب كل هذه القضايا بالضرورة إذا أردت أن تكون واقعية مع الحياة فستبدأ في الكذب على واقعيتها والمرء لا يستطيع وصف الواقع ولكن فقط يعطي تشبيها يشير إليه كل أنواع الوصف الإنساني من التصوير إلى الرياضيات إلى الأدب أيضاً كلها استعارية وحتى الوصف العلمي الدقيق لشيء ما أو لحركة ما هو نسيج استعاري.
لا شك أن هذا القول يدفعنا للتأكيد أن الرواية كممارسة وكمعرفة لا تنجو في بلادنا من صيحة الهيمنة أليست كثرة الكتابات الأخلاقية التي تعج في الروايات العربية تتناوله تعبيراً وحشياً عن إثبات الهوية الأخلاقية للإنسان العربي؟ والرواية كما نعرف لا تستطيع أن تنفصل عن
الإيديولوجية ولا أن تؤسس معرفة تامة التشكيل أضف إلى ذلك أن الرواية هي أساسا ممارسة تتبع لمنطق الممارسة الاجتماعية ولا تستجيب في النهاية إلا لنوع من التساؤل عن الهوية .
وهذا ما ذهبت إليه أبو شرار في تعريفها للهوية كحالة إنسانية وابتعدت قدر الإمكان عن التجنيس الإنساني بمعنى لم تذهب إلى منظومة الجنساوية واقتربت كثيرا من حالات الحلم العام لذا نقرأ ((جميلة.. المقيمة رقم 00745
عاشقة أنا .. ليس لرجل ولكن لرمال وردية اللون والجبال استقرت بهدوء فوق تلك الرمال الناعمة فكيف تمتزج خشونة الجبال بنعومة الورود الوردية؟))"5".
هذه السيطرة النسائية على الذكر هو نوع من التظاهر والمرأة ـ كنوع من الواقع فكرة باردة وحقيقة دافئة وإن بدا للوهلة الأولى انه مشتعل ومشحون بالخيال لكن المدقق لما تسرد الروائية يعرف جيدا أن البرودة هي سيدة الوصف في ظل غياب حرارة الإنسان : ((وحين حل الظلام أضيئت السماء بنور القمر وبملايين النجوم التي اقتربت من الأرض وكأنها تكاد تلامس قمم الجبال ومن جديد توشح المكان بلون فضي لامع رأيت من خلاله ملامح والدي الذي كان يتأمل كل ما حوله بصمت كأنه لا يوجد أي إنسان غيره بهذا المكان فكان لا بد أن نغادر ..))"6".
هذا الانهيار الذي يكون أحيانا علاجا للنفس حين يخور عزم المرأة وتطرد الانقسامات الزائفة في النفس الداخلية تلجأ المرأة إلى الاعتراف انه لا بد من للإنسان الرجل تسجيل حضوره في الحياة ألا يدفع هذا الحضور للرجل الإنسان القول أن النساء هن الجبناء وهن كذلك لأنهن كن لزمن طويل شبه عبيد عدد النساء اللواتي يستطعن الصمود والدفاع عم يفكرون ويشعرون به.
يدفعنا هذا الاعتقاد بما ذهبت به الروائية أبو شرار في جعل المرأة أسيرة خوفها وإنها لا تستطيع مغادرة أنوثتها وعلى الرغم من أننا نعيش في عالم ديمقراطي على الأقل المشهد الإبداعي الإنساني ـ ذو إرادة حرة وعقل حرة يتخذ قراراته بحريته الخاصة وفي الوقت نفسه أسير لمعتقدات وتقاليد عصره وهذا ما تصوره أبو شرار: ((أحيانا اتجرا وأفكر بذاتي كامرأة أليس لي الحق بان يكون لدي زوج وأطفال وحفدة أيضا أليس لي الحق أن يوجد في حياتي إنسان ما يهتم بي واهتم به ومهما حصل يبقى لي وابقي له .))"7".
هذه المبادرة من نظام التقاليد التي فردتها الروائية على الأنثى هو في حقيقة الأمر احتيار حتمي ورغبة في الوقت ذاته للخروج من القولبة المضروب حصارها على أنثى تتنازع مشاعرها ومضطربة فهي أنثى أو حالمة تحمل رؤية أخلاقية وهنا يبرز سؤال هل الأخلاق تتعارض مع المشاعر الطبيعية ؟ سؤال لم تحاول أن تجيب عليه الروائية وان حاولت وضع نهايات للحب والحلم وتركت الأبواب مشرعة نحو الحلم لذا نراها ختمت روايتها على الشكل التالي : ((ساد الصمت وبعد ثوان أجابت جميلة :
ـ اجل أريد أن اذهب معك غدا إلى هذا العالم البعيد عن الأرض ولو أعجبني ذلك العالم الذي تعيشين به ألان سأرافقك إليه أريد أن تساعديني في الوصول إلى الطريق إلى الله لأنه هو من خلق وطني الذي أحب وهو خالق كل الأوطان بل كل الجمال على هذه الأرض وأنا بحاجة إلى رحلة جديدة ليست مع أبي لكن مع ذاتي عسى أن أجد سكينتي حيث وجدتها أنت.)) "8".
في الأزمنة البائسة يصبح الاستثناء هو القاعدة ولهذا فان سناء أبو شرار تحدث جمهورها من القراء طيلة روايتها ((لأني اشتاق إليك )) عن الاستثناء لكنها لن تنسيهم القاعدة الحقيقية التي يمكن أن يستندوا عليها دون أن يعتمدوا على مصباح (( لأني اشتاق إليك)) لان الروائية تريهم دائما حقيقة وجودهم.
الهوامش
1ـ رواية لأني اشتاق إليك ـ سناء أبو شرار ـ دار الهلال ـ القاهرة ـ 2011.
2- مصدر سبق ذكره ص "36 ".
3- مصدر سبق ذكره ص "37" .
4- الرواية اليوم إعداد وتقديم مالكوم براد ى – ث:احمد عمر شاهين ـ سلسلة الآداب ـ القراءة للجميع ـ مكتبة الأسرة ـ 2005ـ ص "91".
5- مصدر سبق ذكره ص "91".
6- مصدر سبق ذكره ص "94".
7- مصدر سبق ذكره ص "109".
8- مصدر سبق ذكره ص "134".
عدي مدانات
"تلك الطرق"
(مرايا الذات وصورة الإنسان في تلك الطرق)
الأعمال الفكرية الهادفة هي التي تستطيع أن تؤسس لنفسها مكانة تحفظها من الاندثار وتكسبها حضورها بقدرتها على التعبير أو الابتكار أو التصوير أو غير ذلك من الإمكانيات التي تقوم عليها وفق المجالات والقضايا التي ترتبط بها.
ويرتبط الخلود عادة بما هو ماض، فالعظمة والقوة كما يقول باختين "1" مع السلف والأجداد لأن الإنسان لا يكون عظيماً في زمنه.
لكن تبين لنا ونحن نقرأ بعض النصوص الروائية الأردنية المعاصرة كيف أنها تكسر الوهم بهذه القاعدة لتكون حاضرة في زمنها، وهذا شأن صاحب الرواية لنموذج القراءة ممن قدم وما زال مواقف وقضايا ووجهات نظر تعكس تبصره بما يقع في مجتمعه الأردني وقدرته على تشخيص الداء في زمنه أو قبله بكثير.
وقبل أن نتوقف عند رواية حديثة الصدور للروائي عديّ مدانات بعنوان "تلك الطرق"(2) ينبغي أن نسجل أن الجيل الجديد الذي بدأ كتابة في الثمانينيات وبداية الألفية الجديدة هو جيل يتميز بالتجديد والتنويع ويغني السرد الأردني اليوم بشخصيات وموضوعات من نمط جديد وباشتغال جديد على الذات والمجتمع والتاريخ وبعمله من أجل أن يستعيد العمل الروائي قدراته على الظهور الفعلي لمرجعه (الذات والمجتمع والتاريخ) دون أن يهمل الاشتغال بطرائق التخيل وأشكال السرد وجماليات القول.
فخلال العقود الأخيرة حدثت تحولات دراماتيكية في حقل الكتابة الروائية الأردنية. هذه حقيقة لا يمكن تغافلها رغم وجود ملاحظات كثيرة على نوع تلك التحولات وأهميتها وعمقها على صعيد تطور السرد الروائي وعلى صعيد مدى الإضافة المقدمة إلى تيار الرواية العربية اليوم، فتلك التحولات لم تطل الشكل فقط بل والمضمون أيضاً مع التأكيد على أن الشكل والمضمون نسيج واحد يصعب الفصل بينهما إذا ما تكلمنا بالتأكيد عن التجارب المهمة والمؤثرة في حقل الرواية.
بداية سنحاول أن نبين من خلال هذه القراءة كيف يصوغ النص عنف الواقع بصنف الكلمة النافذة والساخرة في الوقت ذاته؟ أي في الوقت الذي يصبح فيه "الوقز" غير الوخز ليكتسب صفات أخرى تحمل على بناء الصورة السردية التي ستعكس ما يدهش ويربك ويقهر.
نحن أمام شخصية تحمل في طّياتها إشكالات متنوعة كما يحكيها الراوي "البطل" (صالح الموهمي) ذلك الإنسان العادي الذي يسكنه قلق الضائع في قلب وطنه من جراء معاناته الاقتصادية، فيبث على لسانه سخرية القدر وممارسات الأمن لواقع الإنسان البسيط أو بالأحرى العادي صاحب الشخصية النمطية في المجتمع الذي ليس له سوق الرزق الكريم والعيش الآمن. وهذا لن يحدث إلا حين تختل معايير المجتمع المتمثل في الوطن، فـ "صالح الموهمي" يعيش في الرواية منذ بدايات زمنه فقداناً لمأمنه الوجودي، وحين ينتهي من حكايته مع الزمن الحاضر يؤكد لنا ما سبق أن توصل إليه فكرياً قبل أن يحكي الحكاية.
تبدأ رواية "تلك الطرق" بهذا المقطع الجاذب: (أعلن قائد الخطوط الجوية الكويتية أن الطائرة ستشرع في الهبوط على مدرج مطار الملكة علياء الدولي وأن الساعة بالتوقيت المحلي هي الحادية والعشرون ونصف وأن درجة الحرارة تسع وعشرون، وطلب من الركاب البقاء في أماكنهم وربط الأحزمة فخيم الصمت على الجميع إلى أن لامست عجلاتها الأرض واستقرت فحدثت الجلبة المعتادة وشرع الركاب بلملمة حوائجهم وانتظار الإذن بمغادرة الطائرة)"3".
يتمثل هذا الوصف في الحوار الضمني الذي نسج في عالم الرواية: إنه حوار "جدلي" بين ما يغيب وما يحضر، بين ميتافيزيقية كونية كحركة الزمن من جهة ومخلفات مدفونة متراكمة في الأرض للموجودات والكائنات من جهة ثانية، يتحقق منظور الرواية الفكري ليقارب سؤالاً فلسفياً عن المصير كما سنرى فتتحدد منذ الآن علاقة غير متكافئة بين الراوي (الشخصية المحورية) والقدر، وهي علاقة تتراوح بين الغموض والتحدى.
غموض يوهمنا به النص الروائي، وهو يقدم لنا الطلب عبر محادثة هاتفية بحيث لا يجد فيه على ما يحددها بشكل جليّ يجعل من أعضائها شخصيات واضحة المعالم فيتكسر بذلك أفق القارئ الذي اعتاد على أوصاف اعتبرت في النقد الكلاسيكي ضرورية كالاسم الشخصي والعائلي والانتماء الجغرافي وغيرها من السمات التي تغني البطاقة السينمائية للشخصية، في النصوص الواقعة عادة يكتفي الراوي بتعيين المحادثة بصوت الوطن القادم من قريب "صالح الموهمي" بغض النظر عن الاسم أو الشخصية، فصلة القرابة هي المعيار الذي وظفه الروائي للكشف عن الألم الحقيقي مع الألم النفسي، وبالضرورة هنا القول: إن المحادثات في سير الرواية قد تكون رسائل وليست فقط اتصالاً هاتفيأً، هذه الاتصالات تحمل دلالات كثيرة عميقة تخترق واقع المجتمع المسكوت عنه فيتحول هذا المسكوت عنه إلى صوت شاهد في الرواية يخترق نسيج النص الروائي ليقدم لنا دلالة إضائية محايدة عن الراوي(البطل) بهدف تحليل شخصيته ومواقفه من الناحية الإنسانية والاجتماعية والنفسية فتطرح "تلك الطرق" شخصية الشاهد المحايد والمطلعة على سير حياة البطل "صالح الموهمي" وهي تقنية يوظفها (الروائي) باقتدار حين يصرح بضرورة حضورها:
(بسم الله الرحمن الرحيم
العزيز ابن العم،
السلام عليك وعلى الجميع من عندك
وصلتني رسالتك وأفرحت قلبي، مبروك المكتب إن شاء الله يظل عامر ويكبر بهمتك. أنا بخير ما ينقصني إلا أخباركم. رحت على الشغل لابس أفندي وصرت فرجه)"4".
ليعلن الشاهد بضمير الغائب في الرسالة قبوله للحياة الجديدة ليسير هذا القبول متجانساً ومتناسقاً متناغماً مع سيسرده عبر الزمن القصي الذي يرافق الرواية.
وكما ذكرنا فإن القارئ في هذه الرواية يجد أنه يعود مع الراوي من حيث بدأ وهذه الآلية أتقن توظيفها (عديّ مدانات) ببراعة فائقة حتى تجد نفسك وكأنك تعيش معه آلامه وعذاباته واندهاشه وتساؤلاته وأن صوت "الراوي" الذي يخترق نسيج النص السردي يقدم لنا إضاءة دلالية تحلل شخصية (صالح الموهمي) من الناحية الاجتماعية والنفسية حتى حين ينظر إلى نفسه وهو أفندي ويعبر عن ذلك في رسالته إلى ابن عمه، وهي سخرية لاذعة يلعبها الشاهد مع الراوي.
وكما نلاحظ أن الراوي أمام هذه الحالات العامة يجيب أحياناً بطريقة تجمع بين الدقة والتصميم كإرهاص دال على مراوغة موازية من لدنه للرسالة التي وصلت من ابن عمه من عمّان.
أما التحدي فيتجلى أولاً في هذا الأسلوب الذي يعتمده السارد في الوصف عن الحالة التي وصلت إليها عمان من خلال الإشارة للوضع الاقتصادي الآخذ في الازدهار من خلال فتح المكتب، أي التوسع في الأعمال. وتتوالى بعد ذلك الأوصاف لتجد لها أجوبة لا تخلو من التهكم والسخرية، وهو مفعم بحبه وغيرته على وطنه تأتي الرواية لتفضح الهيمنة الاقتصادية الخارجية الطارئة على بلاده، وهي هيمنة تتحدد في جميع المستويات الفكرية والثقافية والسياسية، يترجمها الوجود النصي للقضية الذي بدأ في طرحها الروائي في الرواية أولاً وهي النمو غير الطبيعي للاقتصاد والتوسع العمراني غير المبرر.
يمكن القول: إن الراوية لا تدعي أنها امتلكت الحقيقة كلها ربما أن غايتها ليست بالضرورة امتلاك الحقيقة بقدر ما يبدو أنها منشغلة بسؤال آخر هو: ماذا عن الحقيقة عندما تكون متمنعة مستحيلة؟ ماذا عن الشتات والوطن؟ وإن وطناً ما يمكنه أن يكشف عن الحقيقة لكن قليلاً ما نتساءل: ماذا عن محكيات الوطن الذي لا يبلغ الحقيقة؟ والغاية ليست أن تصل إلى الحقيقة بل أن تظهر الحقيقة ممتنعة مستحيلة فاتحة بذلك أعين القراء على احتمالات متعددة ملتبسة محيرة، كاشفة مختلف الصعوبات والمخاطر والمزالق التي تنتظر كل باحث عن المعرفة والحقيقة، ولهذا يعلن السارد أن القصة لن تنتهي مع هذا الوطن فله بقية أفصح عن أزمته النفسية وصراعه مع الحياة التي استجلبت كل دمار وتحطيم لنفسه عبر أحداثها حتى مسار نهايتها.
بسجن البطل، هذه الثنائية في النهايات بين حرق زوجة البطل "سناء" ملابسها الفاخرة :(راقبت سناء كل ما يحدث بقلب بارد وكأن المحنة الطاحنة ألقت بملاءة بيضاء على تاريخ أشبه ما يكون بالوهم فجمعت في نوبة تأبين غير اعتيادية ثيابها الفاخرة التي تراكمت على مدى سنين ولم تكن قد ارتدت الكثير منها وحملتها إلى الحديقة ثم أضرمت النيران فيها، وجلست على الشرفة تراقب وهجها والشرارات التي تطايرت في كل اتجاه)"5". ومع نهاية زوجها (صالح الموههي) تبدأ حكاية الرواية "تلك الطرق" في ذهن القارئ تشتعل في خلق حالة من اليقظة المتخيلة: هل نحن أمام رواية حقيقية أم هذا واقع مجتمع عاش في بنية الرواية؟
حين تبدأ بقراءة رواية "تلك الطرق" يثيرك العنوان وتراودك أسئلة كثيرة، فهل رأيت الطرق أو عرفتها؟ وما الدالة الفكرية ذات الأبعاد العميقة التي أرادها عديّ مدانات عن تلك الطرق؟
إنها دلالة هدمية بنائية للتخرصات الرواية يعلنها "عديّ مدانات" بسخرية لاذعة وجرأة وشجاعة ويعمقها بضحك الأقدار وبكاء الفراق في النسيج الداخلي لمدينته الوطن لتصبح الطرق خرافة أسطورية ضائعة والناس عليها هياكل يمرحون ويسرحون بضلالتهم وبطشهم كل حسب قدرته ومكانته في المساحة التي هو عليها.
تمثل تجربة عديّ مدانات في رواية "تلك الطرق" نموذجاً مهماً لقراءة محنة الإنسان المثقف الذي يعاني من غربة الذات والوجود في تصادمها مع وهم الحقائق والانكسارات، والخسائر التي تعكسها ذاته من إحساس بالغموض والشك والفقد إزاء قدرية الحياة ومآسيها لتنصهر التجربة في خصوصيتها وذاتيتها مع الواقع لإعادة تعريف المكان والكشف عن حضوره وغموضه وغيابه وسطوته والمساحات التي تتوفر فيه للحرية.
فتتجلى هذه التعبيرات عند "عديّ مدانات" عن أزمة الإنسان وعلاقته بالوجود في عدد من الضربات المؤقتة والدائمة التي تؤدي إلى تشظي الروح، روح بطله الأول صالح الموهمي، بين غربة الذات التي ترى أن العالم وفق قدرة محتومة والذات "الطموحة" المتمردة التي تحاول فك رموز هذا الغموض مما يضاعف وتيرة الغربة منذ لحظة اصطدامه بحبه لسناء في الحي الذي يعيش فيه حتى قراره بانسحابه والعودة إلى عمان بعد صدمة التجربة التي خاضها في الكويت واستكشافه حقيقة الحياة الزائفة المغلفة والمظاهر الباذخة المتأصلة فيها التي لا تقل عن زيف المكان أو الوجه الآخر للمدينة ليفرغ كافة التخرصات العالقة المتمثلة في مساحة الغربة/ الوطن وصولاً إلى النص الذي يقوم على الدلالة الاستعارية التي لا تخلو أيضاً من الاستعارة المتمثلة في تاريخه (في الثامنة من عمره لم يجد من يسنده أو يمد له العون فهو وحيد والده صالح المواهين الذي التحق بثورة عبد القادر الحسيني واستشهد مخلفاً امرأة ضعيفة لا حول لها ولا قوة وطفلاً يحتاج لمن يرعاه)"6". لذلك كله تعلق بفخ الرد الجميل الذي يطل به علينا من خلال فلسفة طبيعة البشر واختلاف آرائهم في مختلف القضايا التي تبدو بسيطة للآخرين ولكنها كبيرة بالنسبة لهم المحدودة.
شخوص بأصوات متعددة تتصارع أفكارها فتتشعب أحداثها ويحتد رفضها أمام التطوير والتجديد الذي عادة يرفضها من فقد وطنه جرّاء توجسهم من انسحاب ذكريات الوطن المفقود وخوفهم من حلول لعنة النسيان بالأفكار الحديثة، فيما يبرز التناقض والتنافر بين عائلة المواهين المبنية أساساً على الكذب والنفاق التي تعايشوا عليها ومعها زمن يقدم "عديّ مدانات" ذلك كله بأسلوبه الدرامي الذي يكتنز لغة كثيفة هادئة وسهلة وسلسة.
حين لم تكن لعبة الأوضاع السياسية في فترة ما تمنع حب الوطن شكلت أزمة الهوية بعداً رئيسياً في الرواية "تلك الطرق" كونها ـ أي الأزمة ـ نتاج العلاقة غير المتكافئة مع دول الغرب التي حاولت أن تكوّن أنظمة ديمقراطية عربية حقيقية وأفضت بالتالي إلى نزوح المواطن العربي تحت أنظمة غير ديمقراطية وعادات وتقاليد رجعية امتدت لتشمل المواطن المهمش والمنفي داخل وطنه، ولعل أبرزها ما نجده في رواية "تلك الطرق" التي تلامس بحس مرهف رائع مسألة الهوية لكن بهدف إضفاء المعاني الجديدة عليها التي عززت المتخيل التاريخي باقتدار.
فالرواية تدور أحدثها في الثمانينيات من القرن المنصرم وتحديداً في عمان.
إنه ليس من باب الصدفة أن يكون عنوان الرواية "تلك الطرق"، فوراء هذا العنوان ما وراءه من دلالات وثائقية وتعددة وأبعاد تاريخية مهمة وانعطافات سياسية كبيرة قادت إلى إعادة التعريف بخارطة هذه المنطقة الممتدة في المشرق العربي، تاريخياً وسياسياً واقتصادياً وحتى اجتماعياً بعد حصول نكبة فلسطين عام 1948 وبدأت أطماع الغرب وبمختلف الطرق تحوك الدسائس لهذه المنطقة في سبيل بسط هيمنتها وإعادة تشكيل خارطتها، مستعرضاً كل ذلك بأسلوب ممتع وسرد فني شائق رغم تجذر أبعاده التاريخية عبر الشخوص والأحداث فيها، مازجاً بين الرفض والأمل من جهة والمتعة والفائدة من جهة ثانية ليكون الخلاص برمزية الحب الأبدي ألا وهو حب الوطن المتمثل في محبوبته وزوجته "سناء" بالانتظار المرتقب لحل أزمة هويته الوطنية.
تستعيد الذاكرة السردية الزمن باعتباره عالماً كان فتبدو فعلاً يتجاوز التاريخ، فـ "صالح الموهيني" في مسعى الراوي مشروع جواب على الروائي الذي سعى لتوظيف الراوي في كتابة مختلفة للبناء للنوع الأدبي الروائي ولم يكن دافع الاختلاف شكلياً بل هو مرتبط بمادة الكتابة نفسها بموضوع الحكاية التي طرحها الروائي.
نجد أنفسنا أمام هذه الرواية من الأفخاخ الفنية ـ إذا جاز التعبير ـ التي تعكس بعض أوجه الفنون السردية وهي إشكالية نقدية متمثلة في علاقة الكاتب بالراوي والشخصية، فقدم لنا النص مثالاً واقعياً عن ارتباط لا بل عن تلاحم الشخصية الروائية بسياقها التخيلي الخاص في هذا السياق الذي يقود القراءة النقدية إلى عدم الخلط بين الشخصية التخيلية وبين الشخصية كذات إنسانية أو الخلط بينها وبين الراوي والكاتب تحت طائلة الإساءة للنص والانحراف بخطابه عن أبعاده الدلالية بحيث لا يجدي مثلاً التعرف إلى الكاتب "عديّ مدانات" في "تلك الطرق" في وجوه شخصيات أبطال روائية، لأن هذه الشخصيات شأنها شأن باقي الشخصيات: مجرد عناصر قائمة داخل بنية سردية ابتدعها الكاتب لتكتسي دلالاتها ولترفد بهذه الدلالات الخطاب الروائي الكاشف والمضيء بحيث تجلت الأبعاد الدلالية لهذا الخطاب ـ في أحد مستوياته ـ في مناصرة الكلمة الحرة، مكتسباً بذلك حقيقته التي عمل الكاتب على تمويهها بتقنية عالية، كما دعا التشكيك منذ البدء في واقعية الحكايات فكان انسحاب الذات الحرة والخطاب الحر لتظهر الحدود الواهية بين الحلم والواقع ويفرض نفسه كخطاب موجه ضد كل عناصر الاستبداد والظلم والانفلات في عالمنا العربي، وضد تاريخ القهر والغربة والنفاق والعنف الخفي الذي طال الإنسان العربي، فبتركيزها على تحول الإنسان إلى كائن قزمي مهزوم، ذلك لأن المسخ يؤلف إدراكاً وتمثلاً للقدر الشخصي للإنسان في أكثر اللحظات تأزماً من حياته ومجتمعه، يمكن القول: إن الرواية الأردنية كالرواية العربية الجديدة نزلت إلى ميدان الثقافة العربية وهي متسلحة بكل ما وصلت إليه الحضارة الراهنة فوجدت نفسها في خضم عالم معقد لم يعد يحتمل الثنائيات التقليدية في السرد السابق: الخير والشر، المناضل والخائن، الملحد والمؤمن، العربي والآخر، السلطة والفرد، بل حملت في أحشائها الهزيمة، التمرد، التشظي الروحي، العجز النفسي، فقدان الهوية، الانتصارات الفردية الصغيرة.
في هذه الرواية، لا شك أننا نكون أمام كتابة تقول واقعنا وزماننا ومصيرنا ولكن بطريقة لا واقعية لا معقولة تأكيداً على غرابة الواقع المتناقضة المرعبة المقلقة المتحولة عما هو مألوف وإنساني.
الهوامش
1 ـ تلك الطرق: عديّ مدانات ـ دار الأهلية ـ عمان ـ 2008
2 ـ مصدر سبق ذكره ص "5"
3 ـ مصدر سبق ذكره ص "100"
4 ـ مصدر سبق ذكره ص "443"
5 ـ مصدر سبق ذكره ص "28"
فخري قعوار
رواية لا تغرب الشمس
(من المتاهة إلى الحاضر الجنائزي)
(إني أكتب لظلي وحسب، ظلّي الساقط أمام المصباح على الجدار ينبغي أن أعرفه بنفسي) "صادق هدايت ـ البومة العمياء".
إن الإقبال على الكتابة الروائية يسبقه هاجس الاحتراس من لجوء لا مفر منه غالباً إلى لغة الكليشيهات، وخلافاً لوصية فيلسوف أفتى بأن من الأجدى أن نمرّ بصمت على ما لا يسعنا الكلام عليه (فتخنشان)، وهي وصية كان حفظها من ظهر قلب واستظهرها في مناسبات عديدة، وها هو يستظهرها في هذا السياق. فكر بأنه لن يضيره التماس تبرير لهذا اللجوء الاضطراري متذرعاً بالحاجة المسيسة إلى سبيل للإعراب عن إحاطته بالعالم الذي خبره والذي بحسب زعمه يقصد تمهيد الطريق للتصالح معه أخيراً.
كان ذلك في فترة انتابه فيها رغبة ساحقة في الإقبال على مزاولة ضرب من "الكتابة الذاتية" فلم يفلح في أي وقت من الأوقات، ورغم محاولات متعددة، في الولوج لكتابة هذا اللون من الكتابة، وقد ظن في حينها أن إقباله على هذا اللون من الكتابة إنما جاء تحت تأثير قراءة الفيلسوف الألماني ج ج هامان، بيد أنه سرعان ما أيقن بأنه في الحقيقة كان قد تأثر بما كتب عن هامان وليس ما كتبه هامان نفسه ،فهو لم يفهم من أمر هذا الفيلسوف الألماني إلا ما جاء في كتاب لأشميا برلين يحمل عنوان : "سامر الشمال: ج ج. هامان وجذور اللاعقلانية الحديثة".
كان قد ضاق ذرعاً بكتابة القصص بعدما ساورته ريبة بأن استقلالها! عن أي لون من ألوان الكتابة التقريرية الأخرى ليس سوى زعم فارغ. فرغم اتباعها سبيل المخيلة إلى الواقع فإن الكتابة القصصية على ما أضحى وعياً حادّ الحضور إنما هي سبيل "تأويل" حوادث متخيلة لا يختلف كثيراً عن سبيل التأويل التي ينتجها خطاب التاريخ في سرد حوادث الواقعة فعلاً. هذه المقدمة تكاد تنطبق على كاتبنا الروائي فخري قعوار الذي أصدر رواية (لا تغرب الشمس)"1" في مطلع شبابه وتركها للزمن وعاد إليها بعد سنوات طوال فاشتغل في حضرة الغياب عن الرواية بالقصة القصيرة.
ها هو يتذكر الآن "لحظة صدور الرواية" كيف كانت فلسطين تحثه على الإفضاء بما في نفسه، أن يخبرهم أنه عاتب عليها بل غاضب منها، أن يصرح بكل ما يجول في نفسه.
غير أنه يتذكر أيضاً كيف كان يقابل فترة النسيان بابتسامة ساخرة وكأنه ينظر إلى امرأة حمقاء لا تعرف ماذا تقول. هل ظن فخري قعوار حقاً أن الإفصاح غدا له منهجاً يتبعه كي يمضحل النسيان؟
وهل كانت فلسطين تحسب أننا نجلس كقوم متحضرين نحسو القهوة ونتناقش في أمر ما يعكر صفو نيساننا لها؟
ظّن ذلك فخري قعوار عندما أدرك أنه ما إن يرفع الغطاء عن بئر الماضي حتى تتدافع الأمور إلى السطح تدافعاً لا راد له، إذا ما أفلح في ذلك على أية حال فقد بين لفلسطين جلية الأمر بما يجعلها تفهم وبما قد يعود عليه بقسط من الخلاص، وهو في الآن نفسه يريدها أن تفهم أن غياب العقلانية في كل ذلك لهو الأمر الأشد إيلاماً. لو أنه كان يعرف منطق ما يحدث لهان الأمر. بل لربما أمكن أن ينتهي كمحض حادثة تنتمي إلى ماض انقضى ولم يعد له أدنى أثر على الحاضر، ولكن ماذا لو حدث إن كانت ذروة أمانيك أسيرة قسوة عشوائية وغضب لا سبيل إلى سبره، فلا تعرف إذا ما كنت تدنو من النهاية أم أنك ما زلت في البداية؟(إنني جد ناقمة على مجتمعنا البالي، إنني كارهة له كرهاً شديداً، أنظر إلى تقاليده وعاداته ثم في عقليته أشياء عقيمة يتمسكون بها وأصبحت أساساً للثالوث البغيض. الفقر والمرض والجهل أشياء سيطرت على حياتهم وعلى أنفسهم حتى أنهم لا يستطيعون أن يبدوا حراكاً)"2" .
يبدو النص في حالة من التموج بين الانفتاح والانطلاق. وإذ صح ـ مع تودوروف ـ أن النص المغلق أكثر النصوص قابلية للانفتاح باعتباره بلغ الكمال في النظام، أي أصبح علامة بذاته"3"، إلا أن هذه العلامية لا تظهر أبعادها إلا إذا رُبطت بعلامات مماثلة، حيث يظهر منها نص أكبر هو نص الحياة"4"، أو : نص الموت والحياة، أو جدلية الحب والموت حسب هيراقليطس.
(واقتنع أبو عبدالله بوجهة نظره ووافق، وجالا في الأسواق قليلاً وعادا بخيمتين، وذهبا إلى مكان ناءٍ في طرف البلدة وضربا خيمتهما حيث مئات المشردين مثلهم! وأول عمل قاما به بعد ذلك أنهما حفرا قبرين ودفنا فيهما فلذتي كبديهما! صلاح وأحمد ! وعاد الرجلان كل إلى خيمته)"5".
وهكذا تتجدد دورة الحياة، ولا يصبح الموت فاصلاً بين عالمين أو بين وجود ولا وجود بل فاصلاً بين وجود وأخر... لم يقل أي عربي: "النهار ظلّ الليل"، لكن الموت هو الحي الباقي الذي لا يموت!
في رواية "لا تغرب الشمس" نتأمل الروائي فخري قعوار الذي ضم الاغتصاب، على صدر الفتاة التي تعرضت لذلك في أرض مغتصبة خاوية إلا من فكرة مقاومة انتصبت عنيدة وحدَها لتزيد من حس العراء والخواء والرهبة، إلى اغتصاب أرض... إنه على وشك أن يطلق فكرة الاغتصاب كطير يطير وسط الغيوم فيعبر إلى أرض أقل عرياً وخواء منذراً بالويل العتيد. هذه الفكرة احتجاجية: أرض اغتصبت المأساة التي يضمها الإنسان بين جناحيه لتذكره بالفاجعة الممكنة دوماً والتي قد يعبرها الإنسان إلى حيث يتطهر منها وكأنه قد تخطى الموت نحو الحياة من جديد أو قد لا يعبرها ويبقى رهين مأساته: (ونزلت الدموع منها غزيرة أيضاً ثم قالت:
ـ وتقدم أحدهما كالذئب وااغـ ... واغتصبني!
فقالت سلمى:
ـ لعنة السموات عليهم.
ثم قالت أم أحمد :
ـ ثم ماذا حصل؟
قالت المرأة:
ـ تركاني وخلا لي السبيل بعد أن أشبعا رغبتهما من هذا الجسد المتأكل الشائخ!
ثم كررت سلمى جملتها:
ـ لعنة الله عليهم!
ثم سألتها أم عبد الله:
ـ وكيف وصلت إلى هنا؟
قالت:
ـ قطعت مسافة كبيرة سيراً على قدمي ثم لحقت بي سيارة (ترك) وقفت لي فركبت في الخلف حتى وصلت إلى هنا)"6".
هذا الوصف لحالة الاغتصاب مقلق مذهل، فهو يحيا على متناقضات داخلية تمتلئ بالرموز، ولا أحسب أن الروائي برموزه يكون متقصداً أي معنى واضح ينصاع للمنطق. والاغتصاب المتكرر هو نفسه مطلق هذه المتناقضات لأنه يحمل معانيَ لا تتحدد في ذهن الروائي فهو إذن لا يتحداه في ذهن القارئ الذي يتلقاها كما يريد ويعطيها المغزى الذي يريد. بل إنها تعيد باستمرار تشكيل القرائن الذهنية والنفسية لديه كل مرة على نحو مغاير. كما أن لكل قارئ قراره الخاص في تلقي هذه الرموز مهما تكن منطلقات الروائي إذا جاءت وانسابت فيضاً من قريحته.
هذه الرؤى الفاجعة تذكرنا بذلك الفيلسوف الذي ما تأمل الحياة ونظر إلى الناس إلا وعيناه طافحتان بالدموع، غير أن الروائي في روايته "لا تغرب الشمس" يقارب التعبير عن الغضب بدلاً من التفجع على هذا كله. وهو يوارب حين يسمي روايته "لا تغرب الشمس" في حين أنه يريد أن يقول: إنها "الحقيقة والسراب"، الإنسان، البقرة المليئة الضرع له فرع الحصان الجامح، صخرة الكينونة، صخرة "يسزيف" في الفضاء ويفرغ فمه كل ما احتواه في جوفه... فغدا الكابوس هو الحقيقة التي نسمعها الآن لا نعيق الاغتصاب بل صرخة الروائي نفسه تملأ الفضاء .
يخيل إليّ أن الروائي في وصفه للاغتصاب استطاع أن يبلغ بمأساة الإنسان ذلك المستوى الذي تستوعب عنده النص الشاهد في عواطفها المحتدمة لتبلغ به في النهاية حد التطهير من الخوف والشفقة بالضبط كما أراد أرسطو للمسرحية التراجيدية بحيث يعود المشاهد بعد دخوله تجربة الروائي وهو أنقى وأقوى.
يبدو أن الكاتب الذي ظهر في الرواية راوياً لم تكن له تجربة سابقة في كتابة النص الروائي وله عذره فكتب هذه الرواية في سن مبكر جداً لكنه خاضها مع من خاضوا غمار الرواية على غمار تداعيات النكبة الفلسطينية فمنهم من تطلع إلى البناء السردي مهتماً به بمعرفته أو غير معرفته ومنهم من ترك القصة تأخذ شكلها مهتماً بتسليط الضوء على المحطات الساخنة التي تظهره بطلاً ضمن أحداث النكبة التي دخلت التاريخ من خلال هذا التراث المتواضع مع من كتب الشعر والنشر بكل اتجاهاته.
إن اهتمام الراوي بتقديم الأحداث التي تبدو متشابهة في كل الروايات التي تحدثت عن النكبة أثناء وقوعها وبعدها بسنوات، جاء على حساب التماسك البنيوي، فهو لم يعر اهتماماً له وبذلك لم يقدم سرداً روائياً كما ينبغي، بل قام بدور المحدث أو المخبر عن أحداث سمع بها، ولكي تكتمل عنده حلقات الفصل الإخباري استخدم عملية استرجاع ماراً بيوميات ما سمع به وكان متداولاً بين الناس في عمان، ولأجل ذلك كله قدَّم نصًّا فقيراً جداً في الهندسة الفنية التي يتطلبها العمل الروائي.
وعلى الرغم من ذلك فإن عالماً واسعاً كعالم النكبة الفلسطينية يجعل الروائي مضطراً إلى رسم شخصيات ذات أفكار مختلفة في تفسيرها للصراع الذي تعيشه، مما يحتم عليها استحداث طرائف وأساليب مختلفة في أشكال النضال الذي تمارسه للخلاص مما تنوء به من ثقل تبعات التخلف والفقر والاضطهاد من المحتل الإنجليزي قبل نكبة عام 1948 تحت الاستيطان "الإسرائيلي"، ولذلك استخدم الكاتب في روايته "لا تغرب الشمس" أساليب مختلفة في العرض استهدف من خلالها تركيز دور البطولة الجماعية في صورة الفرد والمجموع التي تساهم في تطوير الحدث، وكان من أبرزها التعبير عن المضمون من خلال وعي الشخصية أو ما يسمى بـ(ـالمنلوج) الداخلي وإلمام شخصية الراوي بكل الأحداث والشخصيات وحركاتها وتفاعلها ضمن الإطار السردي، ولهذه الصورة ما يماثلها في رواية "لا تغرب الشمس"، حيث أستخدم الراوي (المنلوج) الداخلي مشيراً إلى إلمامه بكل الأحداث"7". وهذه الحالة صورت من الداخل الفلسطيني قبل وقوع النكبة بسنوات قليلة فحفلت بشخصيات كثيرة حاولت تكريس طاقاتهم للإمساك عملياً بشيء اسمه المستقبل: (لتعيش ثورتنا على التقاليد ولتسقط العقول الرجعية المتأخرة سنسعد بحبنا يا عبد الله وندوس التقاليد، أليس كذلك؟
فقال لها:
ـ أجل)"8".
لم يستطع الكاتب/ الراوي أن يتخلص من هذا النسق الإجباري كما يظهر في هذا النص، لأن أفكاره لم تستطع مغادرة الحالة النفسية التي لازمته أثناء كتابة الرواية "لا تغرب الشمس"، حتى حينما يريد أن يتحدث عن تبعات النكبة التي أدت بالفلسطينيين إلى المنافي والتشرد، ولذلك كان وصفه لهذا المشهد مثل حبيبات الرمان التي انفرطت وتساقطت على الأرض فضاع جمالها. وعلى الرغم من ذلك استطاع في الحد الأدنى أن يحقق للمتلقي متابعة مؤثرة لمفردات الحال الذي كان عليه الراوي/ الكاتب وبطل الرواية (عبد الله).
ولا شك أن الأسلوبية في رواية فخري قعوار برز قصورها في امتلاك مقومات العمل الروائي بعض الشيء، فلم تكن حاضرة في السرد كونه ركز على تسويق أحداثه إلى المتلقين من دون الالتفات إلى الجوانب الأخرى المهمة التي يتشكل منها النص وهي محاولة لكتابة رواية ليس إلا، وعبر هذه الرواية تتشكل لنا صورة المروي له من خلال صورة الراوي وهو المؤلف الذي يوجه خطابه هنا مباشرة إلى المروي له ـ القارئ.
يبدأ فخري قعوار روايته بأسلوب استرسالي إخباري حيث قال: (عمّ الليل على جميع أركان البلدة بعد أن سقط القرص وغاب وراء الأفق، وبدت النجوم صغيرة جميلة بلون فضي ساحر وهي أشبه بقطع فضة ألقيت على بساط أسود والقمر يتوسطها بطلعته البهية وكأنه قائد مقدام يقود جيشاً جراراً) "9".
استخدم الراوي أسلوب الإثارة والتشويق الذي يستفز المتلقي، وكان ذكياً في هذا الاستخدام كي يلفت الانتباه إلى أن هناك قضية أسمها (القضية الفلسطينية)، وهذا الأسلوب قام على أحداث مأساوية بنمط السرد المباشر الذي يخاطب من خلاله عقول المتلقين ثم أفئدتهم محملاً النص الكثير من مفردات المأساة مثل: (الفقر ـ الثورة ـ الأرض)، وهذه المفردات هي رسالة موجهة إلى عالم القرن الواحد والعشرين، عالم البحث عن حقوق الإنسان الذي تعالت فيه أصوات النشاز مناديةً بها هذه الأيام.
رائع جداً أن يتناول الكاتب فخري قعوار قضية الإنسان المعاصر من خلال الإنسان الفلسطيني المشرد في أصقاع العالم التي ضجت فيها أصوات الاستغاثة في دهاليز الليل الذي ما كان له أخر .
لنتأمل نصاً أخر يرويه لنا الراوي العليم ويعرض فيه لوحة مأساوية أخرى فيقول: (أما أبو عبد الله وأبو أحمد فلم يعودا إلى البكاء ثانية على بنيهم! وكانا يقضيان يومهما في خيمة أحدهما فيتحدثان عن يافا وعن محاسنها وعن مساوئها وعن اليهود وعن غدرهم وخيانتهم للعرب طيبي النية وبقدر ما كان أبو عبد الله يمدح اليهود والأجانب ويقول: إنني أعرفهم لقد اندمجت معهم عدة سنين، بقدر ما كان يقول هذا صار يكيل لهم السباب والشتائم ويصفهم بأنهم أنذاك سفلة وحثالة الشعوب)"10".
فالراوي يؤكد في أسلوبية الرواية منذ البداية على مهمته الأساسية في جمع مخزون ذاكرته ونقله محاولاً رص الأحداث رصاً لا يسمح للقارئ معه أن يتهرب من سيطرة مشاعر القلق والتعاطف مع قضية إنسانية عادلة هي القضية الفلسطينية والإنسان الفلسطيني المنفي قسراً خارج أرضه وترابه، ولذلك فإن الراوي يسوق لنا أفكاراً تشغل قضاياها بال الإنسان المعاصر.
وهكذا كان المؤلف راوياً عليماً بكل شيء، والمبدع الحقيقي لا يكتب طبقاً لأنماط معرفية جاهزة ومحفوظة بل يختبر وعيه بمذاق الحياة من حوله مما يحقق تكاملاً فنياً عبر ثلاث حلقات هي: الراوي والكاتب والمروي له، وقد تندمج وظيفة الكاتب والراوي في شخص واحد هو الكاتب نفسه ليكون الكاتب الراوي كما في رواية "لا تغرب الشمس".
الهوامش
1 ـ رواية "لا تغرب الشمس" ـ فخري قعوار ـ وزارة الثقافة ـ 2008
2 ـ مصدر سبق ذكره ص "73"
3 ـ تحليل النص السردي ـ محمد القاضي ـ سلسلة مفاتيح ـ دار الجنوب للنشر ـ تونس 1997 ـ ص"71"
4 ـ مجلة ( فصول المعرفة ـ م13 ـ ع "1" ـ ربيع 1994 ـ عدد خاص بألف ليلة وليلة ـ ص "261"
5 ـ مصدر سبق ذكره ص "260"
6 ـ مصدر سبق ذكره ص "278 ـ 269"
7 ـ الرواية العراقية وقضية الريف ـ باقر جوار الزجاجي ـ دار الرشيد للنشر 1980 ص "203 ـ 303"
8 ـ مصدر سبق ذكره ص "75"
9 ـ مصدر سبق ذكره ص "17"
10 ـ مصدر سبق ذكره ص "269 ـ 270"
تيسير السبول
"أنت منذ اليوم"
رواية اجتماعية بامتياز
إن تصوير التغير في حياة الأفراد والجماعات كان وما زال موضوع الادب الجاد منذ أيام أرسطو وهو القائل: "إن المأساة تصور انقلاب الحال وتغير الحظوظ والمفارقة المأساوية بين الأمس واليوم وبين النية والنتيجة" وما زال موضوعاً أثيراً في الرواية العربية منذ نشأتها وبالذات في أوج ازدهارها على يد كتاب كنجيب محفوظ ويوسف إدريس. وقد عرَّف الاستاذ يونامي دوبريه الرواية بأنها (ذلك الشكل الادبي الذي يقوم مقام المرأة للمجتمع بما أنها إنسان في المجتمع أحداثها نتيجة لصراع الفرد مدفوعاً برغباته ومثله وصراعه ضد الآخرين وربما مثلهم أيضاً وينتج عن صراع الإنسان هذا للملاءمة بينه وبين مجتمعه أن يمزج القارئ بفلسفة ما أو رؤية عن الإنسانية) ومن هنا كانت الرواية أقدر فنون القول على تصوير التغيرات الاجتماعية وكان كتّاب الرواية إذا أوتوا التاريخية السليمة والنظرة الاجتماعية الثاقبة إلى جانب موهبة السرد وبراعة البناء الفني خير من يسجل التغير ويستشعر حركة المجتمع ويجسد الإرهاصات الدقيقة بإيحاء المستقبل قبل وقوعه.
والمكتبة العربية زاخرة بالرواية على اختلاف أنواعها ودرجات إتقانها وبراعتها الفنية، وهي جهد يحمل في صفحاته من المعلومات عن المجتمع العربي الحديث في تطوره.
وجدير بالذكر أن كاتباً هاماً كتيسير السبول جرب يده كفرد من جيل النكسة التي وقعت في عام 1967 في كتابة الرواية.
السبول يطلع علينا قصاصاً بارعاً يحسن السرد والوصف ويسوق التفاصيل التي تساعد القارئ على تخيل صورة المجتمع موضوع الحكاية، وتعبير روايته "أنت منذ اليوم" الصادرة عن دار النهار اللبنانية عام 1968 تعد وثيقة اجتماعية هامة عسى أن تلفت نظر زملائنا العاملين في ميدان العلوم الاجتماعية.
على أن أهم ما يلفت النظر في "أنت منذ اليوم" هو تصوير تيسير السبول للتغير الذي يطرأ على حياة المواطن الأردني والعربي إثر هزيمة حزيران 1967 فإن "أنت منذ اليوم" مقال للرواية التي لا تضيف كثيراً للتراث الفني للرواية العربية ولكنها ذات قيمة عالية كوثيقة اجتماعية وتاريخية.
لقد صوّر تيسير السبول حياة الطبقة الوسطى الاردنية من نكسة 1967 وما بعدها وقد تمثل فيها غالبية ما جرى ذكره في تلك الفترة من أحداث يعرفها قراؤه كأنهم عاشوها لأنهم قرأوها مجسدة في تاريخ أسرة بالذات وشخصيات حية على يد كاتب واسع المعرفة في مجتمعه ونافذ البصيرة.
عالج تيسير السبول فن الرواية فيما عالج من أشكال أدبية لكنه لم يحفل كثيراً بما يشغل النقد الحديث في البناء والحبكة وتصوير الشخصيات والإيحاءات بالجو والخلفية وغير ذلك مما يعالجه نقاد الرواية اليوم، وهو يحسن السرد والوصف وقد اتخذ من الأدب الكلاسيكي نموذجاً احتذاه وكانت النتيجة مثالاً هاماً للجمال الفني في وضوح وبساطة واحتشام، وهو لا يحفل بالتخطيط لحبكة الرواية ولا يقصد إلى جذب القارئ بإخفاء عناصر من الحبكة ليكشف عنها في النهاية بل نجده يسرع بإلقاء الخبر حتى يفرغ إلى التعليق والتحليل وإلى ما يثيره في المستمع/ القارئ من جدل ونقاش.
ولعل السبول استفاد مما قاله عميد الأدب العربي طه حسين في روايته الشهيرة "وراء النهر" الصادرة عام 1974 وهي آخر رواية كتبها: (ليست القصة حكاية للأحداث وسرداً للواقع كما استقر على ذلك عرف النقاد والكتّاب. وإنما القصة فقه لحياة الناس وما يحيط بها من الظروف وما يتابع فيها من الأحداث. وهو تقديمه لرؤيته وتحليله) لحياة الناس وما يحيط بها من ظروف، لا يدّعي أن شخصيات روائية من وحي الخيال ولا يقبل أن تفرض عليه قيود في معالجته للعمل الفني أيا كان مصدرها وهدفها.
يقدم لنا تيسير السبول شخصية هذا "العربي" محور الرواية وبطلها اللابطل الفاشل الذي شاع في روايات القرن العشرين ربما ركب المؤلف شخصية بطله على صورة إنسان حقيقي لكنه عالجها بالتحوير والتعبير وأدخل على حياتها عناصر ووقائع لم تحدث غالباً وإنما هي من حيل المؤلف تخدم عرضه بتصوير شخصية خيالية يسيرها السبول، لا يحفل بأن يبتكر لبطله أسلوباً يميزه عن أسلوب الراوي، أي الكاتب نفسه.
يدرك القارئ المتمرس بقراءة الرواية التناقض الواضح بين أسلوب الكتابة الكلي المنطلق في تمكن والتكنيك البدائي في سرد الرواية، فتيسير السبول يلجأ إلى أقرب الأدوات التي استخدمها رواد فن الرواية في القرن الثامن عشر لحل مشاكل السرد في تحديد وجهة النظر وبيان زاوية القصة.
فالراوي يقص الأحداث بضمير الغائب والبطل يتحدث بضمير المتكلم في أحاديث مطولة إلى الراوي يصف ما يمر به من أحداث وما تفور به نفسه من مشاعر.
واستخدم الأحاديث والوصف أحياناً وسيلة تقليدية لرواية الأحداث من وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر الراوي أو من موقع بعيد عن موقعه.
يعمد المؤلف بعد إثبات صبغة العربي ليلبس هذه الخاصية شخصية من لحم ودم فيقدم صورة ساخرة تقوم على التناقض بين صفاته وأخلاقه الجميلة وقبح وصفه:
(تحدث عربي عن مصرع القطة وتحدث عن أماسي رمضان في القرية وعن أبيه النحيل ذي العينين كعيني الصقر.
سرد قصة الحناجر الستّ والحزام الجلدي العريض الذي يثنيه عندما يضرب زوجاته به ليكون أشد وقعاً. رآه عربي يستعمل الحزام الجلدي كثيراً، لم يره في الهجيج إبان رحيل بني عثمان إلا أن الرواة أكدوا أنه رجل بندقية ممتاز.
لكن من الذي سلخ جلدها عن رأسها؟ إما الكلاب أو القطط الأخرى لا يبدو لك الأمر مهماً ألا ترى؟ فالقطط هي أخت لها) ص 10.
ذكرنا أن تيسير السبول لا يصطنع للشخصية التي ابتدعها أسلوباً مميزاً يختلف عن أسلوبه هو راوياً ومتحدثاً، ونجد في حديث البطل الذي يصف المدينة الفريدة وما طرأ عليها من حروف الأيام:
(مدينة فريدة على أطراف الصحراء قامت على مخيمات اللاجئين والمعسكرات بيوتها من الطوب الطيني تسفيها الرياح الخماسينية صيفاً بلا هوادة إلا أنه يلاحظ الفارق، الطلاب أنظف ويتحدثون عن السينما والوطن والكتب والأحزاب بشكل باهر الوضوح قال للرفاق بأنهم عانوا من نقص الكراسات العقائدية هناك وأنه يعترف بنقص ثقافته ويريد المزيد فطمأنوه وامتدحوا رغبته.
أصائل هجير اللاهثة من الظهيرة ما تزال) ص 16.
إن القيمة الحقيقية لرواية كهذه في الخيط الرئيس للقصة ليست في آلام العربي الثائر المثقف وبحثه عن الوطن وعذابه وحيرته وشوقه إلى الصحبة الأنثوية لكن القيمة الحقيقية في سخريته من الأعلام والكتاب ومن الحوادث التي تعرض لها الأعلام والأدباء وطريقة تناولهم أحداث النكبة: (استمر المذيعون يشتمون.
وقرأ عربي مزيداً من الصحف والشعر كلهم غاضبون بسبب النكبة إلا أن عربي لم يفهم.
كان قد سئم من الخادمة واستمر يجوس في جسدها الأبيض ثم يكتشف وساخة وجهها فيتقزز.... وحين قلت له فتاة نظيفة الوجه أنها لا تمانع في أن يعريها فعل وكفّ عن الخادمة وأيضاً ضجر من الأخيرة) ص 20.
إن قيمة سرد العربي تنطلق حقاً بمقومات حياته وبالقيم الأساسية التي تحكم مجتمعه والتي أدت إلى هزيمة نكراء تعرضت لها الأمة، وهذه الرؤيا السياسية الاجتماعية تحدد دور الشخصيات في الهزيمة حسب وضعها الطبقي ودرجة وعيها السياسي:
(واستمر يقرأ ما يكتبه الأدباء والصحفيون والسياسيون عن مصير الأمة، واعتقد أن هذا الذي كتب يكفي لتسويد دجلة ثلاثة أيام كاملة. وقال المذيعون بعد مدة: ان الذين ذبحوا أعداء الشعب سابقاً هم أنفسهم أعداء الشعب وإن جلود رؤوسهم حرية بالسلخ واعتقد أن هذا سخيف) ص20.
تستند هذه الرؤى السردية إلى تصّور نظري يرى في رحلة الكائن البشري على الأرض برنامجاً منظماً ضمن مسار يربط بين شكلين من أشكال الوجود القيمي: وجه مجرد يحتوي على النماذج العامة التي تختصر الحالات الثقافية في أحكام تضيفه عامة (كالصدق والأمانة والخير والشر والموت) ووجه مشخص يشير إلى النسخ المشتقة من هذه النماذج، وتشكل هذه النسخ ما يشبه التركيب السطحي المنظم للقيم في حالات مخصوصة (كل الأوضاع التي تجسد هذه القيم ضمن حالات حكائية متنوعة).
وعلى الرغم من إمكانية الفصل هذه بين الشكلين فإن الترابط بينهما وثيق جداً لدرجة أننا لا يمكن أن نتصور هذا الحد دون إثارة الحد المقابل، فالنماذج لا يمكن أيضاً فهم النسخة واستيعاب دلالاتها استناداً إلى ما تقدمه النماذج ويعد النموذج في مفهومه البسيط سلسلة من التراكمات المندرجة ضمن الدفق الزمني لسلوك مفرد يتميز بالتكرار. وركب تيسير السبول هذه التقنية من السرد على الحبكة الأصلية وهي موضوع مقاومة الأمة للهزيمة:
(وقلّت رغبته في قراءة ما يكتبون لأنه مثل الكراسات الصغيرة شيء معاد. وحنق عربي على نفسه لأنه بعد أن يضجر من جسد البنت العاري لا يعود راغباً في أن يلمسه.
من حين إلى حين رأى أناساً يملأون الشوارع متصايحين: بغض ضد الحاكمين فيذهب الحاكمون إلى جهنم لا أسوأ منهم بشراً) ص21.
إن هذا النص في تصوره السردي ينبى من خلال إسقاط مسار توليدي يحدد المستويات التي تحتضن السيرورة المولدة بمعنى (لا وجود للمعنى إلا من خلال سيرورة ما) بهذا المسار يقود من أشد المستويات تجريداً ـ ذاك الذي يمثل داخله المعنى على شكل حدود مفهومية مجردة غير مسيجة بأي سياق أي وحدات منتظمة ضمن علاقات نمطية لا تحيل سوى على ذاتها إلى أكثر المستويات محسوسية تلك التي تتحول داخلها القيم المفهومية إلى قيم دلالية مدركة من خلال وضعيات إنسانية حيث تتحرك الشخصيات وتفعل وتسافر وتقيم صداقات وتنبرى للدفاع عن مصالح ـ وفق خطط معيارية ثابته تتخذ شكل مستويات مترابطة فيما بينها.
ولكن هذه المعاني السردية لم يعلقها الكاتب على مجرد رمز معنوي بل أضفاها على دوامة حقيقية:
(قال الأديب
ـ أخي... الأزكو أزمة ديمقراطية اسرائيل والاستعمار قضية ثانوية الأزمة هنا ... في الداخل الديمقراطية.
ووضع مخللة في فمه التهمها بسرعة وشرب للتوّ جرعة أخرى من العرق:
ـ ما رأيك أستاذ عربي؟
كنت مهتماً بالبحث عن فستق بيده وعنبة وجدتها في الصحن كله.
ـ بماذا؟
ـ بحقيقة الأزمة) ص27.
حقق السبول هذه التفصيلات السردية في عمليات استدعاء للذات (كائن ما تنسب إليه أحداث) يشير وجودها إلى إمكانية القيام بفعل ما فالمعنى لا يمكن أن يوجد خارج الدائرة الإنسانية التي تشير إليها كائنات هي المنتجة للمعنى وهي المستهلكة له وهي أولى ضحاياه.
إن هذا التصور يحيلنا على فرضية أخرى تتعلق بتحديد البؤرة الأساس التي تتجلى فيها ومن خلالها الحالات الدالة على الوقائع السردية، فعلى الرغم من أن الطابع السردي معطى من خلال الفعل المدرج ضمن حركية الفعل الإنساني الذي يقود من حالة إلى حالة عبر رواية أحداث تدرك من خلال الزمن باعتباره مدى محسوساً بين الأفعال فإن الإمساك بجوهرها لا يتم في مستوى التجلي المباشر فالسردية لا توجد في المستوى السطحي حيث تأخذ القيم أبعاداً مشخصة أي في اللحظة التي تصب فيها الحياة في أوعية زمنية تلغي الحد المتصل وتحدث فيه شروخاً لتسلسل الشخصيات إلى مسرح الأحداث ضمن وضعيات إنسانية محددة.
إن البحث عنها يجب أن يتم في بؤرة أخرى، إنها موجودة في البنية الدلالية المنظمة على شكل محاور سابقة في الوجود على التجلي المحسوس للوقائع السردية ويمكن تحديد هذه البنية الدلالية المفصولة عن أي سياق، أي خالية من أي بعد زمني من نوع (خير ـ شرـ صدق ـ كذب ـ حرية ـ استبعاد) فهذه المحاور موجودة هنا لا أقل ولا أكثر فهي لا تدل على حالات تدركها العين المجردة ولا تشير إلى فعل ممكن، إنها تحتضن وضعاً يحيل على الحالات الأولى للتجريد القيمي، على أن من حق الكاتب أن يحتفظ بالقيم إذا أراد ولكن يتحتم عليه أن يجعل لها دوراً في الحدث يبرر وجودها في مركز الرواية وهذا ما يفعله كاتبنا.
القيمة في الرواية هي نفس القيمة في فترات مختلفة من عمر الشخصية الرئيسية في الرواية والحاملة لنفس القيمة سواء أكانت هذه القيمة تعمل في المجال الحزبي أم تعيش خارج الإطار الحزبي وحتى وهي تنظر للهزيمة.
بقيت الشخصية في محور الرواية في "قلوب خاوية" فلم ينفعها هذا كثيراً لأن العربي كان مشغولاً بهموم الأمة وبمشكلاتها السياسية والاجتماعية ولم تكن مشاكله العاطفية هذه ذات صلة ضرورية بحياة المدينة التي يعيش فيها العربي، ولولا وجود فكرة الهزيمة التي لاحقته بتداعياتها السياسية والفلسفية لبقي العربي الراوي ـ والقارئ معاً ـ في سجن الجنس والرغبات المبهمة حتى النهاية.
ولعل إدخال شخصيات أخرى في الرواية يعفي الكاتب من ربط أجزائها ربطاً محكماً، فهو يدخل هذه الشخصيات لمجرد أن الراوي التقى بها في مكان ما ثم تختفي هذه الشخصيات لمجرد أن الراوي لم يعد يقابلها مثل الزعم الذي آمن بفكرته، والطالب الجامعي الذي يرافقه أثناء دراسته في الجامعة ونساء البنسيونات اللواتي يصادفهن أثناء تنقله بين البنسيونات .
وربما كان في نية المؤلف أن يظهر التناقض بين حياة اللهو في المدينة وبين ما تعانيه حياة معسكرات اللاجئين، وهو من الموضوعات الرئيسية في الرواية، ولكنه لم يعن بمعالجته فنياً بحيث يصبح جزءاً من نسيجها.
كان تيسير السبول من كتابنا القلائل القادرين على تصوير المناضل السياسي الأردني ودمه، وهو بارع في صياغة الحوار السياسي وفي شد انتباه القارئ إلى روايته فلا يملك أن يضعها جانباً حتى يتمها وهو روائي قومي والرؤية القومية لا تتعارض كما أسلفنا مع الرؤية وأحكام بناء الرواية وإتقان صنعتها.
غالب هلسا
"وديع والقديسة ميلادة وآخرون"
(دراما ساخرة)
غالب هلسا روائي ومترجم أردني من مواليد ماعين جنوب عمان عام 1922، كتب القصة القصيرة والرواية، وترجم العديد من النصوص. له مجموعتان قصصيان هما: "وديع والقديسة ميلاد وآخرون " عام 1968، و"زنوج وبدو وفلاحون" عام 1976، وله ثلاث رواسات هي: "الضحك" عام 1970، "سلطانة" 1987، ورواية "الروائيون" عام 1988، وترجم "جماليات المكان" لفاستون" عام 1980، ورواية "الحارس في حقل الشافون" لـ ج. د. سالنجر عام 1978. وموضوع قراءتي النقدية في هذا المقال مجموعته القصصية "وديع والقديسة ميلادة وآخرون" الصادرة عن دار الثقافة في القاهرة في عام 1968.
ينقسم كتاب "وديع والقديسة ميلادة وآخرون" إلى خمسة عناوين، الأول بعنوان: "البشعة"، والثاني "اغريب"، والثالث" عبد ميلاد"، والرابع "العودة"، والخامس "وديع والقديسة ميلادة وآخرون" .
وما يعنيه الكاتب بوديع والقديسة ميلادة وآخرون هو تجليات من حياة وديع نرى فيها بعض ملامحه الفكرية والنفسية والسلوكية، وهنا يتوقف القارئ أمام هذا العنوان ويتساءل: هل هذا مجموعة قصصية أم رواية؟
وأجيب عن السؤال بأننا أمام رواية اختار لها كاتبها هذا الشكل الخاص من أشكال الحكي، وليس من حقنا أن نلومه لأنه لم يكتب روايته في الأشكال المعتادة، والتلقي الحر لعمله يلزمنا أن نقرأها في شكلها الخاص كما تبلور في عقله وقلبه ووجدانه دون أن نفرض عليه من خارج تجربته شكلاً نبحث عنه ونفتقده وينقصنا وجوده.
وقد اتسم بعض فصول القصص بطابع كاريكاتوري اختلط فيه الجد بالهزل، وهنا أود أن أهيب بالقارئ أن يتجاوز هذه القشرة وأن يقرأ "وديع والقديسة ميلادة وآخرون" باعتباره عملاٍ فنياً جاداً امتزج فيه الضحك والحزن وارتدى فيه الراوي مسوخ المثقف الحكيم حيناً والموظف المسكين والزوج المغلوب على أمره حيناً والمهرج أو البليا تشو حيناً أخر .
تعتمد القصص على نظام روائي يمتاز بالدوائر وأن الراوي يقبع في قلب هذه الدوائر، فمثلاً نجد إشارة إلى اسم شخصية ما أو حدث ما في القصص الأولى ولكن الدائرة لا تكتمل إلا بعد عدة قصص وربما في القصص الأخيرة من المجموعة القصصية، وعلى سبيل المثال فإن "نجمة" تقليدية في القصة الأولى بينما هي تنبض بالحياة حتى السطور الأخيرة من القصة وتساعد الكاتب على ذلك، سواء عن تخطيط مسبق أو عفواً أثناء عملية الخلق الإبداعي، كما أن تعدد (الثنائيات) داخل العمل يجعلها ثنائيات تبدو متباعدة بعضها عن بعض وأن كل ثنائية يضمها عالم خاص وتفاصيل شديدة الخصوصية ولكن يجمع كل هذه الثنائيات خيط واحد هو... الحب.
واعتقد أنه كان من المستحيل تجميع هذه الثنائيات إلا من خلال شخصية مثل شخصية الراوي، فهو (مدمن) التردد على الحارات والأزقة والمقاهي، وهذا ما أتاح له التعرف على العديد من الأشخاص الذين تراوحت معرفته بهم بين الصداقة العميقة والتعارف العابر. كما أن الراوي متعدد الجوانب النفسية والعقلية، فهو في أحيان أقرب إلى الناس والأشياء وفي أحيان أخرى يكون شديد القسوة حتى على أرحامه: أمه وأخواته، وأحياناً يكون شديد الرومانسية، وفي أحيان أخرى يتبع أسلوب الإنسان الحذر، ثم نراه في مواقف أخرى شديد التهور إلى درجة الجنون.
والرواية تطرح سؤالاً لم يكتبه الكاتب ولكن القارئ يستنتجه، وهو: لماذا اهتم الراوي بتجميع ثنائيات الحب، خاصة وأنه في لحظات كثيرة يكون أقرب إلى شخصية الإنسان العبثي؟
تأتي الإجابة من علاقة الراوي بحبيبة عمره... قريته ماعين. هي علاقة شديدة الرومانسية في مناخ شديد الواقعية، بل إنها واقعية فتتردى في أحيان كثيرة إلى درجة الانحطاط، واقعية يغلب عليها تجاهل أي بعد إنساني في علاقة البشر بعضهم ببعض. تصل رومانسية الراوي إلى درجة أنه كان يرى "ماعين" امرأة معشوقة لا تتبرز أو تتجشأ أو تتعرق أو تتنفس مثلنا.
(نهضت بحركة عنيفة وأصبح وجهها أقرب إلى وجه الأم وقالت :
ـ ألا يكفي ما أنا فيه؟ ألا يكفي أنهم زوجوني لرجل كسيح حتى تسولوا على أرضه .. ألا يكفي أنني كنت خادمة لنسائهم! وها أنا الآن سيموت رجل بسببي .. ماذا فعلت .. ماذا فعلت حتى أستحق هذا ..!
صمتت المرأتان .. وعندما تكلّمت الأم كان صوتها يأتي من بعيد.)"1"
إنها ثنائية الحب، بطلتها امرأة عشيقة الراوي التي أظهرها بالقدسية التي هربت من جحيم أنوثتها إلى جحيم رجل مقعد في القرية وفي كلتا الحالتين ظهرت هذه المرأة القديسة معذبة مهانة الكرامة لا قيمة لها غير جسدها.
هذه الإشارة البالغة الدلالة تبدي لنا كيف استطاع الراوي توظيف الجملة القصصية بنفس روائي متحرك يعتمد على الرؤية الدرامية. فنراه يقول: (هذا حكم على المرأة يا ابنتي أن تنال قليلاً من المتعة وشقاء لا حد له. إنها تستلقي ويعلوها الرجل ويذلها. عليها أن تتحمل آلام الوضع والحبَل، أن تتحمل المهانة والضرب ووجود ضرة لها وليس لها أن تحتج)."2"
إذاً نحن مشروع روائي يعتمد على الحكاية التي تطرحها الرؤية الروائية لغالب هلسا "وديع والقديسة ميلادة وآخرون"، فهي رؤية تتحدث عن نفسها أنها تستدعي مفهوم المعجم الذي ننتجه لكي نعرف معنى الكلمة، هي رؤية تفسيرية تدور في أفقها دوال الحقل الدلالي للمفاهيم الحكائية (الألفاظ الخاصة بالأفعال التي تنتج الحكايات بصورة مباشرة حيناً وبالمجاز التمثيلي حيناً أخر). إن الأفعال الدرامية المتكررة فيها أفعال رواية الحكايات من أصوات متعددة وتصوير الراوي المسؤول عن البنية التأليفية للعمل هذه الشخصيات وهي تؤدي فعل الحكاية وتعيش لحظات المحاكاة، مثلما تطرح قصيدة ما، فعل الإبداع الشعري وألفاظه المتداولة في المنظومة الثقافية في فضائها أو تصور الذات الشاعرة بلحظة الإبداع أو تقدم تلك القصيدة أو المفترضة مجموعة من الألفاظ المعايشة للحظات أداء الخطاب الشعري في سياق التلقي.
من هذا المدخل يصبح المتناول النقدي لـ "وديع والقديسة ميلادة وآخرون"، من خلال كونها نصاً درامياً شارحاً لطبيعة الإبداع الحكائي، أمراً مشروعاً، ولكن هذه المقاربة لا تصادر البعد الدرامي التصويري للرؤية، كما أنها لا تنفي عنها الحيوية المستمدة من عالم يوازي مرجعية الحياة الاجتماعية المحيطة بسياق الإنتاج النصي في الإنشاء والاستقبال.
إن المتن النصي لوحة تعرض تصور الذات المبدعة للواقع الذي تعايشه داخلها وخارجها بعد أن قامت حواسها وذهنها وحدسها بعملية الإدراك وأصبح لديها جنين يندفع للحياة ويبحث عن اسم يمنحه هويته، وهذه الذات تقوم بعملية التوظيف الرمزي بما يحقق تجسيدًا لصورة ممتدة في فضاء ذاكرتها الإنسانية والإبداعية، وهي تسعى من خلال هذه الرموز إلى طرح قضية إعادة قراءة الواقع بتفاصيله كافة مع كل مصافحة تومض بها صفحات النص حين تلمسها بصيرة الأخر.
وحينما نذكر أسماء الشخصيات في نص غالب هلسا "وديع والقديسة ميلادة وآخرون" سنملي تلك العناوين التي تسمح بالحركة الذهنية في مدار ما وراء العلامة.
إن المنطقة المعرفية التي تدور فيها الدوالُّ المحورية للكاتب أو المفاتيح التي يدير بها المؤلف تنظيم المعمار النصي ومسارات المعنى الحكائي هي مؤشرات درامية للقضية الأساسية التي ينحو الكاتب للتعبير عنها بأبجدية جمالية يمكن أن تطرح مجموعة من الجمل النصية (القصص والروايات) النابعة من بنية عميقة متصلة بها اتصالاً وثيقاً لكي تتم عملية تشكيل المعنى الكامن في فضاء السرد من قبل الذهنية القارئة، بمعنى أخر أكثر بساطة : إن أعمال غالب هلسا تستند إلى خلفية جمالية وفكرية تحدد طبيعتها وتمنحها حضورها وهويتها.
كان العنوان الأول "البشعة" الذي قدم اسم غالب هلسا المبدع إلى سجل الحكائي في قائمة مبدعي السرد وكتاب القصة القصيرة هو (نسيج الأسماء)، وليس من شك في أن الكاتب الذي اختار لمجموعته هذا الدال يبحث عن هوية العلامات، فالنسيج هو النص، هو خطوط الطول والعرض التي تحدد توقيت المعاني.. إن التوقيت صور حد إدراك الذات للزمان .. أو إدراك الزمان للذات .. فهذه حركة جدلية بين طرفي الإدراك..
وهذه الفكرة هي ذاتها المرتكز الدالي في "وديع والقديسة ميلادة وآخرون"، في "نسيج الأسماء" هناك تجاوز لمفهوم العلاقة السذاجة السويسرية الشهيرة التي تحكم ارتباط الدال بالمرجع وتؤسس"اللسانيات " الوصفية بمعزل عن التاريخ أو رؤية العالم. وعنوان هلسا لا بد أن يستدعي هذه المنطقة السينمائية. إن الأسماء هي مفاتيح المعرفة، ونسيجها خيوط متصلة متناسقة مضى الإنسان في تاريخه يغزلها في محطاته الإدراكية التي شكلت خصوصيته.. النسيج هو النص .. والأسماء هي وحدات الأبجدية المعرفية التي تنتج أفق المجتمع الإنساني للتأمل والتعبير والتواصل والتقدم من خلال عملية تفاعل الجماعة الإنسانية الروحي والذهني عن طريق النصوص، وإن كل نص يحمل اسماً منحه روحه وشكله ودلالته وكل روح مبدعة أنجزت نصاً جميلاً من رحلاتها .. من نسيجها، وتظل الأسماء علامات تستحضر هذه الأرواح، ويظل تحليل النصوص بحثاً دائباً عن نسيج الروح المبدعة.
كتب الروائي والمسرحي الفرنسي جان جينيه مرة أنه كذب كي يقول الحقيقة! وعندما التقيت به في بيروت عام 1984 سألته عن معنى الكذب، ضحك الكاتب الفرنسي ولم يجب، رفع يده إلى الأعلى كي يبعد عن جبينه حكاية علاقة الكتابة بالكاتب وقال: إنه لا يحب الكتابة.
"كتبت لأنني كنت سجيناً، قال، وعندما خرجت من السجن انتهى الموضوع". "لكنك تكذب، قلت له، فأنت كتبت جميع مسرحياتك بعد خروجك من السجن". سكت الكاتب الفرنسي وقال: إذن هو الجواب.. تكذب كي تكتب)"3"
وفي نص "وديع والقديسة ميلادة وأخرون" أمام غالب هلسا العلاقة بين أن نكتب وأن نكذب على حرف صغير يتوسط الكلمتين: وذهب في تهويمات ذلك النص الرائع إلى الأقصى ليلعب مع نفسه ومع قارئه لعبة المرايا.
وبالطبع لا ننسى ما قالته العرب "أعذب الشعر أكذبه". لا أريد من هذه المقالة القول: إنني سأكذب على القراء رغم أن تفسير البلاغيين العرب لمعنى الكذب الشعري عبر وضعه في إطار المتخيل يجعل من كل كتابة أو كلام كذباً في شكل من الأشكال، لكن الكذب الذي تمت ممارسته في نص "وديع والقديسة ميلادة وآخرون" هو كذب ممتع، فغالب هلسا جعل من الأرض مسرحاً والشخصيات تلعب على هذا المسرح، بمعنى أدق: مسرح النص. صحيح أن متعة المتفرج في المسرح مبنية على ضرب من الوهم، فالمتفرج عندما يتوحد بالبطل الذي يوشك أن يتصرف ويتألم على المسرح يعلم أن ذلك ليس سوى تمثيل لا يمكن له أن يهدد أمنه وبوسعه إذن أن يسمح لنفسه بالتمتع بأنه رجل عظيم أو امرأة عظيمة "بالنسبة للمتفرجة" وأن يستسلم لدوافعه المكبوتة دون تردد، ويتيح له التوحد بأبطال كثيرين أيضاً، أي أن تكون له عدة حيوات، فالمسرح تعويض عن فنائنا، والحياة لعبة مصادفة يتعذر فيها أن نستدرك ضرباتها، ولعبة الفن "المسرح" تبيح التكرار على نحو ما، فلا غرابة أن يتحدث المتفرجون في عالم التخيل "العرض" عن تبديل لما كانوا قد افتقدوه في الحياة حيث يجدون فيه "أي: العرض" أناساً يعرفون كيف يموتون أو يخططون حتماً ليقتلوا شخصاً أخر .
وعبر التخيل يجد المتفرج تعدداً من الحيوات التي يحتاج إليها، فهو يموت كالبطل الذي يتوحد به، وهو مع ذلك يظل حياً بعده ومستعداً للموت مجدداً مع بطل آخر، فالمتفرج يظل على هذا النحو في حالة من العافية والسلامة، والفن "المسرح" يمنح الجمهور لذة نرجسية شبيهة باللذة التي يمنحها الحلم، ويلعب التوحد فيها دوراً مهماً"4"
وما دام المسرح إعادة عرض يقدم ما سبق حدوثه ويستعيد ما كان معاشاً سلفاً، فإن ما ينتج عن هذا المسرح من متعة عرض راجع لارتباطه بالماضي ولحتمية انتهائه، وهذه المتعة مرتبطة بإشكالية الزمن الماضي ومحاولة استرجاعه ومحاكاة أحداثه والتمتع "بـ " من جديد: عن طريق متعة حضور فعال ومكرر.
غالب هلسا قدم نصه كمسرح يتمظهر فيه كمؤلف نص مسرحي ليتحول القارئ إلى متفرج:
(ومن يستطيع أن يمنع الناس أن يتكلموا؟ كلامهم لا ينتهي أبداً.. كلام حساد وكلام من لا يجد شيئاً يقوله.. النساء يتكلمن كثيراً فالمرأة عقلها في أسفل وإن لم تجد من يدوس على ذيلها فستقول ما يحلو لها. ليس يهمها إن امتلأت القلوب بالشر وقام الرجال على الرجال.
على إبريق الشاي واندفع الماء من فوهته فأطفأ وابور الجاز فزعقت الأم:
ـ يا مقطوعات النصيب
تتالت صرخات عصبية بين النساء وزغدت إحداهن الأخرى وهي تهمهم بصوت مشحون منخفض، ورنت صفعة على وجه طفل فعلا بكاؤه .. ثم هدأ كل شيء وعاد صوت الوابور)"5"
استطاع غالب هلسا أن يقدم لوحة مسرحية جوهرها نص قصصي درامي يجعل القارئ يتمكن من متابعة النص بتأن من أجل جمع الصورة الدرامية في ذهنه بشكل بطيء، فالقارئ لا يمكنه رؤية كل العلامات معاً بلمحة بصر وبالتالي فإن الأمر يتطلب تجمع العلامات المكونة للصورة لبنائها كونها تقدم غير جاهزة، فنحن لا نراها إلا عبر أجزاء. وهو ما يتطلب أيضاً بعض الإسراع كي نحصل على الصورة من خلال ما نلتقطه من سيل العلامات ضمن حيز زمني محدد.
وقد تجعل الصورة الدرامية للقارئ بأن يشعر بأن المتعة غير متكاملة، فهي تبقى سلسلة علامات رغم وجودها إلا أنها غير مرئية حقيقة فيمعن في رؤيتها من جهة ويجمع ما تبعثر منها من جهة أخرى، فيحصل على متعة عرضية، إلا أنه يكافح ضد هذه العرضية. إن كثافة العلامات وما يتاح للمتفرج من زمن ضيق يبحثان عن التساؤل:
ما هي الأشكال الكفيلة بجعل القارئ يتمكن من تجميع الصورة المبعثرة؟
وما هو الهدف من أن تكون هناك جدلية في العمل الدرامي بين كثافة العلامات وإمكانات المتفرج/ القارئ الإدراكية؟
ثمة ألفة غريبة بين نص غالب هلسا والمسرح في قصص "وديع والقديسة ميلادة وآخرون" :
(الطلبة حولهما صورة العالم بلا قيود .. أجسادهم في حركة دائبة طلقة داخل ملابسهم. ضحكت فتاة بالقرب منهما، نظر إليها وصمت، كان شاباً يزعق بشي وفتاتان تقهقهان..
قال: ((الثورة على القديم معناها تقاليد جديدة أكثر ملاءمة بس هيه كده"6".
لم تعد تصغي. كان صوته متشنجاً وطفلاً وخطان على جانبي فمه قد برزا استدلت منهما أنه يعاني ..)"7"
قصص غالب هلسا مقلقة مذهلة تحيا على متناقضاتها الداخلية التي تملأ رموزها .ولا أحسب أن الكاتب يأتي برموزها متقصداً أي معنى واضح ينصاع للمنطق. والثورة المتكررة هي نفسها مطلق هذه المتناقضات لأنه يحمل معاني لا تتحدد في ذهن الكاتب فهي إذن لا تتحداه في ذهن القارئ الذي يتلقاها كما يريد ويعطيها المغزى الذي يريده، بل إنها تعيد باستمرار تشكيل القرائن الذهنية والنفسية لديه كل مرة على نحو غابر، كما أن لكل قارئ قراره الخاص في تلقي هذه الرموز مهما تكن منطلقات الكاتب التي جاءت فيضاً من قريحته.
والابتكار أن تكون علامات مفاجئة لإشارة تخيل واقعاً خارج النص أو ابتكار لعب على النص يظهر جديداً في ذاته غير مرتبط بدال، وهو ما يتعذر لتعذر القراءة. والابتكار يتم بالاختلاف أو بكسر للرموز المعرفية "التقليدية" التي يعرفها القارئ. وإن كانت قدرة القارئ على ابتكار المعاني ليست مطلقة بل تخضع لطبيعة القراء وعاداتهم، إلا أن ذلك قد لا يمنع من أن يستمتع القارئ بما يقدم له:
(عندما انتهى الفيلم كان يسير بجانبها مطأطئ الرأس خجلاً..
قالت: أنا لازم أستعجل دلوقتي. ماما بتنتظرني في جروبي.
فقال محاولاً النكته: وأنا ماما بتنتظرني في الهيلتون.
لم تضحك وبدت اللحظة ضجرة وعينيها كالقناع. مدّ يده وقال:
ـ طيب فرصة سعيدة قوي .. متشكر على .. طيب أنا مستعجل جداً جداً
فشدّت على راحته وهي تبتسم في حنان:
ـ ما تمشي معايا يا أخي شوية.
وسارا.)"7"
إن غالب هلسا يتقن نصه ويجيد انشاءه ويجعل النص درامياً، عملاً متناسقاً من حيث الصيغة والأداء، محققاً لكل جزء فيه واقعية في التصوير يحسد عليها. وهذا بعض السر في قدرته على "خلق حالة من القلق لدى القارئ" :
إنه يقول شيئاً جاءه متكاملاً ولكن في شكل لم يألفه العقل، يطالب بمغزى يتراءى ويتحول كالسراب دون أن يتلاشى كالسراب ونبقى نحن مشدودين نتساءل لا يمكن أن ننتهي إلى جواب أخير، وهو لو انتهى إلى جواب أخير لانتقص من قيمة العمل الإبداعي الذي يجب أن يحتفظ بالكثير من لغزه وسره: وإلا لتهافت بين أيدينا عند عثورنا على الجواب.
الهوامش
1 ـ وديع والقديسة ميلادة وآخرون ـ غالب علسا ص"27" دار الثقافة القاهرة ـ 1968.
2 ـ مصدر سبق ذكره ص"27".
3 ـ أفق التحولات في الرواية العربية ـ دراسات وشهادات " باب الشمس" الحكاية التي حررتني، إلياس خوري ص"143"، إصدار دارة الفنون ـ مؤسسة عبد الحميد شومان ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ عام 1999.
4 ـ سارة كوفمان: طفولة الفن، ص 189 ـ 190 ـ 191.
5 ـ مصدر سبق ذكره ص"14"
6 ـ مصدر سبق ذكره ص"31"
7 ـ مصدر سبق ذكره ص"1
الرواية في الأردن بين الشكل والمضمون قراءات في الرواية الأردنية
تاريخ النشر : 2013-06-18