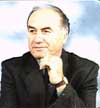قراءة قصيدة
يدُك
شعر : إبراهيم مالك
يدُكِ الفراشُ أم الحريُر
أم برعُمُ الفلِّ النضيرُ
أم ريشُ زغلول ِالحما
م وزغْبُهُ الغضّ الوثيرُ
أم وردةُ الجوريِّ في
نيسان يانعةٌٌ عَطــورُ
أم أنها حبقٌ سقا
هُ الكوثر العذب النميرُ
يا طيبَ لحظة نلْتقي
طفلان نحن فهل يضيرُ
أنّا نحاول وقفَ دو
لابِ الزمان ِ فلا يدورُ
لنروح نلهو ساعةً
والأفقُ ملعبُنا الصغيرُ
نغفو على حلُم ِ ويو
قظ روحَنا الشوقُ الحَرورُ
لا الجدولُ الرقراقُ يَر
وينا ولا النبعُ الغزيرُ
يدك ِ الفراشُ أخاف أل
مُسه فينخدشُ الحريرُ
تندسّ بين يديَّ في
حذر ٍ فينتشرُ العبيرُ
ويدبّ ملَء جوانحي
من طيبهِ خدرٌ مثيرُ
فأروحُ في غيبوبةٍ
نشوانَ تسكرني العُطورُ
يدُكِ الأسيرةُ في يدي
أم أنني وحدي الأسيرُ؟!!!
قراءة في قصيدة "يدك" لإبراهيم مالك
* د. فاروق مواسي *
منذ أن بدأت حكايات الغزل بدأت الوقفة مع لمسات اليدين تحسسًا للتواصل، فهذا أبو صخر الهُذلي يصف يده وتفتَّحها:
تكاد يدي تندى إذا ما لمستها
وينبت في أطرافها الورق الخضرُ
وفي الشعر الرومانسي كثيرًا ما تطرق الشاعر إلى اليد ونعومتها، ولكن لم يعمد إلى تخصيص قصيدة، كما فعل نزار قباني في أكثر من قصيدة من شعره ؛ ففي قصيدة "يدي" (الرسم بالكلمات ص 43)
يخاطب المعشوقة:
"أصبحت جزءًا من يدي
اسمك مكتوب على أبوابها
وجهك مرسوم على ترابها
تذكري
لعبت بالثلج على هضابها
وضِعت كالنجمة في أعشابها
كم مرة
دفأت كفيك على أحطابها
لا لست جزءًا من يدي
أنت يدي"
ولن أتناول هنا قصيدته الطويلة - "حوار مع يدين أرستقراطيتين" (سيبقى الحب سيدي، ص 97) ، فهذه تدل على قدرة وصفية أكثر مما تحمل شحنات انفعالية، رغم هذه الذروة التي أنهى بها :
أصابع موزارت
توصلني إلى حالة انعدام الوزن
وأصابعك
توصلني إلى الله
(أعيد نشر القصيدة في مجموعة نزار: مفاجـآت امرأة رومانسية، ص 106).
سأعمد إلى قراءة مصاحبة لنص الشاعر إبراهيم مالك في شيء من التفسير وشيء من الإضاءة، وذلك بغية خلق صلة بين القصيدة وبين المتلقي. ويستطيع المتلقي – مع ذلك – أن يفلت من "إسار" تصوراتي أنى شاء، فالخطوط والمعالم التي أرتئيها ليست ذات قدسية أذود عنها، وأنا أقرأ في نقدي لأداعب النص وأعايشه، أحلق في أجوائه متلمسًا جمالية أستشفها.
ويلاحظ القارئ أنني لا أمدح ولا أقدح، أي لا أحكم سلبًا أو إيجابًا، وإنما هي ملاحظات أتمثلها في نفسي من خلال معالجة النص.
في قصيدة إبراهيم – بدءًا – تساؤلات، هي بالتالي للتأكيد على أن اليد هي : فراش، حرير، برعم الفل النضير، ريش الزغلول أو زغبه، وردة الجوري، حبق سقاه الكوثر........ والمشبه به في كل مرة يدل على هذا الإحساس النديان بعذوبة اليد ، إذ هي وادعة بين يديه المتلهفتين.
ثم ينتقل الشاعر إلى وصف طيب لحظة اللقاء، وكيف أنه حاول أن يوقف دولاب الزمان، وعندها سيلهو وقتًا في مسرح الأفق، يغفو على حلم، فيوقظه الشوق. وهو في لهوه وغفوته ويقظته يظل يحوم في دائرة السعادة والجمال.
يعود ثانية ليصف اليد "الفراشة" التي يخاف أن يلمسها، وهو يخاف أن يخدش الحرير. وعندما تندس يدها بين يديه – في حذر – ينتشر العبير تدريجيًا مع وقعه. عندها يستفز الحذر المثير جوانحه، ويصاب في غيبوبة النشوة وقد أسكرته العطور، وهنا نتذكر ما قاله قباني:
لا تسألوني ما اسمه حبيبي أخشى عليكم ضوعة الطيوب
زق العبير إن حطمتموه غرقـتـــــم بعاطـر سكيـــــــب
( أنت لي ، ص 109 )
وتنتهي قصيدة إبراهيم بتساؤل فيه عودة إلى أسلوب "تجاهل العارف" فهل يدها الأسيرة أم أنه وحده هو ذلك الأسير؟!
وسواء أجبنا بالشق الأول أم بالآخر فإن كل إجابة لا تنفي واقع الحال في كليهما. والشاعر يصف عبر ملامسة أو عبر غفوة يدوية منتشية، وهو يحس أنه أسير بين يدي الهوى، بين يدي صاحبته، فيأمل أن يتوقف الزمان ليلهو، بين يديها ، ولينعم بالطيب والدفء والعبير والخدر – وهي أوصاف حسية لها صلة بالتجربة الشعرية، وفيها خيط الصدق ونسغه.
وأنا لا أتعجل الحكم على أن في قصيدة الشاعر معاظلة (تعبير ورد في نقد لعمر بن الخطاب) فتراكُب التشبيهات وتلاحقها يشيان بذلك من خلال توزيع الصور الحديثة في العقل اللاواعي.
وفي قول الشاعر: "لا الجدول الرقراق يروينا ولا النبع الغزير".
أرى هنا إحالة وغلوًا، وكان يمكن أن يكون بصوت أهدأ ، كأن يقول ( وعذرًا لأني أقترح ) :
"لا الجدول الرقراق يظمينا (أو يغنينا أو يجزينا، يسلونا...) لكي يبدو لنا وكأنه يذكر حبه في رقرقة مائة وخريره.
ويلاحظ القارئ أن البيت الثاني مركب بصورة تكاد لا تتوافق شعريًا، وذلك بما يستضيف من حشو غير مبرر، فما فائدة "الحمام" ولماذا "الريش" و "الزغب" معًا؟؟
كما أن عنوان القصيدة لم يحمل صورة فنية، بل هو يصلح لأن يستقبل أي معنى: من يد الإحسان إلى يد الله فوق أيديهم ، إلى يد الدهر........ ثم إن تأكيد "يدك الفراش" ألغى سائر الفرضيات .
إن القصيدة مع ذلك فيها وحدة موضوعية ، ففي تكرار (أم) نحس وكأنه يحمل آلة تصوير ، وكل (أُم) كأنها وقع صوت هذه الآلة للانتقال إلى صورة أخرى. حتى إذا وصلنا إلى البيت الأخير - إلى الأسر وصلنا إلى قصيدة وقد تكاملت عن يد المعشوقة - عن يد الآسرة.
لقد حافظت القصيدة على الوزن العروضي ، وكأن الشاعر يثبت بذلك خطأ الرأي الذي يرى أن العصرية والثورية والانطلاق يحد من صلاحية القصيدة القديمة، وأصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أن المضامين الجديدة يجب أن تكون في قوالب جديدة ، بل يغالون في التشبيه أو التمثيل إلى درجة التأكيد أن المضمون نفسه هو الشكل.
وفي رأيي أن القصيدة هي في بنائها الكلي وفي أدائها ومنطقها وبوحها ، وقد صدق الشاعر المرحوم عبد الوهاب البياتي إذ قال لي في لقاء معه في عمان:
إن الخطأ الذي يقع فيه الكثير من النقاد أنهم يفضلون هذا الشكل من الكتاب أو ذاك اللون أكثر من سواه ناسين أولاً وأخيرًا مسألة الإبداع ... والإبداع في رأيه" صاعقة خضراء لطيفة منعشة تحرك الدماء والقلوب وتثير الانتباه والوعي وتسبب النشوة".
ولعل في قصيدة إبراهيم تناصًا هو حوار داخلي أو تماثلي، فإذا قال إبراهيم مالك:
"إنـّا نحاول وقف دولاب الزمان فلا يدور"
فإنه استوحى ذلك من نص للامرتين الفرنسي ( 1790 – 1869 ) هو :
O, temps, suspends ton vol !
Et vous, heures propices
Suspends votre cours
وترجمة ذلك كما ورد في "فن الشعر" لمحمد مندور:
"أيها الزمن كُفّ عن جريانك
وأنت أيتها الساعات السعيدة قفي انسيابك"!
وكنت قد أشرت في تحليلي لقصيدة الشاعر الفرنسي " البحيرة " ( صدى التربية، حزيران – 1992) إلى أننا لو أخذنا في مناقشة طلبات الشاعر منطقيًا لرأينا أنه يطلب عبثًا، فكيف سيتوقف الزمن ؟؟؟ ولو توقف حقًا لاعترى الحياة ركود وموات، ولما كان هناك فرق بين البداية والنهاية، فالزمن باعث على التجديد والإفناء والإحياء، ولكننا في الشعر لا نجيز هذه السببية والمنطقية.
(باقة الغربية)
موقع الكاتب: http://www.geocities.com/faruqmawasi
قراءة في قصيدة يدك لإبراهيم مالك بقلم: د. فاروق مواسي
تاريخ النشر : 2004-12-27