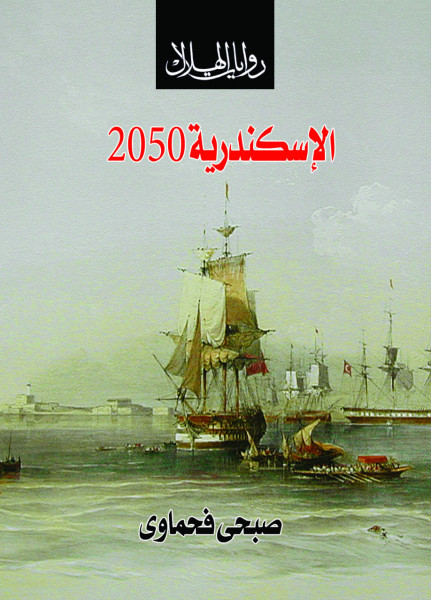
الغرابة في رواية الإسكندرية 2050
لصبحي فحماوي
د. عزوز علي إسماعيل
مدرس الأدب والنقد والبلاغة بالمعهد العالي للغات والترجمة الفورية بالقاهرة
"التاريخ يا برهان مثل موج البحر، يرتطم بصخور الشاطئ، ثم يرتد، مدحوراً، ولكنه يلم شتات نفسه، ثم يهاجم الشاطئ من جديد!" - الإسكندرية 2050-
كلمة الغربة تحمل معاني كثيرة، أقل تلك المعاني قاسية على النفس، وأصعب ما يحمله معناها تلك الغربة التي تكون بداخل الأوطان، والأديب صبحي فحماوي قد تغرب عن موطنه ورحل إلى بلاد عديدة، ذاق من خلالها طعم الغربة والغرابة، وهو ما ظهر بجلاء في أعماله الأدبية، فجاءت "الإسكندرية 2050" لتعبر عن الأمل والألم وما اعتراهما من غرابة، فهي من أهم روايات الكاتب، تلك الرِّواية التي يبدؤها بأقوالٍ لمشاهير الكتَّاب، والتي تتسم بنوع من الغرابة، وتحتاج إلى قراءة، وكانت مقولة "جبران خليل جبران" من الأهمية بمكان: "لو نقدر أن نعيش على عبير الأرض، فنكتفي بالنور كالنبات.. وليس دمنا سوى عصارة أُعدت منذ الأزل، غذاء لشجر السماء.. فأنا كرمة مثلك وستجمع ثماري وتُحمل إلى المعصرة" جبران خليل جبران". تأتي هذه الجملة وهذه المقولة في بداية الرِّواية باعتبارها جملة أو عبارة توجيهية أو مقولة مرتبطة بتلك الغرابة وذلك الخيال العلمي الموجود بداخل العمل، وهي مقتبسة أو تصدير؛ لأن التَّصدير الذي يأتي به الكاتبُ دليلٌ على العملِ نَفْسِهِ, باعتبار أنَّه توجيه للمتلقي، من خلال ارتباطِه بالعمل إشارياً ودلالياً؛ ذلك أنَّ التَّصديْر موجهٌ إلى القارئ أولاً؛ حتى يستطيع من خلاله فكِّ طلاسم النَّصِّ بحكم أنَّه مرتبطٌ بهذا النَّصِّ ؛ فالتَّصديرinscription أو المُقْتَبَسَةُ "جملةٌ توجيهيةٌ يوظفها الكاتبُ في الصَّفحاتِ الأولى لمؤلَّفه التي تسبق عادة متنه لتوضيح القصد العام منه, وقد عرَّفها قاموس الطَّرائق الأدبية بأنَّها: "شاهد يوضَع في مستهل عملٍ أو فصلٍ للإشارة إلى روح هذا العمل أو الفصل"، واعتبرها جيرار جنيت بمثابة حركة صامتة Gestmnet لا يمكن إدراك مغزاها وقصدها إلا من خلال تأويل القارئ"[1]. والمقتبسة تأتي لإنارة طريق المتلقي فهي "شاهد يوضع في أول العمل أو الفصل, وله وظيفة تنبيهية وتوجيهية وتناصية ودلالية. المقتبسة تقليد أدبي وثقافي امتد لفترات طويلة عبر الزَّمان من خلال الإبداع والكتابة وتخطيط العمل أو الكتابة , ويرى ميكائيل ريفاتير أن المقتبسة هي بمثابة مؤولة وتشتغل نموذجاً للاشتقاق الإبداعي, وبالتَّالي. فالمقتبسة تركز أول ما تركز على التناص؛ لأنها تقود القارئ إلى تلك الزاوية مباشرة, سواء رغب في ذلك أم لم يرغب؛ كما هو موجود في روايات عديدة"[2]. ونرى الكاتب يحلل هذه المقتبسة أو هذا القول لجبران خليل جبران ويفسِّره بداخل العمل، من خلال العلاقة بين برهان وأبيه بكون الأب معلماً لابنه؛ وبكون المقتبسة دليلاً استرشادياً للعمل، فيعيش الكاتب في عالم الغرابة أو الخيال، في تحليله لتلك المقنبسة، ولأنَّ جبران نفسه كان هائماً في تلك الحالة المعبرة عن الألم العربي، وما تعانيه هذه الأمة من ضعف وتشرذم فيذكر قوله: "عندما كان برهان صغيراً، كنت تقرأ له كتاب "النبي" لجبران خليل جبران، ومازلت تذكر بعض عباراته التي تقول: "لو نقدر أن نعيش على عبير الأرض فنكتفي بالنور كالنبات.." وكانت تُدهشك عبارة "وليس دمنا سوى عصارة أعدت منذ الأزل، غذاء لشجر السماء. وتستوقفك عبارة أنا كرمة مثلك، وستُجمع ثماري وتُحمل إلى المعصرة.." وتعشق جبران الذي يغسلك بعصير العنب وهو يقول: "يا ليتكم تنشدون بعضكم ككروم العنب، ثم تعودون حاملين عطر الأرض في طيات أثوابكم. ثم يختتم بقوله: "ولكن هذه تمنيات لم تحن ساعتها بعد. "يبدو أن الفكرة عششت في ذهن برهان منذ الصغر وحان وقتها الآن، فأنتج ولده الأخضر كنعان" ص27، 28؛ وإذا كان الأمر به غرابة، فإن الكاتب ومنذ البدء يؤكد هذا الأمر وفي الوقت نفسه لديه حلمٌ طموحٌ وكبيرٌ في تخطي الأزمنة والأمكنة، فهو يتحدث بطريقتين؛ الأولى التذكر والاستنتاج من قبل المخابرات وهذا الجهاز الذي صمم خصيصاً للتنصت على عباد الله، والثانية من ناحية المستقبل الذي يسعى إليه محملاً بكل الطاقات العلمية والثقافية، وكانت المقتبسة التي صدَّر بها العمل مع بعض الاقتباسات الأخرى طريقاً ممتداً بداخل العمل للتأكيد على ما انتواه وخاصة الإنسان الأخضر، وما يتعلق بهذا الأمر، من سعي للبحث عن بديل لذلك الإنسان الذي ملأ الدنيا ظلماً وقتلاً وتدميراً. فكان لزاماً على الكاتب أن يصدر لنا عمله بهذه المقولة وبعض المقولات الأخرى التي تؤكد على فكرته الداعية أولاً إلى التأمل في حال الأمة ثم اليقظة لما يحاك حولها وتحويل ذلك إلى طريق من طرق الاستنارة والبحث العلمي، وإعمال العقل. ومن ضمن الأقوال أيضاً ما قاله هرمان هيسه، حيث يقول: "إنَّ انهيار عالم عتيق وشيك بالفعل. إن شيئاً سيحدث على نطاق واسع. العالم يريد أن يجدد نفسه". وهو الأمر الذي اتبعه الكاتب ليصل إلى الرجل الأخضر الذي يبحث عنه ليملأ هذا الكون حباً وأماناً، ويقصي تلك الصراعات والحروب جانباً، وهو ما سنراه خلال هذه المقاربة.
تبدأ رواية "الإسكندرية 2050" والتي تربط بين الحنين إلى الماضي والأمل في المستقبل، بالتأكيد على عنصر الزمن وما سيحدث في المستقبل القريب بالاعتراف صراحة حول وجود شبكة للتجسس مقرها عكا في الزمان والمكان المحددين، وأنَّ السّيد مشهور شاهر الشهري يخضع لجهاز المخابرات بطلب من ابنه برهان؛ لأنَّ الوالد وصل من العمر إلى مائة عام، ويريد أن يعرف خواطره الماضية، من هنا فإنَّ الرِّواية تخضع أيضاً إلى أدب الخيال العلمي والتنبؤ بما سيحدث في المستقبل "الزمان 25/ 9/ 2050. المكان عكا. نحن شبكة متخصصة بالتجسس على عباد الله منذ الولادة وحتى لحظة الوفاة، بناء على معلومة تقول: "إنَّ المحتضر يتهالك على سريره خلال الساعة الأخيرة من عمره، فيتذكر كل الذي مضى ويستعيد ذكرياته من المهد إلى اللحد، فتمر الأحداث كلها مضغوطة في مخيلته بسرعة مذهلة، يتذكر فيها كل شيء، وكأنه يعيشه الآن" فإنَّ عملنا يقوم على تسجيل رقمي لكلِّ ما يدور بخلد الإنسان في تلك اللحظات الفاصلة"[3]. وهذا الأمر لا نعرفه الآن بل هو تنبؤ بما يمكن أن يكون، فهو غريبٌ في الوقت الذي نحياه وما نعرفه أنَّ هناك أجهزة لمعرفة الكذب والحقيقة، عند المتخصصين من المخابراتية، إلا إن جهاز مثل هذا يقوم بالتسجيل لتلك الذاكرة فهو أمرٌ غريبٌ وليس مألوفا وقد بدأ الكاتب به لسببين: الأول إعلام المتلقي أنَّ هذه الرواية ليست رواية عادية، بل هي رواية تخضع لكل ما يمكن أن نطلق عليه شيئاً غريباً، بالإضافة إلى إنها تقوم على عنصر الدهشة والخيال،"ويرى البعض أنَّ الزمن مهمٌ أيضاً في تفسير الخيال، كما قال أحدهم، وأن هناك فترات كثيرة تفوق فيها الخيال وانتصر"[4] والسبب الثاني: أنَّ الكاتب أراد أن يؤكد على جزئية مهمة وهي التفكير وإعمال العقل، حتى إذا كان هذا الشيء غريباً فعلينا أن نطرح أسئلة لهذا الشيء، وحين تنكشف الأسرار من ذلك الجهاز يصبح الأمر غير مألوفٍ، وعلى غير ما كنا مدركين "فتصبح نسمة الهواء التي كانت تشرح الصدر يا عزيزي نراها الآن أمام أعيننا تنغل دوداً حياً يسعى! نقصد أنها تنغل آهات وصرخات ومعلومات وأسراراً ورسائل وشفرات عسكرية، وعلوماً ووثائق خطيرة وخيانات وأفلاماً وصوراً مختلف ألوانها" وهنا تكمن بعض الغرابة مما يحدث أو سيحدث في المستقبل، والكاتب أراد أن يضع إشارة لنسير عليها من وجهة نظره حول الشيء المثير والمدهش "في اللغة الإنجليزية يشير مصطلح الغرابة إلى نوع من الخبرات المثيرة وللقلق والخوف التي يختل فيها الشعور بالأمن والاستقرار"[5]. فنسمة الهواء أصبحت مع تلك الآهات تنغل دوداً وألماً في بلادنا، مما يبدو منه الغرابة لهذا الشيء الذي من المفترض أن يكون للراحة والسعادة، "والغرابة ضد الألفة. نوع من القلق المقيم، حالة بين الحياة والموت، التباس بين الوعي وغياب الوعي، حضور خاص للماضي في الحاضر، وحضور للآخر في الذات ، قلق غير مستقر بين الزمان والمكان، إقامة عند التخوم؛ تخوم الوعي والوجدان، إفاقة ليست كاملة حالة حدودية أو بينية تقع بين انفعالات الخوف والرهبة والتشويق وحب الاستطلاع"[6]. يؤكد الكاتب أنَّ المعلومات التي يستخرجها ذلك الجهاز المخابراتي الجديد من الشخص المراد كشف أسراره ستكون مذهلة للمتلقي، إذ إن هناك كشفاً للمستور، وهو ما يدخل الغرابة في الأمر، لأنَّ المتلقي سيقف أمامها مصدوماً يقول الكاتب ص6: "صحيح أنها فضائح وهموم عذابات، تنزل على كاهل المتلقي، فتكاد تُذهب عقله، ولكن هناك وضوحاً في الرؤيا. لقد أزلنا طاقية الإخفاء عن الأسرار، والسر لم يعد سراً، وهناك تخصص في الاستقبال، فهذه الأجهزة تحلل المعلومات السياسية وتصنفها، وتلك العلمية، وتلك الفنية وتخصصات لا أول لها ولا...! ". السر من خلال تلك الأجهزة لا يعد سراً بل أصبح معروفاً؛ لأنه كشف الغطاء عن المستور، وهنا لا بد وأن نضع أمراً أمام أعيننا وهو أن الكاتب لماذا جعل جهاز المخابرات هو الذي أعلن عن نفسه؟ وكان من الممكن أنَّ الدولة هي التي تؤكد أن لديها في جميع مصالحها الحكومية أجهزة تستطيع أن تفعل ذلك، ولكن الكاتب جاء بأجهزة المخابرات التي ترعب الناس والتي تدخل في قلوبهم الخوف والفزع خاصة في الدول العربية، والسؤال هنا هل مثل هذه الأجهزة، وإن استخدمت في المستقبل ستكون مقيدة للحريات الإنسانية أم لا؟ وهو الأمر الذي عرض له الكاتب فيما بعد، فالحرية الشخصية تتنافى مع هذا الجهاز الذي يستطيع أن يستخرج كل صغيرة وكبيرة مرت في حياتك، وكيف كان يفكر ذلك الشخص في حياته الماضية "نحن المنفذون لهذه الأعمال البشعة الممتعة، رغم أنها تتنافى مع الحرية الإنسانية، لا تتورع عن رصد تحركات الحكومات الموجهة ضد رأس المال المسيطر، نعم نتجسس على الحكومات لصالح الأشخاص فما داموا يدفعون، نقول لهم. نحن ببساطة شركة فنية مرخصة للتنصت تنفذ ولا تناقش".
[1]يوسف الإدريسي , عتبات النص, بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر, منشورات مقاربات, الطبعة الأولى, المغرب 2008 ص 55.
[2] د. عزوز علي إسماعيل، المعجم المفسِّر لعتبات النصوص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2019 ص365
[3] صبحي فحماوي، الإسكندرية 2050، دار الهلال، القاهرة 2013 ص5
[4] د. شاكر عبدالحميد، الخيال، من الكهف حتى الواقع الافتراضي، سلسل عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت العدد360، فبراير 2009ص445.
[5] د. شاكر عبدالحميد، الغرابة، المفهوم وتجلياته في الأدب، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يناير 2012 العدد 384، مرجع سابق ص21
[6] د. شاكر عبدالحميد، الغرابة، المرجع السابق ص 7

لصبحي فحماوي
د. عزوز علي إسماعيل
مدرس الأدب والنقد والبلاغة بالمعهد العالي للغات والترجمة الفورية بالقاهرة
"التاريخ يا برهان مثل موج البحر، يرتطم بصخور الشاطئ، ثم يرتد، مدحوراً، ولكنه يلم شتات نفسه، ثم يهاجم الشاطئ من جديد!" - الإسكندرية 2050-
كلمة الغربة تحمل معاني كثيرة، أقل تلك المعاني قاسية على النفس، وأصعب ما يحمله معناها تلك الغربة التي تكون بداخل الأوطان، والأديب صبحي فحماوي قد تغرب عن موطنه ورحل إلى بلاد عديدة، ذاق من خلالها طعم الغربة والغرابة، وهو ما ظهر بجلاء في أعماله الأدبية، فجاءت "الإسكندرية 2050" لتعبر عن الأمل والألم وما اعتراهما من غرابة، فهي من أهم روايات الكاتب، تلك الرِّواية التي يبدؤها بأقوالٍ لمشاهير الكتَّاب، والتي تتسم بنوع من الغرابة، وتحتاج إلى قراءة، وكانت مقولة "جبران خليل جبران" من الأهمية بمكان: "لو نقدر أن نعيش على عبير الأرض، فنكتفي بالنور كالنبات.. وليس دمنا سوى عصارة أُعدت منذ الأزل، غذاء لشجر السماء.. فأنا كرمة مثلك وستجمع ثماري وتُحمل إلى المعصرة" جبران خليل جبران". تأتي هذه الجملة وهذه المقولة في بداية الرِّواية باعتبارها جملة أو عبارة توجيهية أو مقولة مرتبطة بتلك الغرابة وذلك الخيال العلمي الموجود بداخل العمل، وهي مقتبسة أو تصدير؛ لأن التَّصدير الذي يأتي به الكاتبُ دليلٌ على العملِ نَفْسِهِ, باعتبار أنَّه توجيه للمتلقي، من خلال ارتباطِه بالعمل إشارياً ودلالياً؛ ذلك أنَّ التَّصديْر موجهٌ إلى القارئ أولاً؛ حتى يستطيع من خلاله فكِّ طلاسم النَّصِّ بحكم أنَّه مرتبطٌ بهذا النَّصِّ ؛ فالتَّصديرinscription أو المُقْتَبَسَةُ "جملةٌ توجيهيةٌ يوظفها الكاتبُ في الصَّفحاتِ الأولى لمؤلَّفه التي تسبق عادة متنه لتوضيح القصد العام منه, وقد عرَّفها قاموس الطَّرائق الأدبية بأنَّها: "شاهد يوضَع في مستهل عملٍ أو فصلٍ للإشارة إلى روح هذا العمل أو الفصل"، واعتبرها جيرار جنيت بمثابة حركة صامتة Gestmnet لا يمكن إدراك مغزاها وقصدها إلا من خلال تأويل القارئ"[1]. والمقتبسة تأتي لإنارة طريق المتلقي فهي "شاهد يوضع في أول العمل أو الفصل, وله وظيفة تنبيهية وتوجيهية وتناصية ودلالية. المقتبسة تقليد أدبي وثقافي امتد لفترات طويلة عبر الزَّمان من خلال الإبداع والكتابة وتخطيط العمل أو الكتابة , ويرى ميكائيل ريفاتير أن المقتبسة هي بمثابة مؤولة وتشتغل نموذجاً للاشتقاق الإبداعي, وبالتَّالي. فالمقتبسة تركز أول ما تركز على التناص؛ لأنها تقود القارئ إلى تلك الزاوية مباشرة, سواء رغب في ذلك أم لم يرغب؛ كما هو موجود في روايات عديدة"[2]. ونرى الكاتب يحلل هذه المقتبسة أو هذا القول لجبران خليل جبران ويفسِّره بداخل العمل، من خلال العلاقة بين برهان وأبيه بكون الأب معلماً لابنه؛ وبكون المقتبسة دليلاً استرشادياً للعمل، فيعيش الكاتب في عالم الغرابة أو الخيال، في تحليله لتلك المقنبسة، ولأنَّ جبران نفسه كان هائماً في تلك الحالة المعبرة عن الألم العربي، وما تعانيه هذه الأمة من ضعف وتشرذم فيذكر قوله: "عندما كان برهان صغيراً، كنت تقرأ له كتاب "النبي" لجبران خليل جبران، ومازلت تذكر بعض عباراته التي تقول: "لو نقدر أن نعيش على عبير الأرض فنكتفي بالنور كالنبات.." وكانت تُدهشك عبارة "وليس دمنا سوى عصارة أعدت منذ الأزل، غذاء لشجر السماء. وتستوقفك عبارة أنا كرمة مثلك، وستُجمع ثماري وتُحمل إلى المعصرة.." وتعشق جبران الذي يغسلك بعصير العنب وهو يقول: "يا ليتكم تنشدون بعضكم ككروم العنب، ثم تعودون حاملين عطر الأرض في طيات أثوابكم. ثم يختتم بقوله: "ولكن هذه تمنيات لم تحن ساعتها بعد. "يبدو أن الفكرة عششت في ذهن برهان منذ الصغر وحان وقتها الآن، فأنتج ولده الأخضر كنعان" ص27، 28؛ وإذا كان الأمر به غرابة، فإن الكاتب ومنذ البدء يؤكد هذا الأمر وفي الوقت نفسه لديه حلمٌ طموحٌ وكبيرٌ في تخطي الأزمنة والأمكنة، فهو يتحدث بطريقتين؛ الأولى التذكر والاستنتاج من قبل المخابرات وهذا الجهاز الذي صمم خصيصاً للتنصت على عباد الله، والثانية من ناحية المستقبل الذي يسعى إليه محملاً بكل الطاقات العلمية والثقافية، وكانت المقتبسة التي صدَّر بها العمل مع بعض الاقتباسات الأخرى طريقاً ممتداً بداخل العمل للتأكيد على ما انتواه وخاصة الإنسان الأخضر، وما يتعلق بهذا الأمر، من سعي للبحث عن بديل لذلك الإنسان الذي ملأ الدنيا ظلماً وقتلاً وتدميراً. فكان لزاماً على الكاتب أن يصدر لنا عمله بهذه المقولة وبعض المقولات الأخرى التي تؤكد على فكرته الداعية أولاً إلى التأمل في حال الأمة ثم اليقظة لما يحاك حولها وتحويل ذلك إلى طريق من طرق الاستنارة والبحث العلمي، وإعمال العقل. ومن ضمن الأقوال أيضاً ما قاله هرمان هيسه، حيث يقول: "إنَّ انهيار عالم عتيق وشيك بالفعل. إن شيئاً سيحدث على نطاق واسع. العالم يريد أن يجدد نفسه". وهو الأمر الذي اتبعه الكاتب ليصل إلى الرجل الأخضر الذي يبحث عنه ليملأ هذا الكون حباً وأماناً، ويقصي تلك الصراعات والحروب جانباً، وهو ما سنراه خلال هذه المقاربة.
تبدأ رواية "الإسكندرية 2050" والتي تربط بين الحنين إلى الماضي والأمل في المستقبل، بالتأكيد على عنصر الزمن وما سيحدث في المستقبل القريب بالاعتراف صراحة حول وجود شبكة للتجسس مقرها عكا في الزمان والمكان المحددين، وأنَّ السّيد مشهور شاهر الشهري يخضع لجهاز المخابرات بطلب من ابنه برهان؛ لأنَّ الوالد وصل من العمر إلى مائة عام، ويريد أن يعرف خواطره الماضية، من هنا فإنَّ الرِّواية تخضع أيضاً إلى أدب الخيال العلمي والتنبؤ بما سيحدث في المستقبل "الزمان 25/ 9/ 2050. المكان عكا. نحن شبكة متخصصة بالتجسس على عباد الله منذ الولادة وحتى لحظة الوفاة، بناء على معلومة تقول: "إنَّ المحتضر يتهالك على سريره خلال الساعة الأخيرة من عمره، فيتذكر كل الذي مضى ويستعيد ذكرياته من المهد إلى اللحد، فتمر الأحداث كلها مضغوطة في مخيلته بسرعة مذهلة، يتذكر فيها كل شيء، وكأنه يعيشه الآن" فإنَّ عملنا يقوم على تسجيل رقمي لكلِّ ما يدور بخلد الإنسان في تلك اللحظات الفاصلة"[3]. وهذا الأمر لا نعرفه الآن بل هو تنبؤ بما يمكن أن يكون، فهو غريبٌ في الوقت الذي نحياه وما نعرفه أنَّ هناك أجهزة لمعرفة الكذب والحقيقة، عند المتخصصين من المخابراتية، إلا إن جهاز مثل هذا يقوم بالتسجيل لتلك الذاكرة فهو أمرٌ غريبٌ وليس مألوفا وقد بدأ الكاتب به لسببين: الأول إعلام المتلقي أنَّ هذه الرواية ليست رواية عادية، بل هي رواية تخضع لكل ما يمكن أن نطلق عليه شيئاً غريباً، بالإضافة إلى إنها تقوم على عنصر الدهشة والخيال،"ويرى البعض أنَّ الزمن مهمٌ أيضاً في تفسير الخيال، كما قال أحدهم، وأن هناك فترات كثيرة تفوق فيها الخيال وانتصر"[4] والسبب الثاني: أنَّ الكاتب أراد أن يؤكد على جزئية مهمة وهي التفكير وإعمال العقل، حتى إذا كان هذا الشيء غريباً فعلينا أن نطرح أسئلة لهذا الشيء، وحين تنكشف الأسرار من ذلك الجهاز يصبح الأمر غير مألوفٍ، وعلى غير ما كنا مدركين "فتصبح نسمة الهواء التي كانت تشرح الصدر يا عزيزي نراها الآن أمام أعيننا تنغل دوداً حياً يسعى! نقصد أنها تنغل آهات وصرخات ومعلومات وأسراراً ورسائل وشفرات عسكرية، وعلوماً ووثائق خطيرة وخيانات وأفلاماً وصوراً مختلف ألوانها" وهنا تكمن بعض الغرابة مما يحدث أو سيحدث في المستقبل، والكاتب أراد أن يضع إشارة لنسير عليها من وجهة نظره حول الشيء المثير والمدهش "في اللغة الإنجليزية يشير مصطلح الغرابة إلى نوع من الخبرات المثيرة وللقلق والخوف التي يختل فيها الشعور بالأمن والاستقرار"[5]. فنسمة الهواء أصبحت مع تلك الآهات تنغل دوداً وألماً في بلادنا، مما يبدو منه الغرابة لهذا الشيء الذي من المفترض أن يكون للراحة والسعادة، "والغرابة ضد الألفة. نوع من القلق المقيم، حالة بين الحياة والموت، التباس بين الوعي وغياب الوعي، حضور خاص للماضي في الحاضر، وحضور للآخر في الذات ، قلق غير مستقر بين الزمان والمكان، إقامة عند التخوم؛ تخوم الوعي والوجدان، إفاقة ليست كاملة حالة حدودية أو بينية تقع بين انفعالات الخوف والرهبة والتشويق وحب الاستطلاع"[6]. يؤكد الكاتب أنَّ المعلومات التي يستخرجها ذلك الجهاز المخابراتي الجديد من الشخص المراد كشف أسراره ستكون مذهلة للمتلقي، إذ إن هناك كشفاً للمستور، وهو ما يدخل الغرابة في الأمر، لأنَّ المتلقي سيقف أمامها مصدوماً يقول الكاتب ص6: "صحيح أنها فضائح وهموم عذابات، تنزل على كاهل المتلقي، فتكاد تُذهب عقله، ولكن هناك وضوحاً في الرؤيا. لقد أزلنا طاقية الإخفاء عن الأسرار، والسر لم يعد سراً، وهناك تخصص في الاستقبال، فهذه الأجهزة تحلل المعلومات السياسية وتصنفها، وتلك العلمية، وتلك الفنية وتخصصات لا أول لها ولا...! ". السر من خلال تلك الأجهزة لا يعد سراً بل أصبح معروفاً؛ لأنه كشف الغطاء عن المستور، وهنا لا بد وأن نضع أمراً أمام أعيننا وهو أن الكاتب لماذا جعل جهاز المخابرات هو الذي أعلن عن نفسه؟ وكان من الممكن أنَّ الدولة هي التي تؤكد أن لديها في جميع مصالحها الحكومية أجهزة تستطيع أن تفعل ذلك، ولكن الكاتب جاء بأجهزة المخابرات التي ترعب الناس والتي تدخل في قلوبهم الخوف والفزع خاصة في الدول العربية، والسؤال هنا هل مثل هذه الأجهزة، وإن استخدمت في المستقبل ستكون مقيدة للحريات الإنسانية أم لا؟ وهو الأمر الذي عرض له الكاتب فيما بعد، فالحرية الشخصية تتنافى مع هذا الجهاز الذي يستطيع أن يستخرج كل صغيرة وكبيرة مرت في حياتك، وكيف كان يفكر ذلك الشخص في حياته الماضية "نحن المنفذون لهذه الأعمال البشعة الممتعة، رغم أنها تتنافى مع الحرية الإنسانية، لا تتورع عن رصد تحركات الحكومات الموجهة ضد رأس المال المسيطر، نعم نتجسس على الحكومات لصالح الأشخاص فما داموا يدفعون، نقول لهم. نحن ببساطة شركة فنية مرخصة للتنصت تنفذ ولا تناقش".
[1]يوسف الإدريسي , عتبات النص, بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر, منشورات مقاربات, الطبعة الأولى, المغرب 2008 ص 55.
[2] د. عزوز علي إسماعيل، المعجم المفسِّر لعتبات النصوص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2019 ص365
[3] صبحي فحماوي، الإسكندرية 2050، دار الهلال، القاهرة 2013 ص5
[4] د. شاكر عبدالحميد، الخيال، من الكهف حتى الواقع الافتراضي، سلسل عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت العدد360، فبراير 2009ص445.
[5] د. شاكر عبدالحميد، الغرابة، المفهوم وتجلياته في الأدب، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يناير 2012 العدد 384، مرجع سابق ص21
[6] د. شاكر عبدالحميد، الغرابة، المرجع السابق ص 7




 صور
صور صور
صور













































