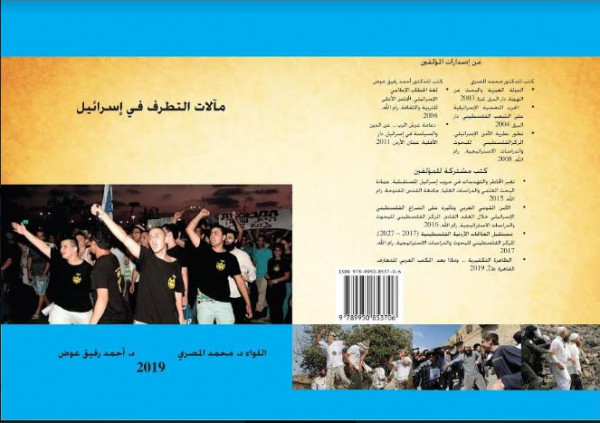
بقلم:اللواء د. محمد المصري- د. أحمد رفيق عوض
التكفير في إسرائيل .. الخارج أولاً ثم الداخل ثانياً
كما قلنا منذ البداية، فإننا سنقوم بعمليات استقرائية لفهم "ظاهرة" التكفير في إسرائيل وإمكانية ظهورها علناً وبشكل مؤثر تُغيّر من مسار الأحداث العام في الدولة والمجتمع.
وهذا يدفع دائماً إلى التذكير بأولئك اليهود الذين خرجوا على المجتمع اليهودي وعلى السلطة الرومانية، فكانوا سبباً في تدمير الهيكل وتشريد المجتمعات اليهودية، وبغض النظر عن تاريخية هذه الأحداث أو تخيلها أو ادعائها، إلا أنها شكّلت إحدى الدعاوي الهامة في السردية الصهيونية في ادعاء البلاد وملكيتها[1].
لهذا السبب، وبغض النظر عن تصديقنا لهذه الرواية التاريخية أم لا، فنحن نعتقد أن ما يُشكّل الهويات الجمعية، فيه جزء كبير من الأوهام والأساطير والمبالغات[2]. ولأن الأمر كذلك فإن رواية تلك الجماعات التكفيرية اليهودية التي ظهرت في القرن الأول للميلاد وعُرفت باسم الغيورين أو حملة السكاكين، وكانت السبب في خراب المجتمع اليهودي في فلسطين آنذاك، قد تتكرر مرّة أخرى على أيامنا هذه، أي ان الوضع الاستثنائي الذي تعيشه إسرائيل، والذي أشرنا إليه في الفصول السابقة، قد يؤدي إلى ظهور تلك الجماعة المتطرفة التكفيرية.
أسباب محتملة لظهور حركات تكفيرية في إسرائيل
نعتقد أن كل حركة تكفيرية إنما تظهر رداً على تحدٍ أو ملئ فراغ أو قراءة خاطئة لواقع مضطرب وغير سوي أو لتطرف في السلوك والتفكير، لتشوه في الرؤية أو لتشوه في النظام، وهو ما أسهبنا في الكلام عنه في كتابنا "الظاهرة التكفيرية .. وماذا بعد"، الصادر عن دار المكتب العربي في القاهرة سنة 2018[3]. وعليه فإن احتمال ظهور حركة تكفيرية علنية في إسرائيل تعمل ضد المجتمع والدولة – وليس فقط ضد الفلسطينيين أو العرب عموماً – إنما قد يكون للأسباب التالية:
السبب الأول: تآكل قوة الردع الإسرائيلية
وهذا قد يتضمن هزائم صغيرة متعددة أو متتالية، أو عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق انتصارات واضحة، إن هزيمة جزئية أو عدة مواجهات عسكرية فاشلة ستؤدي إلى ظهور التطرف والغلو في الجمهور الإسرائيلي، إن مثل هذا الوضع سيؤدي بالضرورة إلى ضعف أجهزة الدولة وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الجمهور، كما أنها ستفقد القدرة على التصرف أو السيطرة على الامور، مما يسمح بظهور مثل تلك الجماعات المتطرفة التي تعمل خارج الأطر الرسمية، ويمكن إثبات هذا الأمر بالحالات التالية:
الحالة الأولى: بعد حرب 1973 التي كانت بمثابة الزلزال في الوعي الإسرائيلي، وخصوصاً بعد الانتصار الذي أسكر المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية، فضلاً عن الشخص العادي في العام 1967، فإن "هزيمة" عام 1973 أدّت سريعاً إلى ظهور جماعة غوش ايمونيم، وهي مجموعة ضمّت سياسيين وأكاديميين ورجالاً من الطبقة الوسطى ومغامرين وعسكريين سابقين وأعضاء كنيست تركوا أحزابهم حتى لا يحرجوها، واختاروا أن يعملوا خارج الأطر السياسية الرسمية، وتسلّحوا بخطاب ديني متطرف لم يعهده الخطاب الرسمي الذي تحافظ عليه إسرائيل عادة، يكتب عكيفا إلدار عن هذه المجموعة ما يلي بالحرف: "ومثّلت محاولة الاستيطان في سبسطية كل جماعة غوش ايمونيم التي تضم شباناً متطرفين يؤمنون بشدة بقرب ظهور المسيح، ومنهم قيادة مؤثرة كثيراً، داست في طريقها على القانون وعلى مؤسسات الدولة المنتخبة"[4].
ويُفصّل إلدار في رؤيته هؤلاء وكيف أنهم حاولوا التوفيق بشكل قسري بين رؤاهم المشيحانية غير الواقعية وبين رؤية حداثية وواقعية ونشطة في إطار موازين القوى، وتملك في ذات الوقت إمكانيات عمل هائلة.
وحول التصادم ما بين الرؤية المشيحانية لجماعة غوش ايمونيم وما بين الرؤية السياسية الواقعية للمؤسسة الرسمية الإسرائيلية، يسوق إلدار الحالة التالية "حاولت نواة ألون موريه التي تُعتبر النواة الأولى لحركة غوش ايمونيم الاستيطان في سبسطية سبع مرّات، وفي كل مرّة كان الجيش الإسرائيلي يتمكن من إخلائهم بالقوة، مستخدمين العنف المتبادل، وقالوا يسقط الصديق سبع مرات، وفي المرّة الثامنة التي تم التخطيط لها كحملة عسكرية، وأُخرجت بعناية، طُلب من الآلاف التوجه إلى الجبل من كل البلاد – عائلات مع أبنائها الصغار ومتدينون وعلمانيون وممثلو الصهيونية الجديدة ومندوبو الصهيونية الاستيطانية القديمة – وقد جاؤوا للاحتجاج على سياسة الحكومة تجاه الاستيطان، ولم يتحدّوا نظام الحكم فقط، بل جاؤوا من أجل طرح بديل كامل وشامل للدولة الديموقراطية غير الكاملة، على حد وصفهم، وقاموا بذلك مستغلين بدقة التناقضات الجوهرية في تركيبة الدولة، ويحملون أفكاراً مقدسة جداً، مستخدمين في ذلك أدوات الدولة ومواردها"[5].
هذه الأفكار هيأ لها الحاخام تسفي يهودا كوك من خلال تشجيع تلاميذه على الاستعداد للحرب والموت من أجل الحقيقة الأبدية التي يدافعون عنها، إذ بعد ثلاثة أشهر من تأسيس حركة غوش ايمونيم صرّح هذا الحاخام الشهير ذو التأثير الكبير بالقول: "في حالة الإكراه من أي طرف كان، كافراً أو يهودياً، لا سمح الله، لن نوافق على اجتثاث أية حقائق موجودة في التوراة، وأدعو الجميع وكل إسرائيلي، إلى التضحية بالروح"[6].
حركة غوش ايمونيم المشيحانية المتطرفة التي استطاعت أن تُجبر المؤسسة الرسمية الإسرائيلية على أن تخضع لها، هي مثال حي على ما نذهب إليه، وفي هذه النقطة بالذات، يجب التوقف طويلاً أمام هذه الظاهرة التي ندّعي أنها تكررت وستتكرر في المستقبل، وأنها في كل مرّة تحقق نجاحاً آخر، بمعنى أن مثل هذه الجماعات المتطرفة تسجّل في كل انبعاث لها نصراً على المؤسسة الرسمية الإسرائيلية.
بادئ ذي بدء، فإن أسباب ظهور غوش ايمونيم كانت كالتالي:
1. رأت هذه الجماعة أن الاستيطان، فضلاً عن كونه أمراً إلهياً وتطبيقاً للحق الرباني والعمل المقدس بأرض إسرائيل وتوسيع الحدود وطرد الأعداء، فإن الاستيطان يُعتبر في قلب السامرة الرد المناسب والوحيد على ضعف معنويات إسرائيل بعد هزيمة 1973 أمام العرب[7].
2. كانت جماعة غوش ايمونيم أيضاً رداً على وصف الصهيونية بالعنصرية في الجمعية العامة للأُمم المتحدة (لنلاحظ هنا أن هذه الجماعة تريد أن تقاتل العالم وتواجهه بمزيد من التطرف والعداء والوضوح، وهو ذات الموقف الذي اتخذته جماعة الغيورين في القرن الأول للميلاد عندما أرادت أن تحارب روما أيضاً).
3. كانت جماعة غوش ايمونيم رداً أيضاً على وثيقة البندقية التي اعترفت بالتطلعات والمصالح الشرعية للفلسطينيين[8].
4. كانت جماعة غوش ايمونيم أيضاً رداً على "محاولة أعدائها إبادتها"[9].ولأن حكومة إسرائيل لم تستطع الرد "فإن غوش ايمونيم هي تعويض عن عجز الديموقراطية والتغطية على فشل الحكومة".
5. كانت جماعة غوش ايمونيم أيضاً رداً على "وقف الانسحاب من سيناء .. ووقف إدخال جنود ورثة هتلر إلى سيناء .. والسماح فوراً لكل الأنوية المعنية بالاستيطان أن تستوطن يهودا والسامرة وهضبة الجولان ومداخل سيناء"[10].
إذن، كانت هذه الجماعة المتطرفة رداً على فشل المؤسسة الرسمية أو تآكل الردع أو إحساس عارم بالهزيمة وإحساس بالحصار والتهديد، ليس من الداخل وإنما من الخارج أيضاً.
ظهرت جماعة غوش ايمونيم – متسلّحة بمهمة إلهية – وكأنها تريد أن تصحح ما تعتبره غير يهودي وأن تفرض رؤيتها على حكومة إسرائيل وان ترد على انتقادات العالم كله، بكل ما فيه من أعداء وأغيار وكفار، وكانت النتيجة مدهشة، إذ أن هذه الجماعة، وهي خارج أُطر ومؤسسات النظام السياسي، ولكنها استخدمت أدواته وإمكانياته بالطبع، استطاعت أن تنجز ما يلي:
1. أسست لواقع استيطاني كبير وعميق، جعلت من التسوية السلمية بوجوده صعبة جداً، أي أن هذا التطرف قطع الطريق الحالي والمستقبلي على أية حلول عقلانية.
2. قدّمت رؤية جديدة للصهيونية العمالية الاشتراكية – المنهزمة والمنافقة – واستبدل ذلك برؤية مشيحانية خلاصية، جعلت من الأرض وامتلاكها جزءاً من الرؤية الكلية للمستقبل، أكثر من ذلك، فإن هذه الرؤية المشيحانية قللت من اعتبار أن الدولة التي أقامتها الصهيونية هي دولة كافرة أو قابلة للزوال، فهي دولة الرب أيضاً ولو كانت بأيدٍ بشرية، الرؤية المشيحانية التي قدمتها غوش ايمونيم كانت رؤية ضرورية للرد على الهزيمة والمخاطر والرد على أية تسويات سياسية قد تضطر إليها إسرائيل، وهذا يُفسّر – ربما – الانقلاب الكبير الذي دخلت إليه إسرائيل في منتصف السبعينات، كانت غوش ايمونيم مقدمة ذلك الانقلاب وأحد أسبابه أيضاً[11].
3. استطاعت هذه الجماعة بسلوكها العنيف ونشاطها الإجرامي ضد الفلسطينيين أن تُسقط حكومة العمل سنة 1977، ضمن عوامل أخرى، ولكن وجود هذه الجماعة وسلوكها وإجرامها ونشاطها على مستوى الإعلام والتنظير، كان سبباً هاماً في تغيير الحياة السياسية في إسرائيل وحتى هذه اللحظة (2019).
4. قدّمت الجماعة الاستيطانية المشار إليها سلوكاً ونمطاً من المشاركة السياسية لم يكن مألوفاً لدى الإسرائيليين، حيث اللجوء إلى التكفير والعنف والتهديد بالتصفية الجسدية والمعنوية والعمل خارج الأُطر الحزبية والسياسية المعروفة، وكذلك جر المؤسسة الرسمية إلى المستويات التي يريدونها، بالإضافة إلى المجاهرة بخطاب فظ وغير مألوف دبلوماسياً ولا عالمياً، كانت الجماعة بمثابة إظهار الهواجس الحقيقية لهوامش واسعة من المجتمع الإسرائيلي اليهودي.
5. أصبح الخطاب التوراتي الحاخامي – بتجلّياته المتعددة، الحلولي والشعبوي والمعتدل، الشرقي والغربي – جزءاً من الخطاب السياسي اليومي للدولة والمجتمع، حيث صارت تطرح التناقضات بين الكنيست والكنيس، وبين السلطة المدنية والسلطة الدينية، وبين خطاب الشريعة وخطاب الدولة .... إلخ، وانتقل هذا الحوار من الهوامش إلى المركز.
6. كانت تلك فرصة لأن تظهر الأحزاب الدينية – على أنواعها – وخصوصاً بعد أن اُقصي حزب العمل عن السلطة عام 1977 وجاء الليكود الذي عمل على إنهاء سياسة الصَهْر وتخلى عن سياسة الاقتصاد الاشتراكي وفتح الأسواق الإسرائيلية أمام الأسواق العالمية وسمح للطوائف والأعراق أن تُعبر عن نفسها، وتم بشكل – ربما أسرع من المعتاد – "تديين السياسة" وتغير مزاج الجمهور إلى حدٍ كبير، وقفزت إسرائيل مبكّرة إلى قلب العولمة باعتبارها إحدى صنائعه وأهم ربائبه، وبهذا كان الذهاب إلى الدين جزءاً من الاحتماء والتقوقع الطائفي والعرقي أيضاً، ولهذا، شهدت الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ردة دينية إسرائيلية عميقة عززتها الأحداث المتتالية في الإقليم العربي[12].
7. وعلى الرغم من ذوبان حركة غوش ايمونيم وتحولها إلى أجسام أخرى أو تمظهرها في هيئات وأُطر أخرى مثل المجلس الاستيطاني في يهودا والسامرة أو ما يُختصر بكلمة "يشع"، وكذلك في أحزاب صغيرة أو أخرى قائمة، إلا أن هذه الجماعة مثّلت الأب الروحي الذي أخرج وثبّت، ليس الرؤية الدينية والسياسة فحسب، وإنما الجماعات المتطرفة الأخرى التي ستظهر فيما بعد ذلك أيضاً.
نخلص من ذلك كله إلى أن حالة الضعف التي وجدت إسرائيل نفسها فيها بعد هزيمة 1973، أنتجت مثل هذه الحركة المشيحانية المتطرفة التي جعلت الأمر أصعب على إسرائيل – برأينا – من ناحية التفاوض أو الدخول في تسوية، قد يقول قائل أن جماعة غوش ايمونيم، حتى وإن كانت على استعداد لمواجهة المؤسسة الرسمية أو أذرع الدولة، إلا أنها في نهاية الأمر حقنت المشروع الصهيوني بدماء جديدة، بل ويمكن القول أنها غيّرت اتجاه هذا المشروع لأن يكون أكثر عنفاً وتطرفاً، وهذا كلام صحيح، يثبت ما نذهب إليه ولا ينفيه، بمعنى أنه في كل مرحلة من مراحل ضعف إسرائيل فإن تشددها يزداد، وهذا ما سنراه في الحالة الثانية.
الحالة الثانية: اتفاق أوسلو
لم يكن خافياً أن القوى والأحزاب الدينية الإسرائيلية، وكذلك الأحزاب القومية المتطرفة، اعتبرت أن التوصل إلى اتفاق أوسلو كان بسبب الضعف والضغط الذي تعرضت له إسرائيل من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاتحاد الأوروبي في ذات الوقت، ولذلك حاول حزب الليكود الحاكم في حينه أن يماطل في التوصل إلى هذا الاتفاق، وقد نجح في ذلك، وترك أمر التوقيع على الاتفاق في العام 1993 لحكومة حزب العمل التي كان يرأسها حينذاك إسحاق رابين، واستطاعت القوى والأحزاب الدينية تصوير اتفاق أوسلو على أنه تخلٍ عن أجزاء من أرض التوراة وأنه اتفاق مع القتلة والارهابيين، وأن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بسبب ضعف إسرائيل وعدم قدرتها على مجابهة العالم، وأن من وقّع على هذا الاتفاق هو خائن وكافر ونازي أيضاً، المدهش حقاً هنا هو أن هذه الاتهامات كانت توجّه لأيقونة العسكرتاريا الإسرائيلية ونجم الصهيونية العالمية وأحد الذين شاركوا في حرب 1948، ونقصد به إسحاق رابين، كان حجم التحريض ضد إسحاق رابين غير مسبوق، إلى درجة أن بعض الحاخامات وقفوا أمام بيته أو أمام الكنيست ودعوا الله من خلال صلاة خاصة لهلاكه، باعتباره عدواً لليهود، وقد انتهى ذلك التحريض بقتل إسحاق رابين في سابقة غير مألوفة ولا معتادة في تاريخ إسرائيل الحديث على الأقل.
إن اغتيال رابين في العام 1995 كان حدثاً فريداً في تطور عمل وسلوك الجماعات المتطرفة الدينية في إسرائيل، والمدهش في الأمر أن الحادثة لم تُشكّل هزّة أو زلزالاً في الوعي الجمعي الإسرائيلي، ولم تحدث مراجعات كثيرة أو اتهامات أدت إلى تغيرات عميقة، بل يمكن القول عكس ذلك تماماً، إذ إن الانتخابات التي جرت بعد الاغتيال في صيف 1996 أسفرت عن فوز بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود، وليقود عملية دفن عملية التسوية مع الفلسطينيين، أي أن قتل رابين كان خياراً عريضاً لجمهور كبير ارتعب من فكرة التخلي عن أرض التوراة، وانتخب من قال علانية إنه سيعارض ذلك[13].
ونعتقد أن اغتيال رابين في العام 1995 كان تعبيراً عن اشتداد التطرف في أوساط أوسع وأعرض في الجمهور الإسرائيلي، فقد لوحظ اصطفاف قوى المتطرفين والقوميين وباقي اليمين بكل تجلياته ضد ما يسمى في إسرائيل باليسار الصهيوني[14].
كان اغتيال رابين، وهو رمز العسكرتاريا والاستقلال والعلمانية والاشكنازية و"التعايش"، اغتيالاً لكل ذلك، وكأن من قتله كان يريد تغيير أو استبدال كل ذلك أو احتقاره أو تغييبه، أو كتابة فصل جديد لإسرائيل ولهويتها ومستقبلها، ونعتقد أن إسرائيل لم تُكفّر عن ذنبها أو تعتذر لقتلها شخصاً بحجم رابين، فقد انتخبت بعد موته خصمه اللدود، كما أنها جعلت من قاتله قديساً يحظى بكل شيء داخل سجنه، وبهذا يمكن القول إن عملية اغتيال رابين هي من عمليات الاغتيال الناجحة في التاريخ، على عكس كل عمليات الاغتيال التي نعرفها، هذا يقود إلى القول إن اغتيال رابين لم يكن اغتيالاً فردياً، بل وقف وراءه قوى كثيرة، واسعة وغاضبة وأكثر تشدداً، ولذلك فإننا نستنتج أن اتفاق أوسلو كان سبباً آخر لتندفع إسرائيل إلى مستوى آخر من مستويات الغلو والتكفير، وهو ما ينسجم مع ادعائنا القائل أن كل هزيمة جزئية أو إحساس بالضعف أو تآكل الردع، فإن إسرائيل تعالج ذلك بالمزيد من التطرف.
الحالة الثالثة: الهروب من لبنان والانتفاضة الثانية
وهذه المرحلة بدأت مع الألفية الثالثة، ترافقت مع انسحاب أو هروب قوات الاحتلال الإسرائيلي من لبنان نتيجة ضربات المقاومة اللبنانية وضغط قوى مدنية داخل إسرائيل بضرورة الانسحاب، وتبع ذلك انفجار الانتفاضة الثانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب فشل محادثات كامب ديفيد بين الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء العمالي آنذاك إيهود باراك، فمن جهة اعتبر انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان دون اتفاق وبشكل مهين للغاية مساساً بقوة وهيبة ومكانة إسرائيل وجيشها، ومن جهة أخرى اعتبر الرد العسكري العنيف على الشعب الفلسطيني في انتفاضته جزءاً من رد الاعتبار وترميم الصورة لجيش الاحتلال، ولما تميّزت الانتفاضة الثانية، أو ما أُطلق عليها اسم انتفاضة الأقصى، باستخدام العمليات الاستشهادية، الأمر الذي جعل من المجتمع الإسرائيلي كله ساحة للمواجهة، فقد استبدل الجمهور الإسرائيلي إيهود باراك سريعاً بأريئيل شارون مطلع سنة 2001، واستبدلوا خطاب "ما بعد الصهيونية" الذي انتعش بعد اتفاق أوسلو بخطاب "تجديد العهد الصهيوني" في السياسة الإسرائيلية القومية والعامة، أي مواصلة الاحتفاظ بوطن التوراة مهما كان الثمن[15].
هذه الصهيونية الجديدة التي توصف أنها "صهيونية جديدة نفاثة، أي عدوانية وفاعلة في مجابهة الفلسطينيين بالأساس، وعلى الصعيدين العسكري والسياسي، كون نشاطها لم يعد مقصوراً على الساحة الإسرائيلية الداخلية .... وهي تحمل مؤشرات واضحة على اتساع ظاهرة العودة في إسرائيل إلى الصهيونية الجديدة القومية الأكثر ارتباطاً بالأهداف السياسية للصهيونية الكلاسيكية والتي تُراهن على الأرض قبل السلام[16].
الصهيونية الجديدة تميّزت بمزيد من الانطباق بين أجنحة اليمين العلماني واليمين الديني، وحراك حزبي وفكري أدى إلى ميلاد صهيونية شعبوية تعتمد على رؤية دينية بالغة التبسيط والجماهيرية، يهودية لم تعد تُفسّر ولا تبرر الاحتلال أو الاستيطان أو القتل، وهذا يفسر سلوك الأحزاب والقوى الدينية والمتطرفة الأخرى.
نعتقد أن الهروب من لبنان واندلاع الانتفاضة أطلق مرّة اخرى رعب أوساط كبيرة في الجمهور الإسرائيلي، إلى درجة أنه منذ عام 2001 وحتى كتابة هذه السطور (2019) فإن اليمين بكل تجلياته الدينية والقومية، الشرقية والغربية، يتعزز ويتجذر داخل المجتمع والدولة على حدٍ سواء، برأينا إن ما حدث منذ سنة 2000 دفع إسرائيل إلى مزيد من التطرف والغلو، وقد تجلّى ذلك فيما يلي:
1. تعطيل اتفاق أوسلو تماماً.
2. توج هذا الاتجاه بالهجوم على مدن الضفة الغربية سنة 2002.
3. تغيير هيكلية النظام السياسي في السلطة الفلسطينية.
4. تسميم ياسر عرفات (وهو ما يُشكّل استكمالاً لقتل إسحاق رابين، وبالتالي استطاع اليمين المتطرف قتل الرجلين اللذين وقعا اتفاق أوسلو، وهو ما يعني التخلي التام عن الاتفاق).
5. وضع اشتراطات جديدة من قِبل حكومة اليمين لاستئناف عملية التسوية (اللاءات الخمس، لا لعودة اللاجئين، لا للانسحاب من الأغوار والمرتفعات، لا لتفكيك الاستيطان، لا لتقسيم القدس، لا لدولة فلسطينية).
6. تعميق عمليات المصادرة والاستيطان وعمليات الإخلاء والطرد في القدس والأغوار ومناطق (ج) وبناء جدار عنصري يُطوّق الضفة الغربية ويصادر من أراضيها ما نسبته 2%.
7. إطلاق يد المستوطنين في إيذاء الفلسطينيين والمس بممتلكاتهم.
8. محاصرة السلطة الفلسطينية والعمل – بأيدٍ دولية – على تغيير أولويات المجتمع الفلسطيني وإشغاله بقضايا مختلفة.
9. محاولة ربط النضال الفلسطيني باعتباره إرهاباً، وبالتالي العمل الحثيث – المدعوم من أطراف دولية – على توريط السلطة الفلسطينية وفصائلها، ومحاولة إخراجها من الاعتراف والقانون الدولي.
بعد ذلك كله، فإن التطرف والغلو القومي والديني استطاع أن يُفرّغ اتفاق أوسلو من محتواه، وحوّله إلى احتلال بدون كُلفه، فيما بدت السلطة الفلسطينية وكأنها شريكة في ذلك[17]. ولم يبق من الاتفاق المذكور سوى الشق الأمني الذي أُستخدم طويلاً للمناكفة السياسية بين الفصائل الفلسطينية، ولما وقع الانقسام الفلسطيني في العام 2007 – بسبب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة دون اتفاق مع السلطة، مما يدلل على الأهداف الخبيثة للاحتلال – كان ذلك بمثابة الهدية غير المتوقعة – أو المتوقعة – للمحتل الإسرائيلي ليتعامل مع الفلسطينيين بطريقة أخرى لا علاقة لها باتفاق أوسلو.
يمكن القول أن الفترة ما بين 2000 – 2011 شهدت ما أسمته المصادر الإسرائيلية بالإجماع الجديد أو "الأغلبية الإسرائيلية الجديدة" التي طوّرت سياسة جديدة تجاه الشعب الفلسطيني، ومن أهم عناصر هذه السياسة التي تم التعبير عنها في انتخابات 2003، 2006، 2008، ما يلي:
1. لا شريك فلسطيني يمكن صنع سلام حقيقي معه.
2. الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة قدر الإمكان حتى لو تطلّب الأمر الانسحاب من بعض الأراضي، وهذا هو الفهم لشعار الانفصال "نحن هنا، هم هناك".
3. محاربة الفلسطينيين تحت شعار محاربة الإرهاب.
4. رفع اللاءات الخمسة التي ذُكرت فيما سبق[18].
كان ذلك بمثابة تجنّد الدولة كلها ضد التسوية مع الشعب الفلسطيني وقيادته، بكلمات أخرى، كان قرار إسرائيل واضحاً وعلنياً أنها لا تغادر التسوية القائمة على الشراكة مع الفلسطينيين حتى في حدها الأدنى فقط، وإنما تعود إلى المربع الأول من مشروعها الصهيوني الأول: إقامة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية.
وقد وفّر شارون أولاً، ثم نتنياهو ثانياً، ما يحتاجه المتطرفون والغلاة من سياسات على الأرض وفي المواجهة العسكرية والسياسية والأمنية ضد الشعب الفلسطيني ثم ضد دول المنطقة، وخصوصاً دول الطوق، إن الفترة الواقعة من بين 2001 – 2011 كانت فترة تجويف اتفاق أوسلو وتقزيمه إلى اتفاق أمني، وكانت فترة إنهاك الفلسطينيين وإضعافهم وتقسيمهم وتوريطهم وإشغالهم في أولويات أخرى، برأينا كانت تلك الفترة هي فترة تحطيم أركان الحركة الفلسطينية: كإعادة الاحتلال، والانقسام، وتوريط الجمهور الفلسطيني وإشغاله[19].
وبهذا تكون إسرائيل الرسمية هذه المرّة قد انتقلت إلى طورٍ آخر من أطوار التطرف والتشدد في أية تسوية محتملة، إن هذا التطرف الجديد – وإن كان سببه إحساس بتآكل الردع والضعف والانكشاف – إلا أنه يثير الدهشة أيضاً، إذ مِمَّ تخاف إسرائيل إذا كان كل من حولها لا يستطيع مواجهتها؟.
هل هذا التطرف هو مكون أصيل في السيكولوجية اليهودية؟ أي هو ميل تاريخي ناتج عن ذلك التاريخ الطويل من المواجهة الخاسرة مع أمم كثيرة.
أم أن هذا التطرف يُخفي تحته ابتزازاً لقوى الغرب الاستعمارية؟
أم أن هذا التطرف هو بديل عن وجود جامع فكري وأيديولوجي قادر على صهر وردم الشروخ العميقة في المجتمع الإسرائيلي؟
أم أن هذا التطرف له ما يبرره واقعياً، كانعدام العمق الاستراتيجي وتزايد المخاطر وتغيّر جبهات الحرب وازدياد الأعداء[20]؟
وبغض النظر عن الإجابة، فإن إسرائيل، وفي الفترة الزمنية المشار إليها، تطرّفت – حكومةً وأحزاباً وحركات خارج الأُطر الرسمية – بطريقة ملموسة جداً، إلى درجة أن ذلك تحول إلى ظاهرة سياسية اجتماعية أُطلق عليها "الانزياح إلى اليمين"[21].
الحالة الرابعة: بعد ما يسمى بالربيع العربي
سقوط عدد من الأنظمة العربية وتفكك عدد آخر منها منذ العام 2011 لأسباب كثيرة، هي خارج بحث هذا الكتاب، أيقظ مخاوف جديدة لدى الجمهور الإسرائيلي، ويمكن القول أن نوعية وكميات التهديدات والمخاطر – وكما حددتها مؤتمرات هرتسيليا السنوية منذ عام 2011 وحتى 2017، تمثّلت في أنواع جديدة من الحروب غير المعهودة لدى حكومات إسرائيل المتعاقبة، كما تمثّلت في نوعية تهديدات جديدة دفعت إسرائيل مرّة أخرى إلى طور آخر من أطوار التطرف، بحيث ابتعدت إسرائيل عن إمكانية التسوية كما يعرفها او يفكر فيها الفلسطيني أو العربي[22].
في هذه الفترة تعمّق إدراك إسرائيل – حكومةً وجمهوراً – بأن قدرتها على الردع متآكلة، وأن حروبها الجديدة لا تستطيع أن تحسمها أو تُنجز فيها أهدافها، وأنها بحاجة إلى الغرب الاستعماري لإنقاذها، وأنها تحتاج إلى أطرافٍ من المنطقة للضغط على الفلسطينيين، "الحروب الجديدة"[23]. التي صارت إسرائيل تخوضها، صارت تكشف عيوب نظرية الأمن الإسرائيلي التي تغيّرت تماماً[24].
ولهذا، فإن هذه المرحلة شهدت ما يلي تعبيراً عن هذه "الاستراتيجية الثقافية لليمين الجديد" وعن "الصهيونية الدينية الحديثة"[25]:
1. ازدياد استخدام القوة التدميرية تجاه الفلسطينيين كما حدث في الحرب على غزة (2012، 2014)، وكذلك خلال ما يسمى بالحرب بين الحروب.
2. تعميق وتكثيف عمليات الاستيلاء على مناطق (ج) في الضفة المحتلة وطرد المواطنين منها والسيطرة على مصادر المياه والمناطق الاستراتيجية.
3. العودة إلى الشعارات القديمة المشيحانية، بمعنى إسقاط النقاش حول مستقبل الأراضي المحتلة باعتبارها قضية منتهية، وإعلاء النقاش حول إعادة الروح إلى "القيم الروحية اليهودية" بما يؤسس لصهيونية قديمة جديدة تقوم على إحياء النغمة الانتقامية[26].
4. وتجسيداً لهذه الاتجاهات الجديدة فلم يكن من المستغرب أن تقوم الحكومة بضغط من الأحزاب القومية والدينية المكونة لها أن تُمرر في الكنيست قوانين عنصرية تجعل من أية تسوية قادمة مع الفلسطينيين ليست صعبة فقط وإنما تكاد تكون مستحيلة[27].
وبرأينا فإن قانوني التسوية ويهودية الدولة أفرغا أية تسوية من معناها أو جدواها، إذ ان قانون يهودية الدولة يقصر ملكية الأرض على اليهود، أما قانون التسوية فهو يُسقط حق الفلسطيني في أن يبني بيته على أرضه إذا كانت هذه الأرض ضرورية لاعتبارات حكومية أو عامة.
5. وتعميقاً لما ذُكر آنفاً، فقد انطلقت جماعات التطرف والغلو تستبيح الأرض والدم الفلسطيني بطريقة غير مسبوقة على الإطلاق، وبلغت ذروتها في خطف وحرق الطفل محمد خضير سنة 2015، وحرق عائلة دوابشة في العام 2016، ومهاجمة منازل المواطنين في برقين ودير استيا والمغيّر، وأماكن أخرى كثيرة، كما انطلقت تلك الجماعات، المعروفة جيداً للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إلى تلال وهضاب الضفة المحتلة لتقيم كرفانات استيطانية حيثما أرادت وكيفما ارادت، دون حسيب أو رقيب[28].
6. أما على المستوى الداخلي الإسرائيلي فإن تغوّل "الصهيونية الجديدة، الرخيصة والهشة"، الشعبوية والنزقة والحادة، كما عبّر عنها أحزاب يمينية جديدة مثل البيت اليهودي، قد عملت على ما يلي:
أ. سحب صلاحيات المحكمة العليا والتضييق على عملها وحتى التشكيك بقراراتها[29].
ب. طرحت مفاهيم جديدة لمفهوم المواطنة في مسعى جديد للتمييز بين المواطنين.
ت. تدهور القيم القديمة وكذلك صورة الدولة والمجتمع من خلال المس بتطبيق القانون والعدالة وخلخلة مفهوم الديمقراطية وتفشي ظاهرة الفساد والرشوة، .... إلخ، وهذا يعني أن التطرف والغلو في المجتمع الإسرائيلي إنما ينعكس سلباً على البنية الاجتماعية والنظام السياسي، التطرف لا يبني المجتمعات ولا يبشّر بمستقبل جيد.
نخلص من ذلك كله أن التطرف والغلو في إسرائيل يتعمّق كلما كان هناك إحساس بالهزيمة او تآكل الردع أو المحاصرة، وعلى مدى 25 عاماً فإن إسرائيل – حكومةً وأحزاباً وجمهوراً – اندفعت إلى مستويات أخرى من مستويات التطرف والغلو، بحيث انها لم تتجاوز اتفاق أوسلو فقط، بل خلقت أوضاعاً – على المستوى الميداني والقانوني والسياسي – سهّلت عليها أن تخرج من الاتفاق المذكور إلى مطالبات وشروط أخرى، أفضت جميعها إلى طرح صفقة ترامب التي تم التمهيد لها باعتراف إدارة ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وأن إسرائيل يهودية وأن الجولان السورية إسرائيلية أيضاً، ولم تكتف هذه الإدارة بذلك بل طرحت أيضاً إلغاء حق عودة اللاجئين وضرب فكرة وحدة الشعب الفلسطيني وإلغاء مبدأ إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، باختصار كانت رؤية إدارة ترامب لا تتبنى رؤية اليمين المتدين الإسرائيلي فحسب، وإنما تتجاوزها إلى صيغة تنجدل فيها الرؤية اللاهوتية المتطرفة بالرؤية الاستعمارية[30].
السبب الثاني: تسوية تتطلب انسحابات من المستوطنات
برأينا فإن اضطرار الحكومة الإسرائيلية – في وقت ما – للدخول في تسوية كلية أو جزئية تتضمن انسحابات من مستوطنات مركزية في الضفة المحتلة، قد يؤدي إلى عصيان مدني أو مواجهة حقيقية بين المستوطنين وقوات الاحتلال، وقد يقول قائل إن تسوية من هذا النوع – إذا تم التوصل إليها – ستقتضي فهماً أو تفهماً من الجمهور الإسرائيلي بما فيه الجماعات المتطرفة، وقد يكون هذا صحيحاً، ولكننا في هذا الافتراض الذي فيه كثير من الواقعية ندّعي أيضاً أن المستوطنات ما هي إلا دفيئات للتطرف والغلو، وأن اجيالاً من المستوطنين نشأت في المستوطنات ولا تعرف لها مكاناً غيرها، بمعنى أن هؤلاء سيعتبرون أنفسهم يدافعون عن "بيوتهم"، فإذا أضفت إلى ذلك أن كثيراً من تلك الأجيال تعتبر أن ما يقوله حاخاماتهم أهم وأكثر جدارة بالطاعة من أوامر الجيش، فإن إمكانية ظهور تلك الجماعات المُكفّرة والمتطرفة وارد جداً، وهو ما رأيناه بشكل تجريبي في إخلاء مستوطنات قطاع غزة سنة 2000، وفي إخلاء المستوطنة قرب سلواد سنة 2015، وحتى نستوفي قول المعترض أن أية تسوية ستضطر إليها إسرائيل فلن يُسمح فيها بترف النقاش أو الرفض، بل إن تسوية من هذا النوع ستُخضع إسرائيل، حكومة وجمهوراً، فهذا صحيح إلى حدٍ كبير، فالهزيمة لن تسمح بالنقاش والجدل، ولكن وفي ذات الوقت، فإن ما نطرحه هنا يتضمن تسوية تنقسم عليها إسرائيل، أو تسوية رمادية تضطر إليها إسرائيل بسببٍ واحدٍ من الآتي أو عددٍ منها:
1. أن تضطر إسرائيل إلى الدخول في تسوية إثر هزيمة قاسية أو تقليلاً للخسائر أو استباقاً لظرف إقليمي أو دولي ضاغط، للحيلولة دون اندلاع حرب إقليمية أو عالمية.
2. أن يُغيّر الغرب الاستعماري علاقته بإسرائيل، بحيث يُضعفها أو يحاصرها أو يضغط عليها بسبب تغير استراتيجي في المنطقة العربية أو بسبب عوامل داخلية في الغرب نفسه.
3. أن تضطر إسرائيل إلى تسوية لأي سبب آخر، مثلاً: كارثة طبيعية، جدال داخلي يؤدي إلى انقسام، تغير جذري في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
إن الافتراضات الثلاثة السابقة، وإن بدت الآن تدعو إلى الدهشة والاستغراب، ولكنها – أي هذه الافتراضات – صحيحة تماماً حسب السيرورة التاريخية، إن أية تسوية تتضمن انسحابات من المستوطنات ستؤدي بالضرورة إلى مواجهة – واسعة أو ضيقة، عسكرية أو مدنية – بين من ينفذ الانسحاب وبين جموع المستوطنين الذين يزدادون شراسة وتطرفاً، وهؤلاء يعلنون منذ الآن أنهم سيقاومون أية انسحابات من مستوطنات الضفة[31]. وبالعودة إلى كتاب "أسياد البلاد" الذي أشرنا إليه، فإن هؤلاء، وحسب الحاخام تسفي يهودا كوك، فإن "أرض إسرائيل ليست ملكاً للملايين الثلاثة من اليهود الذين يعيشون فيها، بل هي لكل يهود العالم، ولا يملك أحد سلطة ولم تتلق تفويضاً للتنازل عن هذه الأراضي ولا يجوز بأي شكل من الأشكال التنازل عنها وهذا أمر صدر من الله، وسوف نقتل من أجل عدم الانسحاب، فنحن لا نعترف بأية حسابات أو تعقيدات سياسية ولا بأية ترتيبات حكومية أو بتصريح لأي من وزرائنا التي لن تُغيّر ولن تفيد في هذا الموضوع"[32].
هذا الكلام وأمثاله قيل في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وقد عاد إلى الظهور الآن في نسخة شعبوية بالغة الطيش والجهل والتطرف، ومدعومة من إدارة أمريكية ترى في هذا الطرح جزءاً من رؤيتها المشيحانية الاستعمارية، ما الذي حصل ما بين سبعينات القرن الماضي وبين بداية العقد الثالث للألفية الثالثة؟ لماذا تعود هذه الصهيونية الجديدة التي لم تجد سوى المسوغات اللاهوتية لرفض التسوية والشراكة والقانون الدولي واعتبارات السياسة الإقليمية والعالمية؟
إن سيطرة هذه الرؤية على الجمهور وعلى الحكومة الإسرائيلية جعلت من فكرة الانسحاب من أية مستوطنة في الضفة الغربية تكاد تكون مستحيلة، ولذلك فإن أية تسوية تتضمن ذلك، ستؤدي إلى انقسام حقيقي في الجمهور الإسرائيلي على الفور، وخصوصاً أن مستوطني الضفة المحتلة يخدمون في جيش الاحتلال وهم مؤدلجون، كما أن هذا الاستيطان لم يعد مجرد خدمة أمنية وإنما تحول إلى مشاريع ربحية استعمارية، بالإضافة إلى أن هذه المستوطنات، أو بعضها على الأقل، غيّرت من صورتها العسكرية واللاإنسانية، إذ أنها تحتوي على مرافق استهلاكية وترفيهية تجعلها ذات جاذبية ما، ليس فقط لدارسي التوراة، وإنما للعلمانيين والباحثين عن معاني وأهداف جديدة[33].
السبب الثالث: وصول المتدينين إلى الحكم في إسرائيل
وهذا قد يحصل من خلال طريقتين، هما:
1. تزايد أعداد المتدينين الذين يعملون في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، في هيئة الأركان وسلاح الجو وأجهزة المخابرات، وقد تحدّث عن ذلك كثير من الباحثين العرب والإسرائيليين، وقد تحدّث بالذات الكُتّاب الإسرائيليين عن مخاوفهم من سيطرة هؤلاء على المؤسسة العسكرية، كما تحدّثوا أيضاً بكثير من التفصيل حول كيفية تفتيت ظهور أية أنوية أو تكتلات لهؤلاء على القرار السياسي أو العسكري[34].
الجيش الإسرائيلي الذي يتغير باستمرار في تركيبته ومحتواه وسياساته، صار أكثر جذياً وسهولة لدخول المتدينين في صفوفه، خصوصاً أن الخدمة العسكرية لم تعد كما كانت في العقود الأولى لقيام إسرائيل، فلم يعد الأشكنازي العلماني الأبيض الذكر هو الذي يحظى بالخدمة وامتيازاتها، إذ أن هذا الجيش صار يستوعب الشرقيين والطوائف والأعراق الأخرى، وكذلك النساء وذوي الاحتياجات الجنسية الإشكالية[35].
إن تطرّف المجتمع الإسرائيلي وانزياحه السريع والعميق نحو اليمينية المتوحشة، بالإضافة إلى تغيّر التركيبة الديموغرافية والاقتصادية لهذا المجتمع، وكذلك تغيّر نوعية المخاطر والتحديات والتهديدات، سيجد له تعبيرات أكيدة في بنية واتجاهات وأهداف الجيش ذاته.
إن احتمال سيطرة المتدينين المتطرفين على الجيش أو على المؤسسة العسكرية ليست من بنات أفكارنا أو أحلامنا، بل هو خطر حقيقي تحدّث عنه الإسرائيليون أنفسهم قبلنا، وهم يأخذون بعين الاعتبار هذه الإمكانية، لهذا فإنهم يعملون على التقليل من تأثيرهم ويمنعون من تكتلهم، ولكن الأمر يرتبط بالأحداث والزمن ليس إلا[36].
هل يمكن للمتطرفين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي أن يفكّروا يوماً بانقلاب عسكري أو اختطاف القرار أو التأثير على المستوى السياسي باتخاذ قرارات متهورة كاستخدام الأسلحة النووية أو الحرب الشاملة أو ضرب مواقع مقدّسة؟
وهل يمكن للمتطرفين هؤلاء أن يقوموا بمذابح واسعة تورطهم وتورط إسرائيل وتُبعد المجتمع الدولي عنها وعن دعمها أو تغطيتها؟
وهل يمكن للمتطرفين هؤلاء مثلاً أن يتخذوا قرارات لا تأخذ بعين الاعتبار المصلحة السياسية الدنيوية ويُنفّذوا "أوامر التوراة" مثلاً؟
وهل يمكن لهم – إذا استولوا على السلطة بأي طريقة من الطرق – أن يُغيّروا وجهة إسرائيل ومضامينها ومزاجها وسياساتها وتحالفاتها؟ هل يمكن أن يكونوا ويُنفّذوا شعار أنهم يهود لا جزءاً من مشروع استعماري كبير وأن "هويتهم" أهم من "وظيفتهم"؟
هذه أسئلة لم نسألها نحن، وإنما سألها يهود أيضاً.
2. إمكانية أن يسيطر المتدينون على السلطة في إسرائيل من خلال صناديق الاقتراع، بمعنى أن تصبح الأحزاب الدينية هي التي تستطيع تشكيل الحكومة دون الاستعانة إلى حدٍ كبير بأحزاب تمنعها أو تكبحها من تطبيق "الشريعة" كما تراها هذه الأحزاب.
وقد يقول قائل إن الحريديم أو المتطرفين جداً، قد لا يعتبرون إسرائيل الحالية دولة أقامها الرب، أو أنها امتداد للمنفى باعتبار أن الرب لم يأذن بدولة كما يريد، ونعتقد أن هذا الأمر تم تجاوزه على أيامنا هذه، إذ أن المتدينين وصلوا إلى قناعات جديدة تُسوّغ لهم التعامل مع هذه الدولة الدنيوية باعتبارها أُقيمت برعاية الرب ولو بأيدٍ علمانية، ثم إن اليهودية الجديدة – الشعبوية والنزقة – تعتبر نفسها وريثة للصهيونية الكافرة، وأن هذه الدولة القائمة هي أيضاً هدية الرب التي يمكن إصلاحها أو تعديلها[37].
وهناك من سيعترض أن جمهور المتدينين في إسرائيل لا يتجاوز نسبة 8% تقريباً، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء أن يتمكنوا من تأليف حكومة، ورداً على هذا الاعتراض الوجيه نعتقد أن هذه النسبة تعكس نسبة الحريديم فقط، أما نسبة من يعتبر نفسه تقليدياً أو محافظاً أو متديناً فهم يُشكّلون نسبة عالية جداً من الجمهور، أكثر من ذلك، نحن نعتقد أن موجة التدين والعودة إلى "الهوية اليهودية"، بغض النظر عن محتواها، ستتزايد يوماً بعد يوم على خلفية ازدياد المخاطر والإحساس بالعزلة، لذلك هناك احتمال كبير لسيطرة المتدينين – على أنواعهم – على دفة الحكم في إسرائيل، وبالتالي فإن المجتمع الإسرائيلي سيواجه أخطاراً متعددة، من ضمنها استعداء أو فتح جبهات قد لا تكون متوقعة.
فهل يمكن لهؤلاء – إذا شكّلوا حكومة – أن يبدأوا حرباً دينية أو أن يشنّوا حروباً متعجلة أو أن يرتكبوا أخطاءً لا يمكن إصلاحها؟ هذه أسئلة تراود زعماء وقادة أحزاب دينية، ولهذا فهم يُشجّعون انخراط أتباعهم في المؤسسات الرسمية ويَشجّعون على انخراطهم في المؤسسات التعليمية والأمنية، كما يستفيدون من لعبة الديمقراطية في إسرائيل، ولهذا فهم يًنظّمون أنفسهم جيداً، وإذا كانوا يكتفون الآن بابتزاز الأحزاب الرئيسية بما يتعلق بالميزانيات وبعض الوزارات الهامشية، فإن المستقبل مفتوح على مصراعيه لكل الاحتمالات[38].
السبب الرابع: ازدياد الصراعات الأثنية في المجتمع الإسرائيلي
احتمالية ظهور جماعات متطرفة مُكفّرة في إسرائيل تتزايد بالنظر إلى تفكك الهويات المستمر في المجتمع الإسرائيلي، فإسرائيل دولة مهاجرين، ولهذا فهي دولة أعراق ودولة ثقافات فرعية ودولة قطاعية من الدرجة الأولى، وهي تتميز بشروخ متعددة، هي:
1. شروخ قومية: وهي صراعات بين الفلسطينيين أصحاب البلاد والحركة الصهيونية التي تعتمد على مهاجرين من أعراق مختلفة تجمع بينهم مصالح وهوية غير واضحة المعالم.
2. شروخ سياسية: وهي صراعات بين يمين قومي (علماني أو ديني) وبين يسار (على غموض المصطلح) ليس بعيداً عن اليمين في توجهاته السياسية، ولكنه يحاول أن يكون بديلاً اقتصادياً أو اجتماعياً.
3. شروخ طائفية: وهي صراعات بين الطوائف الشرقية والطوائف الغربية، وهي صراعات تشمل الطقوس والزواج والتعليم والمزاج .... إلخ.
4. شروخ دينية: وهي صراعات بين المتدينين على توجهاتهم وبين العلمانيين على توجهاتهم.
وهي شروخ واضحة وتؤثر كثيراً في النظام السياسي، وخصوصاً على خلفية تآكل قوة ونفوذ الطوائف الغربية أو الشكنازيم وتناقص عددهم، وازدياد عدد الطوائف الشرقية وانعطافهم نحو اليمين القومي والحريدي، والأمر لا يتوقف عند التأثير العددي – رغم أهميته في نظام سياسي يعتمد على الانتخابات – ولكنه يتجاوزه إلى طبيعة النظام السياسي وتوجهاته.
ورغم وضوح هذه الصراعات وإمكانية متابعة نتائجها من صدامات في الشارع، ونفوذ في الكنيست ومسّ بالقضاء وتغيير في بنية الجيش وتغيّر أولويات الجمهور وتشدد في المواقف السياسية وميل شديد نحو العدوانية، إلا أن هذه الشروخ لم تفحص بعد، بمعنى أن هذه الشروخ موجودة في كثير من المجتمعات غير المتجانسة طائفياً أو عرقياً أو ثقافياً، ولكنها تستطيع الاستمرار والبقاء وتحقيق النمو أيضاً، ولا يمكن فحص مثل هذه الحالات إلا بتعريض هذه المجتمعات إلى تجارب قوية وعنيفة لفحص قوة تماسك المجتمع المتعدد الثقافات أو الأعراق[39].
هل يمكن لأي من هذه الشروخ أن يتحول إلى عامل مساعد لخلخلة المجتمع الإسرائيلي إلى درجة أن تصطدم الطوائف والأعراق؟
هل يمكن لأي من هذه الشروخ أن يزيد عن حده لخلاف على سياسة أو تقاسم السلطة أو الثروة أو لإحساس بالقوة أو امتلاك القوة؟
هل يمكن لهذه الثقافات الفرعية أن تفكك إلى درجة أن تتحول إلى ثقافات معادية؟
هذا سؤال معلّق ينتظر الإجابة التي من الممكن توقعها من خلال استقراء الأحداث والواقع.
السبب الخامس: تدهور الاقتصاد الإسرائيلي وتغيّر نوعية الحياة
هذا السبب كان مقلقاً لباحث إسرائيلي كبير هو أرنون سوفير إلى درجة أنه كتب عدداً من الأبحاث المنشورة يتحدّث فيها عن مخاطر انهيار البنية التحتية في إسرائيلي وتغيّر جودة الحياة وتفشي البطالة والجريمة بسبب ازدياد عدد الفقراء من العرب والمتدينين والمهاجرين والمتسللين[40]. وقد وصل قلقه درجة قال فيها إن الديموغرافيا في إسرائيل قد تقضي على الجغرافيا.
وحتى الآن (2019) فإن إسرائيل دولة جاذبة للمهاجرين، وما يزال اقتصادها في تصاعد رغم الأوضاع والتحديات، ولكن – حسب سوفير – فإن الإبقاء على سياسات الدعم الحكومي وعدم تغيير التعاطي مع القطاعات الحريدية والعربية وكذلك سياسات الهجرة المتّبعة ونسبة المواليد في القطاعات المتعددة، فإنه ومع حلول سنة 2030 فإن إسرائيل ستفقد أفضليتها كدولة من دول العالم الأول، إذ ما سيميزها الأعداد الكبيرة من السكان والموزعين بطريقة عشوائية وبنسب توالد مهولة، الأمر الذي سيضغط على البنية التحتية من ماء وكهرباء وخدمات وإسكان .... إلخ، وبذلك فإن تزايد أعداد السكان والتخطيط العشوائي للمدن والتجمعات السكنية سيفضي إلى الجريمة والبطالة والفساد والأمراض ونقص في كفاءة الخدمة وجودتها.
وقد بلغ سوفير من الوقاحة الحد من القول إلى الإيحاء بأن الحل هو في سلسلة من الإجراءات العنصرية للحد من تزايد السكان أو تجمعهم في مناطق معينة[41].
ما يعنينا في هذا العرض أن إسرائيل التي غيّرت من سلوكها الاقتصادي منذ الثمانينيات من القرن الماضي باتجاه الخصخصة وانفتاح السوق وتخلي الدولة عن الدعم المقدم لطبقات هشة من المجتمع، كل ذلك دفع باتجاه انكشاف تلك الطبقات أو الفئات أكثر فأكثر لمنطق السوق الذي لا ينتظر غير المهرة أو الكسالى أو المنتظرين للهبات الحكومية[42].
فهل يمكن لتوقعات أو تحذيرات أرنون سوفير أن تصبح حقيقة واقعة؟
وهل يمكن أن تلعب المتغيرات الإقليمية والدولية دوراً في تدهور الاقتصاد الإسرائيلي مثلاً؟ كحرب إقليمية أو تغيّر في الأحلاف أو حتى لظرف بيئي؟
وهل يمكن للصراعات الأثنية إذا أُضيفت إلى تدهور في الاقتصاد الإسرائيلي أن تؤدي إلى ظهور جماعات متطرفة ترغب أو تحاول وضع حلول راديكالية لوضع راديكالي؟
من ناحية سيسيولوجية فإن انهيار الاقتصاد وتدني مستوى الحياة يؤدي بالضرورة إلى ثورات من أنواع مختلفة، فهل يمكن لإسرائيل أن تكون استثناءاً؟
وهل يمكن لموجات التطرف التي تضرب الإقليم العربي أن تلعب دوراً كبيراً في إذكاء الجماعات المتطرفة اليهودية كنوع من ردة الفعل العصابية؟
هذه أسباب خمسة قد تؤدي ضمن ظروف معينة إلى ظهور حركات متطرفة قد تعمل ضد مجتمعها انتقاداً أو هدماً أو تصحيحاً أو تنفيذاً لرسائل الرب التي يعتقدون أنهم المخولون بتطبيقها.
وربما يكون هناك دواعٍ أخرى لظهور مثل هذه الحركات إذا جُمعت الأسباب الخمسة معاً أو في معظمها أو لتأثيرات خارجية أو لحرب أهلية أو لأي سبب آخر، هل تبدو إسرائيل مهيأة لذلك؟ أو هل هناك ظروف تقود إلى ذلك؟ هذه سيرورة تاريخ، ولا أحد يقدر أن يتنبأ بشكل نهائي.
[1] يُعتمد في هذه الروايات على ما ذكره المؤرخ اليهودي يوسيفوس الذي تحول إلى مواطن روماني، وبالتالي فقد كتب ما كتب ليرضي عنه السلطات الرومانية، وهذا المؤرخ عادةً ما يُتّهم بالكذب أو المبالغة أو عدم الدقة، أُنظر: جون روز، أساطير الصهيونية، نشر بلوتو برس، لندن، 2004، هذا فضلاً عن كتاب روجيه غارودي الشهير "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية"، الذي نشرته دار الشروق في القاهرة سنة 1998، وكذلك كتاب بولي فندلي "الخداع"، الذي نشرته دار المطبوعات للتوزيع والنشر في بيروت عام 1993.
[2] غوستاف لوبون، من أوائل من أشار إلى أثر ذلك في تشكيل الهويات القومية، أُنظر: كتاب سيكولوجية الجماهير، تقديم وترجمة هاشم صالح، دار الساقي، لندن، 1991، وكذلك كتاب السنن النفسية لتطوّر الأُمم، ترجمة عادل زعيتر، دار هنداوي للنشر، القاهرة، 2016، وفي هذا الصدد لا يفوتنا أن نُشير إلى ما ذكره ابن خلدون في هذا المجال، عندما أشار إلى مكونات تشكّل النظام السياسي بما أسماه "العصبية".
[3] هو طبعة مزيدة ومُنقّحة عن كتاب "قراءة جديدة للظاهرة التكفيرية" الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، رام الله، 2017.
[4] عكيفا إلدار، عديت زرطال، أسياد البلاد .. المستوطنون ودولة إسرائيل 1967 – 2004، ترجمة عليان الهندي، 2006، ص141.
[5] المصدر السابق، ص242.
[6] المصدر السابق، ص268، والحاخام تسيفي يهودا كوك هو ابن الحاخام يهودا كوك الذي أسس المدرسة الدينية "مركاز هراب" في القدس في بداية عشرينيات القرن الماضي، وكان لها تأثيراً كبيراً على مجمل الحراك الديني والسياسي والاستيطاني في البلاد، وكوك الأب له مؤلفات لقيت ترحيباً كبيراً بين أوساط المتدينين بسبب ذلك الطرح الذي وحّد بين مفاهيم متناقضة، إذ قدّم هذا الرجل طرحاً حلولياً جمع فيه ما بين الأرض والشعب والتوراة، بحيث قلل الفروقات وقرّب بين المتناقضات في الطرح الصهيوني العلماني والديني، وأُعتبر ابنه الحاخام تسيفي المفسر المعتمد لهذه الرؤية الحلولية – المتطرفة – التي لقيت تطبيقاً عملياً لها في حركات استيطانية متعددة، أولها – وأعمقها – جماعة غوش ايمونيم، ولكن هذه الأفكار ما تزال حتى اللحظة (2019) تجد لها جماعات هنا وهناك تُعيد ذات الأُطروحة وإن بأساليب مختلفة، أُنظر: نور الدين مصالحة، أرض أكثر عرب أقل .. سياسة الترانسفير، 1949 – 1996، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1997.
[7] عكيفا إلدار، مقتبساً عن اورئيل طال، الأُسس المسيحية السياسية في أرض إسرائيل، مقتبس من الرواية وفهم اليهودية في عصرنا، تل أبيب، 1986، ص119-120.
[8] عُرف ذلك بإعلان البندقية سنة 1980، حيث اعترفت دول الاتحاد الأوروبي بحق تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره وإقامة دولته والطلب إلى إسرائيل بالتوقف عن بناء المستوطنات التي اعتبرها الاتحاد عقبة في طريق السلام، وكانت أوروبا قبل ذلك وفي العام 1975 قد أقامت علاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية على خلفية حرب 1973 وأزمة النفط العالمية، حيث استعمل العرب النفط كسلاح في المعركة، أُنظر: بشارة خضر، أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2003.
[9] إلدار، مصدر سابق، ص243.
[10] غرشون شفيط، غوش ايمونيم .. الرواية من وراء الكواليس، بيت إيل، 1995، ص177.
[11] مولي بيلغ، لنشر غضب الرب من غوش ايمونيم حتى ساحة رابين، تل أبيب، 1997، ص56 وما بعدها، وفي هذا الكتاب يتم تصوير غوش ايمونيم باعتبارها قمة جبل الجليد الذي يُخفي تحته "بنية تحتية اجتماعية وثقافية كبيرة نمت بهدوء خلال سنوات طويلة، وعندما نضجت الظروف التاريخية الخاصة برز فجأة الرأس المتطرف".
[12] تصاعد المد الديني في إسرائيل اتخذ عدة مظاهر مختلفة، أما المظاهر الاجتماعية فقد تمثّلت في ازدياد الصراع الديني العلماني واغتيال رابين وتصاعد دور المتدينين في المؤسسة العسكرية وازدياد ظاهرة التعليم الديني وتعدد وتنوع المصادر المالية التي تغذي القوى الدينية، أما المظاهر السياسية التي جسّدت انتشار وتصاعد القوى السياسية الدينية اليهودية فتمثّلت في ازدياد الحصول على مقاعد الكنيست منذ عام 1977، والمشاركة الكبيرة في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ومدى تأثير القوى الدينية على التوجهات السياسية، حيث رأت معظم تلك القوى ضرورة الاحتفاظ بالأرض المحتلة وتعزيز الاستيطان وعدم الدخول في تسويات مع العرب أو الفلسطينيين، وحول تصاعد القوى السياسية الدينية في إسرائيل، فإن أسبابها قد تعود إلى عوامل دولية (التحول إلى قطاع القطب الواحد وانبعاث الهويات وتغيّر موقع الدين في الإدراك العالمي)، وعوامل إقليمية (الانتفاضة عام 1988، حرب الكويت 1991، انطلاق العملية السلمية 1992، عمليات المقاومة في لبنان وفلسطين)، وعوامل داخلية (الصراع بين الشرقيين والغربيين، وهجرة اليهود الروس، والصراع الديني العلماني)، والتغيرات في النظام السياسي، وكذلك عوامل ذاتية تتعلق بوجود قاعدة ثابتة للأحزاب الدينية، وزيادة عدد المتدينين، وكفاءة القوى الدينية، ووجود عناصر قيادية متميزة، وكذلك عوامل التشاؤم والتوحد الخاصتين للقوى والأحزاب الدينية، للمزيد: عبد السلام المحارمة، تصاعد القوى الدينية الإسرائيلية 1988 -1996 .. رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2000.
[13] صالح النعامي، في قبضة الحاخامات: تعاظم دور التيار الديني الصهيوني في إسرائيل وآثاره الداخلية والإقليمية، الرياض، مركز البيان للبحوث والدراسات، 2013، وكذلك بركات نظام ومحمد الشرعة، القوى الدينية ودورها في الحياة السياسية في إسرائيل، في مجلة المنارة، عدد 1، الأردن، 2006.
[14] النعامي، المصدر السابق.
[15] إيلان بابيه وآخرون، صهيونية جديدة نفاثة، تقديم وترجمة محمد حمزة غنايم، مدار، رام الله، 2001، ص7 وما بعدها.
[16] المصدر السابق، ص9، وقد يبدو أن من المناسب التفريق بين ما يسمى بما بعد الصهيونية التي تميّزت بالتسوية مع الفلسطينيين والسماح برواية أخرى للتاريخ الصهيوني والاعتراف بالشروخ والطوائف والأعراق التي تُشكّل المجتمع الإسرائيلي، وكذلك فتح الإعلام أمام الاستثمارات والتخلص من مؤسسات عمالية وجمعوية وخصخصتها، مثل الهستدروت والكيبوتسات، وكذلك الاندماج في السوق العالمية وشيوع ظواهر الأمركة والاستهلاكية، ما بعد الصهيونية تعمي بشكل ما التخلص من الرؤية العسكرية الاشتراكية القومجية وسيطرة الدولة على الاقتصاد والمجتمع، للمزيد: د. عزيز حيدر، التطورات الاقتصادية والحراك السياسي في إسرائيل، مدار، رام الله، 2005.
[17] صرّح الرئيس محمود عباس عدة مرات أن الاحتلال الإسرائيلي هو أرخص احتلال في العالم، وأن السلطة الفلسطينية بدون سلطة.
[18] د. مفيد قسوم، د. جوني منصور، إسرائيل 2006: ملخص تنفيذي في تقرير مدار الاستراتيجي لعام 2007، وكذلك تقرير مدار الاستراتيجي لعام 2008.
[19] من الغريب حقاً أن يلتقط صحفي فرنسي التغيرات العميقة التي ميّزت تلك الفترة من خلال كتاب نُشر بالفرنسية بعنون "حلم رام الله، رحلة في قلب السراب الفلسطيني"، عن دار جروس للنشر، في العام 2013، ثم ترجمته للعربية سناء خوري، وقال الكاتب في ندوة له بمدينة رام الله بتاريخ 18/03/2013 في متحف محمود درويش: أنه حاول أن يرصد عملية التغير في رام الله وفي الأراضي الفلسطينية بشكل عام وتصوير الأمر هناك دولة تقوم وهناك ازدهار يزدهر بطريقة استفهامية، فيما كان د. أحمد رفيق عوض أكثر مباشرة في مقاله المنشور بجريدة القدس حول الظواهر الجديدة التي يمكن ملاحظتها لدى الجمهور الفلسطيني من حيث تفضيل الكسل وزيادة حالات الاستهلاكية والأمركة والجريمة وقلة المبادرة وتغير وسائل الانتاج وانعكاس ذلك على الحراك الاجتماعي والسياسي، د. أحمد رفيق عوض، الظواهر السيسيولوجيا بعد اتفاق أوسلو، جريدة القدس، 2013.
[20] للمزيد: د. أحمد رفيق عوض ود. محمد المصري، تغير المخاطر والتهديدات في حروب إسرائيل المستقبلية، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة القدس المفتوحة، رام الله، 2015.
[21] شهدت الفترة ما بين 2000 – 2011 تآكل قوى اليسار الإسرائيلي بشكل كبير، وزيادة في قوى الأحزاب اليمينية والدينية، كما شهدت أيضاً ظهور حركات دينية مشيحانية خارج الأُطر الرسمية للدولة، مثل حركات الاستيطان وحركات مطاردة النساء اليهوديات المتزوجات من فلسطينيين، وانتقل صنع القرار الرسمي الإسرائيلي إلى معسكر اليمين الذي عبّر عنه نتنياهو بشكل نموذجي، إلى ذلك فإن الانتخابات منذ 2001 وحتى 2013 شهدت انتصاراً لليمين الإسرائيلي الذي استطاع أن يقدم إجابات أكثر اقناعاً من اليسار الذي فقد القدرة على أن يكون بديلاً سياسياً أو اجتماعياً للجمهور الإسرائيلي الديناميكي وصعب الإرضاء ومتعدد الهويات.
[22] عوض والمصري، مصدر سابق.
[23] تعبير الحروب الجديدة لإسرائيل أصبح دارجاً ومألوفاً مؤخراً، وهو ما يسمى بحروب الجيل الرابع، وذلك للمتغيرات التي أصبحت سمة بارزة لهذه الحروب، مثل اشتراك الجبهات الداخلية فيها والميليشيات شبه العسكرية، وانعدام الحسم، للمزيد: أُوري بن أليعازر، الحروب الجديدة لإسرائيل – تفسير اجتماعي تاريخي، ترجمة عليان الهندي، مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، 2014.
[24] اقترح رئيس هيئة الأركان غازي ايزنكوت استراتيجية للجيش نشرته صحيفة هآرتس بتاريخ 14/08/2015، تقوم على عناصر: الردع، الإنذار، الدفاع عن الجبهة الداخلية، الحسم.
[25] دانيئيل روزنبرغ، الاستراتيجية الثقافية لليمين الإسرائيلي الجديد، في "قضايا إسرائيلية"، عدد 57، مدار، رام الله، 2015، ص9 وما بعدها.
[26] تومر برسيكو، الصهيونية كقومية متطرفة .. النيوليبرالية والمركزانية العرقية، في "قضايا إسرائيلية"، عدد 57، مدار، رام الله، 2015، ص9 وما بعدها.
[27] مثل قانون التسوية الذي يجعل من الاستيطان شرعياً تماماً، أو الذي يجعل من فكرة الاستيطان مبررة قانونياً، وكذلك قانون يهودية الدولة الذي يقصر ملكية الأرض لليهود فقط، وعملياً فإن هذين القانونين يسقطان كل المبررات أو المسوغات للدخول في تسوية تتضمن انسحابات من الأرض.
[28] بلغت الاستهانة بروح ودم الفلسطيني أن برّأ القضاء الإسرائيلي كل المتهمين بقتل أو حرق الفلسطينيين، أكان ذلك في حالة محمد خضير أو عائلة دوابشة أو أمل الرابي، كما أن الاعتداءات المتكررة التي ينفّذها غُلاة المتطرفين ضد القرى الفلسطينية، كحرق المحاصيل أو قطع الأشجار أو تكسير السيارات وتدمير المنازل، لا تُتابع من قِبل أجهزة الاحتلال ولم نسمع أو نقرأ أن أحداً من المنفذين قُدّم إلى محاكمة، فضلاً عن اعتقاله، مما يقود إلى الاستنتاج أن ما يقوم به هؤلاء المتطرفون هو جزء من سياسة ممنهجة تقوم على تقسيم الأدوار وتبادل المواقع.
[29] حكومة نتنياهو الرابعة (2016 – 2019) شهدت مضايقات حقيقية تجاه المحكمة العليا من خلال تعيينات القضاة فيها ومحاولة سحب صلاحياتها باتجاه الكنيست، وفيما يخص المواطنة فقد طرحت مسالة الولاء والخدمة في الجيش كشروط للاعتراف والتمويل، وكذلك سلوكيات أخرى كأحقية السكن وملكية العقارات في المناطق اليهودية، ومصادرات واسعة غير مسبوقة في النقب وهدم المنازل غير المعترف بها من قِبل حكومة إسرائيل، حكومات نتنياهو شهدت موجات غير مسبوقة من موجات العنصرية المقوننة.
[30] كانت إدارة ترامب تضم متطرفين أو حتى مهووسين دينيين مثل نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية بومبيو، وكذلك سفير أمريكا في إسرائيل فريدمان، وهو يهودي يدعم الاستيطان مادياً ومعنوياً، وكذلك جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو يهودي ينحدر من عائلة يهودية احترفت التجارة، وهناك أيضاً جيسون غرينبلات، وهو يهودي متطرف عمل محامياً ومستشاراً لترامب لفترة طويلة من الزمن، أما اليمين الإسرائيلي الحاكم فيضم معظم أحزاب اليمين القومي، العماني، المتدين، المتطرف، (الليكود، إسرائيل بيتنا، البيت اليهودي، شاس، أغودات يسرائيل)، وهنا الكلام عن حكومة نتنياهو الرابعة (2016 – 2019)، يجب القول إن كل ما طرحته إدارة ترامب منذ 2017 وحتى منتصف سنة 2019 من سياسات وقرارات ضد الشعب الفلسطيني وسلطته وفصائله إنما هي مطالب إسرائيلية يمينية سابقة ولاحقة.
[31] ألدار وزرطال، مصدر سابق، ص268.
[32] المصدر السابق، ص270.
[33] تقرير صادر عن هيئة شؤون الاستيطان ومقاومة الجدار، لسنة 2018.
[34] هم كُثر جداً ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، توفيق أبو شومر، 2016، محمد محمود أبو غدير، 2000، يهودا بن مائير، 1996، يورام بيري، 2007، أحمد بهاء الدين شعبان، 1996، وكثيرون غيرهم، وجميعهم بلا استثناء يتحدثون عن أعداد وتأثير هؤلاء المتطرفين على المؤسسة العسكرية، وقد وصل الحال بكاتب إسرائيلي اسمه تسفيكا عميت وضع رواية وتصوّر فيها أن هؤلاء قاموا بانقلاب في إسرائيل مستغلّين تغلغلهم في المؤسسة العسكرية، وقد صدرت الرواية بالعربية سنة 2006، وصدرت عن دار الجليل للنشر في عمان، الأردن، وترجمها بدر عقيلي.
[35] للمزيد: قتيبة غانم، الأُصولية الدينية في الجيش الإسرائيلي، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 2018، ص96 وما بعدها.
[36] أُنظر: نوريت سادلر وإيال بن آري، جنود دينيون آخرون .. وجهات نظر الأرثوذكسي في الخدمة العسكرية في إسرائيل المعاصرة، في "شؤون إسرائيلية"، عدد 9، 2003، ص17-48، وللباحث إيال بن آري دراسة أخرى مشتركة مع عدنة لومسكي حول تقليل تأثير المتدينين في الجيش الإسرائيلي، نُشرت أيضاً في "شؤون إسرائيلية"، سنة 2003.
[37] ألدار وزرطال، مصدر سابق، ص280 وما بعدها.
[38] المصدر السابق.
[39] أُنظر: ولد أباه، مستقبل إسرائيل، دار الفكر المعاصر، بيروت، 2001، وكذلك أنطون شلحت (ترجمة)، من دولة قانون إلى دولة موز، مدار، رام الله، 2006.
[40] كتب هذا الباحث الكتب التالي: إسرائيل 2000 – 2020 .. مخاطر واحتمالات، ترجمة محمد حمزة غنايم، مدار، رام الله، 2001، وكذلك الجغرافيا والديموغرافيا .. أهي نهاية الحلم الصهيوني، منشورات عتليت، حيفا.
[41] المصدر السابق.
[42] حيدر، مصدر سابق، ص15 وما بعدها.



 صور
صور













































