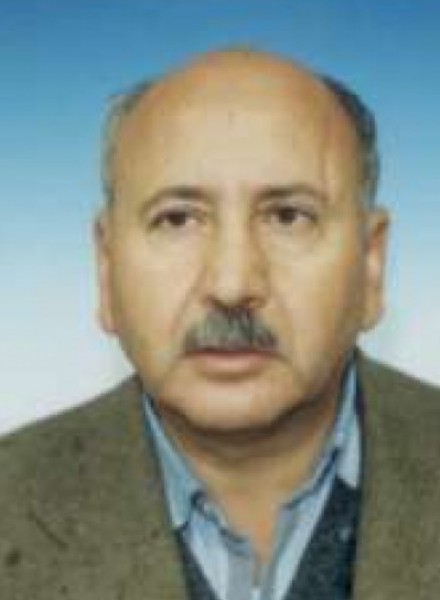
هدير الضمير
مصطلحات سادت ثم بادت!!
البيادر: كيف كانت وأين صارت ؟!
ياسين عبد الله السعدي
البيادر للجمع واحدها (بيدر) كما يقول المنجد (... الموقع الذي يدرس القمح فه ونحوه ويداس بالنورج). ونزيد توضيحاً: البيدر مساحة من الأرض المستوية الصلبة أو يتم جعلها صلبة بعد رشها بالماء وضغط السطح جيداً. كان البيدر بمثابة نقطة تجميع الغلال بعد النضج أيام الصيف والقيام بهرسها ب (النورج) لتخليص الحبوب منها، وخصوصا غلال القمح والشعير والذرة البيضاء والعدس والفول والكرسنة وغيرها مما يزرعه الفلاحون، وإن كانت زراعة الذرة تراجعت إلى درجة الاضمحلال تقريباً. أما السمسم فكان يجمع في حِزَم تُربط من نبات السمسم نفسه بعد أن ينضج وتوضع الحِزَم على شكل صفوف مرتبة على البيدر حتى تجف وتُضْرب بالعصي أو ببعضها لكي يتم إخراج البذور من (أجراسها)، وكانت توضع على سطح البيت عادة إذا لم تكن كثيرة.
قبل البدء بالهرس (الدَّرس) كان يُنصب جدار من أغصان الشجر على طرف البيدر مقابل الجهة التي يَهُبُّ منها الهواء لكي يتم تجميع التبن المتطاير والاحتفاظ به طعاماً للدواب التي يقتنيها الناس للاستعمال أو لتسمينها كالغنم والبقر. أما التبن الخشن فيسمى (القَصَل) ويستعمل وقودا للطابون ويحفظ في (المِقْصَل).
أيام الحصاد هي أيام جني المحصول وحصول الفلاح على نتيجة جهوده التي بذلها من حراثة وبذر وزرع وري أحيانا. كان يتم نقل المحصول على الدواب بواسطة (القوادم) وهي جهاز من خشب الشجر الصلب كشجر الخروب يصنعه الفلاحون بطريقة تجعله من قسمين متساويين مربوطين من الأعلى بشكل محوري يمكن أن يفتح لكي يرفع على الدابة ويربط القش بالحبال بطريقة متقنة بحيث يظل مشدودا ولا يتساقط منه شيء في الطريق قبل إنزاله على البيدر.
من عادة النساء أن يذهبن بعد العصر إلى البيدر ويجلسن ويبدأن بانتقاء العيدان المناسبة لعمل صواني القش التي كنَّ يلونها بألوان مختلفة ويعملن منها أشكالاً ملونة جميلة كانت تعلق على جدار المنزل كأشكال من الزينة. أما الصواني غير الملونة فكانت تستعمل لتقديم الطعام عليها كما نفعل اليوم بتقديم الطعام (أحيانا) على طبق معدني (سِدِر) من الألومنيوم خاصة.
كان يصنع من عيدان قش القمح أيضاً أوعية حفظ الأشياء بأحجام مختلفة ك (التِّرويج) الذي يوضع فيه الطحين الذي يلزم لتحضير العجين كي يتم خبزه في الطابون. أما (القُبْعة) فهي أكبر حجما وتصنع حسب الحاجة. فالمتوسطة الحجم منها تستعمل لجمع بيض الدجاج ووضع الخضار والفواكه وغير ذلك، والكبيرة توضع فيها الأشياء الكبيرة الحجم والكثيرة العدد.
بعد الانتهاء من جمع الغلال على البيدر كان يتم نشر القش بطريقة يمكن الحركة عليها للدواب التي سوف تجر النورج (لوح الدّْرس) وقد تكون حصانا أو بغلاً أو حمارا. وقد تكون اثنين من الحمير أو من الحمير والبقر أو غير ذلك مما يملكه الفلاح يربطهما (النير) الذي يوضع على رقبة الحيوان ويوضع أمامه حزمة من القش محشوة في قطعة من الخيش يقال له (الكَلِّيل) لكي تقي رقبة الحيوان من أن يعضها النير الخشبي. وعندما يتم هرس الوجبة (الطَّرْحة) يتم قلبها لكي يتم الهرس جيداً. ثم يتم وضعها في منتصف البيدر على شكل كومة مخروطية تسمى (العُرْمَة) ويتم طرح وجبة أخرى وهكذا حتى يتم هرس (دَرْس) القش جميعه.
تبدأ مرحلة فصل الحبوب من التبن عندما تهب نسمات الهواء المعتدلة بعد العصر عادة وفي الليل وذلك باستعمال (المِذْراة). وهي على شكل كف الإنسان تبرز منها أصابع اليد ومصنوعة من الخشب أما ما يكون من الحديد فيسمى (الشَّعوب) لأنه متشعب الأصابع وعددها خمسة كأصابع اليد متصلة بمقبض طويل من الخشب الصلب.
عند رفع التبن بالمذراة الذي يضم الحبوب يسقط الحب أمام الرجل ويطير التبن بعيدا ويتم جمع التبن وينقل بأكياس من الخيش وحفظه في غرفة متواضعة تسمى (التَّبَّان) أما التبن الثقيل (القصل) فيحفظ في (المِقْصَل) وقودا للطابون.
بعد الانتهاء من ذلك كله يتم (غربلة) الحبوب ب(الغربال) ثم توضع في أكياس من الخيش وتنقل إلى البيت لحين الحاجة إلى عمل طحين منها. وأذكر كيف كانت تخزن في بناء جانبي في داخل البيت الكبير يقال له (الجرن) ويسمى (الخابية) لها باب صغير من الأسفل لكي يسهل التحكم فيه عند الحاجة إلى القمح بينما يكون له فتحة أكثر اتساعاً من الأعلى لكي يتم صب الحبوب في الخابية.
مكننة الإنتاج
تطورت الحياة كثيراً بعد التطور الصناعي، وتطورت وسائل الإنتاج في مجالات الحياة كلها، وظهر مصطلح (مكننة) الإنتاج، فصارت الآلات الزراعية تقوم بما كان يقوم به الإنسان، وصار المحراث الآلي ( التراكتور) يحرث الأرض وصارت آلة الحصاد (الحصادة) تجمع الغلال، بل وتضعها في الأكياس، بل وصارت تخيط الأكياس أيضا.
أما القش فتقوم آلات أخرى بجمعه وتحزيمه وجعله على شكل مكعبات تسمى (البالات) وربط البالات بخيوط متينة لكي يتم نقلها وحفظها غذاء للحيوانات.
كانت أيام الحصاد أيام بهجة وسرور، و كان البيدر ديوان البلد يجتمع فيه الرجال يتسامرون ويشربون الشاي والقهوة ويروون القصص الشعبية. كان موسم البيادر موسم الخير لأن الناس كانوا يقيمون أعراسهم أو يبنون بيوتهم أو يشترون ما يلزمهم من أدوات بعد أن يبيعوا غلال السمسم وكذلك بعد تصريف موسم البطيخ والشمام الذي كان يأتي في موسم الحصاد أيضاً.
لقد انتهى عصر (البيادر) ولم تعد البيادر موجودة في الواقع ولكن اسماء مواقعها بقيت حاضرة في الوجدان والمكان، وإن كانت الأجيال الجديدة تجهلها، ولكن تكاد لا تخلو مدينة أو قرية فلسطينية سهلية زراعية مثل جنين وطولكرم وقلقيلية وأريحا وبيسان ومدن وبلدات المثلث في الداخل الفلسطيني، من اسم مكان كان موقعاً للبيادر التي سادت ثم بادت لأنها طغت الحركة العمرانية عليها وأقيمت العمارات الكبيرة محل البيدر وصرنا نحصل على الخبز من الفرن الآلي، ولم نعد نحصد وندرس ولم نعد نحتاج إلى الطحين لصنع الخبز ولا إلى التبن، إلا قليلاً، لإطعام الأغنام خاصة التي يقتنيها البعض لكي تقدم طعاما بعد ذبحها, وحلت السيارات محل الخيول والبغال والحمير والدواب التي كانت تستعمل في الأعمال الزراعية المختلفة وانتهى زمن الطابون وزال اسم (المِقْصَل) من المصطلحات.
كانت الحياة كما قال الشاعر المهجري؛ إلياس فرحات:
حياةُ مشقَّاتٍ ولكن لبعدها *** عن الذل تصفو للأبيِّ وتعذبُ
نشر في جريدة القدس يوم الأحد بتاريخ 522017م؛ صفحة 18
[email protected]
مصطلحات سادت ثم بادت!!
البيادر: كيف كانت وأين صارت ؟!
ياسين عبد الله السعدي
البيادر للجمع واحدها (بيدر) كما يقول المنجد (... الموقع الذي يدرس القمح فه ونحوه ويداس بالنورج). ونزيد توضيحاً: البيدر مساحة من الأرض المستوية الصلبة أو يتم جعلها صلبة بعد رشها بالماء وضغط السطح جيداً. كان البيدر بمثابة نقطة تجميع الغلال بعد النضج أيام الصيف والقيام بهرسها ب (النورج) لتخليص الحبوب منها، وخصوصا غلال القمح والشعير والذرة البيضاء والعدس والفول والكرسنة وغيرها مما يزرعه الفلاحون، وإن كانت زراعة الذرة تراجعت إلى درجة الاضمحلال تقريباً. أما السمسم فكان يجمع في حِزَم تُربط من نبات السمسم نفسه بعد أن ينضج وتوضع الحِزَم على شكل صفوف مرتبة على البيدر حتى تجف وتُضْرب بالعصي أو ببعضها لكي يتم إخراج البذور من (أجراسها)، وكانت توضع على سطح البيت عادة إذا لم تكن كثيرة.
قبل البدء بالهرس (الدَّرس) كان يُنصب جدار من أغصان الشجر على طرف البيدر مقابل الجهة التي يَهُبُّ منها الهواء لكي يتم تجميع التبن المتطاير والاحتفاظ به طعاماً للدواب التي يقتنيها الناس للاستعمال أو لتسمينها كالغنم والبقر. أما التبن الخشن فيسمى (القَصَل) ويستعمل وقودا للطابون ويحفظ في (المِقْصَل).
أيام الحصاد هي أيام جني المحصول وحصول الفلاح على نتيجة جهوده التي بذلها من حراثة وبذر وزرع وري أحيانا. كان يتم نقل المحصول على الدواب بواسطة (القوادم) وهي جهاز من خشب الشجر الصلب كشجر الخروب يصنعه الفلاحون بطريقة تجعله من قسمين متساويين مربوطين من الأعلى بشكل محوري يمكن أن يفتح لكي يرفع على الدابة ويربط القش بالحبال بطريقة متقنة بحيث يظل مشدودا ولا يتساقط منه شيء في الطريق قبل إنزاله على البيدر.
من عادة النساء أن يذهبن بعد العصر إلى البيدر ويجلسن ويبدأن بانتقاء العيدان المناسبة لعمل صواني القش التي كنَّ يلونها بألوان مختلفة ويعملن منها أشكالاً ملونة جميلة كانت تعلق على جدار المنزل كأشكال من الزينة. أما الصواني غير الملونة فكانت تستعمل لتقديم الطعام عليها كما نفعل اليوم بتقديم الطعام (أحيانا) على طبق معدني (سِدِر) من الألومنيوم خاصة.
كان يصنع من عيدان قش القمح أيضاً أوعية حفظ الأشياء بأحجام مختلفة ك (التِّرويج) الذي يوضع فيه الطحين الذي يلزم لتحضير العجين كي يتم خبزه في الطابون. أما (القُبْعة) فهي أكبر حجما وتصنع حسب الحاجة. فالمتوسطة الحجم منها تستعمل لجمع بيض الدجاج ووضع الخضار والفواكه وغير ذلك، والكبيرة توضع فيها الأشياء الكبيرة الحجم والكثيرة العدد.
بعد الانتهاء من جمع الغلال على البيدر كان يتم نشر القش بطريقة يمكن الحركة عليها للدواب التي سوف تجر النورج (لوح الدّْرس) وقد تكون حصانا أو بغلاً أو حمارا. وقد تكون اثنين من الحمير أو من الحمير والبقر أو غير ذلك مما يملكه الفلاح يربطهما (النير) الذي يوضع على رقبة الحيوان ويوضع أمامه حزمة من القش محشوة في قطعة من الخيش يقال له (الكَلِّيل) لكي تقي رقبة الحيوان من أن يعضها النير الخشبي. وعندما يتم هرس الوجبة (الطَّرْحة) يتم قلبها لكي يتم الهرس جيداً. ثم يتم وضعها في منتصف البيدر على شكل كومة مخروطية تسمى (العُرْمَة) ويتم طرح وجبة أخرى وهكذا حتى يتم هرس (دَرْس) القش جميعه.
تبدأ مرحلة فصل الحبوب من التبن عندما تهب نسمات الهواء المعتدلة بعد العصر عادة وفي الليل وذلك باستعمال (المِذْراة). وهي على شكل كف الإنسان تبرز منها أصابع اليد ومصنوعة من الخشب أما ما يكون من الحديد فيسمى (الشَّعوب) لأنه متشعب الأصابع وعددها خمسة كأصابع اليد متصلة بمقبض طويل من الخشب الصلب.
عند رفع التبن بالمذراة الذي يضم الحبوب يسقط الحب أمام الرجل ويطير التبن بعيدا ويتم جمع التبن وينقل بأكياس من الخيش وحفظه في غرفة متواضعة تسمى (التَّبَّان) أما التبن الثقيل (القصل) فيحفظ في (المِقْصَل) وقودا للطابون.
بعد الانتهاء من ذلك كله يتم (غربلة) الحبوب ب(الغربال) ثم توضع في أكياس من الخيش وتنقل إلى البيت لحين الحاجة إلى عمل طحين منها. وأذكر كيف كانت تخزن في بناء جانبي في داخل البيت الكبير يقال له (الجرن) ويسمى (الخابية) لها باب صغير من الأسفل لكي يسهل التحكم فيه عند الحاجة إلى القمح بينما يكون له فتحة أكثر اتساعاً من الأعلى لكي يتم صب الحبوب في الخابية.
مكننة الإنتاج
تطورت الحياة كثيراً بعد التطور الصناعي، وتطورت وسائل الإنتاج في مجالات الحياة كلها، وظهر مصطلح (مكننة) الإنتاج، فصارت الآلات الزراعية تقوم بما كان يقوم به الإنسان، وصار المحراث الآلي ( التراكتور) يحرث الأرض وصارت آلة الحصاد (الحصادة) تجمع الغلال، بل وتضعها في الأكياس، بل وصارت تخيط الأكياس أيضا.
أما القش فتقوم آلات أخرى بجمعه وتحزيمه وجعله على شكل مكعبات تسمى (البالات) وربط البالات بخيوط متينة لكي يتم نقلها وحفظها غذاء للحيوانات.
كانت أيام الحصاد أيام بهجة وسرور، و كان البيدر ديوان البلد يجتمع فيه الرجال يتسامرون ويشربون الشاي والقهوة ويروون القصص الشعبية. كان موسم البيادر موسم الخير لأن الناس كانوا يقيمون أعراسهم أو يبنون بيوتهم أو يشترون ما يلزمهم من أدوات بعد أن يبيعوا غلال السمسم وكذلك بعد تصريف موسم البطيخ والشمام الذي كان يأتي في موسم الحصاد أيضاً.
لقد انتهى عصر (البيادر) ولم تعد البيادر موجودة في الواقع ولكن اسماء مواقعها بقيت حاضرة في الوجدان والمكان، وإن كانت الأجيال الجديدة تجهلها، ولكن تكاد لا تخلو مدينة أو قرية فلسطينية سهلية زراعية مثل جنين وطولكرم وقلقيلية وأريحا وبيسان ومدن وبلدات المثلث في الداخل الفلسطيني، من اسم مكان كان موقعاً للبيادر التي سادت ثم بادت لأنها طغت الحركة العمرانية عليها وأقيمت العمارات الكبيرة محل البيدر وصرنا نحصل على الخبز من الفرن الآلي، ولم نعد نحصد وندرس ولم نعد نحتاج إلى الطحين لصنع الخبز ولا إلى التبن، إلا قليلاً، لإطعام الأغنام خاصة التي يقتنيها البعض لكي تقدم طعاما بعد ذبحها, وحلت السيارات محل الخيول والبغال والحمير والدواب التي كانت تستعمل في الأعمال الزراعية المختلفة وانتهى زمن الطابون وزال اسم (المِقْصَل) من المصطلحات.
كانت الحياة كما قال الشاعر المهجري؛ إلياس فرحات:
حياةُ مشقَّاتٍ ولكن لبعدها *** عن الذل تصفو للأبيِّ وتعذبُ
نشر في جريدة القدس يوم الأحد بتاريخ 522017م؛ صفحة 18
[email protected]
















































