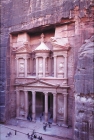
سادساً- الملوك الذين حكموا الدولة النبطية:
من المؤكد أن النظام السياسي للأنباط مر – قبل أن نعرفه – بمراحل تطورية إلى أن جاء بالصورة الأخيرة التي عرفناه بها ألا وهو النظام الملكي النبطي، ومن المؤكد أن المرحلة الأسبق لهذا الشكل كان النظام القبلي الذي يترأسه شيخ أو مجلس شيوخ يجري تثبيته إما بالتوافق أو بالتوارث أو بالأسلوبين معا وفق ما نعرف عن الأعراف البدوية، القبلية التي لا تزال فاعلة حتى عصرنا هذا، ومن المحتمل أيضا أن الأنباط مروا في مرحلة لاحقة على النظام المشيخي ربما كان في شكل إمارات أو دويلات صغيرة، ولا بد أن القبيلة كانت عماد هذه الدويلات الصغيرة، وإنه لمن الحق التساؤل عن سبب تأخر الأنباط في إيجاد الدولة المركزية (قياسا إلى المرحلة التطورية التي تجاوزت نمط الدويلة – المدينة أو دولة المدينة التي كانت معروفة في بلاد الشام على الأقل منذ أواخر العصر االبرونزي (1200 ق.م)، وإن التخمين بأن سبب ذلك يعود إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والسكاني في المنطقة أمر منطقي في ضوء الحقائق التي أصبحنا نعرفها عن أحوال المنطقة في تلك المرحلة. إذ إن الحملات العسكرية الكبيرة لا تكاد تنقطع عن المنطقة منذ أمد بعيد، حتى نهاية العصر المقدوني
332 ق.م، فمن حملات تجلات بلاسر إلى نابونئيد إلى شلمناصر إلى نبوخذ نصر من الحكام الأشوريين إلى حملات قمبيز الفارسي 525 ق.م وليس انتهاء بحروب البطالسة والسلوقيين من أجل الاستحواذ على المنطقة وحروب الجيوش اليهودية لأجل زيادة رقعة الدويلة اليهودية، كل ذلك إلى جانب استمرار الغزوات القبلية الواسعة النطاق في ضوء التخلخل السكاني الدائم في الشرق خصوصا الناتج عن حملات الأشوريين بدرجة أقل من الفرس، وقد لاحظنا آنذاك قيام أنظمة جديدة وانهيار أنظمة قائمة خصوصا في الشرق (بلاد الرافدين وفارس)، ومن الأنظمة المنهارة حضارة قيدار وحضارة الأدوميين وحضارة اللحيانيين والصفويين وآراميي الغرب (العموريين وآراميي دمشق) ونظام (دويلات اليهود) في فلسطين و نظام (فراعنة مصر) في الغرب.
وكنا قد أشرنا في مناقشة نشوء نظام الحكم في الصفحات السابقة إلى أن الأنباط كانوا قد بدأوا يظهرون كقوة سياسية منذ أواخر القرن الرابع قبل الميلاد على الأقل عندما بدأ خلفاء الاسكندر المقدوني الصراع على احتواء المنطقة الجنوبية من بلاد الشام والمنطقة الشمالية من شبه الجزيرة العربية للسيطرة على مفارق الطرق التجارية البرية والبحرية، مما سيدفع بالأنباط إلى واجهة الحدث السياسي والعسكري، وكانت مثل هذه الأحداث تجري دون أن نسمع شيئا عن ملك الأنباط أو حتى عن أية إشارة لنظامهم السياسي، وروايات ديودورس بشأن حملات أنتيجونيوس على (الصخرة-البتراء) تضمنت إشارات متناقضة في هذا الشأن، فالجيش السلوقي وصل إلى البتراء على حين غرة مثلما توحي الرواية، ويبدو أن ذلك وقع في النهار أو في آخر النهار لأن شباب (الصخرة-البتراء) كانوا خارجها آنذاك، ولما عادوا إليها بادروا باللحاق بجيش أنتيجونيوس وباغتوا معسكرهم في أثناء نومهم وقضوا وطرهم وعادوا بسلام غانمين. إذن أين الجيش والحرس والقادة والمسؤولين؟ بمعنى أين النظام السياسي، العسكري وعلى رأسه الأمير والجيش؟ لنفترض أن ديودورس كان قد تجاهل مثل تلك التفاصيل، لكن علم الآثار وحفرياته لا تدلنا على أية مسكوكات أو نقوش أو وثائق أخرى تفيد العكس، هذا ما يدفعنا للاستنتاج أن نظام الحكم لم يكن قد تحول إلى نظام سياسي ملكي أو غيره آنذاك، وعلى الأرجح أن المنطقة وشؤونها المختلفة والسياسية منها كانت تدار وفق النظام القبلي الذي سبق أن استعرضناه أيضا، وهو قائم على وحدات إدارية صغيرة هي غالبا ما تكون المجال الجغرافي أو الديموغرافي لمجموعات سكانية، والقبيلة أو العشيرة كانت عماد هذه الوحدات، خصوصا في ظل المرحلة التي كان ديودورس وقبله هيرودت قد وصفاها بالطابع البدوي، إنه النظام البدوي – العشائري الذي لا يزال فاعلا في أيامنا هذه بهذه الدرجة أو تلك في الكثير من البلدان العربية، ولأن مجتمع الأنباط كان قد ورث مجتمعات أسبق، وأهمها الأدوميين والمؤابيون، فإن هذه المجتمعات كانت قد عرفت الزراعة والاستقرار الزراعي قبل ظهور الأنباط بعدة قرون، ومن المؤكد أيضا أنهم عرفوا أنظمة سياسية غالبا ما كانت ملكية وفق مقاييس ذلك العصر على الأقل، وقد أخبرتنا التوراة عن سلسلة من ملوك الأدوميين، وعلمنا من خلال السجلات الأشورية عن عدد من الملوك العرب ومن ضمنهم الملكات أيضا، وكانت الملكة زبيبة (738 ق.م) اول ملكة عربية نعرف عنها في الممالك والدويلات الشمالية لشبه الجزيرة العربية، وضمت سلسلة ملوك قيدار والعربية قائمة من عشر ملوك أولهم الملكة زبيبة، وقد تبع هذه الملكة خمس ملكات أخريات قبل أن نعرف أربع ملوك آخرين، وفي حضارة لحيان صرنا نعرف اثني عشر من الملوك. أما في الشمال والغرب لبلاد الشام، فإن لدينا أيضا معلومات عن ملوك الدويلات الكنعانية ، والآرامية ثم الفلسطينية والعبرية، وهذه الممالك كانت أسبق من مملكة الأنباط التي لا بد وأن استفادت من تراث تلك الممالك وخصوصا من خلال التواصل الديموغرافي ثم الجغرافي والسياسي، أي أننا أمام أنظمة سياسية تركت تراثا استفاد منه الأنباط أيما فائدة، خصوصا إن بعض الأنباط لم يكن بغريب عن المدنية والاستقرار والزراعة والإدارة كذلك.
ومن المحتمل أن العامل الأكثر فاعلية في قيام الدولة ارتبط بسياسات الدول الكبيرة في المنطقة وصراعاتها، أعني دولتي المقدونيين السلوقيين في الشام والبطالمة في مصر. إذ إن تنظيم المنطقة بنظام حكم واضح المعالم قادر على تحمل المسؤوليات خير لهذه الدول من فوضى اللانظام أو أنظمة المشيخات القبلية التي تحتاج إلى صرف المزيد من الوقت والجهد لضبط سياساتها ودرء أخطار غاراتها على مصالح الدول القائمة. وهذا اتجاه سيترافق مع زيادة وعي الأنباط ورغبتهم في إنشاء دولة عصرية - وفق مقاييس ذلك العصر- مما سيحافظ على مصالحهم التجارية مستغلين حالة الصراع والتنافس بين الفريقين من ناحية، ومعظمين لدورهم بالحفاظ على شرايين التجارة ضد الأخطار التي تتهددها غارات الجماعات البدوية المنتشرة في الصحاري الواسعة من حولهم. وإنه لمن المفيد التذكير بأن المنطقة ظلت محطا لأنظار المجموعات البشرية والقبائل التي لم تجد لها موطئا نظرا لميزات المنطقة الجغرافية والمناخية إضافة إلى وجود المراعي الفسيحة وآبار المياه للمجموعات الرعوية إلى جانب القرى الزراعية أو التي يمكن أن تصبح زراعية للمجموعات الراغبة في حياة الاستقرار من خلال الزراعة والتجارة كذلك. وهذه العوامل مجتمعة ومتفاعلة لا بد من أنها خلقت لدى الجماعات البشرية من سكان المنطقة قدرا من الوعي والرغبة مما يستدعي معه إنشاء سلطة مركزية ستكون أقدر على تنظيم مصالحهم ورعاية شؤونهم. وكانت دول المنطقة قد تأسست بهذه الوتيرة من التطورات كالدولة العمونية، والمؤابية، والأدومية في شرقي نهر الأردن في القرن العاشر قبل الميلاد أو قبل ذلك بقليل، بعد أن كونت القبائل البدوية والمراكز الحضرية وحدات سياسية معا، وأدى التنافس الذي كان قائما بين شيوخ هذه القبائل إلى التطلع للاستيلاء على مساحة واسعة من الأراضي ليتسع نطاق حكم الشيخ ونفوذ قبيلته، وربما تجمعت مجموعة من العشائر في قبيلة واحدة، وأجمعت فيما بينها على اختيار أحد الشيوخ زعيما لهذه العشائر أو القبائل، ونجد مثالا على ذلك في كتاب العهد القديم الذي يروي كيف اختير شاؤول من بين مجموعة من القضاة (الكهنة- المشايخ) حاكما واحدا على إسرائيل(54).
وثمة اجتهادات حول ملك أسبق لحارثة الأول (الذي يصنف باعتباره اول ملك نبطي) لكن دون تأكيد حاسم في هذا الشأن، وليس من المبالغة القول أن عهد الملكية كان قد ابتدأ قبيل منتصف القرن الثاني قبل الميلاد وانتهى عام 106 ميلادي بالملك الثاني عشر أو الثالث عشر رب إيل الثاني. وثمة رأي آخر يفيد أن رب إيل توفي عام 101 م واستلم الحكم ابنه مالك الثالث الذي انتهت دولة الأنباط في عهده(55).
وجل ما نريد تأكيده في هذا الشأن أن النظام السياسي للأنباط لم يكن وليد قرار أو اجتماع بين قادة القبائل أو غير ذلك من الأشكال، إنما كان هذا النظام امتدادا لعملية تطورية مثلما تقتضي عوامل مؤثرة خارجية وداخلية أي موضوعية وذاتية، وعلى الأرجح أن احتكاك الإغريق بالأنباط بما يتضمن ذلك من تحديات سلبية وإيجابية كان قد ساهم في تطور النظام السياسي للأنباط، والأدلة على تأثر الأنباط الإيجابي كثيرة ومنها الشروع بسك العملة وفق المواصفات الهلينية لفترة طويلة بالكاد تنتهي في عهد عبادة الثاني (62-60 ق.م)، وهذا لا يعني توقف التأثير الهليني على هذه الناحية لكن الملاحظ أن السمات الأساسية بدأ يغلب عليها الطابع الشرقي – النبطي أكثر من السمات الهلينية. ويشار كذلك إلى أن الأساليب الإدارية للدولة كانت قد اعتمدت أنظمة مشابهة للأنظمة الهلينية حيث سيظهر ذلك في المسميات الإدارية (كالأسريتج والهفرك والكليركا وقنطرين (الكنتوريو) إلخ، وسنتعرض لهذه المسميات لاحقا.
وتجب الإشارة إلى ثمة تساؤلات لا تزال بحاجة إلى المزيد من التحقق والبحث، خصوصا البحث الأثري، بشأن سلسلة الملوك وكل ما يتعلق بهم كأسلوب أو أساس تتويجهم والقوانين والأعراف المتعلقة بمكانتهم وطريقتهم في العمل؟ ومن ذلك أيضا عدم الجزم بسنوات الكثير من الملوك، أو ببعض الفترات الغامضة في سلسلة تتابعهم، وثمة أيضا بعض الاجتهادات والآراء المتضاربة في هذا الشأن، فمنها ما يجعل رب إيل الثاني آخر ملوك الأنباط، مقابل رأي آخر يقول أن مالك الثالث إبن رب إيل كان آخر الملوك بعد أن قضى خمس سنوات في الحكم. ومن الحلقات الغامضة أيضا في هذه السلسلة ما يلاحظ من فترة طويلة بين الملك الحارثة الأول (169- 168 ق.م) وبين خلفه زيد إيل (146- ؟). ولا نعرف ما هو وضع الدولة النبطية في فترة تزيد عن عقدين من الزمن، دون أن ينتهي الغموض بتقلد زيد إيل السلطة، لكننا بعد ذلك نحصل على تتابع منطقي ومتصل بقليل من الغموض او الاختلاف الذي غالبا لم يكن جوهريا من حيث الاختلاف على بضع سنوات زيادة أو نقص لهذا الملك أو ذاك.
وتذكر بعض الدراسات أن لقب الملك لم يتخذ قبل الملك الحارثة الثالث
(87-62 ق.م)، فقد اتخذ الحارث الثالث لقب الملوك السلوقيين والبطالمة Basilius- باسيليوس- (ومعناها باليونانية "الملك على مسكوكاته)، وبعد ذلك ظهر اللقب النبطي " ملكا " أي الملك على مسكوكات عبادة الثاني (62-60 ق.م)، وبعده فصاعدا على مسكوكات الملوك الأنباط حتى سقوط دولتهم(56).
يشار كذلك إلى أن بعض المصادر تعتقد ان الملك الحارثة الرابع
(9 ق.م – 40 م) هو الملك الذي جاء من خارج السلالة الملكية بعد أن اغتصب الحكم، ويبدو أن هذا الملك كان من كبار ضباط الجيش، وهو الذي لقب نفسه المحب لشعبه (ر ح م ع م هـ )، وكان هذا الملك من القوة بحيث وصلت الدولة النبطية أقصى اتساع لها في عهده إذ شملت دمشق فترة من الوقت، ومما يذكره إسترابو من أن الأنباط في هذا الوقت كانوا تابعين للرومان، ونستطيع الافتراض أن الحارث هذا تمتع بمساندة الرومان خلال حكمه أو قبل قيامه بالسيطرة على الحكم. علاوة على الاستناد إلى قوته القبلية التي يوجد ما يساعد على استنتاجها أو افتراضها.
يشار كذلك إلى أن الأنباط اعترفوا أو أبرزوا دور المرأة إلى جانب الملك، وقد ظهرت صور بعض الملكات على المسكوكات النبطية، ومن ذلك شقيلت (شقيلة) و(خلدو) زوجتي الحارث الرابع وجميلت (جميلة) زوجة رب إيل الثاني. وكانت الملكة تعرف بأخت الملك مما حدا ببعض المستشرقين إلى الاعتقاد أن الملوك الأنباط تزوجوا من شقيقاتهم جريا على سنة الملوك الفراعنة والإغريق، إلا أن مثل هذا العرف لم يكن موجودا في الشعوب السامية عموما والعربية خصوصا، وإذا ما علمنا أن كلمة أخت وأخ لا تنحصر في علاقة الأخوة بالدم حسب مفاهيم اللغات السامية، إذ أن هذه الكلمة تحمل معنى مطلقا يشمل كل العلاقات الإنسانية من صداقة وحلف ومختلف درجات القرابة(57). وقد ذكر سترابو أن الملك النبطي كان يتخذ له وزيرا أو ذراعا قويا كان يسميه " أخو الملك" وهو بمثابة رئيس الوزراء أو الوزير الأول.. ومن المحتمل أن مفهوم أخو الملك كان يماثل "الأمير" أو "الرفيق" في عصرنا هذا لجهة تحمل المسؤولية. وكان الوزير سيليوس Syllaeus (صالح) أشهر هؤلاء الوزراء. ويخبرنا يوسيفيوس أن سيلي كان كثير المكوث في روما بجانب القيصر الأعظم، وقد حاز على ثقته، استطاع إقناع القيصر بأن هيرود ملك يهودا قام بالاعتداء على المملكة العربية، وقام بالقتل وأخذ الأسرى..إلخ. وقد دافع سيليوس خير دفاع عن دولته ومواطنيه، وكان قد لبس السواد (حدادا على ضحايا اعتداءات هيرود) قبل مقابلة الأمبراطور الروماني(58).
وأخيرا تجب الإشارة إلى أن ملوك الأنباط عموما امتازوا بقدر كبير من الديمقراطية والبساطة أيضا، فالملك ما يزال يحتفظ بكثير من خصائص شيخ القبيلة، فهو يخدم نفسه بنفسه، بل يخدم ضيوفه أيضا، ويقدم لشعبه " كشفا " عن شؤونه الذاتية، أي أنه يتمتع بقسط غير قليل من الروح الديمقراطية، وإذا قيل له "مَرنا " بمعنى سيدنا " (أو ربنا) فما ذلك إلا قياما بواجب اللياقة(59).
وفيما يلي استعراض لملوك الأنباط وفق الترتيب الأكثر شيوعا، وسنشير إلى أهم ما توافر من معلومات عن هؤلاء الملوك:
1-الحارث الأول (169ق.م- ؟):
يحيط بعض الغموض عهد هذا الملك، خصوصا فيما يتعلق بسنوات عهده، ونحن لا نعرف عن هذا الملك أكثر ما يعرض علينا سفر المكابيين الذي يصف زعيم النباطيين "بالطاغية"، والطاغية – حسب تفسير د.إحسان عباس- الحاكم المطلق التصرف غير الدستوري. أي أن ذلك وصف للملك النبطي. وإذا ما صدقنا سفر المكابيين، فإن الحارث لم يكن إلا شيخا أو كبير الشيوخ لمنطقة الأنباط. ويبدو لنا أن سفر المكابيين لم ينكر على الملوك ألقابهم فوصف الحكام البطالمة والسلوقيين وغيرهم بألقابهم المعهودة كملوك، وإن كان قد ألحق بهم صفات الظلم والبطش والكفر..إلخ. ومن ذلك مثلا: "فاستخلف ليسياس على أمور الملك من نهر الفرات إلى حدود مصر وهو رجل شريف من النسل الملكي... فاختار ليسياس بطلماوس بن دوريمانس ونكانور وجرجياس رجالا ذوي بأس من أصحاب الملك، ووجه معهم أربعين ألف راجل وسبعة آلاف فارس ليأتوا أرض يهودا ويدمروها على حسب أمر الملك" (المكابيين الأول 39-40) وهذا الوصف يعود بالطبع لملوك السلوقيين وحكامهم الذين يجهزون لحملة على يهودا. وبهذا يبدو افتراض أن زعيم الأنباط في هذه المرحلة لم يكن إلا زعيما قبليا أو أكبر هؤلاء الزعماء افتراضا منطقيا، وهو لم يكتسب لقب ملك بعد، بل إن ذلك سيتأخر أيضا إلى أكثر من مئة عام لاحقة، غير أن شيخ الأنباط يحتل مكانة تضاهي مكانة الملك، ونحن لا نعرف عن طبيعة نظام الحكم وملامحه في حينه الكثير مما يبقي افتراض "صفات المشيخة" هو الأقوى ما دمنا لا نملك ما ينفي ذلك حتى الآن.
2- الملك زيد إيل (146- غير واضح):
وبعض المصادر لا تأتي إلى ذكره. وفي قائمة (Kammerer) نجد الملك الثاني هو (مالك 145 ق.م) بينما نجد (رب إيل الأول) في قائمة (Bowersock) في حين تخلو قائمة (Meshorer) من الملكين الأولين. وقائمتي (Starcky) و(Letmman) تشيران إلى (حارثة الثاني 145 ق.م) كثاني ملوك الأنباط في حين أن مجموعة النقوش النبطية CIS تشير إلى مالك الأول. وهكذا فهذه الفترة من الملكية لا تزال غير واضحة إلى أن تأتي الأبحاث الأثرية بما هو جديد. وثمة احتمالات تخمينية عديدة لهذا الغموض الذي لا يتم حسمه بغير الأبحاث الأثرية الوافية.
3- الحارث الثاني (110- 95 ق.م):
يلاحظ في هذا الترتيب وجود فترة غموض تمتد إلى 36 عاما، ويعتقد البعض أن ثمة ملوك حكموا في هذه الفترة، لكن ذلك لا ينفي أن يكون (الملك الثاني وربما الثالث) قد استمر أو استمرا في الحكم مدة 36 عاما إلى ان وصل الحكم إلى الحارث الثاني.
وفي عهد الحارث الثاني هذا كانت العداوة في أشدها بينه وبين المكابيين اليهود، فقد سارع الحارث إلى مساعدة غزة في عام 96 ق.م بينما كان المكابيون يحاصرونها(60).
4- عبادة الأول (95-88 ق.م) :
تقلد الحكم بعد وفاة والده الحارث الثاني، واستمر في عهده النزاع بين الأنباط وبين المكابيين- اليهود بقيادة جينايوس، لأن أطماع جينايوس التوسعية امتدت إلى جلعاد ومؤاب واستطاع التغلب على عرب هاتين المنطقتين، ولذلك تصدى له عبادة في معركة " قانا " عند جدارة (أم قيس) إلى الشرق من بحيرة طبرية، واضطرته هجمات الأنباط إلى الوقوع في واد عميق، وكاد يفقد حياته، اضطر إلى رد ما كان استولى عليه من مؤاب وجلعاد مقابل أن يمتنع عبادة عن مساعدة خصومه. وقانا هذه تقع إلى الشرق من بحيرة طبريا وانتصر فيها عبادة الأول واسترد منهم المكابيين اليهود مناطق في مؤاب وجلعاد، لتصبح تحت الإدارة النبطية.
5- رب إيل الأول (88- 78 ق.م):
حكم بعد وفاة أخيه عبادة الأول، وانتصر على أنطوخيوس الثاني في حملته الثانية على بلاد العرب حوالي 88 ق.م، حيث قتل فيها أنطوخيوس متأثرا بجراحه على ما يبدو.
6- الحارث الثالث (87-62 ق.م):
هو ابن حارثة الثاني أيضا، وهو الابن الثالث الذي أصبح ملكا بعد إيل الأول وعبادة الأول، وفي عهده امتد الحكم النبطي إلى دمشق التي كانت تعصف بها التحديات والقلاقل جراء تهديد القبائل العربية الإيطورية، وهم حكام شرقي لبنان، وبناء على طلب من مجلس بلدي المدينة، تقدم الحارثة وعين واليا له فيها، ثم سك العملة وفرض الأمن، وظلت تلك النقود تصدر حتى عام 70 م حين انتزعت المدينة من أيدي الأنباط. ومن الطريف أنه ألحق باسمه عبارة "محب اليونانية" Philhellene على نقود تذكارية، وفي عهد هذا الملك وقعت البتراء تحت الوصاية أو التبعية الرومانية بعد أن زحف أحد جيوش "بومبي" إلى المنطقة، وكان الأنباط حينذاك في حالة حرب مع الإسكندر جينايوس حاكم اليهود، وقد زحف جيش بومبي بقيادة "سكاوروس" إلى البتراء وحاصرها وأحرق ممتلكات الأنباط حولها إلى أن جرت التسوية التي قضت بتبعية الأنباط للإمبراطورية الرومانية ثم بدفع جزية مقدارها 300 تالنت من الفضة، وعلى إثر ذلك – على ما يبدو – اصدر الحارثة نقدا عاديا يحمل صورته وصورة القائد الروماني سكاوروس يتوسطهما جمل وغصن زيتون يقدمه الحارثة لسكاوروس(61). ويعتبره البعض المؤسس الحقيقي لسلطة الأنباط، ففي عهده توسعت حدود الدولة، وضم دمشق في عام 85 ق.م لأول مرة نحو خمسة عشرة عاما(62)، كما حارب جانيوس زعيم المكابيين وانتصر عليه في معركة الحديثة قرب اللد حوالي عام 83 ق.م. وعلى إثر ذلك هاجم جانيوس شرقي الأردن واستولى على اثنتي عشرة قرية(63). ويبدو أنه ظل في حرب مع كل زعماء المكابيين الذين عاصرهم من أسرة جانيوس (أرسطوبوليس وهيركانوس) وهيركانوس هذا كان قد التجأ إلى الحارثة الثالث في أثناء صراعه مع شقيقه أرسطوبوليس عقب وفاة جانيوس والدهما، ولكن هيركانوس عندما تمكن من السلطة بمساعدة الرومان عاد وتنكر لصداقة الحارثة وجعل يمد الجيش الذي حاصر البتراء بالقمح، وربما بحكم قوة الرومان الطاغية على المنطقة في حينه. ويذكر أيضا أنه في عهد الحارثة بدأت البتراء تتخذ مظاهر مدينة يونانية نموذجية(64).
7- عبادة الثاني (62- 60 ق.م):
تولى الحكم بعد والده الحارث الثالث، وقد عثر على نقش في البتراء يذكر "عبادة بن الحارث " (لحياة عبادة ملك الأنباط بن الحارث ملك الأنباط، السنة 1)، وفي عهده ارتبطت دولته مع الرومان بتحالف وولاء قويين.
8- مالك الأول (60-30 ق.م):
تولى الحكم بعد والده عبادة الثاني، ولعل أهم الأحداث في عهده مشاركة الرومان بفرقة فرسـان في غزو الإسكندرية عام 47 ق.م، ورفضه مساعدة هيرود، مما أدى إلى وقوع معركة ديون(65).
9- عبادة الثالث (30-9 ق.م):
تقلد الحكم بعد والده مالك الأول، وقد اشتهر عنه ضعف الشخصية لحساب وزيره صالح، ولعل من أهم الأحداث التاريخية في عهده مساندة الرومان عام 25-24ق.م، وقد جرى ذلك بقيام وزيره صالح بقيادة ألف رجل لمساعدة الجيش الروماني في الوصول إلى جنوب الجزيرة العربية، وكان الوزير صالح يتكفل بمهمة إرشاد الجيش وتوفير تمويله من الماء والمواد التموينية، وقد آلت تلك الحملة إلى الفشل، وعزا سترابو ذلك إلى خيانة الوزير صالح للرومان(66) وقيام الرومان باعتقاله وقيادته إلى روما حيث أعدم. لكن الأهم في سيرته هو ما قيل عن نشوء عِبادة المَلك بسببه أو بسبب شخصه، إذ يذكر عدد من المصادر أن "عُبادة الثالث" كان قد ألِه من قبل الأنباط، وربما بعد موته، ووجدت بعض النقوش التي تشير إلى ذلك، ويقترح د.احسان عباس أن يكون هذا "التأليه" بتشجيع من خلفه الحارثة الرابع، طمعا في الحصول على المكانة نفسها بعد موته(67).
10- الحارث الرابع (9 ق.م- 40 م):
استولى على الحكم بعد وفاة عبادة الثالث، واسمه " إيناس"، ويعتقد بأنه من كبار ضباط الجيش وليس من العائلة المالكة، وهو الملقب بالمحب لشعبه (ر ح م ع م هـ).
وفي عهده عم الرخاء ووصلت الدولة النبطية أقصى اتساع لها، حيث شملت معظم شمال شبه الجزيرة العربية، ووصلت سيناء غربا والجوف شرقا وحوران شمالا والحجر في وادي القرى جنوبا(68)، ويذكر سترابو أن الأنباط في ذلك الوقت كانوا تابعين للرومان(69).
وتميز عهد الحارث بازدهار عمراني واسع تركز في البتراء ومدائن صالح (الحجر)، ويظهر جليا في القبور المنحوتة في الصخر التي نحتت معظمها في النصف الأول من القرن الأول الميلادي. وإذا أمعنا النظر فيها وجدناها عملت لضباط عسكريين من رتب مختلفة، مما يشير إلى أن الحجر أصبحت قاعدة عسكرية متأخرة في عمق الصحراء، إدراكا من الأنباط للخطر الروماني الماثل(70)، ومن المعروف أن الحارث الرابع كان أحد أبناء القبائل النبطية الجنوبية، وقد ظهر في النقوش الحجرية أن الحارث قد عين عددا من أبناء المناطق الجنوبية في هذه المناصب الرفيعة في المناطق والمدن النبطية(71).
إن كثافة المسكوكات في عهد هذا الملك تشير إلى ازدهار اقتصادي، حيث أن 80% من المسكوكات النبطية التي عثر عليها تعود للحارث الرابع، وقد تضمنت إصدارات تذكارية لزواجه من شقيلت (شقيلة) بعد وفاة زوجته الأولى خلدو.
ومن أهم الأحداث في عهد الحارث الرابع وقوع معركة بينه وبين "هيرود أنتيباس" حاكم الولاية اليهودية في سنة 34م؛ بسبب طلاق الأخير لابنة الحارث، وانتصر فيها الحارث ففزع هيرود إلى الامبراطور الروماني طيباروس الذي أراد الحارث حيا أو ميتا، إلا أن وفاة طيباروس حالت دون تحقيق ذلك(72).
11- مالك الثاني (40- 71 م ):
تولى الحكم بعد والده الحارث الرابع مدة 31 عاما، والأخبار عنه قليلة، أما أهم الأحداث التاريخية في عهده فهي مشاركته في الحملة الرومانية بقيادة تيطس على القدس عام 70 م بجيش قوامه ألف فارس وخمسة آلاف راجل، وقد أبطأت في عهده وتيرة التقدم مقارنة مع والده الحارث الرابع.
12- رب إيل الثاني (71- 106 م ):
تقلد الحكم صغيرا تحت وصاية أمه مدة خمس سنوات، حيث ظهرت صورتها على النقود معه، ولما كبر تزوج من جميلت (جميلة) حيث ظهرت صورتها معه على النقود ابتداء من عام 76 م.
وكانت فترة حكمه قليلة الأحداث بالرغم من طولها، وبموته عام 106 انتهت دولة الأنباط بعد أن رفض الرومان الاعتراف بخلف له، وقد ألحقها تراجان بالإمبراطورية الرومانية، وسماها "الولاية العربية" وعاصمتها بصرى الشام. وتشير الشواهد الأثرية إلى استمرار النشاطات المختلفة، خاصة الزراعية في نطاق الدولة النبطية.
وهناك رأي آخر يفيد أن رب إيل توفي عام 101 م واستلم الحكم بعده ابنه مالك الثالث حيث انتهت دولة الأنباط في عهده عام 106 م(73)، أي بعد أن رفض الرومان الاعتراف بخليفة الملك الأخير وقاموا بإنشاء ولاية جديدة تضم المناطق النبطية جميعها إضافة إلى مناطق جديدة في بلاد الشام، واسموها " الولاية العربية" وجعلوا عاصمتها بصرى الشام.
صدر الكتاب عن:
دار أسامة للنشر والتوزيع (2009):
عمان – العبدلي
هاتف 5658252 6 00962 ،، أو 5658253 6 00962
فاكس: 5658254 6 00962
ص.ب 141781 عمان ،الأردن
E-mail:[email protected] دار أسامة للنشر والتوزيع :
عمان – العبدلي
هاتف 5658252 6 00962 ،، أو 5658253 6 00962
فاكس: 5658254 6 00962
ص.ب 141781 عمان ،الأردن
E-mail:[email protected]
مراجع الفصل الأول وهوامشه:
1- جواد علي، تاريخ العرب قبل الإسلام ،ص 12
2 -سماح بركات، حروب الأنباط ،ص5
3- Hammond.P.C, The Nabataeans,Their History…p.12
4 - د.احسان عباس، 2007،ص23.
5 -Kuhlenthaland Fischer,20
6 -سماح بركات، حروب الأنباط ،ص 8.
7 - محمد خطاطبة ، 2006،ص48.
8 -د.خير نمر ياسين، الآدوميون،ص 99-100.
9- - هشام أبو حاكمة، 2007،ص217
10- زيد الكفافي، 2006،ص 327
11 - محمد الخطاطبة، 2006،ص 48
12- ,The Other Side.pp 167-193 Gluck
13- سماح بركات، حروب الأنباط ،ص12
14 – Hammond,1973:13
15 - 7:10Diodurs,8
16- جواد علي، المفصل، ج 3،ص18.
17- هتون الفاسي 1993،ص 86.
18- خيرية عمرو2003
19 - هيرودوت، تاريخ هيرودوت 2001،ص 220
20 - أنطون جوسان، 1997، ص 143- 146.
21 - د.احسان عباس، 1985،ص32.
22- زيدان كفافي، 2006 ،ص 382.
23- Markoe,Clenn,Lost & Found: Petra Antiquites.verand,Jan 2004.Issue 1,p36-46.6p,8c.)
24 - خير نمر ياسين1993،ص327
25 – المصدر السابق،ص146
26 - محمد الخطاطبة ،2006،ص49
27 - نبيه عاقل، 1972،ص 109-111.
28 – كان الحكم النبطي في دمشق مؤقتا مدة 15 عاما، أما بالنسبة لشرق لبنان فإن الأمر لم يكن واضحا تماما وربما كان هو الآخر مؤقتا وربما اقتصر على النفوذ التجاري، ويعتقد البعض أن بلدة النبطية في لبنان ما هي إلا من آثار ذلك النفوذ، وعلى العموم لم يعثر حتى الآن على آثار عمرانية للأنباط لا في دمشق ولا في لبنان.
29 – حيث قاوم الأنباط محاولات السلوقيين والبطالمة منذ وقت مبكر عندما بدؤوا بمحاولات الزحف على بلادهم وإخضاعها والإستيلاء على مقدراتها.
30- احمد العجلوني، 2002،ص 73
31- Starcky, op.cit. SD.b,pp 888-900.
32- احسان عباس، ص: 76
33- د.سعد أبو دية 1984، ص19
34- هاردنج 1971،ص 143
35- احسان عباس ،ص73
36 -هامش: القاع هو الأرض الواسعة المنخفضة.
37 - هتون الفاسي 1993،ص 50
38- د.احسان عباس 2007،ص 80
39- محمد خطاطبة، 2006،ص 167
40- موقع السويداء.Swaida.com
41- د.احسان عباس،ص 82
42- محمد خطاطبة، 2006،ص42
43- مصطفى مراد الدباغ، بلادنا فلسطين، ج 1، ق 1، ص 125- 126) وكذلك: رجاء وحيد دويدري، جغرافية سوريا والوطن العربي، دمشق، مطبعة طبرين، 1982 م.ص 46، 67
44- محمد خطاطبة، 2006،181ص.
45 - Negev,1997: 63
46- غالي إبراهيم أمين 1976،ص 26-27.
47- د.احسان عباس 2006،ص 79
48 - زيدون المحيسن، 2007،ص 15
49- موقعwww.swaida.com،
50 - د.إحسان عباس 2006،ص 72
51 - موقعwww.swaida.com
52- غالي إبراهيم أمين، 1976، سيناء المصرية عبر التاريخ، ص 26-27
53 – محمد خطاطبة 2006،ص 45
54 - زيدان الكفافي، ص 402
55 - جواد علي، المفصل 1969، ج 1،ص47
56 - هتون الفاسي،1993،ص 168
57 - احسان عباس 2007،ص 62+115
58 - Josephus,Jewish Antiquities,p323-325
59- د.احسان عباس 2007،ص36
60 - الدباغ ،ج1، ق1، 1973،ص 638
61- د.احسان عباس، 2007،ص 42. خطاطبة 2006،ص 51
62- جواد علي، 1969،ج 3،ص 26
63 - خطاطبة 2006،ص 51
64- الدباغ، ج1، ق1 ،ص 638
65 - عبدالعزيز سالم، 1973،ص 95
66 - محمد مبروك نافع 1952،ص87.
67- احسان عباس،2007،ص52
68- نافع 1952،ص 88
69- Strabo,17,4:21
70- د.احسان عباس 2007،59ص
71- سليمان الذييب، نقوش الحجر النبطية، 1998،ص6
72 - عباس، 2007،ص 65- 66
73 - جواد علي، 1969، ج 1،ص 47
من المؤكد أن النظام السياسي للأنباط مر – قبل أن نعرفه – بمراحل تطورية إلى أن جاء بالصورة الأخيرة التي عرفناه بها ألا وهو النظام الملكي النبطي، ومن المؤكد أن المرحلة الأسبق لهذا الشكل كان النظام القبلي الذي يترأسه شيخ أو مجلس شيوخ يجري تثبيته إما بالتوافق أو بالتوارث أو بالأسلوبين معا وفق ما نعرف عن الأعراف البدوية، القبلية التي لا تزال فاعلة حتى عصرنا هذا، ومن المحتمل أيضا أن الأنباط مروا في مرحلة لاحقة على النظام المشيخي ربما كان في شكل إمارات أو دويلات صغيرة، ولا بد أن القبيلة كانت عماد هذه الدويلات الصغيرة، وإنه لمن الحق التساؤل عن سبب تأخر الأنباط في إيجاد الدولة المركزية (قياسا إلى المرحلة التطورية التي تجاوزت نمط الدويلة – المدينة أو دولة المدينة التي كانت معروفة في بلاد الشام على الأقل منذ أواخر العصر االبرونزي (1200 ق.م)، وإن التخمين بأن سبب ذلك يعود إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والسكاني في المنطقة أمر منطقي في ضوء الحقائق التي أصبحنا نعرفها عن أحوال المنطقة في تلك المرحلة. إذ إن الحملات العسكرية الكبيرة لا تكاد تنقطع عن المنطقة منذ أمد بعيد، حتى نهاية العصر المقدوني
332 ق.م، فمن حملات تجلات بلاسر إلى نابونئيد إلى شلمناصر إلى نبوخذ نصر من الحكام الأشوريين إلى حملات قمبيز الفارسي 525 ق.م وليس انتهاء بحروب البطالسة والسلوقيين من أجل الاستحواذ على المنطقة وحروب الجيوش اليهودية لأجل زيادة رقعة الدويلة اليهودية، كل ذلك إلى جانب استمرار الغزوات القبلية الواسعة النطاق في ضوء التخلخل السكاني الدائم في الشرق خصوصا الناتج عن حملات الأشوريين بدرجة أقل من الفرس، وقد لاحظنا آنذاك قيام أنظمة جديدة وانهيار أنظمة قائمة خصوصا في الشرق (بلاد الرافدين وفارس)، ومن الأنظمة المنهارة حضارة قيدار وحضارة الأدوميين وحضارة اللحيانيين والصفويين وآراميي الغرب (العموريين وآراميي دمشق) ونظام (دويلات اليهود) في فلسطين و نظام (فراعنة مصر) في الغرب.
وكنا قد أشرنا في مناقشة نشوء نظام الحكم في الصفحات السابقة إلى أن الأنباط كانوا قد بدأوا يظهرون كقوة سياسية منذ أواخر القرن الرابع قبل الميلاد على الأقل عندما بدأ خلفاء الاسكندر المقدوني الصراع على احتواء المنطقة الجنوبية من بلاد الشام والمنطقة الشمالية من شبه الجزيرة العربية للسيطرة على مفارق الطرق التجارية البرية والبحرية، مما سيدفع بالأنباط إلى واجهة الحدث السياسي والعسكري، وكانت مثل هذه الأحداث تجري دون أن نسمع شيئا عن ملك الأنباط أو حتى عن أية إشارة لنظامهم السياسي، وروايات ديودورس بشأن حملات أنتيجونيوس على (الصخرة-البتراء) تضمنت إشارات متناقضة في هذا الشأن، فالجيش السلوقي وصل إلى البتراء على حين غرة مثلما توحي الرواية، ويبدو أن ذلك وقع في النهار أو في آخر النهار لأن شباب (الصخرة-البتراء) كانوا خارجها آنذاك، ولما عادوا إليها بادروا باللحاق بجيش أنتيجونيوس وباغتوا معسكرهم في أثناء نومهم وقضوا وطرهم وعادوا بسلام غانمين. إذن أين الجيش والحرس والقادة والمسؤولين؟ بمعنى أين النظام السياسي، العسكري وعلى رأسه الأمير والجيش؟ لنفترض أن ديودورس كان قد تجاهل مثل تلك التفاصيل، لكن علم الآثار وحفرياته لا تدلنا على أية مسكوكات أو نقوش أو وثائق أخرى تفيد العكس، هذا ما يدفعنا للاستنتاج أن نظام الحكم لم يكن قد تحول إلى نظام سياسي ملكي أو غيره آنذاك، وعلى الأرجح أن المنطقة وشؤونها المختلفة والسياسية منها كانت تدار وفق النظام القبلي الذي سبق أن استعرضناه أيضا، وهو قائم على وحدات إدارية صغيرة هي غالبا ما تكون المجال الجغرافي أو الديموغرافي لمجموعات سكانية، والقبيلة أو العشيرة كانت عماد هذه الوحدات، خصوصا في ظل المرحلة التي كان ديودورس وقبله هيرودت قد وصفاها بالطابع البدوي، إنه النظام البدوي – العشائري الذي لا يزال فاعلا في أيامنا هذه بهذه الدرجة أو تلك في الكثير من البلدان العربية، ولأن مجتمع الأنباط كان قد ورث مجتمعات أسبق، وأهمها الأدوميين والمؤابيون، فإن هذه المجتمعات كانت قد عرفت الزراعة والاستقرار الزراعي قبل ظهور الأنباط بعدة قرون، ومن المؤكد أيضا أنهم عرفوا أنظمة سياسية غالبا ما كانت ملكية وفق مقاييس ذلك العصر على الأقل، وقد أخبرتنا التوراة عن سلسلة من ملوك الأدوميين، وعلمنا من خلال السجلات الأشورية عن عدد من الملوك العرب ومن ضمنهم الملكات أيضا، وكانت الملكة زبيبة (738 ق.م) اول ملكة عربية نعرف عنها في الممالك والدويلات الشمالية لشبه الجزيرة العربية، وضمت سلسلة ملوك قيدار والعربية قائمة من عشر ملوك أولهم الملكة زبيبة، وقد تبع هذه الملكة خمس ملكات أخريات قبل أن نعرف أربع ملوك آخرين، وفي حضارة لحيان صرنا نعرف اثني عشر من الملوك. أما في الشمال والغرب لبلاد الشام، فإن لدينا أيضا معلومات عن ملوك الدويلات الكنعانية ، والآرامية ثم الفلسطينية والعبرية، وهذه الممالك كانت أسبق من مملكة الأنباط التي لا بد وأن استفادت من تراث تلك الممالك وخصوصا من خلال التواصل الديموغرافي ثم الجغرافي والسياسي، أي أننا أمام أنظمة سياسية تركت تراثا استفاد منه الأنباط أيما فائدة، خصوصا إن بعض الأنباط لم يكن بغريب عن المدنية والاستقرار والزراعة والإدارة كذلك.
ومن المحتمل أن العامل الأكثر فاعلية في قيام الدولة ارتبط بسياسات الدول الكبيرة في المنطقة وصراعاتها، أعني دولتي المقدونيين السلوقيين في الشام والبطالمة في مصر. إذ إن تنظيم المنطقة بنظام حكم واضح المعالم قادر على تحمل المسؤوليات خير لهذه الدول من فوضى اللانظام أو أنظمة المشيخات القبلية التي تحتاج إلى صرف المزيد من الوقت والجهد لضبط سياساتها ودرء أخطار غاراتها على مصالح الدول القائمة. وهذا اتجاه سيترافق مع زيادة وعي الأنباط ورغبتهم في إنشاء دولة عصرية - وفق مقاييس ذلك العصر- مما سيحافظ على مصالحهم التجارية مستغلين حالة الصراع والتنافس بين الفريقين من ناحية، ومعظمين لدورهم بالحفاظ على شرايين التجارة ضد الأخطار التي تتهددها غارات الجماعات البدوية المنتشرة في الصحاري الواسعة من حولهم. وإنه لمن المفيد التذكير بأن المنطقة ظلت محطا لأنظار المجموعات البشرية والقبائل التي لم تجد لها موطئا نظرا لميزات المنطقة الجغرافية والمناخية إضافة إلى وجود المراعي الفسيحة وآبار المياه للمجموعات الرعوية إلى جانب القرى الزراعية أو التي يمكن أن تصبح زراعية للمجموعات الراغبة في حياة الاستقرار من خلال الزراعة والتجارة كذلك. وهذه العوامل مجتمعة ومتفاعلة لا بد من أنها خلقت لدى الجماعات البشرية من سكان المنطقة قدرا من الوعي والرغبة مما يستدعي معه إنشاء سلطة مركزية ستكون أقدر على تنظيم مصالحهم ورعاية شؤونهم. وكانت دول المنطقة قد تأسست بهذه الوتيرة من التطورات كالدولة العمونية، والمؤابية، والأدومية في شرقي نهر الأردن في القرن العاشر قبل الميلاد أو قبل ذلك بقليل، بعد أن كونت القبائل البدوية والمراكز الحضرية وحدات سياسية معا، وأدى التنافس الذي كان قائما بين شيوخ هذه القبائل إلى التطلع للاستيلاء على مساحة واسعة من الأراضي ليتسع نطاق حكم الشيخ ونفوذ قبيلته، وربما تجمعت مجموعة من العشائر في قبيلة واحدة، وأجمعت فيما بينها على اختيار أحد الشيوخ زعيما لهذه العشائر أو القبائل، ونجد مثالا على ذلك في كتاب العهد القديم الذي يروي كيف اختير شاؤول من بين مجموعة من القضاة (الكهنة- المشايخ) حاكما واحدا على إسرائيل(54).
وثمة اجتهادات حول ملك أسبق لحارثة الأول (الذي يصنف باعتباره اول ملك نبطي) لكن دون تأكيد حاسم في هذا الشأن، وليس من المبالغة القول أن عهد الملكية كان قد ابتدأ قبيل منتصف القرن الثاني قبل الميلاد وانتهى عام 106 ميلادي بالملك الثاني عشر أو الثالث عشر رب إيل الثاني. وثمة رأي آخر يفيد أن رب إيل توفي عام 101 م واستلم الحكم ابنه مالك الثالث الذي انتهت دولة الأنباط في عهده(55).
وجل ما نريد تأكيده في هذا الشأن أن النظام السياسي للأنباط لم يكن وليد قرار أو اجتماع بين قادة القبائل أو غير ذلك من الأشكال، إنما كان هذا النظام امتدادا لعملية تطورية مثلما تقتضي عوامل مؤثرة خارجية وداخلية أي موضوعية وذاتية، وعلى الأرجح أن احتكاك الإغريق بالأنباط بما يتضمن ذلك من تحديات سلبية وإيجابية كان قد ساهم في تطور النظام السياسي للأنباط، والأدلة على تأثر الأنباط الإيجابي كثيرة ومنها الشروع بسك العملة وفق المواصفات الهلينية لفترة طويلة بالكاد تنتهي في عهد عبادة الثاني (62-60 ق.م)، وهذا لا يعني توقف التأثير الهليني على هذه الناحية لكن الملاحظ أن السمات الأساسية بدأ يغلب عليها الطابع الشرقي – النبطي أكثر من السمات الهلينية. ويشار كذلك إلى أن الأساليب الإدارية للدولة كانت قد اعتمدت أنظمة مشابهة للأنظمة الهلينية حيث سيظهر ذلك في المسميات الإدارية (كالأسريتج والهفرك والكليركا وقنطرين (الكنتوريو) إلخ، وسنتعرض لهذه المسميات لاحقا.
وتجب الإشارة إلى ثمة تساؤلات لا تزال بحاجة إلى المزيد من التحقق والبحث، خصوصا البحث الأثري، بشأن سلسلة الملوك وكل ما يتعلق بهم كأسلوب أو أساس تتويجهم والقوانين والأعراف المتعلقة بمكانتهم وطريقتهم في العمل؟ ومن ذلك أيضا عدم الجزم بسنوات الكثير من الملوك، أو ببعض الفترات الغامضة في سلسلة تتابعهم، وثمة أيضا بعض الاجتهادات والآراء المتضاربة في هذا الشأن، فمنها ما يجعل رب إيل الثاني آخر ملوك الأنباط، مقابل رأي آخر يقول أن مالك الثالث إبن رب إيل كان آخر الملوك بعد أن قضى خمس سنوات في الحكم. ومن الحلقات الغامضة أيضا في هذه السلسلة ما يلاحظ من فترة طويلة بين الملك الحارثة الأول (169- 168 ق.م) وبين خلفه زيد إيل (146- ؟). ولا نعرف ما هو وضع الدولة النبطية في فترة تزيد عن عقدين من الزمن، دون أن ينتهي الغموض بتقلد زيد إيل السلطة، لكننا بعد ذلك نحصل على تتابع منطقي ومتصل بقليل من الغموض او الاختلاف الذي غالبا لم يكن جوهريا من حيث الاختلاف على بضع سنوات زيادة أو نقص لهذا الملك أو ذاك.
وتذكر بعض الدراسات أن لقب الملك لم يتخذ قبل الملك الحارثة الثالث
(87-62 ق.م)، فقد اتخذ الحارث الثالث لقب الملوك السلوقيين والبطالمة Basilius- باسيليوس- (ومعناها باليونانية "الملك على مسكوكاته)، وبعد ذلك ظهر اللقب النبطي " ملكا " أي الملك على مسكوكات عبادة الثاني (62-60 ق.م)، وبعده فصاعدا على مسكوكات الملوك الأنباط حتى سقوط دولتهم(56).
يشار كذلك إلى أن بعض المصادر تعتقد ان الملك الحارثة الرابع
(9 ق.م – 40 م) هو الملك الذي جاء من خارج السلالة الملكية بعد أن اغتصب الحكم، ويبدو أن هذا الملك كان من كبار ضباط الجيش، وهو الذي لقب نفسه المحب لشعبه (ر ح م ع م هـ )، وكان هذا الملك من القوة بحيث وصلت الدولة النبطية أقصى اتساع لها في عهده إذ شملت دمشق فترة من الوقت، ومما يذكره إسترابو من أن الأنباط في هذا الوقت كانوا تابعين للرومان، ونستطيع الافتراض أن الحارث هذا تمتع بمساندة الرومان خلال حكمه أو قبل قيامه بالسيطرة على الحكم. علاوة على الاستناد إلى قوته القبلية التي يوجد ما يساعد على استنتاجها أو افتراضها.
يشار كذلك إلى أن الأنباط اعترفوا أو أبرزوا دور المرأة إلى جانب الملك، وقد ظهرت صور بعض الملكات على المسكوكات النبطية، ومن ذلك شقيلت (شقيلة) و(خلدو) زوجتي الحارث الرابع وجميلت (جميلة) زوجة رب إيل الثاني. وكانت الملكة تعرف بأخت الملك مما حدا ببعض المستشرقين إلى الاعتقاد أن الملوك الأنباط تزوجوا من شقيقاتهم جريا على سنة الملوك الفراعنة والإغريق، إلا أن مثل هذا العرف لم يكن موجودا في الشعوب السامية عموما والعربية خصوصا، وإذا ما علمنا أن كلمة أخت وأخ لا تنحصر في علاقة الأخوة بالدم حسب مفاهيم اللغات السامية، إذ أن هذه الكلمة تحمل معنى مطلقا يشمل كل العلاقات الإنسانية من صداقة وحلف ومختلف درجات القرابة(57). وقد ذكر سترابو أن الملك النبطي كان يتخذ له وزيرا أو ذراعا قويا كان يسميه " أخو الملك" وهو بمثابة رئيس الوزراء أو الوزير الأول.. ومن المحتمل أن مفهوم أخو الملك كان يماثل "الأمير" أو "الرفيق" في عصرنا هذا لجهة تحمل المسؤولية. وكان الوزير سيليوس Syllaeus (صالح) أشهر هؤلاء الوزراء. ويخبرنا يوسيفيوس أن سيلي كان كثير المكوث في روما بجانب القيصر الأعظم، وقد حاز على ثقته، استطاع إقناع القيصر بأن هيرود ملك يهودا قام بالاعتداء على المملكة العربية، وقام بالقتل وأخذ الأسرى..إلخ. وقد دافع سيليوس خير دفاع عن دولته ومواطنيه، وكان قد لبس السواد (حدادا على ضحايا اعتداءات هيرود) قبل مقابلة الأمبراطور الروماني(58).
وأخيرا تجب الإشارة إلى أن ملوك الأنباط عموما امتازوا بقدر كبير من الديمقراطية والبساطة أيضا، فالملك ما يزال يحتفظ بكثير من خصائص شيخ القبيلة، فهو يخدم نفسه بنفسه، بل يخدم ضيوفه أيضا، ويقدم لشعبه " كشفا " عن شؤونه الذاتية، أي أنه يتمتع بقسط غير قليل من الروح الديمقراطية، وإذا قيل له "مَرنا " بمعنى سيدنا " (أو ربنا) فما ذلك إلا قياما بواجب اللياقة(59).
وفيما يلي استعراض لملوك الأنباط وفق الترتيب الأكثر شيوعا، وسنشير إلى أهم ما توافر من معلومات عن هؤلاء الملوك:
1-الحارث الأول (169ق.م- ؟):
يحيط بعض الغموض عهد هذا الملك، خصوصا فيما يتعلق بسنوات عهده، ونحن لا نعرف عن هذا الملك أكثر ما يعرض علينا سفر المكابيين الذي يصف زعيم النباطيين "بالطاغية"، والطاغية – حسب تفسير د.إحسان عباس- الحاكم المطلق التصرف غير الدستوري. أي أن ذلك وصف للملك النبطي. وإذا ما صدقنا سفر المكابيين، فإن الحارث لم يكن إلا شيخا أو كبير الشيوخ لمنطقة الأنباط. ويبدو لنا أن سفر المكابيين لم ينكر على الملوك ألقابهم فوصف الحكام البطالمة والسلوقيين وغيرهم بألقابهم المعهودة كملوك، وإن كان قد ألحق بهم صفات الظلم والبطش والكفر..إلخ. ومن ذلك مثلا: "فاستخلف ليسياس على أمور الملك من نهر الفرات إلى حدود مصر وهو رجل شريف من النسل الملكي... فاختار ليسياس بطلماوس بن دوريمانس ونكانور وجرجياس رجالا ذوي بأس من أصحاب الملك، ووجه معهم أربعين ألف راجل وسبعة آلاف فارس ليأتوا أرض يهودا ويدمروها على حسب أمر الملك" (المكابيين الأول 39-40) وهذا الوصف يعود بالطبع لملوك السلوقيين وحكامهم الذين يجهزون لحملة على يهودا. وبهذا يبدو افتراض أن زعيم الأنباط في هذه المرحلة لم يكن إلا زعيما قبليا أو أكبر هؤلاء الزعماء افتراضا منطقيا، وهو لم يكتسب لقب ملك بعد، بل إن ذلك سيتأخر أيضا إلى أكثر من مئة عام لاحقة، غير أن شيخ الأنباط يحتل مكانة تضاهي مكانة الملك، ونحن لا نعرف عن طبيعة نظام الحكم وملامحه في حينه الكثير مما يبقي افتراض "صفات المشيخة" هو الأقوى ما دمنا لا نملك ما ينفي ذلك حتى الآن.
2- الملك زيد إيل (146- غير واضح):
وبعض المصادر لا تأتي إلى ذكره. وفي قائمة (Kammerer) نجد الملك الثاني هو (مالك 145 ق.م) بينما نجد (رب إيل الأول) في قائمة (Bowersock) في حين تخلو قائمة (Meshorer) من الملكين الأولين. وقائمتي (Starcky) و(Letmman) تشيران إلى (حارثة الثاني 145 ق.م) كثاني ملوك الأنباط في حين أن مجموعة النقوش النبطية CIS تشير إلى مالك الأول. وهكذا فهذه الفترة من الملكية لا تزال غير واضحة إلى أن تأتي الأبحاث الأثرية بما هو جديد. وثمة احتمالات تخمينية عديدة لهذا الغموض الذي لا يتم حسمه بغير الأبحاث الأثرية الوافية.
3- الحارث الثاني (110- 95 ق.م):
يلاحظ في هذا الترتيب وجود فترة غموض تمتد إلى 36 عاما، ويعتقد البعض أن ثمة ملوك حكموا في هذه الفترة، لكن ذلك لا ينفي أن يكون (الملك الثاني وربما الثالث) قد استمر أو استمرا في الحكم مدة 36 عاما إلى ان وصل الحكم إلى الحارث الثاني.
وفي عهد الحارث الثاني هذا كانت العداوة في أشدها بينه وبين المكابيين اليهود، فقد سارع الحارث إلى مساعدة غزة في عام 96 ق.م بينما كان المكابيون يحاصرونها(60).
4- عبادة الأول (95-88 ق.م) :
تقلد الحكم بعد وفاة والده الحارث الثاني، واستمر في عهده النزاع بين الأنباط وبين المكابيين- اليهود بقيادة جينايوس، لأن أطماع جينايوس التوسعية امتدت إلى جلعاد ومؤاب واستطاع التغلب على عرب هاتين المنطقتين، ولذلك تصدى له عبادة في معركة " قانا " عند جدارة (أم قيس) إلى الشرق من بحيرة طبرية، واضطرته هجمات الأنباط إلى الوقوع في واد عميق، وكاد يفقد حياته، اضطر إلى رد ما كان استولى عليه من مؤاب وجلعاد مقابل أن يمتنع عبادة عن مساعدة خصومه. وقانا هذه تقع إلى الشرق من بحيرة طبريا وانتصر فيها عبادة الأول واسترد منهم المكابيين اليهود مناطق في مؤاب وجلعاد، لتصبح تحت الإدارة النبطية.
5- رب إيل الأول (88- 78 ق.م):
حكم بعد وفاة أخيه عبادة الأول، وانتصر على أنطوخيوس الثاني في حملته الثانية على بلاد العرب حوالي 88 ق.م، حيث قتل فيها أنطوخيوس متأثرا بجراحه على ما يبدو.
6- الحارث الثالث (87-62 ق.م):
هو ابن حارثة الثاني أيضا، وهو الابن الثالث الذي أصبح ملكا بعد إيل الأول وعبادة الأول، وفي عهده امتد الحكم النبطي إلى دمشق التي كانت تعصف بها التحديات والقلاقل جراء تهديد القبائل العربية الإيطورية، وهم حكام شرقي لبنان، وبناء على طلب من مجلس بلدي المدينة، تقدم الحارثة وعين واليا له فيها، ثم سك العملة وفرض الأمن، وظلت تلك النقود تصدر حتى عام 70 م حين انتزعت المدينة من أيدي الأنباط. ومن الطريف أنه ألحق باسمه عبارة "محب اليونانية" Philhellene على نقود تذكارية، وفي عهد هذا الملك وقعت البتراء تحت الوصاية أو التبعية الرومانية بعد أن زحف أحد جيوش "بومبي" إلى المنطقة، وكان الأنباط حينذاك في حالة حرب مع الإسكندر جينايوس حاكم اليهود، وقد زحف جيش بومبي بقيادة "سكاوروس" إلى البتراء وحاصرها وأحرق ممتلكات الأنباط حولها إلى أن جرت التسوية التي قضت بتبعية الأنباط للإمبراطورية الرومانية ثم بدفع جزية مقدارها 300 تالنت من الفضة، وعلى إثر ذلك – على ما يبدو – اصدر الحارثة نقدا عاديا يحمل صورته وصورة القائد الروماني سكاوروس يتوسطهما جمل وغصن زيتون يقدمه الحارثة لسكاوروس(61). ويعتبره البعض المؤسس الحقيقي لسلطة الأنباط، ففي عهده توسعت حدود الدولة، وضم دمشق في عام 85 ق.م لأول مرة نحو خمسة عشرة عاما(62)، كما حارب جانيوس زعيم المكابيين وانتصر عليه في معركة الحديثة قرب اللد حوالي عام 83 ق.م. وعلى إثر ذلك هاجم جانيوس شرقي الأردن واستولى على اثنتي عشرة قرية(63). ويبدو أنه ظل في حرب مع كل زعماء المكابيين الذين عاصرهم من أسرة جانيوس (أرسطوبوليس وهيركانوس) وهيركانوس هذا كان قد التجأ إلى الحارثة الثالث في أثناء صراعه مع شقيقه أرسطوبوليس عقب وفاة جانيوس والدهما، ولكن هيركانوس عندما تمكن من السلطة بمساعدة الرومان عاد وتنكر لصداقة الحارثة وجعل يمد الجيش الذي حاصر البتراء بالقمح، وربما بحكم قوة الرومان الطاغية على المنطقة في حينه. ويذكر أيضا أنه في عهد الحارثة بدأت البتراء تتخذ مظاهر مدينة يونانية نموذجية(64).
7- عبادة الثاني (62- 60 ق.م):
تولى الحكم بعد والده الحارث الثالث، وقد عثر على نقش في البتراء يذكر "عبادة بن الحارث " (لحياة عبادة ملك الأنباط بن الحارث ملك الأنباط، السنة 1)، وفي عهده ارتبطت دولته مع الرومان بتحالف وولاء قويين.
8- مالك الأول (60-30 ق.م):
تولى الحكم بعد والده عبادة الثاني، ولعل أهم الأحداث في عهده مشاركة الرومان بفرقة فرسـان في غزو الإسكندرية عام 47 ق.م، ورفضه مساعدة هيرود، مما أدى إلى وقوع معركة ديون(65).
9- عبادة الثالث (30-9 ق.م):
تقلد الحكم بعد والده مالك الأول، وقد اشتهر عنه ضعف الشخصية لحساب وزيره صالح، ولعل من أهم الأحداث التاريخية في عهده مساندة الرومان عام 25-24ق.م، وقد جرى ذلك بقيام وزيره صالح بقيادة ألف رجل لمساعدة الجيش الروماني في الوصول إلى جنوب الجزيرة العربية، وكان الوزير صالح يتكفل بمهمة إرشاد الجيش وتوفير تمويله من الماء والمواد التموينية، وقد آلت تلك الحملة إلى الفشل، وعزا سترابو ذلك إلى خيانة الوزير صالح للرومان(66) وقيام الرومان باعتقاله وقيادته إلى روما حيث أعدم. لكن الأهم في سيرته هو ما قيل عن نشوء عِبادة المَلك بسببه أو بسبب شخصه، إذ يذكر عدد من المصادر أن "عُبادة الثالث" كان قد ألِه من قبل الأنباط، وربما بعد موته، ووجدت بعض النقوش التي تشير إلى ذلك، ويقترح د.احسان عباس أن يكون هذا "التأليه" بتشجيع من خلفه الحارثة الرابع، طمعا في الحصول على المكانة نفسها بعد موته(67).
10- الحارث الرابع (9 ق.م- 40 م):
استولى على الحكم بعد وفاة عبادة الثالث، واسمه " إيناس"، ويعتقد بأنه من كبار ضباط الجيش وليس من العائلة المالكة، وهو الملقب بالمحب لشعبه (ر ح م ع م هـ).
وفي عهده عم الرخاء ووصلت الدولة النبطية أقصى اتساع لها، حيث شملت معظم شمال شبه الجزيرة العربية، ووصلت سيناء غربا والجوف شرقا وحوران شمالا والحجر في وادي القرى جنوبا(68)، ويذكر سترابو أن الأنباط في ذلك الوقت كانوا تابعين للرومان(69).
وتميز عهد الحارث بازدهار عمراني واسع تركز في البتراء ومدائن صالح (الحجر)، ويظهر جليا في القبور المنحوتة في الصخر التي نحتت معظمها في النصف الأول من القرن الأول الميلادي. وإذا أمعنا النظر فيها وجدناها عملت لضباط عسكريين من رتب مختلفة، مما يشير إلى أن الحجر أصبحت قاعدة عسكرية متأخرة في عمق الصحراء، إدراكا من الأنباط للخطر الروماني الماثل(70)، ومن المعروف أن الحارث الرابع كان أحد أبناء القبائل النبطية الجنوبية، وقد ظهر في النقوش الحجرية أن الحارث قد عين عددا من أبناء المناطق الجنوبية في هذه المناصب الرفيعة في المناطق والمدن النبطية(71).
إن كثافة المسكوكات في عهد هذا الملك تشير إلى ازدهار اقتصادي، حيث أن 80% من المسكوكات النبطية التي عثر عليها تعود للحارث الرابع، وقد تضمنت إصدارات تذكارية لزواجه من شقيلت (شقيلة) بعد وفاة زوجته الأولى خلدو.
ومن أهم الأحداث في عهد الحارث الرابع وقوع معركة بينه وبين "هيرود أنتيباس" حاكم الولاية اليهودية في سنة 34م؛ بسبب طلاق الأخير لابنة الحارث، وانتصر فيها الحارث ففزع هيرود إلى الامبراطور الروماني طيباروس الذي أراد الحارث حيا أو ميتا، إلا أن وفاة طيباروس حالت دون تحقيق ذلك(72).
11- مالك الثاني (40- 71 م ):
تولى الحكم بعد والده الحارث الرابع مدة 31 عاما، والأخبار عنه قليلة، أما أهم الأحداث التاريخية في عهده فهي مشاركته في الحملة الرومانية بقيادة تيطس على القدس عام 70 م بجيش قوامه ألف فارس وخمسة آلاف راجل، وقد أبطأت في عهده وتيرة التقدم مقارنة مع والده الحارث الرابع.
12- رب إيل الثاني (71- 106 م ):
تقلد الحكم صغيرا تحت وصاية أمه مدة خمس سنوات، حيث ظهرت صورتها على النقود معه، ولما كبر تزوج من جميلت (جميلة) حيث ظهرت صورتها معه على النقود ابتداء من عام 76 م.
وكانت فترة حكمه قليلة الأحداث بالرغم من طولها، وبموته عام 106 انتهت دولة الأنباط بعد أن رفض الرومان الاعتراف بخلف له، وقد ألحقها تراجان بالإمبراطورية الرومانية، وسماها "الولاية العربية" وعاصمتها بصرى الشام. وتشير الشواهد الأثرية إلى استمرار النشاطات المختلفة، خاصة الزراعية في نطاق الدولة النبطية.
وهناك رأي آخر يفيد أن رب إيل توفي عام 101 م واستلم الحكم بعده ابنه مالك الثالث حيث انتهت دولة الأنباط في عهده عام 106 م(73)، أي بعد أن رفض الرومان الاعتراف بخليفة الملك الأخير وقاموا بإنشاء ولاية جديدة تضم المناطق النبطية جميعها إضافة إلى مناطق جديدة في بلاد الشام، واسموها " الولاية العربية" وجعلوا عاصمتها بصرى الشام.
صدر الكتاب عن:
دار أسامة للنشر والتوزيع (2009):
عمان – العبدلي
هاتف 5658252 6 00962 ،، أو 5658253 6 00962
فاكس: 5658254 6 00962
ص.ب 141781 عمان ،الأردن
E-mail:[email protected] دار أسامة للنشر والتوزيع :
عمان – العبدلي
هاتف 5658252 6 00962 ،، أو 5658253 6 00962
فاكس: 5658254 6 00962
ص.ب 141781 عمان ،الأردن
E-mail:[email protected]
مراجع الفصل الأول وهوامشه:
1- جواد علي، تاريخ العرب قبل الإسلام ،ص 12
2 -سماح بركات، حروب الأنباط ،ص5
3- Hammond.P.C, The Nabataeans,Their History…p.12
4 - د.احسان عباس، 2007،ص23.
5 -Kuhlenthaland Fischer,20
6 -سماح بركات، حروب الأنباط ،ص 8.
7 - محمد خطاطبة ، 2006،ص48.
8 -د.خير نمر ياسين، الآدوميون،ص 99-100.
9- - هشام أبو حاكمة، 2007،ص217
10- زيد الكفافي، 2006،ص 327
11 - محمد الخطاطبة، 2006،ص 48
12- ,The Other Side.pp 167-193 Gluck
13- سماح بركات، حروب الأنباط ،ص12
14 – Hammond,1973:13
15 - 7:10Diodurs,8
16- جواد علي، المفصل، ج 3،ص18.
17- هتون الفاسي 1993،ص 86.
18- خيرية عمرو2003
19 - هيرودوت، تاريخ هيرودوت 2001،ص 220
20 - أنطون جوسان، 1997، ص 143- 146.
21 - د.احسان عباس، 1985،ص32.
22- زيدان كفافي، 2006 ،ص 382.
23- Markoe,Clenn,Lost & Found: Petra Antiquites.verand,Jan 2004.Issue 1,p36-46.6p,8c.)
24 - خير نمر ياسين1993،ص327
25 – المصدر السابق،ص146
26 - محمد الخطاطبة ،2006،ص49
27 - نبيه عاقل، 1972،ص 109-111.
28 – كان الحكم النبطي في دمشق مؤقتا مدة 15 عاما، أما بالنسبة لشرق لبنان فإن الأمر لم يكن واضحا تماما وربما كان هو الآخر مؤقتا وربما اقتصر على النفوذ التجاري، ويعتقد البعض أن بلدة النبطية في لبنان ما هي إلا من آثار ذلك النفوذ، وعلى العموم لم يعثر حتى الآن على آثار عمرانية للأنباط لا في دمشق ولا في لبنان.
29 – حيث قاوم الأنباط محاولات السلوقيين والبطالمة منذ وقت مبكر عندما بدؤوا بمحاولات الزحف على بلادهم وإخضاعها والإستيلاء على مقدراتها.
30- احمد العجلوني، 2002،ص 73
31- Starcky, op.cit. SD.b,pp 888-900.
32- احسان عباس، ص: 76
33- د.سعد أبو دية 1984، ص19
34- هاردنج 1971،ص 143
35- احسان عباس ،ص73
36 -هامش: القاع هو الأرض الواسعة المنخفضة.
37 - هتون الفاسي 1993،ص 50
38- د.احسان عباس 2007،ص 80
39- محمد خطاطبة، 2006،ص 167
40- موقع السويداء.Swaida.com
41- د.احسان عباس،ص 82
42- محمد خطاطبة، 2006،ص42
43- مصطفى مراد الدباغ، بلادنا فلسطين، ج 1، ق 1، ص 125- 126) وكذلك: رجاء وحيد دويدري، جغرافية سوريا والوطن العربي، دمشق، مطبعة طبرين، 1982 م.ص 46، 67
44- محمد خطاطبة، 2006،181ص.
45 - Negev,1997: 63
46- غالي إبراهيم أمين 1976،ص 26-27.
47- د.احسان عباس 2006،ص 79
48 - زيدون المحيسن، 2007،ص 15
49- موقعwww.swaida.com،
50 - د.إحسان عباس 2006،ص 72
51 - موقعwww.swaida.com
52- غالي إبراهيم أمين، 1976، سيناء المصرية عبر التاريخ، ص 26-27
53 – محمد خطاطبة 2006،ص 45
54 - زيدان الكفافي، ص 402
55 - جواد علي، المفصل 1969، ج 1،ص47
56 - هتون الفاسي،1993،ص 168
57 - احسان عباس 2007،ص 62+115
58 - Josephus,Jewish Antiquities,p323-325
59- د.احسان عباس 2007،ص36
60 - الدباغ ،ج1، ق1، 1973،ص 638
61- د.احسان عباس، 2007،ص 42. خطاطبة 2006،ص 51
62- جواد علي، 1969،ج 3،ص 26
63 - خطاطبة 2006،ص 51
64- الدباغ، ج1، ق1 ،ص 638
65 - عبدالعزيز سالم، 1973،ص 95
66 - محمد مبروك نافع 1952،ص87.
67- احسان عباس،2007،ص52
68- نافع 1952،ص 88
69- Strabo,17,4:21
70- د.احسان عباس 2007،59ص
71- سليمان الذييب، نقوش الحجر النبطية، 1998،ص6
72 - عباس، 2007،ص 65- 66
73 - جواد علي، 1969، ج 1،ص 47



 صور
صور













































