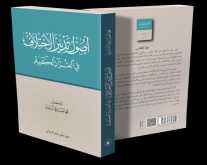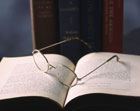كتاب ومضات من حيفا
بقلم الدكتور ماجد الخمرة
تــقــديــم : علي بدوان
الدكتور ماجد الخمرة، ابن خالتي زهرة قاسم عابدي، من أبناء مدينة حيفا، ولد فيها بعد النكبة من اسرة حيفاوية عريقة، درس في مدارسها، ونال شهادة الدكتوراة في علم الاجتماع من بلغاريا. في هذه المادة المرفقة يقدم لنا ذكريات مكتوبة وحية وعلى لسان أبناء المدينة بقالب جميل، في ذكرى سقوطها بيد عصابات الهاغاناه في الثاني والعشرين من نيسان/ابريل 1948.
يسهم الدكتور ماجد الخمرة بكتابه هذا في الجهود المباركة لتأثيث الوجدان الفلسطيني بالذكريات الحيفاوية الحيّة. وهو ابن عائلة حيفاوية عريقة حملت ساحة مركزية في المدينة اسمها: "ساحة الخمرة".. الى أن امتدت الى تلك الساحة يد العبث الطاغي فحوّلت الاسم الى "ساحة باريس"!
سمع الدكتور ماجد في البيت كثيراً من الحكايات عن حيفا وأهلها الذين عمِروها وعمِرت بهم قبل النكبة فدوّنها وأخرجها اخراجاً فنياً ممتعاً فإذا بنا نعيش في تلك المدينة التي حُرمت من اهلها الذين بنوها لتكون العروس الجديرة بالكرمل الأشمّ. فقد عصفت النكبة بسكانها العرب الذين بلغ عددهم حوالي سبعين ألفا سنة 1947 ولم يبقَ منهم في تشرين الثاني سنة 1948 سوى أقل من ثلاثة آلاف وثلاثمائة نسمة!
***
عرِفتُ حيفا طفلاً. فيها بدأتُ دراستي المنظمة بعد "الكُتـّاب" في أسدود، - الى حين- بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة المعارف ؟ في البناية القائمة على الزاوية بين "شارع الكرمة" و "شارع الجبل" الذي تغيرت اسماؤه على اللافتات المتعاقبة، تلك البناية التي أصبحت اليوم "بيت الكرمة".
كتبتُ ارتساماتي وذكرياتي عن حيفا ذلك العهد في كتابي "ظل الغيمة". سحرتني المدينة. من بيتنا في شارع عباس، كان البحر يصافحني ويطلق النظر الى أفق أزرق بعيد. وعندما أجتاز "ساحة الخمرة" الى السوق الابيض كانت تنفتح عوالم ثرية من الالوان والاصوات والوجوه. كنت اتطلع الى كل شيء بعيني الدهشة والانفعال والفرح.
في ساحة الخمرة موقف واسع ترى فيه الخيول والعربات السوداء اللامعة والنحاس الاصفر البرّاق تنتظر المسافرين الى شوارع بعيدة، خاصة تلك التي تتأفعى على سفح الجبل. وعندما تبدأ الرحلة تنطلق موسيقى وقع الحوافر على الاسفلت والأجراس تنبه العابرين والسياط تفرقع في الهواء.
توطّدت صلتي بحيفا عندما تطوّرت ميولي الأدبية فكنت اسافر اليها من الناصرة قاصداً المكتبات العامرة بالكتب والمجلات القادمة من كل انحاء العالم العربي. ما زلت اذكر هناك في وادي الصليب رجلا قصيرا ضخم الهامة يدير عجلة مطبعة صغيرة، هو نجيب نصار صاحب جريدة "الكرمل".
تتلاحق الذكريات: هذه حيفا ابّان الحرب العالمية الثانية ترتفع في سمائها بالونات بيضاء مستطيلة كجزء من الدفاع ضد الغارات الجوية على المدينة، فقد أغارت عليها الطائرات الايطالية آنذاك مما حفز بعض السكان الى اللجوء الى مدن وقرى بعيدة. وهذه شوارعها ممتلئة بالجنود الاستراليين والسنغاليين وغيرهم، وفيها ؟ ككل ميناء عناوين للبحارة لا تبخل على هؤلاء الجنود.
اقرأ كتاب "سبعون" لميخائيل نعيمة حيث يحدث عن سفرته في مطلع القرن العشرين من بيروت الى حيفا قاصدا الناصرة ليلتحق بدار المعلمين الروسية هناك فاذا بالمواصلات بين حيفا والناصرة آنذاك بالعربات تجرها الخيل وحين تصل الى جيدا (رمات يشاي) تبدَّل الخيول لتستريح ثم تعود مع العربة العائدة من الناصرة. وأقرأ سيرة بولس فرح في كتابه "من العثمانية الى الدولة العبرية" فإذا به بعد حوالي عشرين سنة من رحلة نعيمة يجيء من الناصرة على العربات ذاتها. يقول: "كانت هذه العربيات تحمل ستة من المسافرين، كما أذكر، والسابع يجلس بجانب السائق، ولصغر سني فقد جلست بجانب السائق، ويجر العربة حصانان قويان. ومضت العربة بلا توقف حتى موقع جيدا "رمات يشاي" ومن جيدا تنحدر في اتجاه العبهرية (قريات عمال) وكان صعود الجبل الى العبهرية شاقا وصعبا وغير ممكن فكنّا ننزل من العربة في اول الطلوع، ونتسلق الجبل مشيا على الاقدام ونلتقي بالعربة على قمة العبهرية، ثم نعاود الركوب وننحدر الى حيفا حتى نصل "السعادة" وهو موقع تنفجر منه مياه عذبة وتسمى اليوم (تشيك بوست)..."
أرأيتم كيف كان الناس يتنقلون آنذاك؟
* * *
عندما تحب احدا او شيئا فأنك تريد ان تعرف كل شيء عنه ؟ تريد أن تعرف حكايته، "البعد الخامس" للاشياء. وقد شغفتني حيفا فسعيت دائما الى التعرف الى المزيد عنها. وكم اهتممت بتاريخها الثقافي فهو الذي يتحدّى كل محاولات المحو والتغيير والاغتصاب.
كانت بلدة صغيرة على الشاطئ، في موقع "شكمونا"، ولما جاء ظاهر العمر الزيداني في القرن الثامن عشر رأى ان ذلك الموقع غير حصين فأمر ببناء حيفا الجديدة عام 1758م على بعد ثلاثة كيلومترات من الموقع القديم "في رقعة ضيقة بين الجبل والبحر (من ساحة الخمرة حتى البوابة الشرقية قرب عمود فيصل). أحاط المدينة بسور وثلاثة أبراج، أحدها "برج السلام" حيال مبنى البلدية الحالي".
بعد حوالي مائة سنة، عام 1880، كان سكان حيفا 4550 نسمة. في ذلك العهد جاء الاستيطان الالماني فقد كانت المانيا حليفة العثمانيين حكام بلادنا في ذلك الحين. بعد ذلك جاءت موجات الهجرة اليهودية التي تزايدت اثناء الانتداب البريطاني.
***
سنة 1908، حين صدر الدستور العثماني الذي اتاح بعض نسمات الحرية كانت حيفا سبّاقة في الانتفاع به. ففي تلك السنة، بعد شهور من اعلانه، أصدر نجيب نصار جريدة "الكرمل" وأصدر خليل بيدس مجلة ثقافية سماها "النفائس" ثم اضطر ان يضيف كلمة "العصرية" الى ذلك الاسم.
في ظروف الحرب العالمية الاولى (1914 ؟ 1918) عاد سيف الارهاب يغلق الصحف وطورد نجيب نصار الذي انتقد الحلف بين تركيا والمانيا فاضطر الى التخفي والهرب الى الناصرة حيث اختبأ حينا ثم مضى الى مرج ابن عامر، ومن هناك الى شرق الاردن فدمشق، حيث سلّم نفسه للسلطات وسجن. ودوّن لنا ذلك كله بأسلوب ممتع جدا في كتابه "رواية مفلح الغساني". وعادت "الكرمل" الى الصدور في حيفا حتى سنة 1943 كالسفينة التي تداهمها عواصف هوجاء لكن ربانها عنيد يحسن الصمود رغم ملاحقة الرقابة والظروف المادية العسيرة.
اما "النفائس العصرية" فكانت اول وأهم مجلة ثقافية في فلسطين. اتسع انتشارها الى ما وراء البحار وأعيد طبع بعض اعدادها مرتين. ثم انتقلت الى القدس حيث استمرت في الصدور بضع سنين.
ثم كانت مجلة "النفير" التي انتقلت الى حيفا مع صاحبها ايليا زكّا الذي انشأ ايضا مجلة "حيفا" سنة 1924.
وجاء جميل البحري الذي كتب "تاريخ حيفا" وأصدر مجلة "الزهرة" سنة 1922 وانشأ المكتبة الوطنية في تلك السنة وكتب وترجم المسرحيات العديدة وأشرف على ممثليها، ثم اصدر جريدة "الزهور" سنة 1927.
توالى اصدار الصحف والمجلات العربية في حيفا وقد بلغ عددها منذ 1908 حتى النكبة 31 جريدة ومجلة كما صدرت صحيفتان اثنتان باللغة الانجليزية.
وقد حفلت المدينة بالأندية الثقافية والرياضية ودعي الى المحاضرة فيها عدد من اعلام الفكر في العالم العربي.
في حيفا غنّت ام كلثوم وعرض يوسف وهبي وفرقته ابداعهم في التمثيل. يروي بولس فرح بعض ذكرياته عن الترويح في مطلع عشرينيات القرن الماضي: ".. أذكر كان من أبرز متنزهاتها "بستان الانشراح".. وكان يحتوي على ما يلهي المرء من متاعب الحياة وكان موقعه في ما يسمى اليوم "المركز الجديد" ويشقه في الطول "شارع البنوك". وكان البستان ممتد من شارع النبي في اعلاه الى شارع يافا في اسفله وعرضه بحجم طوله... وفيه سمعت غناء منيرة المهدية ورأيت تمثيل يوسف وهبة وفرقة عكاشة الهزلية وغيرها من الفرق التمثيلية والفكاهية العربية".
وما زالت بعض شوارع حيفا تحمل اسماء من التراث الثقافي العربي مما لم تمسه بعد يد المحو والتغيير فهناك شوارع: المتنبي والحريري وابن المقفع وابن سينا وغيرها. اما الفضل في ذلك فيعود الى الشاعر مؤيد ابراهيم الذي كان موظفا كبيرا في البلدية ايام الانتداب واستطاع ان يحقق ذلك. وقد اصدر مؤيد ابراهيم، في الثلاثينيات ديوانا شعريا ومسرحية شعرية غنائية سماها "مجنون ليلى" وظل ينشر شعره في الصحف والمجلات بعد النكبة.
ومن أبرز الوجوه الادبية في سماء حيفا الشاعر عبد الكريم الكرمي ؟ ابو سلمى وقد ضفر من الغزل والشعر الوطني جديلة مبدعة. اشتهرت في حينه قصيدته التي وجهها الى ملوك العرب حينما تدخلوا ليوقفوا الثورة سنة 1936 ومطلعها:
أنشر على لهب القصيد شكوى العبيد الى العبيد
وقد نشر على حبالها ملوك العرب واحدا واحدا، عرّاهم ومزّق اقنعتهم وختم القصيدة متوجهاً الى الشعوب العربية
أيهِ شعوبَ العُربِ أنتم مصدرُ الأملِ الوطيدِ
داعيا الى تحرير الوطن من هؤلاء "العبيد":
بل حرروه من الملوكِ وحرروه من العبيدِ
نشر ابو سلمى قصائده هنا في الصحف والمجلات ولم يصدر مجموعاته الشعرية الا حينما أصبح لاجئاً فكانت المجموعة الاولى بعنوان "المشرّد".
ومن الأعلام الثقافية التي عرفتها حيفا كان الشاعر وديع البستاني ومن آثاره الكثيرة كان ديوانه "الفلسطينيات". أما بيته الذي بناه على الشاطئ على شكل سفينة فسجله باسم الطائفة المارونية قبل ان يغادر الى لبنان في مطلع الخمسينيات وقد رأيته آنذاك في مكتب جريدة "الاتحاد".
وفي حيفا لمع مبكرا اسم الشاعر حسن البحيري الذي طلع على الناس في الأربعينيات بديوانه "الأصائل والأسحار"، تلاه "ارواح الربيع" و "ابتسام الضحى". وتحتل حيفا ووصف جمالها، خاصة في الليل، موقعا خاصا في شعره.
تتوالى الذكريات والصور والأسماء.. "النادي الارثوذكسي" وحنا نقارة، "نادي أنصار الفضيلة" مقهى المتروبول وعدد من المثقفين يسهرون فيه وأفلام شهدتها هناك وآخرها "عنتر وعبلة" في سينما "الأمين" ومشهد يتناجى فيه عنتر وعبلة وفي الطرف الآخر شيبوب رفيق عنتر يناجي جارية عبلة يريد ان يعقد معها مشاركة، اي مشاركة لتكون فاتحة صلة فيقول لها:
يا ريتني أقلع لك عين
وانتي تقلعي لي عين
ونعيش عور احنا الاثنين!!
شكرا للدكتور ماجد الذي استثار هذه الذكريات عن عهد حبيب في بلدة حبيبة وآمل ان تصل رسالته الى الاجيال الجديدة التالية لتقوّي أواصر المحبة لهذه المدينة التي تأبى ان تفقد الذاكرة.
- حنا أبو حنا -
مــقــدمـة
أحيانا يكتفي الانسان بمآسيه المنتهية وغير المنتهية، وأحيانا اخرى يطلب المزيد منها وكأنه يريد التلذذ والاستمتاع بها، ظاناً أنه عن طريق المازوخية يستطيع أن يبرر كيانه ووجوده في هذا العالم. لربما هذا الأمر كان سيجدي نفعاً على الصعيد الشخصي أو في اطار مراجعة الأطباء في عيادات الأخصائيين النفسيين، لكن الأمور تسير في غير هذا المسار وربما عكسه تماماً. فنكبة شعبنا العربي الفلسطيني تأبى التعذيب الذاتي وترفض التمتع بذاتها، لأنها لم تلد نفسها ولم يخطر ببال كافة الشعوب أن تحل بهم الويلات والنكبات كما لم يتمنَّ ولم يدعُ لنفسه الشعب العربي الفلسطيني تلك النكبة ليكون فيما بعد »ضحية الضحية«.
هذه الضحية المنكوبة لها كامل الحق في كتابة تاريخها، وإذا لم تفعل ذلك، فهي ستجرم بحق شعبها وبحق روايتها. ولن يقتصر واجبها على كتابة آلامها فقط، بل عليها أن تُفيض في رواية حياتها اليومية وقصصها الشعبية لتعيد انتاج ذاتها. فنحن نتحدث كثيراً عن ذاكرتنا الفردية والجماعية، لكننا لم نصل بعد الى درجة، إعادة صياغتها، لأن النكبة لم تنته. فنحن ما زلنا نعيش في داخل عالمنا النكبوي كما نعيش في كينونتنا الحالية، حيث يتداخل الماضي في الحاضر، والموجود في المنشود، والواقع في الخيال.
في هذه النصوص، التي لا نستطيع تحديد هويتها وانتمائها الأدبي او اسلوبها حاولنا حصر الذاكرة في مدينة حيفا. هذه المدينة التي نُكِب اهلها في نيسان من ذلك العام لا يمكن إلا أن تكون نموذجا خاصا وعاما لكل ملابسات القضية. » فعامها « هو النكبة بعينها و »خاصها « يشمل كل تاريخ هذه المدينة حتى العام 1948. وينطبق عليها مجمل النقاش حول الروايتين: الصهيونية والفلسطينية. ولكونها مدينة تضم ممثلي الروايتين يزداد الأمر تعقيداً، حيث تصبح المعادلة بين أطراف غير متكافئة، بين القوي المنتشي بنصره وبين المستضعف، الضائع والهش. ففي ظل اللاتكافؤ هذا رأينا من المناسب كسر ما هو مألوف والخروج قليلا عن البكاء لكي نركز على ما هو جوهري محاولين بذلك التصدي للرواية الموازية للتاريخ ذاته، بل أحيانا للأسماء والمواقع ذاتها.
أردنا من خلال هذه النصوص التأكيد على ثلاثة أمور ؟ علماً ان القارئ له كامل الحرية في تثبيت هذه الرغبة او هذا التأكيد او دحضهما ؟ اولا: محاولة إعادة صياغة الذاكرة والتذكير والتذكر، ثانيا: إعطاء جيل النكبة حقه من التاريخ، هذا الجيل الذي ما زال يعيش نكبته يوميا في داخل مدينته المختلطة، محتاراً بين حضوره وغيابه حسب القانون الإسرائيلي، ثالثا: دعوة الأجيال القادمة لأخذ دورها قدر المستطاع بعدما تذوّت الرواية وتستنطق من يحمل هذه الذاكرة. فالأجيال القادمة لها الحق في مساءلتنا والإلحاح في ذلك كما كنا نريد ان نثقل كاهل جيلنا الفائت بالتساؤلات.
أضع امام القارئ العربي في كل مكان وفي كل زمان نصوصاً ربما لن تجذب البعض، لكني متأكد انها ستؤلم البعض وتدخل ذات ذاته حتى النخاع وخاصة اذا كان ينتمي بهذا الشكل او ذاك لمدينة حيفا.
لقد نشرت هذه النصوص من حيث التتابع الزمني منذ العام 1995 وتحديداً في شهر نيسان، حيث حرصنا أن تصدر هذه المقالات في هذا الشهر، لأنه شهر نكبة هذا البلد. وكانت صحيفة »الاتحاد« »الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الاسرائيلي« التي تصدر في حيفا هي السباقة في هذا النشر تعاملاً مع اهدافها منذ صدورها في العام 1944 وفي حيفا. ولا يسعني هنا الا ان اردد كلمات طيب الذكر الكاتب الكبير اميل حبيبي معتزاً بصحيفته ومكان صدورها حيث قال »كون الاتحاد تصدر في حيفا فهي حيفاوية بكل معنى الكلمة«. وفيما بعد تم نشر آخر ثلاثة نصوص في مجلة »مشارف« المشرفة التي اصدرها اميل حبيبي لتتابع اصدارها الشاعرة سهام داهود.
مهما يكن من أمر هذه النصوص فنحن نعتقد بأنها ستبقى في إطار محاولة حكّ الذاكرة وتسليط الأضواء على جوانب لم تأخذ حقها من الكتابة الفلسطينية والعربية.
اعتقد أننا دخلنا مرحلة كتابة النكبة ذاتها وليس عنها او ما يدور من حولها.
خواطر مكانيّة لخواطر زمانيّة
في نهاية النصف الثاني من شهر نيسان عام 1948، سقطت حيفا، عروس الكرمل، التي طالما تغنّى بها الشعراء والكتّاب، وما كان لعربها إلا الرحيل مهرولين الى ابواب الميناء فزعا من أهوال المجازر التي وصلت اخبارها الى السكان، عن دير ياسين والطنطورة وغيرهما، ذلك غير القنابل التي كانت تُقذف من حي "الهدار" العالي على الحي العربي في دونه الأسفل، على حارة الكنائس. فقد قام رجال من "الهاجاناة" بدحرجة برميل من ساحة البرج الى ساحة الكنائس عبر شارع "ستانتون" ، وقاموا بعمل مشابه في وادي النسناس ، وآخر.. وضعوا قنبلة ناسفة في سيارة عبد القادر الحاج، وهو موظف كبير في بلدية حيفا آنذاك، فانفجرت به وأردته قتيلاً قرب مرآب (كراج) "أبي شامي"، ومثل هذه الأعمال ما لا يُعد ولا يُحصى.
بقي القليل من العائلات الحيفاوية العريقة في حيفا ورحل الكثير من شهود العيان. لكن الحقيقة لم ترحل. والذاكرة تأبى أن تمحى. فهي تنتقل من الجد الى الأب الى الحفيد. وها نحن ؟ ابناء الجيل الثاني بعد النكبة ؟ نستذكر وندوّن كي لا يضيع الحق التاريخي. وللتاريخ قيمة غالية، علينا الحفاظ عليها ونقلها من جيل الى جيل.
هنالك في الجانب اليهودي ؟ ابناء الجيل الثاني ؟ شيء يدعى "صدمة الكارثة" بعد الكارثة التي حلّت بالشعب اليهودي، حيث نقل الآباء، الذين عايشوا وذاقوا صنوف التعذيب في معسكرات الإبادة والتشرّد، الصورة لأبنائهم. وما كان على الأبناء إلا أن يرثوا الصدمة، صدمة الرعب وتوجّس الفزع من الآتي والخوف من الآخرين وغيره. وقد وصل الأمر ببعض هؤلاء الى درجة عدم الجرأة على زيارة تلك الأماكن في اوروبا.
أما نحن، فقد ورثنا عن آبائنا صدمة المكان، إذ قال جدّي، لأمي، لأولاده وزوجته وهم في عكا، حيث كانت المحطة الأولى من الرحيل: ".. ان ابقوا!!".
وما زلت ألوم الآباء والأجداد على ذلك. لكن التاريخ علّمنا ان الهجمة والمؤامرة الثلاثية كانت اقوى من أن يأمر أب ابنه.. وقد قيل لنا أنه، آنذاك، قام رئيس بلدية حيفا، شبتاي ليفي، بجولة في الأحياء العربية للمدينة بحثّ السكان، عبر مكبرات الصوت: ".. ان ابقوا". لست مؤرخا مختصا لأتقصّى مدى صحة هذا الأمر، إلا أنه سمعنا، مؤخراً، بوجود حاسوب يستطيع استرجاع كلمات رددت في الهواء حتى قبل 2000 عام. فبدأنا بجمع الأموال لذلك! واستناداً الى كلمة "ان ابقوا" كلمة الجد لأبنائه، و "ان ابقوا" لشبتاي ليفي، لا يسعنا إلا ان نجتر كلمة "لو" او "يا ريت" تعبيرا عن حلم جميل كان له أن يتحقق فيما لو بقوا.
فصدمة المكان هذه ترافقنا أينما ذهبنا. نغيب ونصول ونجول في أصقاع العالم ونرجع الى حيفانا، والى وادي نسناسنا، ذي الشهرة العالمية. فهو حي كانت له مكانته المرموقة ثقافيا وسياسيا، حيّ أنجب العديد من الأدباء والمفكرين كالبحيري ونجيب نصار وغيرهم، حيّ أقيمت فيه المؤتمرات كمؤتمر العمال العرب، وصدرت فيه الصحف، كصحيفة "الاتحاد" الناطقة بلسان مؤتمر العمال العرب، ثم عصبة التحرر الوطني آنذاك. وإذا كنا نحن ؟ أبناء هذا الجيل ؟ نتحسّر ونعضّ على شفاهنا غضباً فكم بالحريّ أبناء ذلك الجيل؟.. ولكن نعم سنبقى..
يقول لنا أبناء عمنا في حيفا: ها نحن قد غيّرنا البلدة التحتا من مكان مقفر ومظلم الى مكان يعجّ بالناس، والآن سنحوّل حارة الكنائس الى مكاتب حكومية وتشغيلية وتجارية وغيره. أهلاً بكم وبحضارتكم. فالمكان كان يعجَ بناسه وكانت ساحة الخمرة مثالاً لساحات المدينة، حيث الأشجار والعربات التي تشدها الخيول تنتظر الركّاب لإيصالهم الى حي الألمانية او الموارس او الى الكرمل، الى دار شوماخر في شارع الصنوبر "شدروت هنسي" . وكان على أعتاب شارع "ستانتون" الذي اصبح "شيفات تسيون" (اي العودة الى صهيون) قبالة موقع الزحلان، بئر للمياه تدعى "الزحاليق" لكثرة ما تزحلق الناس في ذلك الزمان وذلك المكان. كان هذا المكان ينبض بالحياة والأسرار والنهفات والنكات والضحكات والآلام وشظف العيش، كما كان مثالاً للتآخي الإسلامي ؟ المسيحي.
كان في ذلك المكان والزمان أناس يعملون، كانت حياة جارية بكل معنى الكلمة، وليس كما قالوا: "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب". ولطالما تعيد والدتي ؟ مدّ الله في عمرها ؟ كلماتها "سقى الله أيام العرب" وتقصد أيام ما قبل عام 1948. وتقول أيضا: "كنا نلعب ونلهو قرب دار عائلة مسمار حيث ولدت هناك على تخوم وادي الصليب وحارة الكنائس، الى أن جاءنا يهودي ابن عرب وقال لنا: ما لكم تلعبون وتلهون. فليكن ذلك ولكن، إعلموا اننا نتأهّب ونشتري الأسلحة، ويوماً ما، كل هذا سيصبح لنا". وتتابع والدتي وتقول: "لم ندرك كنه ذلك."
يقولون لنا: وما هي جذوركم في حيفا، فكلكم مهاجر من القرى المجاورة..؟ فإليكم التاريخ. كان جد جدّي لأبي، عبدالله الحاج، ميسور الحال ومالكا للأراضي في كفر لام (موشاف هبونيم)، قابعاً في حيفاه متزوجا ثلاث او أربع نساء حسب شريعة محمد (ص)، حيث أنجبن له العديد من البنين والبنات كان من بينهم عبد الرحمن الحاج، رئيس بلدية حيفا في سنوات العشرين، لم تر بلدية حيفا من المناسب تخليد ذكراه حتى العام 1998. وما زال منزله قائماً في شارع البرج "معاليه هشحرور" (تلة التحرير) اما مبنى البلدية فكان قائما عند مفترق شارع "ألنبي" (على اسم القائد البريطاني الذي "حرر" فلسطين من الاتراك) و "ستانتون".
اعلم أنه لا جدوى من الوقوف على الأطلال والبكاء، لكن رفقا بالذاكرة، إذ كيف سينسى آباؤنا احداث الـ 48 في حيفا؟ كيف لا يذكرون امرأة حملت الوسادة بدلاً من طفلها اثناء الهلع والخوف؟ ومراد عبدالله الذي أبقى "البريموس" مشتعلاً لشرب فنجان القهوة العصملية . ومحمد عيد الصغير، الذي أخذ مفاتيح بيته للعودة السريعة، كما فعل شاعرنا الكبير ابو سلمى من بيته في حي الألمانية. وهاكم جدّتي لأمي، تسلم الكوشان لأختها في السيارة وهما في المنفى في لبنان، ظانة أنه، بعد اسبوعين، ستلتقيان في داريهما، فراح الكوشان وبقي المكان. وهاكم جدي يدخل بيته بعد هدوء العاصفة فيجد حاخامين ليقولا له: "إذهب من هنا، ولا حق لك في أخذ شيء." وبعد إلحاح سمحا له بلملمة شهادات ميلاد أولاده لتبقى للتاريخ.
لقد أكثرت من التجوال في حيفا القديمة برفقة جدي لأمي، وحفظت ؟ عن ظهر قلب ؟ الكثير من المباني التي كانت تابعة للعائلات الحيفاوية، بيد أن جدي، ولشدّة تعصبه لحيفاه، لم يكتف بذلك، بل كان يشدد على معرفة منبع العائلة، أحيفاويّ هو أم من القرى المجاورة. فكان يشير: تلك مدرسة السباعي، والمدرسة الإسلامية، وتلك مقبرة الاستقلال، التي كانت ملكا لآل القط. وتلك عمارة آل عابدي في شارع "ستانتون" وأخرى في شارع "سيركن". وها هي دار نفاع، كيّلو، رنّو، بكير (من أصل طيراوي)، وها هو جامع الحاج عبدالله (أبو) يونس، يطل شامخاً من الحليصة. وها هي السرايا، مقر القائمقام. وها هي أملاك دار الخمرة - الصغير في درج الأنبياء، والجدع والدحبور وتوما وطوبي والقلعاوي والزعبلاوي و (أبو) زيد وخوري وصهيون وكوسا. فحفظنا الأسماء عن ظهر قلب. حتى إن ابنتي بدأت الدخول في دوامة المكان لتحفظ في ذاكرتها ؟ قدر المستطاع ؟ ولو جزءاً من التاريخ.. ومأساته.
وهل حدثكم ابن ابناء جيله، كاتبنا الكبير، اميل حبيبي، في متشائله وسعيد نحسه عن طرفة جدي لأمي؟ فقد كانت أيام ثورة الـ 36، وجدّي يحدثنا عن نجاته من محاولة قتله عندما اشتبه فيه الثوار بأنه يتعاون مع البريطانيين، حيث كان يبيع لهم الخيول. وكان هنالك أمر يمنع بيع أي شيء للجيش البريطاني. فسألناه: ولماذا كنت تفعل ذلك؟ فقال إنه كان يبيع الخيول "الكديش" اي (التعبانة)، فكانوا يسقونها النبيذ مع الماء حتى تثمل وتصبح مطيعة فيقتنيها الإنكليز. أو كانوا يقصون من أسنان الحصان حتى يبدو صغيرا، لأن الإنكليز كانوا يشترون الخيول الشابة فقط. فجاء الثوار، بقيادة شخص يدعى العسكري (قضى أيامه الأخيرة ؟ في سنوات السبعين ؟ في مقام الخضر (أبو العباس)، واقتادو جدّي لرميه في البئر عقاباً "لتعاونه" مع الانجليز، لكنه نجا بفضل قريب له كان من ثوار العام 1936 الذي تشفع له باسم الخضر وباسم "ستنا مريم".
وكان لهذا الجد صديق يهودي يدعى حاييم شميدوف، أصرّ على ان أحداث الـ 48 تدعى استقلالاً، أما جدّي ؟ وبفطرته ؟ رفض هذه التسمية، وبدلاً من أن يسميها احتلالاً سماها "استحلالاً" على وزن استقلال!! وما زالت والدتي تردد هذا المصطلح!
فالمكان هو حيفا بأزمنتها العثمانية والبريطانية والإسرائيلية، بأحيائها: حارة الكنائس، والوادي، وساحة الخمرة، وساحة البرج، والسعادة، وعمارة صائب سلام، والقشلة، والموارس، وبوابة الدير، والخضر (أبو) العباس، ونزلة الكلداوي، ووادي الصليب، والحليصة، وبحر (أبو) نصّور، وحارة الشوافنة، وكنيسة الروم، والجامع الكبير، وسوق الشوام، وغيرها من المواقع مما تبدّلت اسماؤها لكن المكان هو المكان نفسه..
.. فابقوا!!
اُنـطـق أيـهـا الحجر
في الاسبوع الأول من شهر تشرين الأول من العام 1995، أقيم معرض في مبنى "الشيكم الجديد" تحت عنوان "آثار سكانية" للفنانة ايلانة اورتار- سلامة وكان موضوع المعرض بيت عائلة الخوري الذي بنيت على انقاضه بناية شاهقة زجاجية سوداء، تجمع بين التجارة والمكاتب الحكومية والمقاهي ودور السينما. وبالإضافة للوحات الكولاجية فقد أنتجت وأخرجت الفنانة فيلما "قصيرا" على غرار "الفيديو آرت" تتحدث به عن قصة المكان من وجهات نظر مختلفة وكاتب هذه السطور كان احد المتحدثين.
ارادت الفنانة ان تروي قصة هذا المكان في ذلك الزمان دون ان تتخذ موقفا صريحا محاولة الابتعاد عن السياسة. ولا آخذ مأخذا عليها فليس كل شيء سياسة، الا أنه وبالذات هذا المكان وذلك الزمان هو السياسة بعينها. فالمكان "فيلا" بيت آل الخوري، وهو مبنى جميل واسع بني في اواخر القرن العشرين في الخط الحدودي بين حي الهدار اليهودي والحي العربي في درج الانبياء مقابل بيوت آل توما والخمرة وحبيب وبدران.
ومن المعروف أنه دارت معارك طاحنة في 22/4/1948 حول هذا الموقع نظراً لاستراتيجيته الهامة. وأصبح مصير البيت والعائلة كمصير حيفا آنذاك. لا نعلم بالضبط ما حل بعائلة الخوري لكننا نعلم علم اليقين أن مصير المكان- البيت هو نفس مصير العقارات والبنايات العربية التي تحولت لأيدي الدولة لإدارة أملاك العدو او الحاضر ؟ غائب. وفي الستينات جاءت أيدي الهدم على المبنى ومحت قطعة تاريخية مكانية ؟ زمانية هامة في تاريخ حيفا. فلو استطاعت حجارة البيت ان تنطق لسردت لنا التاريخ. لكن لا بأس فقد أقيمت البناية الشاهقة وبدأ الناس يؤمونها لشراء حاجياتهم وقضاء ساعات لشرب الجعة ومغازلة الشقراوات من الشعوب السلافية دون اكتراث للتاريخ ودون التفكير ولو للحظة ان "شيئاً ما حصل هنا". طبعا، ليس لنا مأخذ على الزبائن فنحن منهم، لكن رفقاً ورحمة بالقيم التاريخية. لسنا دعاة تخلف وتراجع والعيش في الماضي لكنه كان من الممكن الحفاظ على البناية وإعادة ترميمها. بيد أن السياسة التي كانت سائدة جاءت لتمحو كل ما يتعلق بتاريخ حيفا وعربها.
وفي هذا السياق أجريت عدة أبحاث عن تاريخ حيفا وعائلاتها العربية كان مرادها الإثبات بأن اصل العائلات العربية في حيفا جاء بالأساس من الأقطار العربية الأخرى كعائلة الحاج المصرية والخوري اللبنانية وغيرهما محاولين التلميح بأنه لا جذور للعرب في هذه المدينة. طبعا لا يمكن التحدث عن نقاوة الأصل والجذع فلا المانيّ مئة بالمئة ولا تركيّ مئة بالمئة وكذلك لا حيفاوي مئة بالمئة. ففلسطين لم تكن دولة مستقلة مطلقا على مر العصور وما كانت إلا مصرا من الأمصار العربية، وكانت العائلة تتجول في انحاء الامبراطورية العثمانية حسبما شاءت سواء طلبا للرزق، او الزواج او الثراء.
ومهما يكن من أمر فحيفا هي حيفا وكي يتعرف الشخص عليها وجب عليه مخاطبة بناياتها القديمة وزيارة البلدة القديمة. فكان المستعمر البريطاني أول من اطلق تسمية ؟old city؟ على الرقعة الممتدة من ساحة الخمرة غرباً الى سكة الحجاز (عامود فيصل شرقا). ففي هذه الرقعة المهدومة تجد تاريخك. تخرج من ساحة الخمرة داخلاً الى حارة الكنائس معرجاً على "السرايا"، متجولاً في سوق الشوام، مصليا في كنيسة الروم وفي جامع الجرينة، زائراً الموتى في مقبرة الاستقلال، والجاً شارع العراق ثم صاعداً للحليصة لتؤدي صلاة العصر في جامع الحاج عبدالله ابو يونس. وبعدها تستطيع التنزه في حارة "ارض اليهود" عابراً شارع سيركن ونزهة والبرج لتدخل المدرسة الاسلامية "مدرسة الجمعية" (وزارة الداخلية تقريبا). ومن ثم ترجع الى ساحة الخمرة لتركب الحنطور لتصل الى محطة الكرمل لترى البساتين عبر شارع القشلة وابن الأثير لتنتقل بعدها عبر الموارس الى بوابة الدير ومن ثم الى واديك المحبوب وادي النسناس.
لعلّ هذه الرحلة القصيرة في رقعة المسافة الزمنية تجعلك بدون مكان وزمان، تجعلك ملحاحاً أمام حجارة المباني لتستنطقها لتأتيك بالأخبار من سفر الدهور، أخبار ظاهر العمر الزيداني، رشيد الحاج ابراهيم، الزعبلاوي، الجدع، عبد الرحمن الحاج، صنبر، عوض، الحجار، القط، حوا، عابدي، مصطفى باشا الخليل والقسام وغيرهم من الأسماء التي تعجز ذاكرة الجيل الثاني بعد النكبة عن احتوائهم. وتزودك الحجارة بكل حدث وتؤكد لك احداث نيسان من ذلك العام.
لا يكفي النظر الى الوراء فالزمان يسير من الماضي الى الحاضر والى المستقبل، لا يمكن إرجاع عجلة التاريخ. علينا ان نتطلع الى الأمام، الى حيفا عصرية ذات احياء نظيفة ومراكز جماهيرية فعالة ومجهزة بجميع اللوازم، و... و القائمة طويلة والعمل شاق، شاق جداً. فدعونا نتكاتف ونلبس مكاننا وزماننا حلة جديدة كقول شاعرنا الكبير عصام عباسي رحمه الله "وكيف سيضحك هذا الزمان اذا لم يدغدغ بكل يد".
لكلٍّ حيفاه ولكلٍّ نكبته
سقطت حيفا. هكذا كان جدّي ؟ رحمه الله ؟ يردد هذه الجملة مع التشديد على الفعل "سقطت"، وفيما بعد اختلطت التسميات وسط أهل حيفا الأصليين، فهناك من يقول: "عندما دخل اليهود" أو "لما راح الإنجليز". وهناك من يقول ؟ وهذا المثير للتساؤل:- "الاستحلال"، فلماذا لم يقولوا: الاحتلال؟ ومن المثير، أيضا، أن أهل حيفا ؟ عندما يريدون وصف أوضاع معينة ما قبل عام 1948 ؟ يقولون: "أيام العرب"، قاصدين بذلك آواخر الفترة العثمانية وبداية الفترة البريطانية وكذلك الحياة اليومية لهؤلاء الناس، حيث كانت الحياة تدار ببساطة خالية من التعقيدات.
لكل عربي حيفاوي قصة مع النكبة، وليس هذا فقط، فالنكبة جزء من حياته، يعيشها ويستنشقها بصمت ومن دون إثارة الضجيج حول ذلك.
وهناك العديد من الأشخاص الذين واكبوا النكبة بأجيال متفاوتة، فمنهم من كان ابن عشر سنوات او ثماني عشرة سنة.. وهناك من دخلت النكبة الى لا وعيه حتى إنه يكاد لا يجرؤ على المرور من أمام الأماكن التي تذكّره بذلك، من دون أن يدري السبب. فهم لا يجرؤون على المرور من وادي الصليب وأزقته الملتوية ودرجاته المتعددة، فضلاً عن حارة الكنائس التي هدم الجزء الأكبر منها مباشرة بعد العام 1948 ضمن برنامج "شيكمونا".
فإذا كانت، في السابق، حارة الكنائس هي الشاهد والمذكّر، فما تبقى الآن هو أطلال وادي الصليب المهدوم، وبعض الأبنية على تخوم شارع البرج وحسن شكري و "ستانتون" و الأفغاني. والخوف هو أن لا يبقى أي معلم حضاري يغذّي الذاكرة الجماعية أو الفردية.
إن من يتصفح ويطّلع على الوثائق التاريخية من صور وخرائط لحيفا يستطيع ؟ بسهولة ؟ أن يتعرّف على نوعية الحياة آنذاك، على الرغم من وجود الانتداب البريطاني. تستطيع أن تلاحظ عدد المدارس الكثير للمسلمين والنصارى واليهود، للبنين والبنات، والكنائس للطوائف جميعها، والمساجد والكنس اليهودية، والسوق، سوق الشوام والأبيض والجرينة، ومصنع الثلج في محطة الكرمل، والمقابر والنوادي والمرافق الحكومية والجمرك والأديرة والأراضي، مثل أرض البلان، أرض الرمل، الزحاليق، والأودية، مثل السعادة ورُشميا والتينة والسياح والحارات، مثل حارة اليهود ووادي الصليب والنسناس والمحطة والكنائس ووادي الجمال و "بات ﭽاليم"، و "نافيه شأنان" والحارة الشرقية، وكذلك الشواطئ، مثل شاطئ (أبو) نصور والعزيزية وغيرها من الأماكن. وإن ننسَ، فلن ننسى ساحة الخمرة، التي كانت بمثابة الساحة المركزية للبلدة القديمة منذ العهد التركي والمركز التجاري العام للعرب واليهود.
لقد كتب الشيخ عمر نمر الخطيب في كتابة "سر النكبة" ما كتب، وكان من ضمنه جملة ما زالت ترافقني أنا ؟ ابن الجيل الثاني بعد النكبة ؟ حتى يومنا هذا، حيث قال: "إن لسقوط حيفا سراً ستعرفه الأجيال القادمة" وهذا السر سأحاول إفشاءه ما دمت حيّا.
لقد تحدثت كثيراً مع الشيخ المشقّق الوجه (أنظر كتاب الأديب سلمان ناطور، "مانسينا") وهو حيفاوي أباً عن جد، وطرحت عليه السؤال: "ما رأيك في دولة اسرائيل؟" فأجابني قائلاً: "وهل تقصد دولة اليهود؟" فقلت: "نعم"، فقال: "هذه الدولة تستطيع أن توقّع العديد من الاتفاقيات مع دول العالم جميعها وبضمنها "م.ت.ف."، إلا أنها ؟ حتى الآن ؟ لم تأتِ إليّ للتباحث معي في شؤون قضيتي. فبيني وبينها قصة طويلة لم تبذل هذه الدولة جهداً لحلها. فأنا القابع هنا في حيفائي، أباً عن جد، سلبتني هذه الدولة أملاكي جميعها، وأنا الذي لم أبرح حيفا لحظة واحدة في أثناء الأحداث في نيسان 1948، ولم أعتبر حاضرا غائبا حسب قانونهم المجحف. ومع ذلك، فقد سلبتني حقي في الملكية والهوية وحتى اللغة." ويتابع الشيخ قوله: "في 22 نيسان 1948 كنت جالسا، كعادتي في الخان الذي أملكه في البلدة التحتا، بين شارع الناصرة وشارع العراق، أدّخن النارجيلة وأرعى شؤون الخان، وأذكر أنه كان يوما ماطرا على غير عادة في شهر نيسان وكأن الرب أو الخضر (أبو) العباس ؟ دستور من خاطره ؟ أراد ذلك ليشير إلينا بخطورة الأمر.
"إلا أننا لم نأبه، حتى سمعت بأذني دويّ القنابل التي بدأت تتساقط من شارع البرج و "ستانتون". فعند سماعي الدويّ الأول قلت: راح بيتنا، والدويّ الثاني راح الخان، والثالث راحت السرايا فالرابع والخامس.. إلا أنني.. خفت على أولادي، فأغلقت الخان، وبدأت أركض في أزقّة حارة الكنايس حتى وصلت ساحة الخمرة، التي كانت مليئة بالناس على غير العادة، عندها فهمت أن الأمر جدي جدا.
"وفي ساحة الخمرة قرب فندق "إيجد" التقيت شريكي اليهودي في المصلحة، وقال لي بالحرف الواحد: "اليوم عقدت جلسة في دار البلدية مع الخواجة شبتاي ليفي وممثلي العرب وتقررت دعوة عرب حيفا الى عدم النزوح"، فقلت له "على راسي وعيني.. ولكن الطخ والقتل والسلب والنهب ضارب أطنابه في حارة الكنائس ووادي الصليب"، فأجابني "دبّر حالك!!". فقلت في نفسي: سأدبّر حالي مثلما تدبّرت مع الأتراك والإنجليز.
فرجعت الى بيتي في حارة الكنائس فلم أجد زوجتي وأولادي. وقالت لي جارتي أم خالد، من دار القلعاوي، إن زوجتي خرجت مع الأولاد قبل ساعة ويمكن أن ألاقيها على باب الميناء. "إلا أنه في اثناء ذلك، حاولت الدخول الى بيتي فوجدت شخصين يهوديين متدينين قالا لي: "إنك لا تستطيع الدخول الى هنا، فهذا ملك مهجور، فاستعطفتهما فسمحا لي بالدخول، فلملمت بعض الأوراق، كانت بينها شهادات ميلاد أولادي. وبقيت الأوراق وضاع الحق الى يومنا هذا...". ويسأل الشيخ نفسه، ويحق، حتّام سأبقى ضائعاً بين نكبة القانون (الحاضر غائب)؟ وهل كتب عليّ وعلى شعبي الشقاء..؟
هذا غيض من فيض، فكما قلت: لكلّ نكبته، يستطيع أن يحدثنا عنها أياما وأسابيع، لتدخل إلينا نحن ؟ أبناء الجيل الثاني ؟ وتغذّي ذاكرتنا الجماعية كي لا ننسى. وبينما نحن منهمكون في نكبتنا يأتينا الباحثون والمؤرخون ليتجادلوا ويتباحثوا حول أحداث العام 1948 في حيفا، وليؤكدوا لنا، تارة، أنه لم يحصل تهجير بل كانت "أوامر من فوق" وتارة ليقولوا: لقد هرب عرب حيفا بمحض إرادتهم. فأجبهم أيها الشيخ، أيها الشيخ المشقّق الوجه.
رسالة من الجد « ق» إلى الحفيد « م» في حيفا
حفيدي العزيز "م"!
أخطّ لك هذه الرسالة استجابة لرسائلك العديدة التي كنت قد أرسلتها إليّ عبر ما يسمّى بالـ "انترنت". لم أستطع الرد عليها مباشرة، لأنه ؟ كما تعلم ؟ نحن الأموات ؟ لا ندري كنه هذه الآلة، حتى إن رسائلك لم تعرف كيف نقرؤها، الا أننا "استبشرنا خيراً" بوفود بعض الشباب إلينا، كنا قد أسفنا جداً لرؤيتهم بيننا، لكن ما العمل؟ فما في اليد حيلة، هذه هي مشيئة الله والقدر!
عزيزي "م" أعتقد أنك ما زلت على العهد، وما زلت تحفظ وتحافظ على السر الصغير الذي بيننا ورمزه 22/4/1948. لقد حاولت جاهداً أن ابعث إليك ببعض من الإشارات السماوية حاثاً إياك على أن تحفظ العهد، لكنها لم تصلك، فلا ضير! فها أنا أخطها لك كي لا تنسى الرمز وسرّه.
إعلم، يا حفيدي العزيز! إنني هنا في الأعالي ما زلت أحمل نكبتي على كتفيّ، وما يعزيني هنا أنني التقي، يومياً، اصدقائي من الطفولة، الذين سبق وحدّثتك عنهم عندما كنا سائرين سويّة بين أطلال ما تبقّى من حارة الكنائس، أوتذكر؟!.. ففي الصباح التقي صديقي اليهودي، شميدو، ونتبادل الحديث حول تجارة الخيول، ومن ثم أتجاذب أطراف الحديث مع صديقي الآخر، ماير الأزعري، ابن شفاعمرو، وغيرهما من أصدقائي أولاد الحارة الشرقية والكنائس ووادي الصليب، وبعدها أخلد الى النوم، حسب قوانين السماء.
أما بعد الظهر، فأنتهز الفرص لأتجوّل بين المعارف.. فقبل اسبوعين التقيت (بن غوريون) مرتدياً سرواله (الخاكي) كعادته، ودار حديث بيننا مفاده أنه يأسف لما يحصل الآن لشعب اسرائيل ويأسف لوجود قادة أمثال أريئيل شارون. فسألته: "أوَلم تأسف لنكبتنا؟" قال: "عام يسرائيل حاي" أي (شعب اسرائيل حي). فقلنا: ومن قال غير ذلك. فسكت. لكنني لم أسكت، فشتمته بالعربية، فشتمني بالـ "إيديش" . وبينما نحن نتبادل الشتائم، جاءني كل من الأفندي (شبتاي ليفي)، رئيس بلدية حيفا الأسبق، وحسن شكري بك، رئيس بلدية حيفا الأسبق، أيضاً، فرددت عليهما التحية بالتركية كعهدي في تلك الفترة، وحظيت منهما بجلّ الاهتمام نظراً الى معرفتهما بي وبعائلتي وبأصلي وحسبي ونسبي، لكني صرخت في وجه حسن شكري مذكّراً إيّاه بالشعار الذي رددناه آنذاك ضده، قائلين: "حسن بك يا ديّوس.. بعت الوطن بالفلوس"، فلعنني هو، أيضا، لكن بالتركية. أما (شبتاي ليفي) فذكرناه برمز السر فلم يدر ما هو الأمر، لكنه تمتم شيئاً ما بالتركية والعبرية والعربية!
حفيدي العزيز! هذا هو القليل عن حياتنا في الأعالي، لكن خبّرني بالله عليك، ما أصابكم، ماذا دهاكم يا "عرب اسرائيل"، ما الذي سمعناه عن مدينة الناصرة ، ما هذا الذي نسمعه عن المسيحي والمسلم؟! أهذه هي ناصرتنا؟ أهذه هي حيفانا التي تركناها لكم مع رمز السر؟ إنك تحدثني، وبكل وقاحة، أن أموال الوقف في حيفا ما زالت تؤكل. صحيح أنني مخضرم وقد عاصرت هذه البلاد منذ حكم الأتراك فالإنكليز واسرائيل، وأعلم أن اموال الوقف بدأت بالتآكل منذ رمز السر، إلا أن ما جاء في رسالتك تقشعر له الأبدان.. وهل للأموات أبدان؟
قل لي بربك! ألم يتبقّ بعض من البنايات التي كنت أحدثك عنها؟ فهل السرايا ما زالت قائمة رغماً عن وجود الملاهي والمراقص للأجيال المراهقة فيها، هل مقبرة جدي حسين القط ما زالت قائمة بشقيها "الفوقا" و "التحتا"؟ حدّثني يا جدي، هل بقيت الآثار؟ هل بقي المكان؟ هل بقي الزمان؟ هل بقيت أملاكنا في شارع "سيركن" و "ستانتون" وقبالة راهبات المحبة؟ هل بقيت المسامك؟ هل بقيت دار عبد الرحمن الحاج، رئيس بلدية حيفا الأسبق، في شارع البرج 13؟.. هل وهل..؟
حفيدي العزيز! نحن عشنا النكبة، ذقناها، ذقنا مرارتها و "حلاوتها" على طراز المتشائل، ومهما يحدث من أمر فنحن ما زلنا شعباً منكوباً.
إنك تحدثني عن إسلام اوروبا وكوسوفو وألبانيا، وكأنك يا جدي! تذكرني بأيام الدولة العثمانية، بأيام "السفربرلك" (الحرب العالمية الاولى). فالعديد من أبناء عائلتي خدم في العسكرية العثمانية رغماً عن أنفه، منهم من وطئت قدماه بلاد البلقان، وآخرون منهم وطئوا بلاد اليمن وحتى المغرب العربي... فكلنا كنا عثمانيين.. ومن بعدهم "جاء الإنجليز" (الانتداب البريطاني) لتتقوى عروبتا، وبعدها "عند الاستحلال" لم نصبح اسرائيليين.
قلت يا حفيدي! إن بعض الأشخاص الآن يعيش من دون نكبة، فهل يُعقل هذا الأمر؟ العيش هكذا من دون نكبة، من دون حساب دنيا وآخرة؟ فما أنتم فاعلون؟
تستطيع هذه الدولة أن تحتفل بعيد استقلالها كما شاءت وكيفما شاءت، إلا أن احتفالها منقوص ما دامت تتنكر هي وتنفض يديها ؟ كبيلاطس البنطي ؟ من شراكتها في مأساتي ومأساة شعبي، فهي غير مستعدة لتعترف بما اقترفت يداها من جرائم في حقي وفي حق شعبي، في حيفا وغيرها، أنا لا أنكر حق أبناء عمنا، بل قل إخوتنا لأبينا، ابراهيم الخليل، في العيش بكرامة وحدود آمنة، لكن آن الأوان لأن تخاطبنا الدولة ليأخذ كل ذي حق حقه.
هم يتحدثون عن قانون الحاضر ؟ غائب، أما أنا فلم أكن غائباً عن حيفا ولو هُنيهة. كيف أغيب عنها وقد أصبحنا توأمين، أعرفها وتعرفني، أعرف فيها كل حجر دقّ من بحر العزيزية الى بحر أبي نصور، فالكروم والموارس وبوابة الدير وأرض البلان والمحطة وطريق يافا وبستان الانشراح والألمانية ووادي النسناس والصليب والحليصة، ولا أنسى حارة الكنائس، مرتع صباي، هذه الحارة، التي علمت منك انها ستصبح مجمع الحكومة، وكيف ذلك يا ولدي؟ لقد أبيدت حارة الكنائس ومنطقتها التي تعتبر بلهجتنا المحلية "البلد" شرّ إبادة، كمن يريد محو آثار الجريمة، ولكن هيهات، ما دامت أجراس كنيسة الروم الأرثوذكس تقرع، وما دامت مؤسسة "بيت النعمة" قابعة في كنيسة "السيدة" تستقبل الشباب من الطوائف والملل جميعها، كعهدها، وما دام أذان جامع الاستقلال يصم آذان من لا يريدون سماع النداء والتاريخ.
إسمع يا حفيدي! كل من يسألك عن تاريخ حيفا أرسله الى "البلد"، الى ما تبقّى من معالم، وقل له بصوت عالٍ من دون جزع أو خوف، هذه ساحة الخمرة، هذه عمارة اللاتين.. وقف الروم، بنايات آل توما، السوق الأبيض، سوق الشوام، عمارة سلام، وهنا دار سقيرق، وهنا خمارة فاطمة الزعرة.. أما هناك فنادي الأرثوذكس الذي كان زيتونة فلسطين، الشاعر ابو سلمى، عضواً فيه، وبلّغ الأمر للذين يجهلون تاريخنا المتسامح والمتآخي.
يا حفيدي! لا أريد أن أطيل الحديث، ففي جعبتي الكثير الكثير لأحدثك عنه، وسأختم رسالتي بسر آخر لا تعرفه أنت، ففي نيسان 1998، كنت قد التقيت ؟ هنا في الأعالي ؟ الخواجا شلومو، وهل تعرف مَن هو شلومو، إنه الوصي على أملاك الغائبين. التقينا كي نستمر في التفاوض معه على أملاكنا. فيا لسخرية القدر، أنت لا تعلم أنه في عام السر ورمزه سكنت في حي وادي النسناس بعدما أجبرتنا قيادة "الهاﭽاناه" على التقوقع في هذا الحي تاركين أطياننا وعقاراتنا وطفولتنا في حارة الكنائس ووادي الصليب. وكنت قد امتلكت ؟ في هذا الحي ؟ بيتا ورثته عن أحد أقربائي، إلا أن البيت اعتبر ملكا للغائب، وبالتالي كان الخواجا شلومو، ومن قبله الخواجا ريخوشوفيتش ، قيّماً ووصيّاً أميناً على هذا الملك، فباعني حصة من هذا البيت حسب قوانين لا ادري كنهها "حماية المستأجر"، وفي أوائل التسعينات وقبل تلبيتي دعوة الرفيق الأعلى، بدأت التفاوض مع الخواجا شلومو لشراء حصتي كمالك لجزء من البيت الذي ورثته، إلا أن الأقدار شاءت أن أستمر في التفاوض معه هنا في الأعالي، وما زال النقاش مستمراً. مع العلم أنه وصلت مسامعي عن طريق ما تسمونه بالـ "ﭙلفون؟ ، بوساطة الأقمار الاصطناعية، أن شركة الخواجا شلومو تقدم تخفيضاً يصل الى 40% من سعر البيت..! على كلٍ يا عزيزي! سأخبرك بالمستجدات. عندنا الجميع في خير، إلا أن تلويث البيئة لديكم وصلنا ويؤثر على صحتنا.
وفي الختام لكم أحر السلامات من أحبائكم، أبناء حيفا: المطران حجّار، عبد الرحمن الحاج، د. عثمان الخمرة، المحامي أنس الخمرة، الدكتور حمزة، إبراهيم الجارحي، أحمد كيلو، رفعت عابدي، الياس صهيون، محمد علي دلول، جميل عصفور، ميخائيل توما، سليم سبيرو، سامي طه، الحاج طاهر قرمان وحتى من سهيل بن حسن شكري.
كما يَهديكم السلام الحار كل من: المحامي حنا نقارة، د. اميل توما، اميل حبيبي، علي عاشور، علي الخمرة، عصام عباسي، صليبا خميس، آرنا مار ؟ خميس، بولس فرح، شفيق وجورج وتسيبورا طوبي، د. إدوار الياس، ديب عابدي.. ولك سلام حار من الوالد والجدة.
ودُمت لجدّك
" ق "
أين أنتَ يا رشيد الحاج إبراهيم؟
منذ بضع سنوات أخذت على عاتقي كتابة نص واحد كل سنة في ذكرى نكبة عرب حيفا، على أن يصدر قريباً من تاريخ سقوطها في 22/4/1948.
وفي هذه المرة وجب علي أن أقول الصراحة بأنه لكثرة اهتمامي بالموضوع حسبت نفسي وكأنني عشت تلك الأيام، أيام العرب، حتى العام 1948، فبدأت أؤرخ الأحداث بقبل النكبة وبعدها، فأصبحت أقول بأنني وُلدت بعد النكبة بـ 12 عاماً، ووالدتي، أمد الله في عمرها، ولدت قبل النكبة بـ 14 عاماً وهكذا دواليك. ولكثرة ما سمعت عن ذلك الحدث من كبار السن، وكذلك عن الحياة ما قبل النكبة بدأت أتجول في مكان الحدث والحياة باحثاً عن اولئك الأشخاص الذين صنعوا التاريخ، اولئك الذين عاشوا يومهم الإعتيادي وخططوا للمستقبل الذي خانهم أيما خيانة، علماً أنه لم تكن في الموضوع أية صدفة.
كنت أتجول في وادي الصليب وموقع البرج حاملاً في ذهني صوراً عن الوثائق العديدة التي وقعت بين يدي بهذه الطريقة او تلك، أحمل الخرائط الانتدابية وأسماء الشوارع والمحلات والحارات وأسماء العائلات، أحمل سجل هذا الشعب ويومياته، فأصبحت أرشيفاً متنقلاً يحمل مقولتي الزمان والمكان يتنقل بينهما بأبعاد مكانية وزمانية تمتد من الماضي الى الحاضر والمستقبل. فلا مستقبل بدون ماض، وما هو ماضينا؟ يسألني سائل هل ما نطمح ونصبو اليه هو الرجوع الى الماضي؟ فأجيب ؟ كلا، انما لن نستطيع الخروج من هذه الدوامة طالما لم ندرك نحن، ابناء الجيل الثاني بعد النكبة، أبعاد وجوهر ما حصل في حيفا وغيرها من المدن والقرى. حقاً انها نكبة شعب، انها نكبة سياسية ؟ اقتصادية اجتماعية ؟ نفسية ما زلنا نحصد آثارها وتأثيرها في شتى مجالات الحياة.
كل هذه المناجاة راودتني في أثناء تجوالي في المكان والزمان. فالمكان موقع البرج قرب دار عبد الرحمن الحاج، رئيس بلدية حيفا الأسبق (عم جدي لأبي وعم جدتي لأمي) والزمان قبل النكبة وتبدأ القصة على النحو التالي:
من المعروف أنه حسب القوانين المساعدة للسلطات المحلية يجري الإعلان عن البنايات ذات القيمة الفنية ؟ الهندسية ؟ المعمارية والتاريخية كبنايات محمية، وعلى من يمتلكها ان يرممها حسب ما كانت عليه في الأصل. وما يقوم به المهندس المعماري هو إجراء "بحث الصيانة والحماية"، فإلى جانب الوصف الدقيق لحالة البناية لما كانت عليه، يقوم المهندس بالكشف عن مالكي البناية وكتابة نبذة تاريخية قصيرة عن الملكية. وهكذا تعرفت بالصدفة على مهندس شاب (اخينا من ابينا ابراهيم الخليل) أراد أن يجري بحثاً عن بناية قائمة في شارع البرج (معاليه هشحرور) رقم 9 ب. لم يعرف المهندس التفاصيل التاريخية عن البناية، إلا أنه تمكن من الدخول بإذن "المالك" الحالي الذي ابتاع البناية من شركة عميدار وكيلة دائرة أراضي اسرائيل، "الوصية" على أملاك الغائبين. وفي البحث عن "الحقيقة" التي لا يعرفها المهندس وجد "كنزاً" من الأوراق والكتب ظانا أنها تابعة للرئيس (عبد الرحمن الحاج، هكذا كانوا يدعونه في تلك الفترة). ومن نظرة ثاقبة في الوثائق يتضح أن البناية "كانت" ملكاً لرشيد الحاج ابراهيم من كبار رجالات حيفا، وحسب قول جدي لأمي، فقد كان الحاج ابراهيم "اكبر زعيم وطني في حيفا وأعضا كبير" والمقصود بذلك عضواً، فكلمة عضو مجلس أو أي عضو في هيئة إدارية عثمانية كان يدعى في التركية منقولاً عن العربية بـ "آزا" أي عضو، وبالتالي دخلت هذه الكلمة (اعضا) في البروتوكولات الرسمية وفي اللغة الشعبية. أما رشيد الحاج ابراهيم الذي نبحث عنه وعن نكبته فهو من مواليد حيفا في العام 1888 ويعتبر من القادة السياسيين وأرباب التجارة في حيفا. اشتق طريقه كموظف في سكة الحديد الحجازية ليصبح بعد عدة سنوات مديراً للمحطة. في بداية الثلاثينيات أدار شؤون البنك العربي في حيفا، وفي نفس الوقت بدأ نشاطه السياسي ؟ الاجتماعي الوطني حيث كان عضواً في اللجنة العربية ومن نشيطيها المتشددين. وفي العام 1930 عُين رئيساً للوقف الاسلامي وفي العام 1932 كان من مؤسسي حزب "الاستقلال"، وكان رئيسا لجمعية الشبيبة الاسلامية في حيفا ومن رؤساء التنظيم السري لمجموعات الشيخ عز الدين القسام.. وفي العام 1934 أصبح عضواً في المجلس البلدي مع عبد الرحمن الحاج. وفي نيسان 1936، استقال من العضوية معه ليشكل فيما بعد رئاسة اللجنة القومية في حيفا. يعتبر رشيد الحاج ابراهيم من مؤيدي المفتي الحاج أمين الحسيني. وفي العام 1938 نفي الى جزيرة سيشل وفي العام 1940 عاد الى وطنه فلسطين وشرع في تجديد نشاطه حيث استعاد نشاطه الاقتصادي ؟ الاجتماعي والسياسي وسعى لتشكيل قيادة عربية في حيفا. وأصبح رئيساً للغرفة التجارية الحيفاوية وبادر للتحضير للمؤتمر القطري للغرفة التجارية العربية في كانون الأول 1942. ومن نشاطه في هذه الفترة تفعيل "صندوق الأمة" حيث أصبح من الفاعلين في إدارته. وفي العام 1945 قلص من نشاطه السياسي ليتفرغ للمجال الاقتصادي حيث تعامل مع التجارة والبنوك ولا سيما في مجال التبغ.
أما في سنوات 1947 ؟ 1948 فقد كان رئيس "اللجنة القومية" في حيفا الموالية للمفتي ومسؤولا عن الدفاع عن المدينة، وفي نيسان 1948 اضطر لترك المدينة كغيره من السكان ليصل الى الاردن ويصبح مديرا لفرع بنك الأمة في عمان الى أن توفي في العام 1953. ويقال أن رشيد الحاج بدأ في كتابة مذكراته خلال النصف الثاني من الاربعينيات إلا أن مصيرها غير معروف.
هذا هو رشيد الحاج ابراهيم، من رجالات حيفا، وهذا ما تبقى منه، إلا أن وثائقه المستفيضة في الحياة ستبقى نصبا تذكاريا لجيل النكبة وجيل ما بعد النكبة. فمن جولة سريعة في الوثائق نصل للاستنتاج البسيط أنه في تلك الأعوام التي قبل الـ 48 كانت حياة اقتصادية ؟ اجتماعية ؟ سياسية ؟ عارمة بعكس ما ادعى "الختيار" بن غوريون والذي دعاه جدي لأمي "بلا غليون". وفي الوثائق العديد من الكتب المدرسية باللغة التركية كالجغرافيا والرياضيات، التي كانت تدرس في تلك الفترة حتى بعد انتهاء الاستعمار التركي في العام 1918. أما المميز في هذه الوثائق فهو دفاتر الحساب التي كان يديرها الحاج ابراهيم سواءً في اللغة العثمانية او العربية، لكنه كان حريصاً ان تكتب التقارير المالية والصفقات المالية باللغة التركية. ومنها دفاتر سجلات العمال واسماؤهم واسماء قراهم ومدنهم، فنجد بيروت وصيدا وصور، وطرعان وكفر كنا والناصرة وجنين ونابلس وكذلك العديد من القرى التي لم يعد لها أي ذكر.
طبعاً هنالك العديد من الاشياء الجديرة بالتحليل والبحث الاكاديمي ؟ المتحفي، إلا وجدتني في حيرة من أمري لأن تجوالي في تلك المنطقة قد "الاص" الأمور عليّ، ولا تسألوني ما معنى "الاص" لأن عائلتي الحيفاوية الجذور هكذا قالت ؟ على وزن "هكذا قالت العرب"!
سبق وذكرت لكم أنني أعيش الحياة اليومية لعرب حيفا ما قبل النكبة، ولهذا وجدتني اخترق بنظري جدران ما تبقى من البيوت القديمة في وادي الصليب باحثاً عن وثيقة ما تثبت لنا وجودنا، حتى انني بدأت أقلد المتشائل في مشيته، حيث كان يسير ملقياً نظره الى الأرض لربما وجد شيئا نفيسا. إن ما وجدته لم يعد لي... ولكن...
نعم هذه هي بنايتك يا رشيد الحاج ابراهيم، هذا هو برجك، هذه هي وثائقك، وخط يدك الذي لم يعد ملكاً لك ولنكبتك بل أصبحت ملكاً لنا جميعا ولنكبتنا، هذه هي حياتك التي أصبحت حياتنا. فاعلم يا رشيد افندي أن جيلنا يعرف كيف يدافع عن حقوقه ويدرك من اين تؤكل الكتف.
فنم قرير العين في ارضك وسمائك لأننا سنكمل الكفاح.
جدّي العزيز قاسم بن ديب
عطفاً على رسالتك التي كنت بعثت بها إليّ من أجوائك السماويّة هناك، أنقل لك تحية حارة من حيفا الى سمائك. كيف الحال والأحوال؟ عندنا الجميع بخير، إنتظرنا فنحن اللاحقون.
وبعد،
مرّت سنتان على رسالتك، ولا استطيع أن أحدّد، الآن، الأحداث وأرويها لك، إلا أنك ستراني استعرض بعضاً من احاديثك عن ذلك الزمان وذلك المكان، فهي فعلاً خواطر زمانيّة.
جدّي العزيز! أَتذكر طيّب الذكر رشيداً الحاج ابراهيم الذي وصفته بأنه كان "أعضا كبيرا"؟ راح الأعضا وراح بيته الذي كان قائما في شارع البرج 9، حيث هدم خلال شهر آذار الغدّار ولم يرف للبلدوزر جفن، حيث لا وجع ولا تنهّد. لم يرحموا التاريخ، فكيف سيرحمهم؟
أما افراد عائلتك من جميع أطرافها، فأصبحوا مزارا للباحثين من إخوتنا لأبينا الخليل، يأتون من مختلف الجامعات لتسجيل أصواتنا و "تطقيعنا" الصور الصامتة والمتحركة منها ليوثقوا ما كان علينا، نحن ؟ أبنا الجيل الثاني بعد النكبة ؟ توثيقه. يأتوننا وفي رؤوسهم تدوي دوامة الضمير على ما اقترفه أجدادهم بحقنا في حيفا، في موقع البرج "الهدار" وحواسة وبلد الشيخ. أَتذكر ما رويته لي من أحداث آذار ونيسان من ذلك العام؟ أتذكر كيف لملمت شهادات ميلاد أبنائك وكيف طردوك من بيتك، وكيف شققت طريقك في درب الآلام؟
وكيف قلت لي إنك تحملت العثمانيين والإنجليز وستتدبر أمورك مع اسرائيل؟! هكذا تمرّ الأيام ولا نعلم كيف تدبّرت الأمر في الزمن العصيب؟!
بالله عليك، يا جدّي! أجبني عن سؤال حيّرني جداً، هل كانت هنالك مجازر أم لم تكن؟ فقد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها حول هذا السؤال. أرادوا ويريدون التشكيك في روايتك ورؤياك، ويكذبونك في نكبتك. ومن تجرأ على إثبات المجازر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في الطنطورة، ساقوه الى المحكمة، ليس ليحاكموه هو ذاته، فقط، ليكون عبرة لمن اعتبر، بل ليحاكموك أنت الذي لم تفارق حيفا، حيث ولدت في أحشائها وداخل حارة الكنائس وعدت الى ربك مَرضياً من كفر سمير.
والآن، يا جدّي! يسألنا العقلاء منهم: وهل ستنتهي مشكلتنا فيما لو أعادوا الينا عقاراتنا وأطياننا؟ ونجيبهم بالسؤال: هل هذا هو حق العودة؟ هل هذا هو الحق الإنساني الذي ترونه مناسبا لحجم نكبتنا؟ وماذا فعلتم مع جدّي ومع آباء واجداد وامهات الآخرين القابعين والباقين في حيفا، أوَلا تذكرون كيف جمعتموهم ووضعتموهم في وادي النسناس وأغلقتم عليهم بالأسلاك الشائكة؟ ألم تنهبوا بيوتهم ومتاعهم؟ لماذا لم تتحدثوا إليهم؟ لماذا لم تعقدوا اتفاقيات "اوسلو" معهم؟ لماذا لم تضعوهم على طاولة المباحثات؟ أم أن تجنيسهم بالهوية الإسرائيلية كان الحل الأمثل والإنساني لنكبتهم؟!
أأحدثك يا جدّي! عن ذلك الشخص (ما بتعرف غيره) الذي "يحملنا الجميل تلو الجميل" حيث وجب علينا أن نعتذر اليه والى الصهيونية على سقوط 6000 مقاتل يهودي إبّان أحداث الـ 48، وعليك أن تقبّل يديه غير النظيفة على القفا والوجه؛ لأنه سمح لك بأن تبقى في حيفاك؟!
أم أحدثك عن ذلك الذي يسأل العربي الحيفاوي أبّا عن جدّ: من أية قرية أنت؟ على اعتبار أن لا عربي من أصل مدني والأنكى من ذلك انك حين تؤكد لهم أنك من حيفا يعودون بالسؤال "ومن أية قرية في حيفا انتم؟"
وأخيرا، يا جدّي! أطلب منك أن تقف يوم الحساب على قدميك متيناً شامخاًً أمام الملاكين الرحومين اللذين سيسألانك: ما اسمك وما دينك؟ فقل لهما بلا جزع أو خوف: حيفا مدينتي، وحاراتها مرتعي، جوامعها أذاني، كنائسها أجراسي، أناسها أخوتي، كرملها جبلي. وإنّني ولدت وعشت ومت على أنني "باق في حيفا".
وإلى اللقاء في نيسان القادم
حفيدك - (حيفا)
من نكبة إلى نكبة. من حيفا إلى رام الله
حفيدي العزيز!
عطفاً على رسالتك التي ارسلتها إليّ، سأحاول أن أردّ عليك ولو باقتضاب شديد؛ لأن ظروفنا السماويه لا تسمح لنا بالإطناب، وعلى الرغم من ذلك فأنا ملزم أن أقول لك:
ما أشبه هذا اليوم بتلك الأيام. ما يحدث اليوم كنا نتوقعه، علماً أننا لم نؤمن بأن ضحايا النازية سيرتكبون بحقنا تلك المجازر، ويمارسون ضدنا ما مورس على جلود وجثث آبائهم وأجدادهم في اوروبا المتحضرّة. كما لم نؤمن بأن "الحكام العرب"، ملوكاً وأمراء ورؤساء، سيعيدون الكرّة مرة اخرى ليؤكدوا لنا وللعالم خيانتهم وبؤس رجولتهم ومدى خَنَثهم.
لقد ودّعت حيفا أيام مؤتمر مدريد واستبثرت خيرأ، وزادني استبشاراً زيارة ابن البلد الأصيل، القائد الشيوعي توفيق طوبي ـ أمد اللّة في عمره ـ لتقديم التعازي لكم في بيتي آنذاك. وقد علمت انكم قمتم بزيارته في بيته، مما ترك فيكم عميق الأثر لما تداولتموه من أمور سياسية واجتماعية وتاريخية، ومن أهمها موضوعي أنا ؟ حيفا. فقد سبق وقلت لك إنني انا وحيفا توأمان. ارجو أن تكرروا هذه الزيارات لأبناء بلدنا وأن تتكاتفوا وتتكافلوا مع أبناء حيفا جميعهم. وعلى فكرة، متى ستقيمون جمعية عثمانية لأبناء حيفا؟ لكني أعيد وأكرر، انه إذا كان هنالك تاريخ لحيفا او ذاكرة لها فهما نحن ؟ أبناء ذلك الجيل.
إسمع يا حفيدي! انا على علم وإدراك أنه في مثل هذا الزمن العصيب لا وقت للرسائل، لا وقت للحديث ولا لإرسال التحيات، وكذلك ليس هو بالوقت المناسب للتحليل العلمي على الرغم من أمّيتي، وما دمت أميّا دعني أحلل لك ؟ مع احترامي لدراستك الأكاديمية ودرجتك العلمية في الاقتصاد السياسي ؟ أسباب ما يدور في بلادنا من أحداث دامية ومجازر شارونية. فهل تعلم أنه لا اقتصاد من دون سياسة وبالعكس؟ بالطبع تعلم، لكنك لم تدخل في عمق الأمور. فاعلم يا ولدي، أن اي نزاع يتأجج في الشرق الأوسط هو نتيجة لثلاثة أمور: اسعار النفط، بيع الأسلحة، وتنظيم حركة رأس المال. فقد ارتفعت مرة أسعار النفط من الدول المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط، وعلى رأسها ايران، بعشرات النسب المئوية، الأمر الذي أغضب الإدارة الأمريكية التي يقودها ؟ بالفعل ؟ ممثلو أكبر الاحتكارات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى، الملتفون حول بوش (من الجد الى الأب والى الحفيد) وهكذا، فكلما طرأت أية زيادة او اي احتمال لإرتفاع أسعار النفط العربي تزداد التوترات والانفعالات في الشرق الاوسط بإيعاز من الإنجليز (عفواً أقصد الأمريكان).
أما بخصوص الأسلحة والتسلّح والعسكرة، فعلى ما يبدو المسألة واضحة وضوح الشمس، إلا أنك لا تدري بما صرحه لي هنا في الأعالي السيد ريتشارد نيكسون، حيث قال لي ما معناه الويل ثم الويل للإدارة الأمريكية إذا اهملت مسألة إثارة النزاعات الإقليمية في العالم وإدارة الأزمات، لأنه في حالة الهدوء والركود النسبي لن يتم بيع الأسلحة، وسيكون وبالاً علينا إذا لم نبع الأسلحة الحديثة غير المجرّبة، وإذا ما اختزنت فستبلى. وبالتالي، لن نستطيع بيعها، وبالتالي فإسرائيل هي الأداة التي تجرب هذا السلاح على الشعوب العربية عموماً وعلى الفلسطينيين واللبنانيين خصوصاً، وعندها، فقط، نستطيع نحن والحركة الصهيونية في امريكا بيع هذا السلاح.
أما في ما يخصّ حركة رأس المال فأقول لك يا أيها الماركسي أنه طالما لم تنظم حركة رأس المال ؟ بغضّّ النظر عن شكل الانتقال، بمعنى الانتقال من بلد الى بلد أو من فرع الى فرع في الاقتصاد ؟ فاللجوء الى الوسائل الفاشية وارد في الحسبان، وهذا ما حصل في حركة التاريخ..
هل توافقني الرأي أيها الحفيد؟ قد تقول نعم وقد تقول لا.. لا يهمني.
كل ما يهمني هو كيف ستعمل انت ورفاقك لتخفيف العبء عن هذا الشعب. وأسألك بصراحة، كيف ستخرجني من نكبتي؟ قد أستبق الجواب لأقول لك إنه مهما فعلت ومهما قمت به من نشاطات فلن تستطيع إرجاع ما سُلب مني.. حقي في وطني، أرضي، مدينتي حيفا وأحيائها من وادي النسناس الى وادي الصليب ووادي الجمال ووادي روشميا؛ والحليصة وأرض البلان والزوارة والكروم والمرج والزيتون والحلقة والوردية وشاطئ الرمل و (أبو نصور) والعزيزية؛ وشوارع العراق والناصرة والجبل والراهبات والمخلّص وصلاح الدين واحمد شوقي والمامون والأخطل والفرزدق والصنوبر والأفغاني والملوك والبوتاجي، وغيرها مما استُبدلت اسماؤه.
لا اريد أن أقلل من أهميتكم، انتم ؟ الشباب ؟ في عملية ومهمة إرجاع حقوقي المسلوبة، لكني أود أن اؤكد لكم أن ما ارتكب بحقي وحق شعبي لا تستطيع عدسات الـ "سي.إن.إن" و "الجزيرة" وصفه. فما رأته عيناي في أثناء تهجير عرب حيفا في ذلك اليوم عجز عارف العارف عن وصفه.
يطلبون مني هنا في الأعالي أن أكف عن البكاء على الأطلال، والتوقف عن استرجاع التاريخ. كيف سأفعل ذلك ما دام اليهود قد استحضروا التاريخ من قبل 2000 عام وأعادوه، وأنا لا أستطيع أن أستعيده من 54 عاماً.
ودمت لجدّك
قاسم بن ديب عابدي
أين أنت يا دكتور عثمان حسن الصغير؟!
ويُسأل السؤال، لماذا نستلهم وحي النكبة؟ هل النكبة وحدها لا تكفي فنرفقها ونزيد عليها هذا الوحي؟ ثم أي وحي سيكون هذا، أهو وحي من غار حراء، أم من جانب الطور الأيمن، أم من بشارة الناصرة، أم من أجدادي الحيفاويين (الحيافنة)، أم هو آتٍ من غيلان وشياطين الشعراء في الجاهلية، ليمتد الى بلادنا فلسطين مع مسيرة الفاروق عمر بن الخطاب مع ناقته ليستقبله مطران الديار المقدّسة، أم هو وحيٌ آتٍ من بلاد الفرنجة والكلت والإنـﭽليز والقوط والآريين ممزوجاً بأرواح اخوتنا الساميين من تلك البلاد، أم، أم، وأم..؟
فهي نكبة، وهو وحي. وحي يذكّرنا جيداً بأننا ما زلنا نعيش النكبة، لكن بأشكال متطورة ومختلفة عمّا كانت عليه. لا تأريخ لهذه المدينة بعربها ويهودها يمكن بدؤه من دون النكبة، فهي نقطة الارتكاز لما قبلها ولما بعدها. وما جاء من بعدها من "نِعَم" وتحوّلات وتطورات لا يمكن أن يُنسينا ؟ ولو لحظة ؟ ما كان قبلها فالنكبة لا يمكن الحكم عليها فيما إذا قدّت من قبلٍ أو من دُبُر، فليس هذا هو الجوهر. كل ما أريد الإفضاء به ؟ أمام القارئ الكريم ؟ هو الإشارة والتذكير، وليس البكاء على الأطلال، علماً أن البكاء يحوي ؟ في طيّاته ؟ الألم والذكرى والذاكرة والتذكّر والأمل، أيضاً. فذكّر إن نفعت الذكرى.
لا اقصد بكتاباتي عن النكبة ووحيها استحضار الأرواح، لأستعطف وأستجدي أحاسيس قدامى الحيفاويين ممن كانوا قبل النكبة، من خلالها، ومن بعدها.
هاكم هذه القصة التي تدور أحداثها في فلك "ما قبل، في أثناء، وما بعد النكبة".
الدكتور عثمان حسن الصغير، ألا وهو الدكتور عثمان الخمرة (عم جدتي لأبي) كان من أوائل الأطباء العرب في المدينة، لا بل في فلسطين كلها.
تخرّج من جامعات جنيف وﭙاريس في تلك الفترة. الى جانب انتمائه الى عائلة حيفاوية عريقة، دُعيت ساحة المدينة الرئيسة على اسمها، فقد كان عضواً في المجلس البلدي من العام 1927 حتى العام 1934، أي خلال فترة المدعو "حسن بك شكري"، وفي العام 1934 لم يقدم ترشحه للانتخابات البلدية، بعدما تأكد من نوايا الاستعمار البريطاني وانتدابه المزعوم، تعيين رؤساء بلدية موالين لهم وللصهيونية. وقد انضم اليه ؟ في خطوته هذه ؟ كل من نصر الله خوري، الياس منصور، اسكندر برغش، عزيز ميقاتي، وجميل أبيض.
هذا الطبيب ورجل المجتمع آنذاك، قد أرخص عمره في سبيل المدينة والوطن. وحتى الآن، ما زال بعض السكان من قدامى الحيفاويين يذكرون له جميله في الطب والسياسة. قبل "الاستحلال" ؟ كما كان يقول جدي، توأم حيفا:- "كان الدكتور عثمان (وكانت تخرج من فمه لفظة الدكتور باستبدال خفيف للدال بالتاء، فكانت قريبة من التكتور مع مدّ الواو) ضليعاً في مهنته، انسانياً في تعامله، فكانت تكفيه نظرة عامة فاحصة على المريض مع التدقيق في وجهه وحلقه وأذنيه والضرب بعض الضربات على بطنه، لكي يصف حالته وليعطيه وصفة دواء ليقتنيها من الفرمشيّة (الصيدلية) من ساحة الخمرة، حيث كانت عيادته وصيدليته التي أدارها فتحي جرداني".
ويذكر من تلك الفترة (ما قبل النكبة) أنه جاءه مريض يهودي من أصل عربي (يهودي ابن عرب ؟ شفاعمري) في صيف العام 1931، حيث كانت الحرارة مرتفعة جداً على غير عادتها، يشتكي الإسهال الذي يعانيه، وخجلاً منه، من أن يذكر للطبيب كلمة إسهال، قال له إن "الإمّاي في المجاري فاضت"، (اتّبع ان يقال إن الإمّاي هي القناة الرئيسة للمجاري، ولن أتدخل في سبب التشبيه). وللدعابة حاول الدكتور عثمان، عضو المجلس البلدي، الإتصال بالجهات المختصة في البلدية لينقل لهم هذه المشكلة، إلا أن المريض حاول عبثاً أن يقول له إن "الإمّاي" هي في بطنه.
أما في أثناء النكبة، فقد انتكب الدكتور عثمان كغيره من أبناء حيفا، وأصبح لاجئاً في مخيم جنين (يا للمفارقة.. نعم مخيم جنين). نعم أصبح لاجئاً مع رقم مسجّل في "الأونروا" (وكالة الغوث) بدلاً من رقمه كطبيب.. فلم يطق، بل قل لم يُسلّم بالأمر الواقع، فعمل المستحيل ليعود الى وطنه ومدينته. عاد "متسللاً".. (مُستنناً) (في اللغة العبرية) عبر درب الآلام، كغيره من أبناء شعبه، ليطرق باب صديقه اليهودي من تلك العهود، ألا وهو دافيد هاكوهين. ودافيد هذا هو ابن لعائلة يهودية هاجرت في بداية القرن العشرين من روسيا الى فلسطين ومن القدس الى حيفا. وقد خدم دافيد في الجيش التركي ومن بعدها نهل العلم في بريطانيا، وكان نشيطاً في الحركة الصهيونية، وفي العام 1927 انتخب ؟ مع الدكتور عثمان الخمرة ؟ لعضوية المجلس البلدي في حيفا، وقد نمت علاقة صداقة بين الإثنين ارتكزت على المصالح المشتركة لعمران المدينة وازدهارها.
في العام 1950 خرج عثمان من مخيم جنين بعدما دبّر أمور أولاده وزوجته (من عائلة حبيشي العكاوية). وبعد ولادة ابنه بدر الخمرة (طبيب في العلاج الرياضي، يعمل في رام الله، حالياً)، خرج من المخيم ليصل الى حيفاه. وما كان على دافيد هاكوهين إلا أن يذكر اللقاء التراجيدي المثير من ناحية، والمنفر من ناحية أخرى، في كتابه "حان الوقت للحديث"، ففي صفحة 303 كتب يقول: "على ما أذكر، فإنه في ساعة متأخرة من الليل طُرق باب بيتي الكائن على جبل الكرمل. إنتصب أمامي رجل نحيل مرهق، غير حليق اللحية، يرتدي بدلة بالية ويعتمر قبعة، إنه الدكتور عثمان الخمرة، صديقي الأسبق في مجلس بلدية حيفا. إنفجر بالبكاء لحظة عناقنا وكاد يجثو (على ركبتيه)؛ فقد عبر الحدود من جنين الى جبال "الـﭽلبوع" وهبط الى الشارع الرئيس في مرج ابن عامر في الظلام، انتظر الحافلة ووصل الى حيفا، الى بيتي. إستعطفني كي أساعده على البقاء في البلاد، فقد تعب من وجوده في مخيم اللاجئين في جنين؛ لأنه كان طريداً، مهيض الجناح، لا يمارس مهنته، كما أنه كان ملاحقاً من قبل المتزمتين. وقد كان مستعداً لأن يتنازل عن كل شيء، عن أملاكه في المدينة وعن مجد عائلته، من أجل أن يسمحوا له بالبقاء معنا. جهّزت له الحمام ليغتسل، وقدمت له الطعام وواسيته لمأساته وفرشت له فراشاً مرفهاً. وفي الغد سافرنا معاً الى الناصرة قاصدين صديقي عضو الكنيست، سيف الدين الزعبي ، حيث طلبت منه أن يساعده. لم يخطر ببالي أن أسلمه للشرطة كمتسلل عبر الحدود من أرض العدو، حتى إنني لم أقدّم تقريراً بذلك".
لا يسعني هنا ؟ كإنسان نزل عليه وحي النكبة ؟ إلا أن أشكر لدافيد أفندي (حسب سجلات البلدية) مواقفه الإنسانية والمؤثرة جداً، والتي إن دلت على شيء، فهي تدل على عمق العلاقات الإنسانية التي سادت في المدينة، بغضّ النظر عن الانتماءات القومية والطائفية، وليشهد على ذلك شبتاي ليفي أفندي، أيضاً، حين قدم كلمة تعزية قبل ظهر يوم الأربعاء، الواقع في 6 شباط سنة 1946، في الجلسة الثالثة والستين للمجلس البلدي، والتي تغيّب عنها "العضو الخواجة دافيد هاكوهين" (هكذا)، حيث قدم كلمة لوفاة المغفور له عبد الرحمن الحاج (رئيس بلدية حيفا الأسبق 1920 ؟ 1927) جاء فيها: "ومن المعلوم أن المغفور له قام بمهمة رئاسة البلدية خلال سبع سنوات متوالية، وبعدها انتخب عضواً في المجلس البلدي، وكان عملنا معه ؟ خلال هذه السنوات الطويلة ؟ بكل تفاهم وتعاون؛ لأننا كنا نفكر دائماً في مصلحة المدينة وعمرانها بغض النظر عن الاعتبارات الجنسية أو الطائفية، ونرجو أن تدوم هذه الروح بين جدران هذه المؤسسة لخير مدينتنا وازدهارها..".
فعلاً، فعندما نبحث عن أسباب ما يسمى بالتعايش الحالي لربما نجد له مستنداً وثائقياً وشفهياً من المعاصرين، وبالتالي نستطيع القول إنه كان لهذه المدينة تاريخ مشترك.
إلا أنك يا دافيد تراني مجبراً على مراسلتك في السماء في إطار رسائلي السماوية الى جدي. وأعدك برسالة خاصة لأعبّر لك عن عميق شكري وامتناني لمشاعرك ولمساعدتك للدكتور عثمان الخمرة، الذي سرعان ما طردته السلطات مع أخيه المحامي أنس الخمرة، الذي دعي الى الرفيق الأعلى في العام 1996، وهو في حصرته كلاجئ في عمان.
وفي رسالتي القادمة لك ؟ إن شاء الله ؟ سأقول لك إن مذكراتك وذكرياتك من تلك الليلة وتعابيرك، تحمل ؟ في طيّاتها ؟ ليس علاقة الصداقة القديمة، فقط، بل علاقة السيد بالعبد، علاقة المنتصر والمنتشي بالنصر على المهزوم والمنكوب. أهكذا يستقبل "البطل" أعداءه ؟ أصدقاءه المهزومين؟ هل بالتشفي والشماتة؟!
وفي العام 1967 تمتزج النكبة بالنكسة لتصبح "نَكبَسَة"، ننكبس بها ونغوص في مفارقاتها. ففي العام 1981 قمت بزيارة عائلة "مُنكَبسَة" في أحد المخيمات، كانت انتكبت في العام 1948 ولجأت الى المخيم وانتكست في العام 1967، وبقيت في المخيم. لم أعرف العائلة، إنما كنت رسولاً لإبنها الذي درس معي في الخارج. بدأ أب العائلة باستدراجي ليعرف أصلي وفصلي. وكان حين ذاك قانون الإرهاب في أولى خطواته. وحرصاً منا على سلامتنا من السين والجيم وطائلة العقوبات، اتفقنا على أن لا نكاشف بأسمائنا. إلا أنني لم أصمد أمام فِراسة الأب؛ حيث عرف من لهجتي أنني من الشمال، وكلما نطقت أكثر زادت معارفه "فوقعت" في كلمة "عاهة ومندبة" (وتقال للشخص الذي لا ينفذ الأمور بالشكل المطلوب). عندها أصرّ على أنني من حيفا. ثم تفرّس في سمرة بشرتي ليطرح السؤال المباشر: هل أنت من آل الخمرة؟ فلم أصمد أمامه، فقلت: نعم. فكان العناق والبكاء ليقول لي إن الدكتور عثمان الخمرة عالجه في حينه، أما أخوه المحامي، أنس الخمرة، فدافع عنه في إحدى القضايا في محاكم الانتداب. ومن ثم اختتم الأب حديثه بالقول "أنا من نكبة الى نكسة، فهل من منقذ؟!"
والآن ليفهم سائلي ما سرّ هذا الوحي الذي أحاول جاهداً أن أفكّ رموزه! إنها نكبة وهو وحي.
عالنَّاصْري...
هكذا كانت تخرج تلك الكلمات من فم ذلك الرجل الذي كان يقف عند ساحة الخمرة (الحناطير) في الطرف الأيمن شرقاً عند زاوية شارع الخطيب ومطعم (العبد) على حدود حارة الكنائس، مرتع ذلك الجيل ؟ جيل إبراهيم عاقلة وديب عابدي وفريد فرح وغيرهم من الأولاد. نعم إنه ذاك الرجل بالقبعة الفرَنجيّة الرماديّة اللون، أو قل ليس لها أي لون لكثرة استعمالها. حيث كان شغله الشاغل حثّ المارة على السفر "عَ الناصري" بسيّارات الأجرة على نوعيها من "الشقر" و "الدوزوتو". كان صوته ثخيناً كصوت "الجاروشة"، تخرج الأحرف ليس من فمه، بل من حلقه مباشرة فتبرز شرايين رقبته منتفخة الى حدّ الإنفجار، وإن خرجت من فمه فإنك تبصر أسناناً لم يُترك لها لون للبياض.
نعم إنه ذلك الرجل الذي لا أعرف اسمه ولا كنيته، لكنني أعرف أنه كان يقف على مفترق هام جداً في حياة المدينة في ذلك الزمان وفي ذلك المكان ؟ "البلد"، إذ ليس بالصدفة، أن دعونا ذلك المكان بالـ "البلد" قبل وبعد نكبة البلاد كلها. ويُستخدم هذا المصطلح للدلالة على الرقعة الزمكانية (زمان ؟ مكان) الممتدة من البوابة الشرقية (عمود فيصل والمنطقة) وحتى البوابة الغربية (ساحة الخمرة) فطريق يافا. عرب حيفا ما زالوا ينطقون ويستخدمون "البلد" على نقيض من يستخدمون "البلدة السفلى او التحتا". فالبلد ؟ بالنسبة إلينا ؟ شيء عظيم، أما الآن، فقد أصبح أشبه بمدينة أشباح، عمارات شاهقة ومكاتب وأسماء مختلفة.. "بال يام"، "ناتانزون"، "كريات هممشلاه"، عوضاً عن شارع أمية وساحة الجرينة وحارة الكنائس و.. و.. و.. وفي البلد، نحن ؟ أبناء الجيل الثاني للنكبة ؟ اشترينا معظم ثيابنا للمدرسة وأيام العيد من عند التاجر أبي داوود (يهودي ابن عرب) بالتقسيط، الممل والمريح (من دون شيكات ومن دون فيزا) على البساطة والأمانة، فقط، التي عُرفت قبل الـ 48.. هيهات!! فالبلد بالنسبة إلينا ؟ ليس المدينة السفلى أو التحتا كما هو مكتوب على اللافتات، بل قطعة تاريخية اقتطعت من جسدنا بعدما تمّ محو المعالم حسب خطة "شيكمونا" خلال ايار ؟ آب 1948، حيث أتت الخطة على مساحة 250 دونماً كان بن غوريون طلب من رئيس البلدية ؟ في حينه، شبتاي ليفي ؟ تنفيذ أمر الهدم، إلا أن الأخير ادعى أن الأمر منوط بقرار عسكري وليس بقرار بلدي، وبالتالي فعلى الحكومة فعل ذلك. وفعلاً قام الجيش بتنفيذ الهدم. وفي هذا "البلد" وجدت المؤسسات المركزية والرئيسة للمجتمع العربي أساساً، منها الجوامع وأملاك الوقف والكنائس والمقابر والمدارس والأسواق والمقاهي والمحال التجارية، وإن نسينا فلن ننسى حانوت نعيم العسل في ساحة الجرينة، حيث كانت تحوي كل ما تبتغيه من بقالة وملبس وحاجيات بيتية.
إذاً، ما علاقة "عَ الناصري" بالبلد ؟ المدينة؟! إنها علاقة تاريخية تمتد من النكبة الى يومنا هذا، أولَم أقل لكم إن النكبة هي نقطة الإرتكاز؟ وفي هذا السياق، قد سبقني المحامي أيمن عودة، عضو المجلس البلدي، عن الجبهة، في مقالته "المدينة" في العدد السابق من صحيفة "حيفانا"؛ ليتحدث عمّا يسميه بالمدينية، استمراراً لما طرحه، سابقاً، حول انقطاع التطور المديني العربي للمدن العربية الفلسطينية قبل النكبة، وخصوصاً، مدينتي حيفا ويافا، وليخصّ بالذكر "العاصمة" و "المدينة" قاصداً بذلك الناصرة، العاصمة وحيفا، المدينة. وللتنويه، فقد سبق وطرحت هذا الموضوع، ولكن بالمنحى الفلسفي ؟ السياسي لعلاقة "عَ الناصري" بحيفا، وما سأطرحه الآن قد لا يمت بصلة مباشرة الى النكبة إلا أنه من وحيها. فالمدن الفلسطينية كانت ستتطور من دون نكبة، أو من دون دولة إسرائيل أسوة بباقي المدن في العالم. وكان للتجمع العربي الفلسطيني المدني في حيفا مواصلة دربه ليصل درجة الإرتقاء كباقي مدن الميناء في حوض البحر الأبيض المتوسط.
اليوم، نحن نشهد حركة اجتماعية ؟ اقتصادية ؟ سياسية نشطة في المجتمع العربي الحيفاوي، وهذا ما يثلج الصدور. فأنا ؟ كابن لهذه المدينة أباً عن جد- يسرّني أن تعاد اليها هذه الحركة. لكن من الملاحظ أن وتيرة التركز والتمركز فيها من قبل الجماهير العربية من خارج حيفا، هي في تسارع غير عاديّ.
وأقصد بذلك انتقال أو وجود معظم مقرات ومراكز الحركات السياسية والجمعية والثقافية فيها. وهذا الأمر، أيضاً، يثلج صدري ويجعلني أستعيد مجد الحركة النهضوية لمدينة حيفا من الصحافة والأدب والشعر ودور العرض (السينما) واللهو ومظاهر الحياة المدينية بكل معانيها وأشكال ظهورها. إذاً، ما الضرر في ذلك؟
جُلّ ما أخشاه أن كل ذلك يتم على حساب "عَ الناصري"، على حساب "قَرْيَنة" (من كلمة قرية) مدينة الناصرة وإفراغها من مضمونها كعاصمة الجماهير العربية الفلسطينية في اسرائيل، بإدعاء أنه ما زال يخيّم على مدينة الناصرة الفكر القروي الأبوي (البطرياركي) على شاكلة "نمط الإنتاج الآسيوي"، الأمر الذي يدعو الحركات الى الخروج منها، لربما!! لكن بالإضافة الى ذلك، فالمؤسسة الحاكمة ترحب بهذه العملية، تارة بالصمت وتارة بالتشجيع المعلن والمخفي منه. ويُسأل السؤال: هل من مصلحة الحكومة إفراغ مدينة الناصرة من جوهرها القومي والسياسي والإجتماعي والثقافي، حتى لا تسمع بعد الأصوات "المتطرفة" في واحة "القومية العربية" و "البنلادنية"؟! هل تقتضي مصلحتها إنتاج وإضافة آلاف عدّة من العرب للسكن في مدينة حيفا، الذين سيذوبون داخل 250 ألف يهودي من سكان المدينة، وبالتالي يتم تمريرهم من خلال مصفاة "الاسرائيلية" وتدجينهم بها؟! هل المقصود بالإفراغ النصراوي والإغداق الحيفاوي "بيتتة" (من بيت) العرب القادمين الى حيفا ومؤسساتهم والتقليل من "التطرف"، وبالتالي جعلهم مختلفين عن باقي شعبهم؟! لربما أنا على خطأ وأتمنى أن أكون كذلك.
فعلى الرغم من هذه التساؤلات، دعونا نطرح الحقائق ميدانياً، فما سينتج عندما نقارن مظاهرة ؟ على سبيل المثال لا الحصر ؟ تنطلق في الناصرة من "الكراجات" الى العين وتحمل الشعارات التي نعرفها ونرددها عن ظهر قلب، بمظاهرة تحمل الأهداف نفسها في حيفا، هل في اعتقادكم ستكون الشعارات مماثلة من حيث الشكل والتأكيدات، مع أن الجوهر واحد؟! فما نقوله في الناصرة ليس له أن يكون ؟ بالضرورة ؟ ما نقوله نفسه في حيفا ولو على سبيل التكتيك. وهاكم مثالاً حياً: الآن يقدمون لائحة اتهام ضد المحامي أيمن عودة لرفعه شعاراً خلال تظاهرة (رفع شعارات) وليس مظاهرة، يقول فيها "يا شارون يا قاتل.. الانتفاضة ستنتصر"، فهل كانت ستقدم بحقه لائحة اتهام لو رفع هذا الشعار في الناصرة؟!
ومما يزيد من التساؤل أنه حتى في داخل مدينة حيفا، ما نرفعه من شعارات في الكرمل يختلف (ليس جوهرياً) عما نرفعه داخل وادي النسناس، فكم بالحريّ ما رُفع من شعارات في "البلد" في ذلك الزمان وفي ذلك المكان؟! إننا على يقين من أن السلطة على دراية تامة بهذا الفصل وليس القول، وبالتالي ستكون مسرورة جداً باستيعاب الموضوع وتلك الحركات وتشجيعها معنوياً وربما مادياً من أجل حصر هذا "التطرف" الحاصل وسط "عرب اسرائيل" حسب تقرير "الموساد". وفي ما يخص الشعارات بين الناصرة وحيفا والكرمل ووادينا النسناسيّ، فنقول: نعم إنه من المعقول، لا بل من المطلوب، التأقلم مع البيئة السياسية والإجتماعية والضرب على الوتر الحساس واجتذاب النفوس، لكن ليس من المعقول إفراغ ناصرة البشارة من مضمونها وهدفها باسم هذا التكتيك أو حتى بادعاء أن المدينة قد أنهت دورها المديني ولنترك المكان فارغاً أمام "القروية". فإذا كانت النكبة في حيفا قطعت التواصل والإمتداد والتطور الطبيعي لمجتمعها العربي لأسباب نعلمها، فكيف لنا أن نقطع هذا التطور لمدينة الناصرة ومن دون نكبة تذكر. ففي نهاية المطاف نحن نصبو الى تطوير المدن والقرى العربية الفلسطينية في البلاد جميعها ؟ سواء أكانت الناصرة أم حيفا، فبغض النظر عن خصوصيات كل بلد وبلد، نأمل لحيفا تطوراً مزدهراً لعربها ويهودها وللناصرة ألف سلام.
وإن سألتني ؟ يا عزيزي القارئ، مرة أخرى ؟ ما علاقة "عَ الناصري" بحيفا ؟ البلد ؟ فسأقول لك إن ذلك الرجل ذا القبعة التي لا لون لها، وقف في مكان مفصليّ جداً، وهو في البلد، في ساحة الخمرة، في حارة الكنائس، وهو في الناصرة، رحمك الله يا رجل ورحم أجدادنا ومهما يكن من أمر فكلنا الى "عَ الناصري..".
فاطمة الزّعرة
نعم.. هي فاطمة الزّعرة، هذا هو اسمها وهذه هي كُنيتها. فرحلتنا اليوم، هي بإس (مبتدأ كل شيء) فاطمة المذكورة أعلاه. (وهنا لا يسعني إلا أن أستميح الفاطمات عذراً على هذه التسمية، لكنه، فعلاً، اسمها المَكنيّ) لن تتخطى "حدود البلد" ؟ رقعتنا الزمكانية ؟ وسنتمحور في الحياة الترفيهية وعوامل الحياة المدينية ومقوّماتها، لمدينة بحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط، هذا الحوض الذي يجمع مدن الشاطئ بروابط مشتركة بغضّ النظر عن الانتماء القومي، الحدود الجغرافية، العادات، وتقاليد كل شعب من الشعوب.
فالمدن التي يذكرها الكاتب العربي الكبير حنا مينا، في روايته الفذّة، "قصة بحّار"، وغيرها، هي المدن نفسها التي نتحدث عنها ومنها حيفا، طرابلس، اللاذقيّة، بيروت، أثينا، والإسكندرية.. ففي تلك الرقعة النكبويّة سكنت فاطمة، وللتدقيق أكثر، وحسب المسح الميداني الذي أجراه موظف البلدية في حينه، السيد جورج حزبون، حسب طلب بلدية حيفا الانتدابية عام 1945، فقد كانت مستأجرة في بلوك 10839/ قسيمة 98، ولم يكن في الإمكان التوصّل الى مثل هذه الدقة لوصف مكان سكناها من دون هذا المسح الميداني الذي أصرّت سلطات الانتداب البريطاني على تنفيذه تمشياً مع سياستها القاضية بشقّ الطريق واجتياز البلد تسهيلاً للحافلات العسكرية. كان هدفهم فحص إمكانيات الهدم بالتعاون المدروس مع المؤسسات الصهيونية لرسم مستقبل المدينة والبلد، فبفضل هذا المسح ذي الهدف المشتبه، استطعنا أن نعرف كيف، أين، ومتى سكن أجدادنا. الوثائق تشير الى العنوان (البلوك والقسيمة)، نوعية الحجارة، مساحة البيت، اسم المالك وورثته، المستأجرين، الجيل، العمل، القومية والدين. ومن اللافت للنظر أن اليهودي الذي سكن تلك المنطقة وُصف في الاستمارة تحت خانة الدين وليس القومية.
أما فاطمة ذاتها، فهي من أصل يافاويّ، أو ؟ كما اعتدنا أن نقول ؟ من يافة القدس. جاءت الى حيفا طلباً للرزق كغيرها ممن جار عليهم الزمن والزمان، لتصبح ؟ فيما بعد ؟ من كبيرات البطرونات في البلد. والبطرون لفظة لاتينية تعني حرفياً "المدافع" او "الحامي". قد اشتقت الكلمة، تاريخياً، من الحياة في روما. فكان البطرون عبارة عن مواطن حرّ ومتنفذ ومتساوي الحقوق يحمي مواطنين أحراراً أو مُعدمين. ثم تحوّل المصطلح الى مفهوم سياسي ؟ اجتماعي ؟ اقتصادي للدلالة على نوع من تنظيم، وصاية وحماية المتنفذين لمواطني (زبائن) روما وغيرها.
فاطمة ؟ بوصفها رمزاً من رموز حياة الترفيه في البلد، وكبديل للحياة البوهيمية، (البوهيمي: لفظة فرنسية تدل على الشخص الذي يخوض حياته من دون حسيب ورقيب ويترك نفسه عرضة للرياح) التي تميّزت في الثلاثينيات من القرن الماضي في حيفا كمدينة ميناء، وخصوصاً في الأحياء اليهودية، خدمة للضباط والجنود البريطانيين والبحّارة ؟ استطاعت أن تقدم خدماتها من خلال "العوالم" في قهوة (مقهى) "السنترال" في البلد. لربما كلمة "عوالم" مشتقة من اللفظة الساميّة (العبرية) ("עלמה" عَلْمه أي فتاة وעלם- عِلِمْ - غلام) لتنافس ما تقدمه الغانيات اليهوديات والأجنبيات في المقهى الواقع في مفترق شارع المفخرة (هرتسليا) وأنا فورتا (هنفيئيم) للزبائن الكرام.
فاطمة ؟ على الرغم من أفعالها كلها وأفضالها على من يذكرونها من أجيال النكبة، من أبناء حيفا وخارجها ؟ هي قصيرة القامة تتوسطها كرش، متوسطة الحجم، تخرج من أكمام قميصها المزركش زنود كزنود هرقل الجبّار لتتواصل مع أيد ممسوحة خالية من كل شعرة، تنتهي بحلى ذهبية من "الحيايا"، "السحّابات" و "المباريم" وصولاً الى الخواتم المرصّعة بفصوص ماسيّة وغير المرصّعة منها. أما خدّاها فتخالهما كيسين أحمرين لكثرة المساحيق، تتوسطهما دائرتان مرسومتان بشكل دقيق يعجز عنه المهندسون في الرسم والدقة. أما فمها ؟ فحدّث ولا حرج ؟ فلها فمان: الواحد طبيعي والآخر مرسوم؛ ففي تلك الفترة كانت تميل الشفاه المرسومة الى الحمرة القانية وفاطمتنا كانت تتفنن في ذلك. أما شعر رأسها فكانت تصبغه باللون الفاتح المائل الى "الشقار"، مرفقة به حلقاً من اللون نفسه، يتدلّى من أذنيها غير البارزتين.
وفاطمة ؟ بكونها بطرونة ؟ ذات تجربة في مثل هذه الأمور، كانت تجلب البنات الحسناوات من بيروت بإدعاء أنها تملك مشغلاً للخياطة. وشاءت الأقدار أن يدخل الى مقهاها غير المعلن ("كرخانة") الواقع قرب شارع البور (الميناء) شخص من بقايا النكبة ليلبّي رغباته، ليتفاجأ بوجود فتاة تستعطفه وتحدثه عن سبب وجودها في مثل هذا المكان، وتقصّ عليه قصتها المثيرة ومسيرتها من لبنان الى فلسطين طلباً للعمل في مشغل خياطة فاطمة الزعرة. فما كان من الرجل إلا أن يصدقها ويتعاطف معها، ومن ثم يكتب كتابه عليها. وما كان من المحكمة الانتدابية إلا أن تحكم بالعدل، خسرت فاطمة القضية، إلا أنها لم تخسر عملها و "مخيطتها".
قد كانت فاطمة قويّة ومدبّرة؛ فقبل المحكمة استأجرت خدمات كل من "زينب القرعة" و "زينب الهدروس" و "ماري الشورا" بثلاث تعريفات (العملة الفلسطينية قبل النكبة)، "ليردحن" لذلك الشخص ويبهدلنه أمام بيته. فقد كان ؟ في حيفا ؟ أربع نساء متخصصات بمجال "الردح" مقابل أجرة معينة. لا استطيع أن أشير الى الرابعة لأسباب الالتزام والنزاهة الصحافية. لكن ذلك كله لم يجد نفعاً؛ فالإقبال عندها كان مستمراً من جهة الرجال لتلبية الرغبات، ومن جهة النساء للعمل، فحتى بعض الحسناوات الحيفاويات عملن عندها، إحداهن كانت حيفاويّة من أصل جنوب لبناني.
وفاطمتنا هذه كانت تعاقر الخمرة، ولا سيما عرق "دكلوش". في إحدى الليالي ؟ بعدما شربت كمية لا بأس بها من ذلك العرق ؟ خرجت من "مخيطتها" سيراً على الأقدام لتصل الى بيتها في حارة الكنائس بمساعدة أحد معاونيها، وكان المعاون شاباً "أسود" تتعكز عليه في ترنحها، وصعدت بمساعدته الى سطح العمارة لتستنشق الهواء النقيّ الرطب. ومن كثر الحَم والحرارة طلبت منه أن "ينِش" عليها ليخفض قليلاً من درجة حرارتها ودرجة سكرها فكانت تقول له "نِش" يا "أخو الـ......." "و لك نِش"! وشمّرت فستانها لينِش عليها من أسفل! سُمع الشخير... شخير فاطمة الزعرة، إذ غطت في نوم عميق لتستيقظ في صباح 22/4/48 وتنتكب.
نعم، بكل بساطة.. حتى فاطمة الزعرة انتكبت، يرحمك الله يا فاطمة، ورحم زبائنك، فأنتِ ابنة البلد المنكوبة وجزء من "بانوراما" الحياة في ذلك المكان وذلك الزمان. ومهما يكن من أمر فهي نكبة وهو وحي...
مارغاروش
هل هنالك تراث حيفاوي خاص بأهالي حيفا؟ الجواب: نعم. إلا أنه غير مقطوع أو معزول عن مجمل التراثيات الفلسطينية وحتى العالمية. فتطوّر اللغة، مثلاً، أية لغة، هو عملية تاريخية معقدة مرّت بها كل الشعوب، حتى أن هناك تشابهاً في منطق ونهج إنتاج الحروف لدى العديد من الشعوب. وفي السياق نفسه والمسار تطورت التراثيات على أنواعها وتعدّديتها لدى معظم الأمم. فحيفا لم تكن بمعزل عن الحركة التراثية الفلسطينية والعربية والعالمية. فقد جمعت في داخلها تلك المكنونات والمكنوزات وجبلتها في أحشائها لتخرج الى النور فولكلوراً مميزاً لأهلها. لكن النكبة ووحيها ومن وقف ويقف من ورائها لم يمكنّوه من التطور أو حتى من الإنتشار داخل المجتمع العربي الحيفاوي بعد النكبة. فالبقية الباقية من عرب حيفا، الضائعة، الممزقة والمنكوبة، لم تستطع نشر هذا التراث، ليس لسبب سوى لإقترانه بالصدمة (تراوما). فالصدمة كانت قاتلة لدرجة لا يقدر المصدوم ؟ المنكوب بها على البوح بالكلمة على الرغم من أنه "في البدء كانت الكلمة". وكان لهذه الكلمة ؟ التراث أن يُنشر ويتطور بانسياب طبيعي. وبينما نتخبط بالإنسياب وغير الإنسياب فقد سبقنا أخوتنا لأبينا الخليل في البحث عن هذا التراث ليجعلوا منه أداة لحصولهم على هذه الرتبة العلمية الجامعية أو تلك. فذلك الأخ يبحث عن لهجة عرب حيفا الأصليين (وإنتو خلّيتوا أصليين؟!)، وتلك الأخت تبحث في اندماج العرب في بيئة جبل الكرمل قبل العام 1948! وذاك الأستاذ الجامعي يتخصص في نوع مأكولات عرب حيفا قبل النكبة! فنحن المقصّرون.
وما دمنا مقصّرين فلا بدّ من بداية ما، تلك البداية التي افتتحها ومهّد طريقها الأدباء أمثال اميل حبيبي وحنا أبو حنا والعديد ممن كتبوا سيرتهم الذاتية من خلال تطرّقهم الى حيفا المدينة وعائلاتها وشوارعها، وإلى أسماء رجالات صنعت تاريخ هذه المدينة أمثال جميل البحري، أبو سلمى، عز الدين القسّام، سامي طه، سليم الخوري، راجي صهيون، رشيد الحاج ابراهيم، حنا نقارة، حبيب صنبر، حنا عصفور، عبد الرحمن الحاج، المطران حجّار، نمر الخطيب، مصطفى باشا الخليل، محمود الماضي، نجيب نصار، وغيرهم الكثير ممن لا تستطيع الذاكرة تحمّل وزن أعمالهم وعطائهم للمجتمع الحيفاوي بشكل خاص، وللمجتمع العربي الفلسطيني بشكل عام.
ففي كل رقعة من أحياء حيفا ستجد تلك المؤثرات من الحجارة والشبابيك والأقواس والشرفات التي ستروي لك قصة ذلك المكان وذلك الزمان. إذن، فنحن بصدد بقع ورقع زمكانية متناثرة في تلك الرقعة الممتدة من ساحة الخمرة (الحناطير/ باريس) غرباً الى عمود الملك فيصل شرقاً. ففي هذه المساحة المنكوبة ما زال بعض من الحجارة القديمة تقاوم مخطط الهدم وسحق المعالم العربية. فجامع "الجرينة" الذي كان أطول عمارة في "البلد" أصبح قزماً أمام "عمارة الحكومة" يكاد يدخل قمقم سليمان الحكيم مع جانه أشمداي. أما "كنيسة السيّدة" التي أحياها ونفخ روح "ستنا مريم" فيها، من جديد، طيب الذكر، كميل شحادة، فقد اختفت عن الأنظار ليحجبها بنك "إيـجود" ومكاتبه المكيّفة. وفي "حارة الكنائس" تبخّرت مدرستان للروم الأرثوذكس، واحدة للبنين وأخرى للبنات. ومؤخراً هُدم بيت رشيد الحاج ابراهيم في شارع البرج (9) وكذلك المدرسة الإسلامية للبنات قرب "مقبرة الاستقلال".
ومع كل ذلك.. دعك من ذلك واقلب الصفحة في سفر النكبة!
ولنعد الى رقعتنا الزمكانية ذات الأزقة الملتوية وغير الملتوية التي كانت تفوح منها رائحة البخور والعطور وصابون الحمّامات والقصص والخرافات. فالفسحة المكانية كانت ضيّقة والبيوت متلاصقة والعتمة مخيّمة ومخيفة والإيمان غيبي والناس بسطاء، والأديان الثلاثة برجالها منتشرة بين الجوامع والكنائس والكُنُس. أضف الى ذلك عساكر الأتراك من اليوزباشي الى الزابطية (ضابط في العربية) بكلابكهم ("الكلبك"، قبعة الجندي التركي) وسيوفهم وطبنجاتهم المسلطة فوق رؤوس العامة. كل هذه الموجودات أدّت بالسكان الى إطلاق عنان أفكارهم للخيال وللإبداع، الموروث والمكتسب، ليحاكوا الجان والشياطين على أنواعها، وليؤلفوا قصصاً شيّقة تخرج معهم من الحمّام. فمن هو مارغاروش؟ إنه إسم من أسماء الجان. وجرت العادة أن نبسمل (أي قول بسم الله الرحمن الرحيم) قبل ذكر إسمه تماماً كما نذكر "الخضر أبو العباس" حيث نرفق ذكره بجملة "الدستور من خاطره". وعند كتابة هذه السطور بسملت كثيراً كي لا أُصاب بأذى منه. وعلى ما يبدو فمارغاروش، حسب إحدى الروايات، هو أحد أبناء ملك الجان أشمداي الذي تحدّى سليمان الحكيم. وفي رواية أخرى هو صهره لإبنته الجنية حشتماروش. ومهما يكن من أمر أصله وفصله. فمارغاروش أصبح بطلاً من أبطال جدّاتنا في بيوتهن وفي حماماتهن ؟ "حمام الباشا"، الذي ما زال قائماً في البلد مختفياً وراء عمارة "شركة الكهرباء"، التي بنيت على قطعة من أراضي "الوقف الإسلامي"، وكذلك "حمّام دار كُزبَر" الذي لا يبعد كثيراً عنه. وما دام مارغاروش هذا بطلاً فلا بد من تفصيل القصص من حوله على الرغم من قصر حجمه الذي كان يوصف عادة بطول العضو التناسلي الذكري حيث تقول الجدة "طوله طول الـ..". وبما أنه لم يكن إنساً فقد أضفوا عليه صفات لا تليق بالأبطال، فعدا عن قصر حجمه كان وجهه طويلاً وعيناه طويلتان غير مستديرتين يعتمر قبعة جنيّة مزركشة بأحرف غير معروفة وإشارات غريبة لكنها تحوي شارة خاتم سليمان! أما يداه ورجلاه فكانت ممتلئة بالعضلات تبرز منها شرايين منتفخة يسير فيها الدم الأزرق!! وقد عُرف مارغاروش لدى العامة والخاصة برشاقته وعدم "قلة خواصه" (أي أنه كان نشيطاً ولم يكن منزوحاً حسب لهجتنا)، إلا أنه كان مخيفاً وخاصة عندما كان يحرّك رأسه بسرعة يمنة ويساراً تاركاً شفتيه الغليظتين للحركة بحريّة فيخرج لسانه الطويل و "المرَوّس" ليُحدث صوتاً مرعباً مرفقاً هذه الحركة بحركة رهيبة بكلتا يديه المفتوحتين مع أصابعه الثلاثة من كل يد. وللغرابة فقد أجمعت العامة على أنه كانت له لحية طويلة بطول جسمة، أما الخاصة فقد نفت ذلك.
هذا هو مارغاروش. لكن ليست هذه هي القصة فهو بطل من أبطال قصة "أُم ضريطة" التي جرت أحداثها في البيت الفخم الواقع بين "جامع الجرينة" وبيت نايف الحاج ابن عبدالله محمد فرج. وللأسف لا نستطيع تبيانه حسب الخرائط الحالية لأنه لم يعد قائماً. ولكن على الرغم من ذلك نستطيع القول إن البيت الفخم يقع بين عمارة "بنك هـبوعليم" (العمال) الشاهقة وعمارة "تسيم" (شركة الملاحة الإسرائيلية) الشاهقة أيضاً، وبالتالي ففخامة ذلك البيت ستختفي أمام هذه الشواهق. ومهما يكن من أمر فيحكى أن امرأة من تلك المنطقة كانت ملحاحة على زوجها و "تنقّ عليه" ليل نهار بأن يشتري لها حلقاً لأُذنيها فوعدها بذلك فأخبرت الجيران وهيّأتهم. لكنه رجع بدون حلق. فزجرته، ويا لشماتة الجيران! فقال لها: "شو حلق ما حلق.. أنت أحسن لك الخلخال، حتى تضعيه في رجلك اليمنى العامرة" (أي التي لا عورة فيها). اقتنعت الزوجة و "فزّعت" الجيران ووعدت بأنها ستدخل الحمام استعداداً للخلخال. وفي ساعات الصباح المبكرة لفت "بقجتها" الحمّامية داسّة في داخلها كل ما يتعلق بالنساء من ملبس و "ميزر" وصابون وطيب وليفة. وشرّقت من بيتها نحو "حمام دار كُزبَر"، إلا أن الأمر كان في غاية الخطورة ؟ الرجال يستحمون في ساعات الصباح والنساء بعد الظهر. كيف ستخرج بطلتنا من هذا المأزق وهي في نشوة من "كيفها" بالخلخال الموعود. فما كان عليها إلا أن تأخذ سلة من القش وتضع فيها سكينة المطبخ ذات النصل الحاد، التي اقتنتها مؤخراً من دكان نعيم العسل (دكانجي، يقع حانوته قرب جامع "الجرينة" يبيع كل شيء من الملابس حتى المسامير)، فوصلت الى باب الحمام وهتفت "بريمو" (أي تريد الإستحمام بمكان خاص)1 فقيل لها ان لا مكان للنساء في ساعات الصباح، فأخرجت السكين وهددت: "سأقطع له إياه.. كل من سيعترضني".
فدخلت الحمام واستحمّت بمياهه الساخنة وبخاره المنعش. رجعت المرأة الى بيتها ولم يكن أي خلخال في انتظارها. وعلى ما يبدو فقد أراد الرجل التخلّص منها لأنه ضاق ذرعاً بها وبطلباتها. قال لها: "بدناش لا حلق ولا خلخال، بدي أودّيك على قصر، فبقرب بيتنا يوجد بيت فخم وهو لك". أما البيت إياه فهو مسكون بالعفاريت والجان ولا سيما مارغاروش. فقد كان الرجل مدركاً أن البيت مسكون، حيث قال لنفسه لأرسلنّها هناك وليأكلها مارغاروش. لم يستغرق إقناع المرأة سوى بضع دقائق حتى كانت على باب البيت المسكون فأدخلها زوجها وأغلق الباب بإحكام مستخدماً "الشنغل". دخلت المرأة الى البيت و "انبهرت" من فخامته ومن "عفشه"، فالرخام رخام وخشب المرينا مرينا والزان زان و "التريات" "إشي إشي" ودورة المياه افرنجية "آخر ألِسطة" و.. و.. إلا أن انبهارها لم يدم طويلاً.. دخل عليها مارغاروش بقبعته ولحيته ولسانه المدفوع الى الأمام، وبدأ في حركته اللاإرادية وهمهم: "هم..م..هم..م..م.. يا بتشغليني يا باكلك.. هم..م..هم..م..". تمالكت المرأة أعصابها بعدما "تمسمرت" في مكانها وزمانها وبعدما "دستَرَت" و "تفتفت" على اليمين والشمال. كيف لها أن تخاف وهي التي هدّدت الرجال في الحمام بقطع أعضائهم التناسلية. فعملت بحكمة عنزة "كليلة ودمنة" مع الأسد التي نذرت للإله "شيفا" أن تفترس عشرة أسود، وافترست تسعة منها وبقي لها أسد واحد. لكن امرأتنا لا تستطيع الإفتراس فعملت بنصيحة مارغاروش وشغلته، فأمرته: غسّل الصوف، فغسّل، كنِّس، أُشطف، مسّح، غسِّل البرادي، رتّب الكومودينا (خزانة صغيرة تستعمل إما للتحف أو للتخزين) فرتب، أُحفر.. فحفر (أُحفر يا فرفور!!) وعندما انتهى مارغاروش من كل هذه الأعمال التي أنجزها بدقّة متناهية، يعجز الإنس عن صنعها، توجّه إليها مرة أُخرى بهمهمة أكثر شراسة من المرة الاولى: "يا بتشغليني.. يا باكلك"! فاحتارت امرأتنا من أمر هذا الجان، خاصة أنه لم يبق لديها من أوامر تأمره بها لينفّذها، فشمّرت عن فستانها النيلي وخلعت سروالها الداخلي وأدارت مؤخرتها له وأمرته بـ "النش".. فبدأ ينش بسرعته الجنية حتى انتفخت ثم ضرطت فصّاً مريباً ناشفاً وحاد الصوت "فتزعفل مارغاروش بأربعته" ومات.
في أثناء كل هذه الأحداث من الأوامر وتنفيذها وكذلك النش والإنتفاخ كان الزوج قد جهّز لزوجته تابوتاً ظاناً بأنه عندما يُفتح الباب بعد الثانية عشرة من منتصف الليل - وهذه هي ساعات عمل الجان في حارة شارع أمية في البلد - سيرى زوجته ميتة و "مرمية" أمام البيت الفخم، لكنه عندما فتح باب البيت رأى زوجته والى جانبها مارغاروش إبن أشمداي مطروحاً على الأرض ميتاً من "النش" ورائحته الكريهة. فبدلاً من أن يضع زوجته في التابوت، وضع مارغاروش فيه ودفنوه رمياً في مياه بحر دار الصيقلي خوفاً من رجوعه. إلا أنه عاد وسيعود، لأنه جان ولأنه مارغاروش ولأنه بطل من أبطال حارة الكنائس والبلد وشخصية من شخصياتنا الإنسانية. نعم هذا هو مارغاروش. أما "حمّام الباشا" فقد استمر في قصصه وخرافياته المعهودة والتي قد تضاهي قصص حمامات عكا ودياميسها التي تنقلها لنا بمشاهدها المسرحية الممثلة، ابنة زواريب عكا، سامية قزموز ؟ بكري. فلا عجب في تلاؤم وتوافق الروايات بين عكا وحيفا. فحيفا هي نسخة تاريخية عن عكا وبالتالي فسأعفي نفسي من رواية قصة الولد في الحمام والعروس ذات البدلة المحروقة من طرفها الأيسر أو الأيمن. فرواية حيفا يسرى ورواية عكا يمنى.
قصص تلك الرقعة الزمكانية لا تنتهي ولا تنتهي أيضاً روايات حماماتها حيث ظهر الجان في الحمام لأحد العرسان من دار السهلي و "لوى نيعه" لأن أبا العريس لم "يعبّرهم" ولو بقطعة شوكولاطة واحدة، حسبما طلبوا، وذلك عبدالله كيّلو الذي عاد الى زوجته "مشطبّاً" في كل أنحاء جسده العلوي وقليلاً بجزئه السفلي مضافاً الى "نيعه" الملتوي ولسانه الذي "يلتّ"، حيث قال لزوجته زينب إن الجان اعترضوه وهو راجع الى بيته وبنوا حيطاً مانعاً حال دون عبوره للزقاق فعاركهم وكانوا سبعة أقزام ذوي لحى حمراء يتوسّطهم مارغاروش. هذه هي الرواية بينما الحقيقة التي جمعناها شفهياً وكانت هناك صعوبة جمّة في ربط أطرافها تقول بأن عبدالله كيّلو كان سكراناً "طيخة" خرج لتوه من "العوالم" في "قهوة السنترال" ؟ معقل دار فاطمة الزعرة الباطرونة ليعود الى بيته فعلق بـ "طوشة" عمومية ليس إلا.
إن ما يميّز تراثيات تلك الرقعة هو عمق الخيال ومزجه في الواقع وتأثيره على الحياة اليومية وكأن همّ أهالي حيفا من تلك الفترة هو تفادي أذى الجان ومارغاروش والإستعاذة منهم ومن شرورهم، فغطوا المرايا في الليل خوفاً من الإنعكاسات وظهور العفاريت، وتفادوا القطط السوداء ليلاً ولم يتركوا المقصّات مفتوحة الأذرع تحسّباً من أن يستخدمها مارغاروش وعائلته، وأكثروا من استعمال الحجب والفتح بـ "المندل" ووضع الحجارة المقدسة من الحج على الصدور كي "لا يكبسوا" فلاناً بإصابة العين. فلم يعد مارغاروش مجرد عفريت مخيف بل أصبح شخصية قرينة وملازمة للمجتمع العربي الحيفاوي وبطلاً من أبطالها نستطيع إضافته الى "سعيد المتشائل" وفاطمة الزعرة، وغيرهما، من الخيال والواقع، بل أصبح أكثر من ذلك إذ تحوّل الى مثل يُتداول فقط في حلقات خاصة من أهالي حيفا الأصليين حين يقول الزوج لزوجته: "رايح أعملك مارغاروش". للدلالة على استعداد الرجل للقيام بالأعمال المنزلية عوضاً عن زوجته، وليس للإخافة ودبّ الذعر والرعب.
هل شاءت الأقدار أن يموت مارغاروش وتتبخّر هذه الشخصية مع ما سحق وهدم من بنايات وحكايات "البلد" التي تدعى بلغة اليوم "البلد السفلى" أو "التحتا". كلا. فحتى أفلام الرعب والخيال لا يموت أبطالها. حتما سيخرج مارغاروش المكبّل بالسلاسل والجنازير من بحر دار الصيقلي أو أبي نصور أو من بحر العزيزية ليستقر في مكانه وغير زمانه في عمارات الحكومة في تلك الرقعة ليظهر لهم ويخيفهم ويذكرهم بأرضه، مرتع صباه وبيئته، من أهالي حيفا، كالزعبلاوي والخطيب والكنفاني والخمرة وحبايب وعابدي والماضي ومنصور ونفاع ونقارة وكيّلو والشيتي والبوتاجي وغيرهم. وسيبقى بطلنا راسخاً في رقعته شاهداً على نكبتنا ولربما كرّمناه بنصب تذكاري نكتب عليه:
"رحمك أشمداي يا مارغاروش ورحم الله أمواتنا". ومهما يكن من أمر فنَم أو قم يا مارغاروش قرير العين، فما أنت سوى منكوب إبن منكوب، ومع كل ذلك فليلعنك الله الى يوم الدين لأنك جن وليس بإنس، ولأنك وحيٌ وهي نكبة.
رسالة إلى العبرانيين
فصل أليم من بشارة النكبة الى أهل حيفا العبرانيين. إخوتي لأبي إبراهيم الخليل، إنها رسالة ننقلها لكم من أخوتكم المهجّرين من رقعتهم الزمكانية من "البلد" وأبطاله من الإنس والجان وقصص الحمّام. رسالة ننقلها لكم باسم التراث العربي الفلسطيني الحيفاوي وباسم كل من مسّته النكبة ووحيها من قريب أو بعيد.
وبعد، أيها الأحبّة، حان الوقت للمصارحة الأبدية المجبولة بعرق اولئك الناس السرمديين، حان الوقت لقصّ روايتنا كما هي، من دون زيادة أو نقصان.
هذه رسالة باسم الذين لا يكتبون ولا يتكلّمون، ليس بسبب أًُميّتهم وجهلهم، بل بسبب انقطاعهم القسري عن الحياة العادية، ذلك الانقطاع الذي بلغ ذروته في سِفر دهور النكبة من العام 1948. اولئك، ما زلنا نبحث عنهم وعن حياتهم بين الأنقاض في وادي الصليب وحارة الكنائس، فقد نجد وريقة صفراء مغبّرة تثير الحساسية في الرئتين المسمّمتين والملطّختين بالنيكوتين وغازات "الريفاينري" . نبحث عنهم ونحن مطأطئي الرأس، كما كان يمشي سعيد أبي النحس المتشائل في شوارع وادي النسناس بأمرٍ من سيده سفسارشيك .
نرسل هذه الرسالة من صميم الحياة اليومية التي كانت سائدة في ذلك المكان، "البلد"، تلك الحياة التي كانت ستستمر بحلاوتها ومرّها لولا مياه البحر والرياح العاتية التي نشبت في نيسان من ذلك العام فأين انتم يا أخوتي، يا من سكنتم تلك البيوت وسط الفسيفساء البشري والمعماري في "البلد"، يا من طليتم بيوتكم باللون الأزرق "النيلي" للدلالة على يهوديتكم، أمن المعقول أنكم قد نسيتم تلك البساطة التي دفعتكم للمشاركة في حياة العامة؟! أوتذكرون كيف كنتم تلجأون للمحكمة الشرعية الإسلامية للاحتكام في قضاياكم لتنالوا من سعادة القاضي حكماً عادلاً يرضيكم ويرضي إلهكم ؟ إلهنا؟ ماذا ستقولون حين نأتيكم بالخبر اليقين حول ابراهيم ابن آسا وكيل وقفكم، وكذلك بأخبار ابراهيم ابن شبتاي من أصحاب السيادة في الفترة العثمانية، ولن ننسى سلمون فرحي أمين صندوقكم، ويعقوب ليفي مختاركم ومن بعدهم نسيم مزال ؟ طوف وإسحاق ليفي وإبراهيم منصور وإبراهيم حلفون، الذي حوّر اسمه الى خلفون، ويا للمفارقة.. أو يا للتاريخ. ففي أواخر السبعينيات قررت مجموعة شابة من عرب حيفا أو قل من بقايا النكبة، أن تبني لها بيتاً خاصاً في حي الزيتون المتاخم لشارع الدير. وكان أن قدّم هؤلاء الشبان طلباتهم المرفقة بالخرائط والوثائق المفصّلة. واتضح فيما بعد أن الأرض كانت ملكية خاصة لوالد أحد أعضاء المجموعة، ذلك الوالد الذي ورثها عن عمته شرعاً وقانوناً. لكن شاءت الأقدار أن تختفي هذه المفارقة، مفارقة الضعيف، لتحلَ محلها مفارقة القوي ولتفرض بلدية حيفا في حينه اسم الراف خلفون مع التشديد على الخاء. فبين الحاء والخاء "خففتمونا" أيها الأخوة.
وللتخفيف عن همومنا لا بد من التذكير بأحلام ذلك الجيل من أهل "البلد"، حيث لم يخطر ببالهم ولا حتى في أحلامهم الأكثر ورديّة من الورود أن يحلّ بهم ما حلّ من انقطاع الحلم الممتدّ من بحر العزيزية وحتى بوابة عكا التي لا تشبه "بوابة مندلباوم3" إلا في مفارقاتها.
إذ نخطّ لكم هذه الرسالة نودّ تذكيركم بقبورنا التي نبشتموها في مقبرة القسّام والاستقلال وسلبتم أسلافنا متعة الانتماء ولذّة العزاء وصيرورة الذاكرة والتذكير. فلم تبقوا شاهداً من شواهد قبورنا الرخامية والحجرية العارية إلا أخذتموه. تلك الشواهد التي تحمل أسماءنا وتاريخ ميلادنا ووفاتنا "فسلام علينا يوم ولدنا ويوم نموت ويوم نبعث أحياء"، نعم سنبعث أحياءً لنقضّ مضاجعكم ليس لسبب كرهنا لكم، بل لتذكيركم بذلك الزمان وذلك المكان.
إخوتنا، لماذا كان علينا أن نسير في درب الآلام؟ لماذا كُتب علينا أن نكون ضحية الضحية؟ لماذا كتبت عليكم الصدمة من الكارثة، وكتبت علينا الصدمة من النكبة؟ هل كان اقتلاعنا من ذلك المكان وذلك الزمان "كتاباً موقوتاً" وسياقاً تاريخياً محتوماً كما تدّعيه "الحتمية التاريخية"؟ وهل استطيع أن أقنع جدي "ق" المنكوب بهذه الحتمية التي كان يلعنها صباح مساء، ذهاباً وإياباً في تجواله في مكان مرتع صباه، حيث كان يلعن وعد "واحد من فوق" (وعد بلفور) مضيفاً لعنة على "حرامية التاريخ" (الحتمية التاريخية).
هل كانت حيفا وعربها الحل للاجئيكم وقادميكم من أقاصي الدنيا؟ هل كانت خطة "شيكمونا" وخطة "المقصّ" (الخطة التي قضت بحصر العرب في وادي النسناس ووادي الصليب في العام 1948) تتضمن فيما تتضمنه قطع الأحلام والآمال وفسخ الأحبة والأزواج عن بعضهم البعض؟!
أولم نتحدث فيما بيننا عن ذلك العربي "م" ذي الطربوش الذي أحب فتاة يهودية "ر" ذات الجديلة الملساء وتزوجها ليس على سنة الله ورسوله، وليس على سنة المجتمع وأحكامه. فقد عاش "م" و "ر" في رغد من العيش واستأجرا بيتاً على تخوم شارع ستانتون (على اسم الضابط البريطاني، والآن "شيفات تسيون"، أي عودة صهيون) وشارع البرج (حالياً "معاله هشحرور"، أي تلة التحرير). وكانت لـ "م" و "ر" علاقات غرامية تخطّت جميع المخططات والمؤامرات، وحتى العفريت "مارغاروش" لم يستطع التدخل في مثل هذه الأمور لإفشالها.
كما أننا تحدثنا فيما بيننا عن "ص" من عائلة القلعاوي، الذي كان على علاقة غرامية تضاهي علاقة روميو بجولييت مع سارة الملقبة تحبباً بـ "سيرينا"، حيث أنجبا طفلة خارج الزواج ما زال اسمها في طيّ الكتمان. فقد كانت سيرينا معروفة في كل "البلد" بلقبها "الحلوة" بنت الخواجات، التي كانت تتقن اللغة العربية باللهجة الفلسطينية الحيفاوية فتفتح ما قبل التاء المربوطة (كالطاولة والمعكرونة وليس الطاولي والمعكروني) وتشدّد على واو "البقدونس" وتمدَ واو "الثومي" وتستخدم الألفاظ الحيفاوية المحضة كقولها "إحنا بضُلا4" و "عاهة مندبي"5، وتكثر من لفظة "يا صباح الشوم" و "يا صباح الهنا"6. والأنكى من ذلك أنها بالغت في استخدام كلمة "يو.. يوه.."7، حيث يتطلب الأمر معرفة استخدامها زمانياً ومكانياً وظرفياً وكذلك دراية تامة بلفظها حين تُزَمّ الشفاه وتندفع الى الأمام. إن كل هذه المواصفات تدلّ على مدى تفاعل سيرينا وانخراطها في ذلك العالم النكبوي، الذي انقطع دون علم من "ص" ومن سيرينا. فقد انتكب "ص"، هكذا. ووجد نفسه في مخيم صيدا للاجئين، وانتكبت سيرينا إلا أنها وجدت نفسها في عالم غير عالمها ؟ في دولة اسرائيل. أما ابنتها المجهولة الاسم فقد تزوجت شابا من ابن جلدتها على حساب "ص" قبل النكبة بعام ونيّف. حيث أقام لها حفلة على نفقته دون علمها وعلم الراب والربانيين لأنه "ﭽوي" (غير يهودي) "إبن ﭽوي" ليصبح فيما بعد "ميعوطي ابن ميعوطي" (أقلية ابن أقلية)، هذه الإبنة وجدت نفسها امرأة بالغة، عاقلة، تقطن في وادي الصليب لتستقبل أقارب أبيها "غير الشرعي" وتتعرف عليهم وتعترف بهم أيما اعتراف. و "بالعلامة" (أي للدلالة) أنكرت إبنها الذي كان يخدم في صفوف "جيش الدفاع الإسرائيلي" تحسساً منها لمشاعر أقارب أبيها القادمين لتوّهم ولفترة قصيرة من عالم اللجوء والتشرّد. هكذا.
إخوتنا.. نقصّ عليكم هذه الروايات ليس فقط من أجل أن تنصفونا أو أن ترحمونا، أو أن تُتمتِموا علينا بالإيديش (لغة اليهود الأشكناز) "سوت نيشت جيدافت باسيرن!" (أي: ما كان هذا الأمر ليحدث) كمن يترحّم على ذبيحته عند تقديم القرابين في يوم الغفران أو في عيد الأضحى. نروي لكم حكايتنا لكي تعترفوا ولكي تفسّروا لنا كيف أُفرغت المدينة من عربها في ذلك العام، وكيف دخلتم الى بيوتنا من دون إذن منّا لتنهبوا ما شئتم من متاع ومن وثائق ومن هويّة! لماذا نكثتم العهد كما نكثتموه مع نبيّكم ونبيّنا موسى عليه السلام حين عبدتم العجل؟ لم نطلب منكم ذلك. كل ما أردناه منكم فقط هو أن تحفظوا العهد والناموس الذي تعاقدنا عليه معكم في حينه!
إخوتنا لأبينا... أولم نتفق معكم على صيانة عماراتنا وأطياننا في جميع أحياء المدينة في وادي الصليب والمحطة ووادي رُشميا وحتى حارة اليهود؟ أولم نتعاهد على إبقاء بيت آل توما والخمرة والحاج وسقيرق وجرار والقط والحاج إبراهيم وطوبي لتكون شاهداً من شواهد حياتنا المشتركة؟!
لماذا هذا الإخلال بالوعد؟ لقد خيّبتم أملنا ونحن ما زلنا نعتقد بأن حيفانا هي مشتركة.. أونسيتم أنه في العشرينيات حين كان عددكم بالكاد يتجاوز منزلة المئات حرصنا على أن يكون لكم ممثل في المجلس البلدي! طبعاً هذه ليست منّة منّا عليكم، بل واجب ولربما حق.. والآن أيها الأخوة، ماذا جرى لكم؟ لماذا تنكرون التاريخ وتغيّرون أسماء تلك الشوارع التي عبرنا فيها سوية كما عبرها "ص" وسيرينا و "م" و "ر"؟ لماذا قطعتم تلك الأحلام؟
لنصارحكم بأكثر من ذلك، فنحن الذين لا نكتب ولا نتكلم نقول لكم إن "البلد" بلدنا والحمّامات حماماتنا وحتى الجان ؟ العفريت مارغاروش ؟ فهو من جاننا، والذي أقسم أغلظ الإيمان بأن يدافع عن حقوقنا حتى في هذه الأيام. فعلى ما يبدو لم يعد مجدياً مخاطبة الإنسان، فلجأنا الى الجان.. ومهما يكن من أمر النكبة فنحن لا نستطيع الخروج من دوامتنا ودوامتكم لأن قصتنا معكم طويلة..
المدام كلير والحاج نايف
سأله سائل، هل انت من حيفا؟ (ولم تُلفظ حيفا بفتح الحاء وتسكين الياء) وهذا ما اقعده عن الاجابة، فانكتم عن الكلام المباح ريثما يتأكد من كسر الحاء، وما كان إنكتامه سوى تعاملاً مع عادة ام جدته "حليمة" القلعاوي، الصيداوية الأصل حينما كانت تمتنع عن الكلام وتصوم ثلاثة أيام، لأنها اقسمت اليمين والأيمان كقولها "كسر الهاء وعقد اليمين والذي أعظم منه عظيم". ولحسن حظه لم يك بحاجة لذلك القسم، لأن السائل، وهو شيخ غير مشقق الوجه توجه اليه جازماً "إنتِ حيفاوي" فيجيبه "أيوَه، نعم". فتأمله ذلك الشيخ برهة ليخرج باستنتاج بأنه حجّاوي، أي من دار الحاج، حيث قال له "ولَك إنتِ حجّاوي يا ولد". فراقت وطابت له كلمة ولد دون الحجّاوي.
كان ذلك في عاصمة معشر البلغار صوفيا حين التقى ذلك الولد الشيخ الحيفاوي من آل سقيرق من "الملاكين"، الذين مُحيت اطيانهم في طوفانٍ ليس من طوفان نوح عليه السلام، بل من طوفان شهر نيسان.
هذا هو المشهد الرمادي للقاء الأجيال من الداخل والخارج في عواصم أجنبية، حين يشمشمون أبناء البلد الواحد، لا بل أبناء الحارة الواحدة بعضهم بعضاً مبتدئين لقاءهم بكلمات السر والرمز، التي أصبحنا ندعوها "بالكود"، فكلمة السر كانت حيفا بكسر الحاء. فقد اصبحت "الحيفاوية" سلعة نادرة نتداول سرّ أصلها وفصلها، ونتأملها من قريب ومن بعيد، من أسفل ومن علٍ، متجاهلين على مضض ما حلّ بتلك السلعة من نكبة ومن نكسة، ونستمر في فحصها لعلها كانت مزيفة او خاطئة كفاطمة الزعرة لنرجمها بحجر من حجارة المجدلية أو من حجارة وادي الصليب المهزوم والمهدوم.
التعصب للأصالة الحيفاوية ما هو إلا تعصّب للجذور والإنتماء، فسكان حيفا الأصليين، الأحياء منهم والأموات ما زالوا يذكرون تلك القصص و "الخراريف" التي ستدخل في طيّات صفحات التاريخ المكتوبة وغير المكتوبة، سواء كانت من الحمام ام من نسج خيال الجدّات ذوات التجاعيد من الجبين الى أخمص القدمين مروراً بالبطن وما تحته. فاولئك الجدّات "الستّات" او قل "المدامات" كان لهن مقامهن ومكانتهن في المجتمع الحيفاوي دون أن ندري، فكنّ يدخنّ النارجيلة على "كيفهن" وعلى مزاجهن دون إذن من "بعولهن" من على بلاكين ومن ساحات البيوت في محطة الكرمل ووادي النسناس. فالنارجيلة واستخدامها لم تكن عادة نكراء كما يحاول البعض تصويرها. فقد كانت طقسا من الطقوس المرفهة، تجتمع فيه السيّدات من العامة ومن الخاصة كل على طريقتها لتلخيص الأمور العامة من السياسة والإجتماع والإقتصاد. ففي الانتخابات للمجلس البلدي في حيفا من العام 1928 كان لاولئك السيّدات دوراً خاصاً من الدعاية "الحزبية" غير المكتوبة. ففريق منهن أيّد حسن بك شكري سيء الصيت وفريق آخر أيّد عبد الرحمن الحاج المؤيد للحسينيين.
وكان أن نشب خلاف من على بالكونة مدام عطالله في حي محطة الكرمل المزدهر ببساتينه الخضراء المليئة بشجر البيلسان الذي انتكب واختفى كغيره من النبات عن الوجود. فكان الجدال مستعراً بين "النساوين" المجتمعة حول "سكَملةِ" مدام عطالله، التي امتلأت بالتبولة وبعض من عرق "دكلوش" ودخان النارجيلات يتصاعد بكثافة عالية جداً من افواههن الملطخة بحمرة قانية. وكانت مدام عطاالله السبّاقة في طرح فكرها السياسي على "النساوين" لأنها كانت المضيفة، ولأن جذورها غير العربية مكّنتها من ذلك. فتلك المدام كانت تجيد العربية والفرنسية في ذلك العصر، وبالتالي فقد طرحت تأييدها للمرشح حسن بك على الرغم من اختلاف الإنتماء الديني الذي كان يلعب دوراً هاماً. وما كان على "المدامات" سوى أن يبقبقن ويتفاخرن في نفث دخان نارجيلاتهن، ومن خلال ذلك تشجعت إحدى "الهانمات" لتعارض "المدام" المذكورة أعلاه وبجدّة. تبيّن فيما بعد بأنها على صلة قرابة من البطن الأول بالرئيس المرشح المغاير لمرشح "المدام". نشب الخلاف وتعالت الأصوات ولا سيما صوت "عبد الرحمن خانم" الذي امتازَ بالتأتأة، المرفقة بلثغة خلطت بين حرف الراء والسين، مما جعلها تبدل المعاني السليمة بمعانٍ لها صلات "بكلمات العيب".
وعلى الرغم من ذلك فقد أبدت كل "هانم" رأيها... وفترة صمت... صمت رهيب أصاب ذلك المجلس من على بالكونة مدام عطالله. فقبل برهة كانت الأصوات النسائية تتعالى، حتى أن أحدى المدامات بُحّ صوتها فوصفوا لها الزنجبيل وصفة... ..
إستمر الصمت... حتى بقبقات النارجيلات انكتمت...
فما الخطب إذن؟ اتضح فيما بعد أنه في الغرفة المجاورة لبالكونة مدام عطاالله كانت ابنة المدام "بريدانس" تعاني الأم المخاض. وفي هذه اللحظة الخطيرة، لحظة انخفاض صوت النارجيلات ثار جدل عسير بين "الهوانم" ؟ فأية داية ندعو؟ أداية إفرنجية أم عربية؟ فمن العربيات كانت الداية سنية الغزاوي و "الحِدئَة" من عكا وعزيزة الخمرة، وقيل عنهن أن إيديهن "دِيّة" وخلفهن "صبيان ؟ ذكور". أما من الفرنجيات فكانت الدّاية لطفية كنعان، حيث قالت العامة "جيبي لك دايي فرنجية، ومش عربية، لأنها متعلمة عند الإنكليز ومعها السرتيفيكات؟!". لكن الموقف كان يتطلب غير ذلك النقاش فصرخت "عبد الرحمن خانم" "سرتيفيكات ومش سرتيفيكات لتقم الداية بمهامها لإخراج الطفل الذكر". ولم يخرج في تلك الليلة من شهر نيسان في العام 1927 سوى إنخراس صوت البقبقات والخرافات من تلك النسوة ومن تلك "القعدة" عند المدام عطاالله. ومرة اخرى صمت يتلوه صمت آخر. وعندها عرف أن النتيجة ولادة انثى. وهكذا عرفنا أنه عندما تسود فترة صمت في مجلس من مجالس "المجموعات" يقال "شو السيرة، كِنّو (وكأنه) وُلدت بنت؟!".
وبعد خروج تلك "الأنثى" الى العالم النكبوي الذي سينتظرها تبادلت النساء من على بالكونة مدام عطاالله التبريكات والتهاني بقولهن "الحمدلله على السلامة؛" فتأتي الأخرى لتقول "وما لها الحمامة والسلامة!"
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فعلى الرغم من ولادة الطفلة البريئة، التي دعيت فيما بعد جميلة العبدالله، أُقيمت الحفلة في باحة شارع ابن الأثير في محطة الكرمل ليحضرها البشوات والبكوات وأصحاب السيادة ذوي الطرابيش الحمراء مع نسائهم، وكما قيل فقد "بدّعَت" "المدامات" في الرقص على انغام الدربكة والعود والحان رقصة "الهوانم" ورقصة "سِتّي". ويُذكر من تلك الحفلة ان المدام "كلير" من حي الزيتون كانت مرتدية "كل أواعيها" (كل ثيابها) المتناسقة الألوان، الجاكيت الأحمر ذو الأزرار "المجيديّة" و "الأبى" ، فالبلوزة الخضراء، فالتنورة الكحلية، التي يبعد آخرها عن كرسوع القدم مسافة شبرين تفصلهما جرابات شفافة تُظهر مهارة "سالخة الشعر" من "حفلات النتف" لتريك ساقين ملساوين، متعة للناظرين. تلك المدام ولقربها من أهل الفرح كان لزاما عليها إظهار ما يمكن إظهاره من النشاط المطلوب في مثل هذه المناسبات، وحسب عادات تلك الفترة ؟ فترة اللعب واللهو، بينما الأعادي ساهرون. إلا أن المدام كانت من النوع الخجول جداً، وهذا ما ادخلها في وضع خطير لا تستطيع الخروج منه، إلا بقدرة قادر، لحظات والفرج آتٍ. فها هي النساء تتوجه نحوها داعية إياها باستعطاف جمّ لتقوم بمشاركتهن بالرقص. وفي مثل هذه الحالات تُمسك إحدى النساء بيد المدعوّة لتقيمها عن مقعدها، وبالتالي تُجابَه بالرفض في المرة الأولى، فالثانية والثالثة "ثابتة"، حيث يُحلف أغلظ الإيمان، عندها تقف المدعوّة الخجولة على رجليها. وفي حالة المدام كلير لم تكن خروقات عن المالوف سوى زيادة خجلها الذي بان حين وثبت على ساقيها مستهمة للرقص حيث امتقع وجهها إحمراراً فكادت وجنتاها المتدليتان تسقطان على كتفيها الضّيقتين، فكانت تحركهما من اسفل الى اعلى وكأنها تبغي رفع وجنتيها حرصاً على سلامتهما. واخيراً وقفت المدام..... ورقصت حتى انها كانت "تَقصَع" الى وراء ومع كل "قصعة" الى الخلف كانت تنسحب معظم ثيابها الى وراء فيطول الجانب الخلفي ويقصر الجانب الأمامي من ثيابها ليتبين بين الفينة والأخرى الجزء السفلي من سروالها الطويل... و في أحد "القصعات" فقدت توازنها وانقلبت الى الخلف فخرّت على الأرض... وهنا الطامة الكبرى... لم تستسلم المدام... فرفضت المساعدة واستعادت نشاطها لتواصل الرقص "حتى انخلع باطها" دون كلل أو ملل ولم تكن أيّة قوة تستطيع ردعها من اداء واجبها المفرط، كلا... حتى زوجة مختار الحارة "الست ام جورج" لم تستطيع تهدئة هذا الرقص الجامح.....
هذه هي قصة المدام كلير... بينما قصتنا، لا بل قضيتنا تتطلب أن نروي المزيد عن أبطالنا من تلك الفترة وتلك الرقعة. فإذا كانت "المدام" كلير في روايتنا هي بطلتنا من محطة الكرمل فسنشق طريقنا بحنطور السائس "الـجيسي" مروراً بالشاطئ الواصل بين تلك المحطة ومركز مدينة حيفا لنتوقف قليلاً بجانب "ساحة الخمرة" وللتدقيق في شارع أمية، لنقرع باب بطل آخر هو الشيخ نايف من الطابق الثاني من البناية، الذي عُرف عادة بخفة دمه ونخوته، لكنه بالتعريف غير العادي وُصف ببخله وبعدم تعصبه للدين وولعه بخرافات الجن وقصص النساء. فالشيخ نايف، الذي وصفته جارته "صفية بنت محمود" بالشيخ المستنير، هو من "أصايل حيفا"، ابن لعائلة ملاّكة، كثرت أطيانها في حيفا وكفر لام (مستوطنة هبونيم حاليا قرب حيفا)، طويل القامة والأنف يتملك عينين "مُجوّرتين" تطلان من حفرتين محفورتين داخل جبينه العريض. وكان يعتمر الطربوش الملفوف بالشال ويلبس الشروال والشملة الملتفة على وسطه، حيث كان يدسّ بها خلسة "رُبعية" العرق على الرغم من حجته وضلوعه بالفقه وبالأحاديث. وحتى تكتمل الصورة علينا أن نقول بأن نايف هذا خدم في "السفربلك" في اليمن مدة 12 عاما، حيث تعلم اصول التنجيم حسب كتاب "شمس المعارف" وعاد الى حيفاه لتستقبله زوجته "حليمة" وابنته "هدية" التي لم يرها قط. ويقال أنه عرفها عند بوابة الميناء من سحنتها القريبة جداً الى ابيه عبدالله محمد فرج جليس المحكمة الشرعية آنذاك.
ولكي يستعيد نايف حياته المدينية كان عليه أن ينخرط من جديد في نمط تلك الحياة ؟ حياة العوام والخواص ؟ من تلك الحقبة الزمنية ليدخل دوّامة الانتقال من حكم الأتراك الى حكم الإنكليز، الذين وصفهم "بأولاد البرنيطة والتنانير" ، فلغته التركية لن تطعمه الخبز، فأطلق العنان لهواياته ليمارس فيما بعد فن التنجيم وليقارع النساء وقصصهن مع بعولهن، لأنه آثرهن عن دون خلق الله في عملية كتابة الحجب نظراً لإيمانهن المتعصب والغيبي بإنجازات ونجاحات هذا اللون من "الفنون". وفعلاً فقد لاءم الحاج نايف نفسه لوضعه الجديد آخذاً بعين الاعتبار موقع منزله في "البلد" بقرب الجوامع والكنائس والمدارس، ومحطة الحناطير اضافة الى الخمارات و"الكراخانات" ، خاصة "ورشة الخياطة" التابعة لباطرونة البلد المدعوة "فاطمة الزعرة". فما أن أعلن عن خطبه حتى توافدت على باب منزله عشرات النساء من المدينة ومن القرى المجاورة ولا سيما قرية الفريديس التي وصفها قائلاً "آه منك يا الفريديس يا ام التعاريص" . ومن نجاح الى نجاح في كتابة الحجب وطرد العفاريت على أنواعها (علماً أنه لم يستطع التغلب على العفريت المدعو "مارغاروش") اشتهر اسمه وعرف بتخصصه بقضايا الغرام وجمع الأحباب. فكان أن أتت اليه ثلاث نساء من قرية لا تبعد كثيراً عن قرية املاكه كفر لام هي قرية إجزم التي لم يحبها ولم يطق ساكنيها نظراً لبخلهم واطنابٍ في شُحّهم، حيث وصفها بقوله "اجزم ؟ احمل فرشتك وانهزم" هكذا قيل. لكن التاريخ لم يثبت هذا الأمر. فأتت اليه النساء الثلاث وفي ايديهن "بقجات" جمعن بها ما طاب من المواد الغذائية والسكاكر التي إقتنينها من جوال المنطقة "أبو هِجرس". ففي تلك الفترة كان الدفع مقابل هذه الخدمات ليس بالمال بل بما يسمى "الناتور" (على الطبيعة ؟ بالمقايضة)، فما أن استقبلهن الشيخ نايف حتى عرف مبتغاهن ؟ تقريبهن من بعولهن. وبعد السؤال واقسام ضئيلة من الجواب وتبادل الكلام طلب منهن أن يقمن بفعل غريب من نوعه. فقد كان عليهن قياس اعضائهن الحساسة بخيوط ملونة يقدمنها له ليتابع عمله ونشاطه وتأثيره الربّاني والجنيّ. فكان له ذلك فأخذ الخيوط الثلاثة ووضعها في "النملية" بطريقة آية في الترتيب ليعود اليها بعد سبوع كامل حفاظاً على الرقم 7 ذي الصفات المقدسة والسحرية. وفي اليوم الثامن عاد الشيخ الى تلك الخيوط فلم يجد سوى خيطين بدلاً من الثلاثة في ذلك المكان الذي حرص على ضمانته وسلامته من أي أذى. يا للهول، ويا للمصيبة.... استشاط غضباً على زوجته "حليمة". "فانعقد صباحه" واصطفت تجاعيد جبينه العريض صفاً صفاً، وازدادت عدداً، وتوسعت عيناه القابعتان في محجريهما وتراقص أنفه الطويل.
فما أن رأت زوجته هذا المنظر حتى أدركت ما سينتظرها في مثل هذه الحالة. فاستلّ ربعيته من خصره وعَبّ منها جرعة طويلة النفس ليهدئ روعه من صاعقة الحدث إلا أن هذه الجرعة أخرجته عن إتزانه مما زاد غضبه فارتفع صوته وجفّت شفتاه حتى خرج "الزبد" على جانبيها ولم يعد يدرك ما يقوله لتنتابه البلبلة بين الخيوط وجوهر قياسها ليقول لها "وِلك وضعت ثلاث.... أينهم؟" "وين راح الـ ... الثالث"؟ ....صراخ يتلوه صراخ، لكن دون جدوى،لأن زوجته قد "عزّلت" النملية ونظفتها. وبما أن الشيخ نايف مبدئي في مسلكه ومهنته فرض على زوجته قياس ما "عندها" تعويضاً عن "الخيط" الضائع. لم تستطع "حليمة" رفض هذا الطلب، لأن رفضها سيعني الطلاق، كُن فيكون.
إرتاح الشيخ نايف كعادته بعد كل "فصّ أو فصلٍ أو شرّ" يفعله. فأشعل لفافة من التبغ الإنكليزي وبدأ يغني أغنيته التي لا يعرف اغنية سواها:
يا لَدَن يا لَدن آه يا لداني يا سيدي أُوف حُبّك ملاني
صَفَّت العساكر عساكِر بسلاحها اللي بتلالي يا فيصل
وفيصل عَ حصانه راكب عسكره هجم على الدوشمان
امان...... امان
إنطفأت أضواء المصابيح غير الكهربائية وزاد الليل من حلكته في حارة الكنائس، فاشعل الشيخ نايف شمعته السحرية ليتمتم على "خيوطه" ما شاء وطاب من كتاب "شمس المعارف" وليكتب الحجب اللازمة مع الإشارات الغريبة، حيث النجمة السداسية والأشكال الهندسية المختلفة والأبجديات والخطوط الواصلة بينها وكذلك الأسماء الغريبة مثل سخروش وإسرافيل وبَهروش ولا سيما "إستَكهَنبَر مَهمَمنَتَباش" هذا اللفظ الذي طالما تفاخر به ولفظه بطلاقة يُحسد عليها حتى أنه كان يلفظه تارة من اليمين وتارة من اليسار. وعلى ما يبدو هذا هو السحر بعينه وربما زوّده بالرمز "الكود" الذي يدعى 8 ؟ 4 ؟ 9 ؟ 1 ؟ 4 ؟ 2 ؟ 2. وبالإضافة الى الكتابة "المهنية" فقد أضاف من عنده أقوالا لا نستطيع كتابتها حرفياً لأنه دوّنها بالتركية.
كُتبت الحجب وَدُسّت في سراويل البعول من تلك القرية وسرى مفعولها لتعود تلك النسوة محمّلات بحاجات تفوق حمل حاملات الطيب للمسيح ابن مريم لتشكرن شيخنا، بل بطلنا من شارع أميّة. فأغدقن عليه ما تيسّر من المؤن ومن الدعوات ثم عُدن الى بلدهن. نادى الحاج نايف حليمته ليسألها "أوَتذكرين تلك الفلاحات من إجزم؟" فأومأت بالإيجاب، إذ كيف ستجيبه بالسلب بعد ذلك الفصل الذي سمّته "فصل الأعضاء الملونة؟" فأردف قائلاً: "لقد نجحن في جذب أزواجهن. أوَتدرين ما كتبت لهن؟ كتبت فيما كتبت "إن حَبِّك، حَبِّك وإن ما حبِّك فـ ........؛" لم تبتسم زوجته، فأدرك الحاج أن نغاشته ليست بمكانها. وعلى الرغم من ذلك فكل حارة الكنائس والحارات الأخرى تحدثت عن هذه الطرفة بمزيج من التحبب والهزل، الأمر الذي زاد من شعبية الحاج، التي إستغلّها فيما بعد اخوه في دعايته الإنتخابية لرئاسة بلدية حيفا.
هذه هي قصة الحاج نايف بينما قصتنا وقضيتنا هي ...........
)(
الزيتون الأشقر و" أبو جميلة"
ولدت بالصمت وجئت من عالم الصمت الى عالم الضجيج والحياة الصاخبة والزاخرة بالمفاجآت والمليئة بالمفارقات. لا أحد يعلم من أنا ومن أكون، وما هو أصلي وفصلي، حسبي ونسبي. أتيت الى هذه الدنيا ووجدت نفسي قابعاً في مسرح "الفنون" أعمل في الصيانة المهنية، أفعل ما اؤمر به، أنفذ التعليمات، أُكثر من الأفعال وأقتصد في الكلام.
الكل يجهل حضوري ولا يقيم لي وزناً يُذكر، علماً أنه لي من البدانة باع ومن العضلات صاع ومن الذراع ذراع، لكن ما العمل فهذا هو الواقع.
ابدأ عالمي اليومي قبل طلوع الفجر لأنهيه في عالمي الليلي من يوم آخر، وهكذا دواليك.. ليست لي امنيات ولا مواهب، فأنا سراب وطلسم من طلاسم ايليا أبو ماضي. لا أكره ولا أحب، وصفت نفسي "بأرقش" ميخائيل نعيمة. فقسمت العالم الى صامتين وغير صامتين.
حتى أن صاحبة المسرح الشقراء وصفتني بـ "العدم" وكانت تناديني بهذا اللقب ؟ تعال يا عدم واذهب يا عدم، فاستلطفت هذا الاسم الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ مني ومن شخصيتي العدمية. الأمر الذي حدا بشقراء المسرح، التي كانوا يدعوها معشر الممثلين المتملقين لها بـ "البيـچ بوس"، و غير المتملقين "بأم البيضات" تحويلي الى كائن حي، يأكل، يعمل وينام وطيع إشارة من إصبعها. والآن لا استطيع التعليق على مثل هذه الأمور غير الجدية بالنسبة لعدميّ مثلي. ولكن في مقدوري وصف معلمتي شقراء المسرح كوني الانسان الصامت الأقرب الى الواقع ؟ واقع الكواليس، واقع الأقنعة التي توضع على وجوه الناس من على خشبة المسرح ومن خلالها الى العالم ؟ الواقع. فمعلمتي هذه تغازل الستين من عمرها وما زالت تحمل بقايا الجمال العربي المتدلية على وجنتيها ذاتي الأصل الأسمر، بل الأسود، لأنها فعلا ليست بالشقراء. فالصبغة المصنعة "رقم 26" ما زالت طاغية على شعرها الأشعث والكث، الذي اكتوى من زيارة "الكوافيرات" ؟ هذه المعلمة ما زالت تحمل في تركيبتها النفسية انتماءها القروي الذي طمسته عميقاً في لا وعيها ظانة أن ذلك سيمكنها من الدخول الى المجتمع الراقي في المدينة، والدليل على ذلك أنها سكنت المنطقة العليا منها، علماً أن اغلب سكان تلك المنطقة لا يمتون للمدينة بجذور انتمائية تذكر وعلى ما يبدو ايضاً فأنهم يرتبطون بالحضارة المدينية من خلال ألقابهم المهنية ورواتبهم الشهرية فقط لا غير!! فإن سألتهم عن تاريخ المدينة وأهلها كما سألتهم معلمتي فيجيبون بكل ما علموه عنها متطرقين الى نكبتها من العام 1948 كما ورد في كتب التاريخ مزايدين على أبناء هذه المدينة في حرقة الانتماء وحسن معرفة في التاريخ، فمعلمتي، وعلى ما يبدو وبناء على ما ذكر أعلاه هي ضحية هذه الأوهام التي وصفتها باللغة الأجنبية "ارلوزيا" التي هي "ايلوزيا". وما دمنا في باب المصطلحات التي تستخدمها الشقراء ظانة أنها ستكون بما يسمى "IN" في داخل ما يسمى بالمجتمع "الراقي" فقد وقعت في اخطاء لا تعد ولا تحصى فكلمة اوركسترا ؟ اوكسترا، سكرتيرة ؟ سكتيرة والحبل على الجرار. فأنا "البهيم" حسب اقوال بعض الممثلين "الحوَش واللمم" استطعت إدراك المشكلة الإجتماعية لشقرائي التي ستشكرني فيما بعد على ذلك.
طبعاً المسرح لا يعتمد فقط على هذه المعلمة ؟ فهنالك معشر الممثلين والممثلات الذين واللاتي ينتمون الى شتى الإنتماءات فمنها الحزبية واللاحزبية، الإجتماعية واللاإجتماعية وأهمها الحرفية واللاحرفية. وهنا لن اوفر احدا من اولئك. فأنا اللاشيء اُهنت كثيراً من قِبلهم. سبق وقلت لكم انني غير ملموس، على الرغم من اهميتي، فأنا الذي أحضر لهم القهوة والشاي وأحضر الديكور واهتم بالقاعة وبالكراسي وبمكبر الصوت وبالإضاءة وكل الأمور الضرورية للتمارين وللعرض المسرحي في يوم العرض. فعلى الرغم من ذلك واسترقت السمع للأحاديث التي كانت تدور بين المعلمة الشقراء ؟ معلمتي ابنة الستين وبين ذلك المعشر من الممثلين، الذين قسمتهم الى عدة مجموعات، وبكوني ذلك الشخص الصامت سأحاول رغم بخلي في الكلام أن احدثكم الكثير الكثير عما يجري دون أن تدري المعلمة والممثلون.
ففي احد الأيام من شهر نيسان من ذلك العام هطلت امطار غزيرة ذكرتني بذلك الهطول ايام نكبة هذه المدينة وتحديداً نيسان. وإن أنسَ فلن انسى تلك المفارقة مع ذلك الفنان ؟ الضيف اليهودي الذي ذكرته بهذا التاريخ حين قلت له "أنه الـ 22 من شهر ابريل" حيث استغرب من التاريخ ذاته. طبعاً لن الوم هذا الفنان او تلك الفنانة طالما لم يبالوا بوجودي اصلاً، كما يُقال "فإنهم مش شايفيني من 2 سنتمتر" فكم بالحري معلمتي التي بدأت اولع في حبها.
يصرخون علي، يفرغون غضبهم عن طريق هذا الصراخ، ينادونني وينعتونني بشتى الأوصاف القذرة، ألبّي الطلب والبسمة تعلو على شفتي، بينما حريق ونار جهنم في صدري تشتعل دون أن احترق. أفهمهم واتفهمهم لكنهم حين يتجاوزون الخطوط الحمراء احاول ان اتصدى لهم بطريقتي الخاصة، طريق الصمت، لأنني أنتمي الى عالم الصمت.
صمت... صمت... صياح ودوي قذائف الشتائم المتبادلة تعلو من مكتب سيدتي الملطخة بالصفار المزيف، فما الخطب إذن؟ إنه جدال "عادي" بين "ام البيضات" وأحد الممثلين. لم اكن بحاجة لإستراق السمع والتنصت كما جرت العادة في كل مسارح العالم. بمعرفة صوت ذلك الممثل ادركت كنه المعركة غير المبدئية. فعلام الخلاف؟ سأبدي رأيي جازماً بأن الممثل "ع" رفض امر السيدة على اساس مهني، حيث طلبت منه أن يقوم بدور "س" فرفض.
طبعاً ليس هذا هو بيت القصيد. فداعيكم "ابو الصمت" يعرف بواطن الأمور. الخلاف لم يكن مهنياً فشقرائي المبتذلة لاحظت أن الممثل "ع" يميل الى تمثيل الأدوار الشعبية والمستضعفين "اكثر من اللازم" فأرادت بطبيعة الحال تحجيم "ع" على الرغم من عينيه الزرقاوين الواسعتين اللتين لا تمتزجان بلونهما مع لون عيون وهموم الأحياء الشرقية من البلد. وما كان على الممثل "ع" سوى الغضب وشتمها بشتى الشتائم التي أسمعها لأول مرة ؟ فعورة الأم أعرفها، إلا أنه استخدم عورات أخرى. وبطبيعة الحال فكل الغضبانين والمغضوب عليهم يأتون إلي ويفرغون أعصابهم داخل غرفتي الصغيرة التي يدعونها تحبباً با "الصومعة". وكنت ادعوهم الى صومعتي مستخدماً كلمة عيسى ابن مريم عليه السلام "دعوا الاولاد يأتون إليّ" لأنهم بالفعل اولادي وبعد الاستماع الى ذاك الولد ؟ الممثل عرفت السبب الأساسي والرئيسي للمشكلة، فسيدتي الشقراء ما زال "منخارها" مرفوعاً الى أعلى وكما يصفها بعض من الممثلين فهي "متعجرفة" وبما انني انا الصامت ادرك هذه الأمور، واعرف مديرة المسرح من حيث الحسب والنسب فقد تضامنت مع هذا الممثل، وبما أن هذه السيدة ليس لها علاقة بهذه المدينة لا من قريب ولا من بعيد فقد اقترحت على هذا الولد أن يراقبها في شهر ايلول وأن يراقب سر اختفائها لبضعة ايام!! ما هي إلا ايام حتى اكتشفنا أن تلك السيدة تتحول الى فلاحة بكل معنى الكلمة.
فالشعر الأشقر المرفوع الى الوراء يتحول وبقدرة قادر الى شعر بني مع قمطة، وتلك الأنامل المنتهية باظافر مقلمة ونظيفة تتحول الى اصابع ذات اخاديد وقنوات، وذلك القد الممشوق يصبح بدون اي شكل هندسي فحتى السيقان الناعمة تتحول الى أرجل تشبه بتشوهاتها أرجل "حمير الحجارة" حيث الجروح والخدوش وذلك الصوت العذب والانثوي والجنسي الذي كان يذوبني حين كانت تنادي "بالعدم" يتحول الى صوت "ام العبد" من تلك القرية.. نعم انها ايام قطف الزيتون.
ففي مدينتي هذه مدينة "ام الغريب" والكل فيها غرباء من الجليل والمثلث ابناء هذا الوطن يتحول يوم "قطف الزيتون" الى يوم الجذور والانتماء. حتى اشجار الزيتون الباقية في المدينة من تلك العهود والمنتشرة في "حي الزيتون" (شارع اللنبي) تلامسها ايادي الجذور لتمرط منها حبات الزيتون السوداء والخضراء، مما جعل اخوتنا من ابينا الخليل يتخوفون لدرجة "الهسترة" ظانين أن ايادي الجذور تستولي على املاك الدولة. لكن لا ضير.
فشقرائي قادرة على مواجهة ذلك من خلال مسرحها ومسرحتها للواقع ضاربة بعرض الحائط كل القيود والقوانين، فخلافاتها مع الممثلين تتقزم امام عزمها للنهوض في واقع ابناء هذه المدينة ليصبح مسرحها هو الواقع ذاته.
اما انا فقد كنت احاول كثيراً عن طريق صمتي غير الممسرح تشجيعها للمضي قدماً في هذا النهج ؟ نهج الخيال والواقع حتى اصبح مسرح "الفنون" مدينة تضم مجتمعاً مدينياً طور التكوين يحمل في طيّاته القديم والجديد، القروي ؟ الفلاحي والمديني، الأصيل والمبتذل، وكل هذه المكونات تتربع على عرش تاريخ هذه المدينة وما حل بها وبأهلها من احداث قبل خمسة وخمسين عاما.
اذن، كيف ستدير "البيـج بوس" هذا المسرح ؟ المجتمع من خلال تلك المركبات المعقدة مضيفاً الى ذلك ما يسمى بـ "مجمل القضية"؟ لم يك لدي اي جواب، ولم احاول حتى التفكير في الاجابة. كل ما اعلمه أنه في احدى الليالي سهرت كعادتي في خمارة البلد التي ادعوها تحبباً "بخمارة غوركي" في النهار وفي الليل ادعوها "خمارة جان فلجان" وتسامرت على غير عادتي مع نديم يدعى "ابو جميلة" (بلفظ الجيم المصرية) من بقايا ذلك العصر، أنه كهل عريض المنكبين، غليظ الشفتين تحسبهما "شفاطة"، سواد لون بشرته يضاهي كحل العيون، صوته ثخين يناسب حجم رقبته، فإن حاولت خنقه تطلب الأمر المزيد من الأيادي. اما العلامة المميزة له فهي شعرتان تعلوان صدره الرحب. وعلى الرغم من كهولته ما زال ذلك الشخص الذي عرفته. جاء من السودان طلباً للرزق في هذه المدينة فعمل عتالاً يحمل الحقائب وكل ما توجب حمله، وحين التقيته لأول مرة في "البلد" عند قريب لي بقرب "السوق الأبيض" قال لي: "اسمع يا ولد، انا صحيح أعتل، لكني احمل على ظهري كل هموم هذه الدنيا، وما دامت الحياة مسرحا فأنا خير ممثليها". كلمات سمعتها اصبحت واقعاً.
نعم أنه "ابو جميلة" هكذا عرفته كما عرفت أنه سكن في حينه ولفترة وجيزة تحت عمارة "فاطمة الزعرة" ؟ باطرونة البلد..! وعرفته ايضاً من سينما "الانشراح"، حيث عُرض فيلم لعبد الوهاب "رصاصة في القلب" على ما اذكر ودخلت متأخراً الى القاعة الدامسة الظلام فبحثت عن مكان لأجلس عليه، فجلست. قام الصراخ لاتبين فيما بعد انني جلست في حضن "ابو جميلة" وقد تأكدت من ذلك حين ابتسم كل ذلك الصف من الجالسين من اصدقائه فبانت وبرزت اسنانهم البيضاء فقط!؟!
أما سر اسمه فيقال أنه أحب فتاة تدعى جميلة من وادي النيل فهام على وجهه بحثاً عنها عندما اختفت ولم يعد بالإمكان رؤيتها فردد جملته "سبع سنين في الجبالا من شان جميلة" وكنت احب الاستماع الى لهجته السودانية التي استبدلت العين بالهمزة والقاف بالغين والحاء بالهاء، ولا سيما حين عمل في بيع البوظة "الدندرمة" فكان يردد جملة موسيقية راقصاً على انغامها رقصة سودانية "دندر البوظة يا سئيدة؟ (استبدل العين بالهمزة وسعيد هو اسمه)، وعندما يمر عليه يوما مشؤوم كان يدخل خمارة فاسيليوس اليوناني في شارع البور ويخمر، وعند خروجه كان يصيح بأعلى صوته "إهنا أبيد من السودان نضرب ضربة في البيضان "قاصداً" نحن عبيد من السودان..." فكما قلت فإن هذه هي مدينة الغريب أوت العديد من العرب الذين لجأوا من البلدان العربية المجاورة ولا سيما من جنوب لبنان حيث اختلطت اللهجات في هذه المدينة لتصبح خليطاً من المصرية والشامية.
تسامرت وتنادمت مع "ابو جميلة" ورفعنا الأنخاب لذكرى "الحبيب والمنزل" وسكبنا الدموع، إلا أن دموعه توقفت حين ذكرت له اسم حبيبته الثانية "جميلة الحلبية" التي تشبه معلمتي في عهودها الأولى، تلك "الـجميلة" الثانية التي هام في حبها لدرجة السير على الأقدام من يافا الى حلب برهاناً على حبه ووفائه وإخلاصه لها!! بيد أن القضية لم تتوقف عند هذا الحد "فأبو جميلة" يعتقد أن صاحبة المسرح هي نفسها جميلة الحلبية. فهنا كانت الطامة الكبرى. كيف سأفسّر له هذه المفارقة المجردة وقد شرب ما تيسر من الكونياك الرخيص الذي دعوناه با "الأمونياك"؟! فسكرة "ابو جميلة" "عاطلة" جداً! فما العمل؟! بدأت "ادندن" له بعض من الأغنيات السودانية التي لقنني إياها "ايام العرب"، إلا أنها لم تدخل مزاجه. توقفت. أفاق من سكرته ليذكرني بفلسفته في الحياة، التي حفظتها عن ظهر قلب ؟ فهي تتلخص بحبه للناس "من تحت" ولحياة الدراويش والبساطة المتناهية لدرجة الإحتراف وكرهه للناس "من فوق"، ففي السابق كان "التحت" البلدة القديمة و "من فوق" موقع البرج ووادي النسناس أما اليوم فكل ما كان "من فوق" اصبح "من تحت" فلذلك يحبهم لأنهم الأقرب الى قلبه. أما انا فأقسم الناس الى "ذوي اللسان" والى "ذوي الأذنين". وعلى الرغم من هذا التقاطع فقد صحونا نحن الاثنين وأيادينا السمراء والسوداء متشابكة وأضواء المسرح القوية مسلطة على كلينا لتبرز اسمالنا البالية من عهود النكبة لنردد امام مشاهدينا في مسرح "الفنون" مقاطع من اغنية سيد درويش "مصر والسودان":
جالت لي هالتي ام أهمد ...........كـلـمايــة فـي متلايــة
سرجوا الصندوج يا مهمد ...........لـكـن مـفـتاهــه مآيــة
ما فيش هاجـه اسمه مصري ........... ولا هاجـة اسمه سوداني
بهر النيل راسه في ناهية ........... ورجليه في الناهية التاني
**** **** **** **** ****
أسود أبيض يا بو رامه ........... آيشـيـن ويـا باضـيـنـا
سوداني فيه إنده كرامه ...........مصري طول امره أهينا
**** **** **** **** ****
الشـجل بـتـأنـا تـأب ...........بواب في بـيت الـبـاشـا
يوم فاصوليا وبـجـلاوة ........... يوم ملوخية وشوكلاطة
**** **** **** **** ****
يا اوروبا خليك شاهد ...........عَ الـبولـيتـكة الترلـلـي
الـرايـة بـتـأنـا واهــد ...........لازم يستـنى المـتـولـي
تصفيق حاد من الجمهور ؟ مجتمع المسرح ومسرح المجتمع ؟ الصامت وغير الصامت، "من فوق" و "من تحت"، منكوب وغير منكوب، لتنهض جميلتنا المشتركة من خلال هذا الجمع ؟ المجتمعي كبركان نَشِط لتوه ليفجر جميع القيود ناثرة في القاعة ؟ المدينة سهامها المشعة، صارخة:
" يا هـبـيـبـي أود لـي تـانـي أنـا أهـبّ الأسمراني"
فلم ندرك انا و "ابو جميلة" لمن "الأودة" ("العودة") أللأسمر الصامت أم للأسود السوداني؟!
عفواً! هل جميلتنا هي سرايا بنت الغول؟
عفواً! هذه هي مسرحيتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم بخيال آخر!
عفواً! هل هي حيفا التي تستبقي أبناءها؟
أسدل الستار!
بقلم الدكتور ماجد الخمرة
تــقــديــم : علي بدوان
الدكتور ماجد الخمرة، ابن خالتي زهرة قاسم عابدي، من أبناء مدينة حيفا، ولد فيها بعد النكبة من اسرة حيفاوية عريقة، درس في مدارسها، ونال شهادة الدكتوراة في علم الاجتماع من بلغاريا. في هذه المادة المرفقة يقدم لنا ذكريات مكتوبة وحية وعلى لسان أبناء المدينة بقالب جميل، في ذكرى سقوطها بيد عصابات الهاغاناه في الثاني والعشرين من نيسان/ابريل 1948.
يسهم الدكتور ماجد الخمرة بكتابه هذا في الجهود المباركة لتأثيث الوجدان الفلسطيني بالذكريات الحيفاوية الحيّة. وهو ابن عائلة حيفاوية عريقة حملت ساحة مركزية في المدينة اسمها: "ساحة الخمرة".. الى أن امتدت الى تلك الساحة يد العبث الطاغي فحوّلت الاسم الى "ساحة باريس"!
سمع الدكتور ماجد في البيت كثيراً من الحكايات عن حيفا وأهلها الذين عمِروها وعمِرت بهم قبل النكبة فدوّنها وأخرجها اخراجاً فنياً ممتعاً فإذا بنا نعيش في تلك المدينة التي حُرمت من اهلها الذين بنوها لتكون العروس الجديرة بالكرمل الأشمّ. فقد عصفت النكبة بسكانها العرب الذين بلغ عددهم حوالي سبعين ألفا سنة 1947 ولم يبقَ منهم في تشرين الثاني سنة 1948 سوى أقل من ثلاثة آلاف وثلاثمائة نسمة!
***
عرِفتُ حيفا طفلاً. فيها بدأتُ دراستي المنظمة بعد "الكُتـّاب" في أسدود، - الى حين- بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة المعارف ؟ في البناية القائمة على الزاوية بين "شارع الكرمة" و "شارع الجبل" الذي تغيرت اسماؤه على اللافتات المتعاقبة، تلك البناية التي أصبحت اليوم "بيت الكرمة".
كتبتُ ارتساماتي وذكرياتي عن حيفا ذلك العهد في كتابي "ظل الغيمة". سحرتني المدينة. من بيتنا في شارع عباس، كان البحر يصافحني ويطلق النظر الى أفق أزرق بعيد. وعندما أجتاز "ساحة الخمرة" الى السوق الابيض كانت تنفتح عوالم ثرية من الالوان والاصوات والوجوه. كنت اتطلع الى كل شيء بعيني الدهشة والانفعال والفرح.
في ساحة الخمرة موقف واسع ترى فيه الخيول والعربات السوداء اللامعة والنحاس الاصفر البرّاق تنتظر المسافرين الى شوارع بعيدة، خاصة تلك التي تتأفعى على سفح الجبل. وعندما تبدأ الرحلة تنطلق موسيقى وقع الحوافر على الاسفلت والأجراس تنبه العابرين والسياط تفرقع في الهواء.
توطّدت صلتي بحيفا عندما تطوّرت ميولي الأدبية فكنت اسافر اليها من الناصرة قاصداً المكتبات العامرة بالكتب والمجلات القادمة من كل انحاء العالم العربي. ما زلت اذكر هناك في وادي الصليب رجلا قصيرا ضخم الهامة يدير عجلة مطبعة صغيرة، هو نجيب نصار صاحب جريدة "الكرمل".
تتلاحق الذكريات: هذه حيفا ابّان الحرب العالمية الثانية ترتفع في سمائها بالونات بيضاء مستطيلة كجزء من الدفاع ضد الغارات الجوية على المدينة، فقد أغارت عليها الطائرات الايطالية آنذاك مما حفز بعض السكان الى اللجوء الى مدن وقرى بعيدة. وهذه شوارعها ممتلئة بالجنود الاستراليين والسنغاليين وغيرهم، وفيها ؟ ككل ميناء عناوين للبحارة لا تبخل على هؤلاء الجنود.
اقرأ كتاب "سبعون" لميخائيل نعيمة حيث يحدث عن سفرته في مطلع القرن العشرين من بيروت الى حيفا قاصدا الناصرة ليلتحق بدار المعلمين الروسية هناك فاذا بالمواصلات بين حيفا والناصرة آنذاك بالعربات تجرها الخيل وحين تصل الى جيدا (رمات يشاي) تبدَّل الخيول لتستريح ثم تعود مع العربة العائدة من الناصرة. وأقرأ سيرة بولس فرح في كتابه "من العثمانية الى الدولة العبرية" فإذا به بعد حوالي عشرين سنة من رحلة نعيمة يجيء من الناصرة على العربات ذاتها. يقول: "كانت هذه العربيات تحمل ستة من المسافرين، كما أذكر، والسابع يجلس بجانب السائق، ولصغر سني فقد جلست بجانب السائق، ويجر العربة حصانان قويان. ومضت العربة بلا توقف حتى موقع جيدا "رمات يشاي" ومن جيدا تنحدر في اتجاه العبهرية (قريات عمال) وكان صعود الجبل الى العبهرية شاقا وصعبا وغير ممكن فكنّا ننزل من العربة في اول الطلوع، ونتسلق الجبل مشيا على الاقدام ونلتقي بالعربة على قمة العبهرية، ثم نعاود الركوب وننحدر الى حيفا حتى نصل "السعادة" وهو موقع تنفجر منه مياه عذبة وتسمى اليوم (تشيك بوست)..."
أرأيتم كيف كان الناس يتنقلون آنذاك؟
* * *
عندما تحب احدا او شيئا فأنك تريد ان تعرف كل شيء عنه ؟ تريد أن تعرف حكايته، "البعد الخامس" للاشياء. وقد شغفتني حيفا فسعيت دائما الى التعرف الى المزيد عنها. وكم اهتممت بتاريخها الثقافي فهو الذي يتحدّى كل محاولات المحو والتغيير والاغتصاب.
كانت بلدة صغيرة على الشاطئ، في موقع "شكمونا"، ولما جاء ظاهر العمر الزيداني في القرن الثامن عشر رأى ان ذلك الموقع غير حصين فأمر ببناء حيفا الجديدة عام 1758م على بعد ثلاثة كيلومترات من الموقع القديم "في رقعة ضيقة بين الجبل والبحر (من ساحة الخمرة حتى البوابة الشرقية قرب عمود فيصل). أحاط المدينة بسور وثلاثة أبراج، أحدها "برج السلام" حيال مبنى البلدية الحالي".
بعد حوالي مائة سنة، عام 1880، كان سكان حيفا 4550 نسمة. في ذلك العهد جاء الاستيطان الالماني فقد كانت المانيا حليفة العثمانيين حكام بلادنا في ذلك الحين. بعد ذلك جاءت موجات الهجرة اليهودية التي تزايدت اثناء الانتداب البريطاني.
***
سنة 1908، حين صدر الدستور العثماني الذي اتاح بعض نسمات الحرية كانت حيفا سبّاقة في الانتفاع به. ففي تلك السنة، بعد شهور من اعلانه، أصدر نجيب نصار جريدة "الكرمل" وأصدر خليل بيدس مجلة ثقافية سماها "النفائس" ثم اضطر ان يضيف كلمة "العصرية" الى ذلك الاسم.
في ظروف الحرب العالمية الاولى (1914 ؟ 1918) عاد سيف الارهاب يغلق الصحف وطورد نجيب نصار الذي انتقد الحلف بين تركيا والمانيا فاضطر الى التخفي والهرب الى الناصرة حيث اختبأ حينا ثم مضى الى مرج ابن عامر، ومن هناك الى شرق الاردن فدمشق، حيث سلّم نفسه للسلطات وسجن. ودوّن لنا ذلك كله بأسلوب ممتع جدا في كتابه "رواية مفلح الغساني". وعادت "الكرمل" الى الصدور في حيفا حتى سنة 1943 كالسفينة التي تداهمها عواصف هوجاء لكن ربانها عنيد يحسن الصمود رغم ملاحقة الرقابة والظروف المادية العسيرة.
اما "النفائس العصرية" فكانت اول وأهم مجلة ثقافية في فلسطين. اتسع انتشارها الى ما وراء البحار وأعيد طبع بعض اعدادها مرتين. ثم انتقلت الى القدس حيث استمرت في الصدور بضع سنين.
ثم كانت مجلة "النفير" التي انتقلت الى حيفا مع صاحبها ايليا زكّا الذي انشأ ايضا مجلة "حيفا" سنة 1924.
وجاء جميل البحري الذي كتب "تاريخ حيفا" وأصدر مجلة "الزهرة" سنة 1922 وانشأ المكتبة الوطنية في تلك السنة وكتب وترجم المسرحيات العديدة وأشرف على ممثليها، ثم اصدر جريدة "الزهور" سنة 1927.
توالى اصدار الصحف والمجلات العربية في حيفا وقد بلغ عددها منذ 1908 حتى النكبة 31 جريدة ومجلة كما صدرت صحيفتان اثنتان باللغة الانجليزية.
وقد حفلت المدينة بالأندية الثقافية والرياضية ودعي الى المحاضرة فيها عدد من اعلام الفكر في العالم العربي.
في حيفا غنّت ام كلثوم وعرض يوسف وهبي وفرقته ابداعهم في التمثيل. يروي بولس فرح بعض ذكرياته عن الترويح في مطلع عشرينيات القرن الماضي: ".. أذكر كان من أبرز متنزهاتها "بستان الانشراح".. وكان يحتوي على ما يلهي المرء من متاعب الحياة وكان موقعه في ما يسمى اليوم "المركز الجديد" ويشقه في الطول "شارع البنوك". وكان البستان ممتد من شارع النبي في اعلاه الى شارع يافا في اسفله وعرضه بحجم طوله... وفيه سمعت غناء منيرة المهدية ورأيت تمثيل يوسف وهبة وفرقة عكاشة الهزلية وغيرها من الفرق التمثيلية والفكاهية العربية".
وما زالت بعض شوارع حيفا تحمل اسماء من التراث الثقافي العربي مما لم تمسه بعد يد المحو والتغيير فهناك شوارع: المتنبي والحريري وابن المقفع وابن سينا وغيرها. اما الفضل في ذلك فيعود الى الشاعر مؤيد ابراهيم الذي كان موظفا كبيرا في البلدية ايام الانتداب واستطاع ان يحقق ذلك. وقد اصدر مؤيد ابراهيم، في الثلاثينيات ديوانا شعريا ومسرحية شعرية غنائية سماها "مجنون ليلى" وظل ينشر شعره في الصحف والمجلات بعد النكبة.
ومن أبرز الوجوه الادبية في سماء حيفا الشاعر عبد الكريم الكرمي ؟ ابو سلمى وقد ضفر من الغزل والشعر الوطني جديلة مبدعة. اشتهرت في حينه قصيدته التي وجهها الى ملوك العرب حينما تدخلوا ليوقفوا الثورة سنة 1936 ومطلعها:
أنشر على لهب القصيد شكوى العبيد الى العبيد
وقد نشر على حبالها ملوك العرب واحدا واحدا، عرّاهم ومزّق اقنعتهم وختم القصيدة متوجهاً الى الشعوب العربية
أيهِ شعوبَ العُربِ أنتم مصدرُ الأملِ الوطيدِ
داعيا الى تحرير الوطن من هؤلاء "العبيد":
بل حرروه من الملوكِ وحرروه من العبيدِ
نشر ابو سلمى قصائده هنا في الصحف والمجلات ولم يصدر مجموعاته الشعرية الا حينما أصبح لاجئاً فكانت المجموعة الاولى بعنوان "المشرّد".
ومن الأعلام الثقافية التي عرفتها حيفا كان الشاعر وديع البستاني ومن آثاره الكثيرة كان ديوانه "الفلسطينيات". أما بيته الذي بناه على الشاطئ على شكل سفينة فسجله باسم الطائفة المارونية قبل ان يغادر الى لبنان في مطلع الخمسينيات وقد رأيته آنذاك في مكتب جريدة "الاتحاد".
وفي حيفا لمع مبكرا اسم الشاعر حسن البحيري الذي طلع على الناس في الأربعينيات بديوانه "الأصائل والأسحار"، تلاه "ارواح الربيع" و "ابتسام الضحى". وتحتل حيفا ووصف جمالها، خاصة في الليل، موقعا خاصا في شعره.
تتوالى الذكريات والصور والأسماء.. "النادي الارثوذكسي" وحنا نقارة، "نادي أنصار الفضيلة" مقهى المتروبول وعدد من المثقفين يسهرون فيه وأفلام شهدتها هناك وآخرها "عنتر وعبلة" في سينما "الأمين" ومشهد يتناجى فيه عنتر وعبلة وفي الطرف الآخر شيبوب رفيق عنتر يناجي جارية عبلة يريد ان يعقد معها مشاركة، اي مشاركة لتكون فاتحة صلة فيقول لها:
يا ريتني أقلع لك عين
وانتي تقلعي لي عين
ونعيش عور احنا الاثنين!!
شكرا للدكتور ماجد الذي استثار هذه الذكريات عن عهد حبيب في بلدة حبيبة وآمل ان تصل رسالته الى الاجيال الجديدة التالية لتقوّي أواصر المحبة لهذه المدينة التي تأبى ان تفقد الذاكرة.
- حنا أبو حنا -
مــقــدمـة
أحيانا يكتفي الانسان بمآسيه المنتهية وغير المنتهية، وأحيانا اخرى يطلب المزيد منها وكأنه يريد التلذذ والاستمتاع بها، ظاناً أنه عن طريق المازوخية يستطيع أن يبرر كيانه ووجوده في هذا العالم. لربما هذا الأمر كان سيجدي نفعاً على الصعيد الشخصي أو في اطار مراجعة الأطباء في عيادات الأخصائيين النفسيين، لكن الأمور تسير في غير هذا المسار وربما عكسه تماماً. فنكبة شعبنا العربي الفلسطيني تأبى التعذيب الذاتي وترفض التمتع بذاتها، لأنها لم تلد نفسها ولم يخطر ببال كافة الشعوب أن تحل بهم الويلات والنكبات كما لم يتمنَّ ولم يدعُ لنفسه الشعب العربي الفلسطيني تلك النكبة ليكون فيما بعد »ضحية الضحية«.
هذه الضحية المنكوبة لها كامل الحق في كتابة تاريخها، وإذا لم تفعل ذلك، فهي ستجرم بحق شعبها وبحق روايتها. ولن يقتصر واجبها على كتابة آلامها فقط، بل عليها أن تُفيض في رواية حياتها اليومية وقصصها الشعبية لتعيد انتاج ذاتها. فنحن نتحدث كثيراً عن ذاكرتنا الفردية والجماعية، لكننا لم نصل بعد الى درجة، إعادة صياغتها، لأن النكبة لم تنته. فنحن ما زلنا نعيش في داخل عالمنا النكبوي كما نعيش في كينونتنا الحالية، حيث يتداخل الماضي في الحاضر، والموجود في المنشود، والواقع في الخيال.
في هذه النصوص، التي لا نستطيع تحديد هويتها وانتمائها الأدبي او اسلوبها حاولنا حصر الذاكرة في مدينة حيفا. هذه المدينة التي نُكِب اهلها في نيسان من ذلك العام لا يمكن إلا أن تكون نموذجا خاصا وعاما لكل ملابسات القضية. » فعامها « هو النكبة بعينها و »خاصها « يشمل كل تاريخ هذه المدينة حتى العام 1948. وينطبق عليها مجمل النقاش حول الروايتين: الصهيونية والفلسطينية. ولكونها مدينة تضم ممثلي الروايتين يزداد الأمر تعقيداً، حيث تصبح المعادلة بين أطراف غير متكافئة، بين القوي المنتشي بنصره وبين المستضعف، الضائع والهش. ففي ظل اللاتكافؤ هذا رأينا من المناسب كسر ما هو مألوف والخروج قليلا عن البكاء لكي نركز على ما هو جوهري محاولين بذلك التصدي للرواية الموازية للتاريخ ذاته، بل أحيانا للأسماء والمواقع ذاتها.
أردنا من خلال هذه النصوص التأكيد على ثلاثة أمور ؟ علماً ان القارئ له كامل الحرية في تثبيت هذه الرغبة او هذا التأكيد او دحضهما ؟ اولا: محاولة إعادة صياغة الذاكرة والتذكير والتذكر، ثانيا: إعطاء جيل النكبة حقه من التاريخ، هذا الجيل الذي ما زال يعيش نكبته يوميا في داخل مدينته المختلطة، محتاراً بين حضوره وغيابه حسب القانون الإسرائيلي، ثالثا: دعوة الأجيال القادمة لأخذ دورها قدر المستطاع بعدما تذوّت الرواية وتستنطق من يحمل هذه الذاكرة. فالأجيال القادمة لها الحق في مساءلتنا والإلحاح في ذلك كما كنا نريد ان نثقل كاهل جيلنا الفائت بالتساؤلات.
أضع امام القارئ العربي في كل مكان وفي كل زمان نصوصاً ربما لن تجذب البعض، لكني متأكد انها ستؤلم البعض وتدخل ذات ذاته حتى النخاع وخاصة اذا كان ينتمي بهذا الشكل او ذاك لمدينة حيفا.
لقد نشرت هذه النصوص من حيث التتابع الزمني منذ العام 1995 وتحديداً في شهر نيسان، حيث حرصنا أن تصدر هذه المقالات في هذا الشهر، لأنه شهر نكبة هذا البلد. وكانت صحيفة »الاتحاد« »الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الاسرائيلي« التي تصدر في حيفا هي السباقة في هذا النشر تعاملاً مع اهدافها منذ صدورها في العام 1944 وفي حيفا. ولا يسعني هنا الا ان اردد كلمات طيب الذكر الكاتب الكبير اميل حبيبي معتزاً بصحيفته ومكان صدورها حيث قال »كون الاتحاد تصدر في حيفا فهي حيفاوية بكل معنى الكلمة«. وفيما بعد تم نشر آخر ثلاثة نصوص في مجلة »مشارف« المشرفة التي اصدرها اميل حبيبي لتتابع اصدارها الشاعرة سهام داهود.
مهما يكن من أمر هذه النصوص فنحن نعتقد بأنها ستبقى في إطار محاولة حكّ الذاكرة وتسليط الأضواء على جوانب لم تأخذ حقها من الكتابة الفلسطينية والعربية.
اعتقد أننا دخلنا مرحلة كتابة النكبة ذاتها وليس عنها او ما يدور من حولها.
خواطر مكانيّة لخواطر زمانيّة
في نهاية النصف الثاني من شهر نيسان عام 1948، سقطت حيفا، عروس الكرمل، التي طالما تغنّى بها الشعراء والكتّاب، وما كان لعربها إلا الرحيل مهرولين الى ابواب الميناء فزعا من أهوال المجازر التي وصلت اخبارها الى السكان، عن دير ياسين والطنطورة وغيرهما، ذلك غير القنابل التي كانت تُقذف من حي "الهدار" العالي على الحي العربي في دونه الأسفل، على حارة الكنائس. فقد قام رجال من "الهاجاناة" بدحرجة برميل من ساحة البرج الى ساحة الكنائس عبر شارع "ستانتون" ، وقاموا بعمل مشابه في وادي النسناس ، وآخر.. وضعوا قنبلة ناسفة في سيارة عبد القادر الحاج، وهو موظف كبير في بلدية حيفا آنذاك، فانفجرت به وأردته قتيلاً قرب مرآب (كراج) "أبي شامي"، ومثل هذه الأعمال ما لا يُعد ولا يُحصى.
بقي القليل من العائلات الحيفاوية العريقة في حيفا ورحل الكثير من شهود العيان. لكن الحقيقة لم ترحل. والذاكرة تأبى أن تمحى. فهي تنتقل من الجد الى الأب الى الحفيد. وها نحن ؟ ابناء الجيل الثاني بعد النكبة ؟ نستذكر وندوّن كي لا يضيع الحق التاريخي. وللتاريخ قيمة غالية، علينا الحفاظ عليها ونقلها من جيل الى جيل.
هنالك في الجانب اليهودي ؟ ابناء الجيل الثاني ؟ شيء يدعى "صدمة الكارثة" بعد الكارثة التي حلّت بالشعب اليهودي، حيث نقل الآباء، الذين عايشوا وذاقوا صنوف التعذيب في معسكرات الإبادة والتشرّد، الصورة لأبنائهم. وما كان على الأبناء إلا أن يرثوا الصدمة، صدمة الرعب وتوجّس الفزع من الآتي والخوف من الآخرين وغيره. وقد وصل الأمر ببعض هؤلاء الى درجة عدم الجرأة على زيارة تلك الأماكن في اوروبا.
أما نحن، فقد ورثنا عن آبائنا صدمة المكان، إذ قال جدّي، لأمي، لأولاده وزوجته وهم في عكا، حيث كانت المحطة الأولى من الرحيل: ".. ان ابقوا!!".
وما زلت ألوم الآباء والأجداد على ذلك. لكن التاريخ علّمنا ان الهجمة والمؤامرة الثلاثية كانت اقوى من أن يأمر أب ابنه.. وقد قيل لنا أنه، آنذاك، قام رئيس بلدية حيفا، شبتاي ليفي، بجولة في الأحياء العربية للمدينة بحثّ السكان، عبر مكبرات الصوت: ".. ان ابقوا". لست مؤرخا مختصا لأتقصّى مدى صحة هذا الأمر، إلا أنه سمعنا، مؤخراً، بوجود حاسوب يستطيع استرجاع كلمات رددت في الهواء حتى قبل 2000 عام. فبدأنا بجمع الأموال لذلك! واستناداً الى كلمة "ان ابقوا" كلمة الجد لأبنائه، و "ان ابقوا" لشبتاي ليفي، لا يسعنا إلا ان نجتر كلمة "لو" او "يا ريت" تعبيرا عن حلم جميل كان له أن يتحقق فيما لو بقوا.
فصدمة المكان هذه ترافقنا أينما ذهبنا. نغيب ونصول ونجول في أصقاع العالم ونرجع الى حيفانا، والى وادي نسناسنا، ذي الشهرة العالمية. فهو حي كانت له مكانته المرموقة ثقافيا وسياسيا، حيّ أنجب العديد من الأدباء والمفكرين كالبحيري ونجيب نصار وغيرهم، حيّ أقيمت فيه المؤتمرات كمؤتمر العمال العرب، وصدرت فيه الصحف، كصحيفة "الاتحاد" الناطقة بلسان مؤتمر العمال العرب، ثم عصبة التحرر الوطني آنذاك. وإذا كنا نحن ؟ أبناء هذا الجيل ؟ نتحسّر ونعضّ على شفاهنا غضباً فكم بالحريّ أبناء ذلك الجيل؟.. ولكن نعم سنبقى..
يقول لنا أبناء عمنا في حيفا: ها نحن قد غيّرنا البلدة التحتا من مكان مقفر ومظلم الى مكان يعجّ بالناس، والآن سنحوّل حارة الكنائس الى مكاتب حكومية وتشغيلية وتجارية وغيره. أهلاً بكم وبحضارتكم. فالمكان كان يعجَ بناسه وكانت ساحة الخمرة مثالاً لساحات المدينة، حيث الأشجار والعربات التي تشدها الخيول تنتظر الركّاب لإيصالهم الى حي الألمانية او الموارس او الى الكرمل، الى دار شوماخر في شارع الصنوبر "شدروت هنسي" . وكان على أعتاب شارع "ستانتون" الذي اصبح "شيفات تسيون" (اي العودة الى صهيون) قبالة موقع الزحلان، بئر للمياه تدعى "الزحاليق" لكثرة ما تزحلق الناس في ذلك الزمان وذلك المكان. كان هذا المكان ينبض بالحياة والأسرار والنهفات والنكات والضحكات والآلام وشظف العيش، كما كان مثالاً للتآخي الإسلامي ؟ المسيحي.
كان في ذلك المكان والزمان أناس يعملون، كانت حياة جارية بكل معنى الكلمة، وليس كما قالوا: "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب". ولطالما تعيد والدتي ؟ مدّ الله في عمرها ؟ كلماتها "سقى الله أيام العرب" وتقصد أيام ما قبل عام 1948. وتقول أيضا: "كنا نلعب ونلهو قرب دار عائلة مسمار حيث ولدت هناك على تخوم وادي الصليب وحارة الكنائس، الى أن جاءنا يهودي ابن عرب وقال لنا: ما لكم تلعبون وتلهون. فليكن ذلك ولكن، إعلموا اننا نتأهّب ونشتري الأسلحة، ويوماً ما، كل هذا سيصبح لنا". وتتابع والدتي وتقول: "لم ندرك كنه ذلك."
يقولون لنا: وما هي جذوركم في حيفا، فكلكم مهاجر من القرى المجاورة..؟ فإليكم التاريخ. كان جد جدّي لأبي، عبدالله الحاج، ميسور الحال ومالكا للأراضي في كفر لام (موشاف هبونيم)، قابعاً في حيفاه متزوجا ثلاث او أربع نساء حسب شريعة محمد (ص)، حيث أنجبن له العديد من البنين والبنات كان من بينهم عبد الرحمن الحاج، رئيس بلدية حيفا في سنوات العشرين، لم تر بلدية حيفا من المناسب تخليد ذكراه حتى العام 1998. وما زال منزله قائماً في شارع البرج "معاليه هشحرور" (تلة التحرير) اما مبنى البلدية فكان قائما عند مفترق شارع "ألنبي" (على اسم القائد البريطاني الذي "حرر" فلسطين من الاتراك) و "ستانتون".
اعلم أنه لا جدوى من الوقوف على الأطلال والبكاء، لكن رفقا بالذاكرة، إذ كيف سينسى آباؤنا احداث الـ 48 في حيفا؟ كيف لا يذكرون امرأة حملت الوسادة بدلاً من طفلها اثناء الهلع والخوف؟ ومراد عبدالله الذي أبقى "البريموس" مشتعلاً لشرب فنجان القهوة العصملية . ومحمد عيد الصغير، الذي أخذ مفاتيح بيته للعودة السريعة، كما فعل شاعرنا الكبير ابو سلمى من بيته في حي الألمانية. وهاكم جدّتي لأمي، تسلم الكوشان لأختها في السيارة وهما في المنفى في لبنان، ظانة أنه، بعد اسبوعين، ستلتقيان في داريهما، فراح الكوشان وبقي المكان. وهاكم جدي يدخل بيته بعد هدوء العاصفة فيجد حاخامين ليقولا له: "إذهب من هنا، ولا حق لك في أخذ شيء." وبعد إلحاح سمحا له بلملمة شهادات ميلاد أولاده لتبقى للتاريخ.
لقد أكثرت من التجوال في حيفا القديمة برفقة جدي لأمي، وحفظت ؟ عن ظهر قلب ؟ الكثير من المباني التي كانت تابعة للعائلات الحيفاوية، بيد أن جدي، ولشدّة تعصبه لحيفاه، لم يكتف بذلك، بل كان يشدد على معرفة منبع العائلة، أحيفاويّ هو أم من القرى المجاورة. فكان يشير: تلك مدرسة السباعي، والمدرسة الإسلامية، وتلك مقبرة الاستقلال، التي كانت ملكا لآل القط. وتلك عمارة آل عابدي في شارع "ستانتون" وأخرى في شارع "سيركن". وها هي دار نفاع، كيّلو، رنّو، بكير (من أصل طيراوي)، وها هو جامع الحاج عبدالله (أبو) يونس، يطل شامخاً من الحليصة. وها هي السرايا، مقر القائمقام. وها هي أملاك دار الخمرة - الصغير في درج الأنبياء، والجدع والدحبور وتوما وطوبي والقلعاوي والزعبلاوي و (أبو) زيد وخوري وصهيون وكوسا. فحفظنا الأسماء عن ظهر قلب. حتى إن ابنتي بدأت الدخول في دوامة المكان لتحفظ في ذاكرتها ؟ قدر المستطاع ؟ ولو جزءاً من التاريخ.. ومأساته.
وهل حدثكم ابن ابناء جيله، كاتبنا الكبير، اميل حبيبي، في متشائله وسعيد نحسه عن طرفة جدي لأمي؟ فقد كانت أيام ثورة الـ 36، وجدّي يحدثنا عن نجاته من محاولة قتله عندما اشتبه فيه الثوار بأنه يتعاون مع البريطانيين، حيث كان يبيع لهم الخيول. وكان هنالك أمر يمنع بيع أي شيء للجيش البريطاني. فسألناه: ولماذا كنت تفعل ذلك؟ فقال إنه كان يبيع الخيول "الكديش" اي (التعبانة)، فكانوا يسقونها النبيذ مع الماء حتى تثمل وتصبح مطيعة فيقتنيها الإنكليز. أو كانوا يقصون من أسنان الحصان حتى يبدو صغيرا، لأن الإنكليز كانوا يشترون الخيول الشابة فقط. فجاء الثوار، بقيادة شخص يدعى العسكري (قضى أيامه الأخيرة ؟ في سنوات السبعين ؟ في مقام الخضر (أبو العباس)، واقتادو جدّي لرميه في البئر عقاباً "لتعاونه" مع الانجليز، لكنه نجا بفضل قريب له كان من ثوار العام 1936 الذي تشفع له باسم الخضر وباسم "ستنا مريم".
وكان لهذا الجد صديق يهودي يدعى حاييم شميدوف، أصرّ على ان أحداث الـ 48 تدعى استقلالاً، أما جدّي ؟ وبفطرته ؟ رفض هذه التسمية، وبدلاً من أن يسميها احتلالاً سماها "استحلالاً" على وزن استقلال!! وما زالت والدتي تردد هذا المصطلح!
فالمكان هو حيفا بأزمنتها العثمانية والبريطانية والإسرائيلية، بأحيائها: حارة الكنائس، والوادي، وساحة الخمرة، وساحة البرج، والسعادة، وعمارة صائب سلام، والقشلة، والموارس، وبوابة الدير، والخضر (أبو) العباس، ونزلة الكلداوي، ووادي الصليب، والحليصة، وبحر (أبو) نصّور، وحارة الشوافنة، وكنيسة الروم، والجامع الكبير، وسوق الشوام، وغيرها من المواقع مما تبدّلت اسماؤها لكن المكان هو المكان نفسه..
.. فابقوا!!
اُنـطـق أيـهـا الحجر
في الاسبوع الأول من شهر تشرين الأول من العام 1995، أقيم معرض في مبنى "الشيكم الجديد" تحت عنوان "آثار سكانية" للفنانة ايلانة اورتار- سلامة وكان موضوع المعرض بيت عائلة الخوري الذي بنيت على انقاضه بناية شاهقة زجاجية سوداء، تجمع بين التجارة والمكاتب الحكومية والمقاهي ودور السينما. وبالإضافة للوحات الكولاجية فقد أنتجت وأخرجت الفنانة فيلما "قصيرا" على غرار "الفيديو آرت" تتحدث به عن قصة المكان من وجهات نظر مختلفة وكاتب هذه السطور كان احد المتحدثين.
ارادت الفنانة ان تروي قصة هذا المكان في ذلك الزمان دون ان تتخذ موقفا صريحا محاولة الابتعاد عن السياسة. ولا آخذ مأخذا عليها فليس كل شيء سياسة، الا أنه وبالذات هذا المكان وذلك الزمان هو السياسة بعينها. فالمكان "فيلا" بيت آل الخوري، وهو مبنى جميل واسع بني في اواخر القرن العشرين في الخط الحدودي بين حي الهدار اليهودي والحي العربي في درج الانبياء مقابل بيوت آل توما والخمرة وحبيب وبدران.
ومن المعروف أنه دارت معارك طاحنة في 22/4/1948 حول هذا الموقع نظراً لاستراتيجيته الهامة. وأصبح مصير البيت والعائلة كمصير حيفا آنذاك. لا نعلم بالضبط ما حل بعائلة الخوري لكننا نعلم علم اليقين أن مصير المكان- البيت هو نفس مصير العقارات والبنايات العربية التي تحولت لأيدي الدولة لإدارة أملاك العدو او الحاضر ؟ غائب. وفي الستينات جاءت أيدي الهدم على المبنى ومحت قطعة تاريخية مكانية ؟ زمانية هامة في تاريخ حيفا. فلو استطاعت حجارة البيت ان تنطق لسردت لنا التاريخ. لكن لا بأس فقد أقيمت البناية الشاهقة وبدأ الناس يؤمونها لشراء حاجياتهم وقضاء ساعات لشرب الجعة ومغازلة الشقراوات من الشعوب السلافية دون اكتراث للتاريخ ودون التفكير ولو للحظة ان "شيئاً ما حصل هنا". طبعا، ليس لنا مأخذ على الزبائن فنحن منهم، لكن رفقاً ورحمة بالقيم التاريخية. لسنا دعاة تخلف وتراجع والعيش في الماضي لكنه كان من الممكن الحفاظ على البناية وإعادة ترميمها. بيد أن السياسة التي كانت سائدة جاءت لتمحو كل ما يتعلق بتاريخ حيفا وعربها.
وفي هذا السياق أجريت عدة أبحاث عن تاريخ حيفا وعائلاتها العربية كان مرادها الإثبات بأن اصل العائلات العربية في حيفا جاء بالأساس من الأقطار العربية الأخرى كعائلة الحاج المصرية والخوري اللبنانية وغيرهما محاولين التلميح بأنه لا جذور للعرب في هذه المدينة. طبعا لا يمكن التحدث عن نقاوة الأصل والجذع فلا المانيّ مئة بالمئة ولا تركيّ مئة بالمئة وكذلك لا حيفاوي مئة بالمئة. ففلسطين لم تكن دولة مستقلة مطلقا على مر العصور وما كانت إلا مصرا من الأمصار العربية، وكانت العائلة تتجول في انحاء الامبراطورية العثمانية حسبما شاءت سواء طلبا للرزق، او الزواج او الثراء.
ومهما يكن من أمر فحيفا هي حيفا وكي يتعرف الشخص عليها وجب عليه مخاطبة بناياتها القديمة وزيارة البلدة القديمة. فكان المستعمر البريطاني أول من اطلق تسمية ؟old city؟ على الرقعة الممتدة من ساحة الخمرة غرباً الى سكة الحجاز (عامود فيصل شرقا). ففي هذه الرقعة المهدومة تجد تاريخك. تخرج من ساحة الخمرة داخلاً الى حارة الكنائس معرجاً على "السرايا"، متجولاً في سوق الشوام، مصليا في كنيسة الروم وفي جامع الجرينة، زائراً الموتى في مقبرة الاستقلال، والجاً شارع العراق ثم صاعداً للحليصة لتؤدي صلاة العصر في جامع الحاج عبدالله ابو يونس. وبعدها تستطيع التنزه في حارة "ارض اليهود" عابراً شارع سيركن ونزهة والبرج لتدخل المدرسة الاسلامية "مدرسة الجمعية" (وزارة الداخلية تقريبا). ومن ثم ترجع الى ساحة الخمرة لتركب الحنطور لتصل الى محطة الكرمل لترى البساتين عبر شارع القشلة وابن الأثير لتنتقل بعدها عبر الموارس الى بوابة الدير ومن ثم الى واديك المحبوب وادي النسناس.
لعلّ هذه الرحلة القصيرة في رقعة المسافة الزمنية تجعلك بدون مكان وزمان، تجعلك ملحاحاً أمام حجارة المباني لتستنطقها لتأتيك بالأخبار من سفر الدهور، أخبار ظاهر العمر الزيداني، رشيد الحاج ابراهيم، الزعبلاوي، الجدع، عبد الرحمن الحاج، صنبر، عوض، الحجار، القط، حوا، عابدي، مصطفى باشا الخليل والقسام وغيرهم من الأسماء التي تعجز ذاكرة الجيل الثاني بعد النكبة عن احتوائهم. وتزودك الحجارة بكل حدث وتؤكد لك احداث نيسان من ذلك العام.
لا يكفي النظر الى الوراء فالزمان يسير من الماضي الى الحاضر والى المستقبل، لا يمكن إرجاع عجلة التاريخ. علينا ان نتطلع الى الأمام، الى حيفا عصرية ذات احياء نظيفة ومراكز جماهيرية فعالة ومجهزة بجميع اللوازم، و... و القائمة طويلة والعمل شاق، شاق جداً. فدعونا نتكاتف ونلبس مكاننا وزماننا حلة جديدة كقول شاعرنا الكبير عصام عباسي رحمه الله "وكيف سيضحك هذا الزمان اذا لم يدغدغ بكل يد".
لكلٍّ حيفاه ولكلٍّ نكبته
سقطت حيفا. هكذا كان جدّي ؟ رحمه الله ؟ يردد هذه الجملة مع التشديد على الفعل "سقطت"، وفيما بعد اختلطت التسميات وسط أهل حيفا الأصليين، فهناك من يقول: "عندما دخل اليهود" أو "لما راح الإنجليز". وهناك من يقول ؟ وهذا المثير للتساؤل:- "الاستحلال"، فلماذا لم يقولوا: الاحتلال؟ ومن المثير، أيضا، أن أهل حيفا ؟ عندما يريدون وصف أوضاع معينة ما قبل عام 1948 ؟ يقولون: "أيام العرب"، قاصدين بذلك آواخر الفترة العثمانية وبداية الفترة البريطانية وكذلك الحياة اليومية لهؤلاء الناس، حيث كانت الحياة تدار ببساطة خالية من التعقيدات.
لكل عربي حيفاوي قصة مع النكبة، وليس هذا فقط، فالنكبة جزء من حياته، يعيشها ويستنشقها بصمت ومن دون إثارة الضجيج حول ذلك.
وهناك العديد من الأشخاص الذين واكبوا النكبة بأجيال متفاوتة، فمنهم من كان ابن عشر سنوات او ثماني عشرة سنة.. وهناك من دخلت النكبة الى لا وعيه حتى إنه يكاد لا يجرؤ على المرور من أمام الأماكن التي تذكّره بذلك، من دون أن يدري السبب. فهم لا يجرؤون على المرور من وادي الصليب وأزقته الملتوية ودرجاته المتعددة، فضلاً عن حارة الكنائس التي هدم الجزء الأكبر منها مباشرة بعد العام 1948 ضمن برنامج "شيكمونا".
فإذا كانت، في السابق، حارة الكنائس هي الشاهد والمذكّر، فما تبقى الآن هو أطلال وادي الصليب المهدوم، وبعض الأبنية على تخوم شارع البرج وحسن شكري و "ستانتون" و الأفغاني. والخوف هو أن لا يبقى أي معلم حضاري يغذّي الذاكرة الجماعية أو الفردية.
إن من يتصفح ويطّلع على الوثائق التاريخية من صور وخرائط لحيفا يستطيع ؟ بسهولة ؟ أن يتعرّف على نوعية الحياة آنذاك، على الرغم من وجود الانتداب البريطاني. تستطيع أن تلاحظ عدد المدارس الكثير للمسلمين والنصارى واليهود، للبنين والبنات، والكنائس للطوائف جميعها، والمساجد والكنس اليهودية، والسوق، سوق الشوام والأبيض والجرينة، ومصنع الثلج في محطة الكرمل، والمقابر والنوادي والمرافق الحكومية والجمرك والأديرة والأراضي، مثل أرض البلان، أرض الرمل، الزحاليق، والأودية، مثل السعادة ورُشميا والتينة والسياح والحارات، مثل حارة اليهود ووادي الصليب والنسناس والمحطة والكنائس ووادي الجمال و "بات ﭽاليم"، و "نافيه شأنان" والحارة الشرقية، وكذلك الشواطئ، مثل شاطئ (أبو) نصور والعزيزية وغيرها من الأماكن. وإن ننسَ، فلن ننسى ساحة الخمرة، التي كانت بمثابة الساحة المركزية للبلدة القديمة منذ العهد التركي والمركز التجاري العام للعرب واليهود.
لقد كتب الشيخ عمر نمر الخطيب في كتابة "سر النكبة" ما كتب، وكان من ضمنه جملة ما زالت ترافقني أنا ؟ ابن الجيل الثاني بعد النكبة ؟ حتى يومنا هذا، حيث قال: "إن لسقوط حيفا سراً ستعرفه الأجيال القادمة" وهذا السر سأحاول إفشاءه ما دمت حيّا.
لقد تحدثت كثيراً مع الشيخ المشقّق الوجه (أنظر كتاب الأديب سلمان ناطور، "مانسينا") وهو حيفاوي أباً عن جد، وطرحت عليه السؤال: "ما رأيك في دولة اسرائيل؟" فأجابني قائلاً: "وهل تقصد دولة اليهود؟" فقلت: "نعم"، فقال: "هذه الدولة تستطيع أن توقّع العديد من الاتفاقيات مع دول العالم جميعها وبضمنها "م.ت.ف."، إلا أنها ؟ حتى الآن ؟ لم تأتِ إليّ للتباحث معي في شؤون قضيتي. فبيني وبينها قصة طويلة لم تبذل هذه الدولة جهداً لحلها. فأنا القابع هنا في حيفائي، أباً عن جد، سلبتني هذه الدولة أملاكي جميعها، وأنا الذي لم أبرح حيفا لحظة واحدة في أثناء الأحداث في نيسان 1948، ولم أعتبر حاضرا غائبا حسب قانونهم المجحف. ومع ذلك، فقد سلبتني حقي في الملكية والهوية وحتى اللغة." ويتابع الشيخ قوله: "في 22 نيسان 1948 كنت جالسا، كعادتي في الخان الذي أملكه في البلدة التحتا، بين شارع الناصرة وشارع العراق، أدّخن النارجيلة وأرعى شؤون الخان، وأذكر أنه كان يوما ماطرا على غير عادة في شهر نيسان وكأن الرب أو الخضر (أبو) العباس ؟ دستور من خاطره ؟ أراد ذلك ليشير إلينا بخطورة الأمر.
"إلا أننا لم نأبه، حتى سمعت بأذني دويّ القنابل التي بدأت تتساقط من شارع البرج و "ستانتون". فعند سماعي الدويّ الأول قلت: راح بيتنا، والدويّ الثاني راح الخان، والثالث راحت السرايا فالرابع والخامس.. إلا أنني.. خفت على أولادي، فأغلقت الخان، وبدأت أركض في أزقّة حارة الكنايس حتى وصلت ساحة الخمرة، التي كانت مليئة بالناس على غير العادة، عندها فهمت أن الأمر جدي جدا.
"وفي ساحة الخمرة قرب فندق "إيجد" التقيت شريكي اليهودي في المصلحة، وقال لي بالحرف الواحد: "اليوم عقدت جلسة في دار البلدية مع الخواجة شبتاي ليفي وممثلي العرب وتقررت دعوة عرب حيفا الى عدم النزوح"، فقلت له "على راسي وعيني.. ولكن الطخ والقتل والسلب والنهب ضارب أطنابه في حارة الكنائس ووادي الصليب"، فأجابني "دبّر حالك!!". فقلت في نفسي: سأدبّر حالي مثلما تدبّرت مع الأتراك والإنجليز.
فرجعت الى بيتي في حارة الكنائس فلم أجد زوجتي وأولادي. وقالت لي جارتي أم خالد، من دار القلعاوي، إن زوجتي خرجت مع الأولاد قبل ساعة ويمكن أن ألاقيها على باب الميناء. "إلا أنه في اثناء ذلك، حاولت الدخول الى بيتي فوجدت شخصين يهوديين متدينين قالا لي: "إنك لا تستطيع الدخول الى هنا، فهذا ملك مهجور، فاستعطفتهما فسمحا لي بالدخول، فلملمت بعض الأوراق، كانت بينها شهادات ميلاد أولادي. وبقيت الأوراق وضاع الحق الى يومنا هذا...". ويسأل الشيخ نفسه، ويحق، حتّام سأبقى ضائعاً بين نكبة القانون (الحاضر غائب)؟ وهل كتب عليّ وعلى شعبي الشقاء..؟
هذا غيض من فيض، فكما قلت: لكلّ نكبته، يستطيع أن يحدثنا عنها أياما وأسابيع، لتدخل إلينا نحن ؟ أبناء الجيل الثاني ؟ وتغذّي ذاكرتنا الجماعية كي لا ننسى. وبينما نحن منهمكون في نكبتنا يأتينا الباحثون والمؤرخون ليتجادلوا ويتباحثوا حول أحداث العام 1948 في حيفا، وليؤكدوا لنا، تارة، أنه لم يحصل تهجير بل كانت "أوامر من فوق" وتارة ليقولوا: لقد هرب عرب حيفا بمحض إرادتهم. فأجبهم أيها الشيخ، أيها الشيخ المشقّق الوجه.
رسالة من الجد « ق» إلى الحفيد « م» في حيفا
حفيدي العزيز "م"!
أخطّ لك هذه الرسالة استجابة لرسائلك العديدة التي كنت قد أرسلتها إليّ عبر ما يسمّى بالـ "انترنت". لم أستطع الرد عليها مباشرة، لأنه ؟ كما تعلم ؟ نحن الأموات ؟ لا ندري كنه هذه الآلة، حتى إن رسائلك لم تعرف كيف نقرؤها، الا أننا "استبشرنا خيراً" بوفود بعض الشباب إلينا، كنا قد أسفنا جداً لرؤيتهم بيننا، لكن ما العمل؟ فما في اليد حيلة، هذه هي مشيئة الله والقدر!
عزيزي "م" أعتقد أنك ما زلت على العهد، وما زلت تحفظ وتحافظ على السر الصغير الذي بيننا ورمزه 22/4/1948. لقد حاولت جاهداً أن ابعث إليك ببعض من الإشارات السماوية حاثاً إياك على أن تحفظ العهد، لكنها لم تصلك، فلا ضير! فها أنا أخطها لك كي لا تنسى الرمز وسرّه.
إعلم، يا حفيدي العزيز! إنني هنا في الأعالي ما زلت أحمل نكبتي على كتفيّ، وما يعزيني هنا أنني التقي، يومياً، اصدقائي من الطفولة، الذين سبق وحدّثتك عنهم عندما كنا سائرين سويّة بين أطلال ما تبقّى من حارة الكنائس، أوتذكر؟!.. ففي الصباح التقي صديقي اليهودي، شميدو، ونتبادل الحديث حول تجارة الخيول، ومن ثم أتجاذب أطراف الحديث مع صديقي الآخر، ماير الأزعري، ابن شفاعمرو، وغيرهما من أصدقائي أولاد الحارة الشرقية والكنائس ووادي الصليب، وبعدها أخلد الى النوم، حسب قوانين السماء.
أما بعد الظهر، فأنتهز الفرص لأتجوّل بين المعارف.. فقبل اسبوعين التقيت (بن غوريون) مرتدياً سرواله (الخاكي) كعادته، ودار حديث بيننا مفاده أنه يأسف لما يحصل الآن لشعب اسرائيل ويأسف لوجود قادة أمثال أريئيل شارون. فسألته: "أوَلم تأسف لنكبتنا؟" قال: "عام يسرائيل حاي" أي (شعب اسرائيل حي). فقلنا: ومن قال غير ذلك. فسكت. لكنني لم أسكت، فشتمته بالعربية، فشتمني بالـ "إيديش" . وبينما نحن نتبادل الشتائم، جاءني كل من الأفندي (شبتاي ليفي)، رئيس بلدية حيفا الأسبق، وحسن شكري بك، رئيس بلدية حيفا الأسبق، أيضاً، فرددت عليهما التحية بالتركية كعهدي في تلك الفترة، وحظيت منهما بجلّ الاهتمام نظراً الى معرفتهما بي وبعائلتي وبأصلي وحسبي ونسبي، لكني صرخت في وجه حسن شكري مذكّراً إيّاه بالشعار الذي رددناه آنذاك ضده، قائلين: "حسن بك يا ديّوس.. بعت الوطن بالفلوس"، فلعنني هو، أيضا، لكن بالتركية. أما (شبتاي ليفي) فذكرناه برمز السر فلم يدر ما هو الأمر، لكنه تمتم شيئاً ما بالتركية والعبرية والعربية!
حفيدي العزيز! هذا هو القليل عن حياتنا في الأعالي، لكن خبّرني بالله عليك، ما أصابكم، ماذا دهاكم يا "عرب اسرائيل"، ما الذي سمعناه عن مدينة الناصرة ، ما هذا الذي نسمعه عن المسيحي والمسلم؟! أهذه هي ناصرتنا؟ أهذه هي حيفانا التي تركناها لكم مع رمز السر؟ إنك تحدثني، وبكل وقاحة، أن أموال الوقف في حيفا ما زالت تؤكل. صحيح أنني مخضرم وقد عاصرت هذه البلاد منذ حكم الأتراك فالإنكليز واسرائيل، وأعلم أن اموال الوقف بدأت بالتآكل منذ رمز السر، إلا أن ما جاء في رسالتك تقشعر له الأبدان.. وهل للأموات أبدان؟
قل لي بربك! ألم يتبقّ بعض من البنايات التي كنت أحدثك عنها؟ فهل السرايا ما زالت قائمة رغماً عن وجود الملاهي والمراقص للأجيال المراهقة فيها، هل مقبرة جدي حسين القط ما زالت قائمة بشقيها "الفوقا" و "التحتا"؟ حدّثني يا جدي، هل بقيت الآثار؟ هل بقي المكان؟ هل بقي الزمان؟ هل بقيت أملاكنا في شارع "سيركن" و "ستانتون" وقبالة راهبات المحبة؟ هل بقيت المسامك؟ هل بقيت دار عبد الرحمن الحاج، رئيس بلدية حيفا الأسبق، في شارع البرج 13؟.. هل وهل..؟
حفيدي العزيز! نحن عشنا النكبة، ذقناها، ذقنا مرارتها و "حلاوتها" على طراز المتشائل، ومهما يحدث من أمر فنحن ما زلنا شعباً منكوباً.
إنك تحدثني عن إسلام اوروبا وكوسوفو وألبانيا، وكأنك يا جدي! تذكرني بأيام الدولة العثمانية، بأيام "السفربرلك" (الحرب العالمية الاولى). فالعديد من أبناء عائلتي خدم في العسكرية العثمانية رغماً عن أنفه، منهم من وطئت قدماه بلاد البلقان، وآخرون منهم وطئوا بلاد اليمن وحتى المغرب العربي... فكلنا كنا عثمانيين.. ومن بعدهم "جاء الإنجليز" (الانتداب البريطاني) لتتقوى عروبتا، وبعدها "عند الاستحلال" لم نصبح اسرائيليين.
قلت يا حفيدي! إن بعض الأشخاص الآن يعيش من دون نكبة، فهل يُعقل هذا الأمر؟ العيش هكذا من دون نكبة، من دون حساب دنيا وآخرة؟ فما أنتم فاعلون؟
تستطيع هذه الدولة أن تحتفل بعيد استقلالها كما شاءت وكيفما شاءت، إلا أن احتفالها منقوص ما دامت تتنكر هي وتنفض يديها ؟ كبيلاطس البنطي ؟ من شراكتها في مأساتي ومأساة شعبي، فهي غير مستعدة لتعترف بما اقترفت يداها من جرائم في حقي وفي حق شعبي، في حيفا وغيرها، أنا لا أنكر حق أبناء عمنا، بل قل إخوتنا لأبينا، ابراهيم الخليل، في العيش بكرامة وحدود آمنة، لكن آن الأوان لأن تخاطبنا الدولة ليأخذ كل ذي حق حقه.
هم يتحدثون عن قانون الحاضر ؟ غائب، أما أنا فلم أكن غائباً عن حيفا ولو هُنيهة. كيف أغيب عنها وقد أصبحنا توأمين، أعرفها وتعرفني، أعرف فيها كل حجر دقّ من بحر العزيزية الى بحر أبي نصور، فالكروم والموارس وبوابة الدير وأرض البلان والمحطة وطريق يافا وبستان الانشراح والألمانية ووادي النسناس والصليب والحليصة، ولا أنسى حارة الكنائس، مرتع صباي، هذه الحارة، التي علمت منك انها ستصبح مجمع الحكومة، وكيف ذلك يا ولدي؟ لقد أبيدت حارة الكنائس ومنطقتها التي تعتبر بلهجتنا المحلية "البلد" شرّ إبادة، كمن يريد محو آثار الجريمة، ولكن هيهات، ما دامت أجراس كنيسة الروم الأرثوذكس تقرع، وما دامت مؤسسة "بيت النعمة" قابعة في كنيسة "السيدة" تستقبل الشباب من الطوائف والملل جميعها، كعهدها، وما دام أذان جامع الاستقلال يصم آذان من لا يريدون سماع النداء والتاريخ.
إسمع يا حفيدي! كل من يسألك عن تاريخ حيفا أرسله الى "البلد"، الى ما تبقّى من معالم، وقل له بصوت عالٍ من دون جزع أو خوف، هذه ساحة الخمرة، هذه عمارة اللاتين.. وقف الروم، بنايات آل توما، السوق الأبيض، سوق الشوام، عمارة سلام، وهنا دار سقيرق، وهنا خمارة فاطمة الزعرة.. أما هناك فنادي الأرثوذكس الذي كان زيتونة فلسطين، الشاعر ابو سلمى، عضواً فيه، وبلّغ الأمر للذين يجهلون تاريخنا المتسامح والمتآخي.
يا حفيدي! لا أريد أن أطيل الحديث، ففي جعبتي الكثير الكثير لأحدثك عنه، وسأختم رسالتي بسر آخر لا تعرفه أنت، ففي نيسان 1998، كنت قد التقيت ؟ هنا في الأعالي ؟ الخواجا شلومو، وهل تعرف مَن هو شلومو، إنه الوصي على أملاك الغائبين. التقينا كي نستمر في التفاوض معه على أملاكنا. فيا لسخرية القدر، أنت لا تعلم أنه في عام السر ورمزه سكنت في حي وادي النسناس بعدما أجبرتنا قيادة "الهاﭽاناه" على التقوقع في هذا الحي تاركين أطياننا وعقاراتنا وطفولتنا في حارة الكنائس ووادي الصليب. وكنت قد امتلكت ؟ في هذا الحي ؟ بيتا ورثته عن أحد أقربائي، إلا أن البيت اعتبر ملكا للغائب، وبالتالي كان الخواجا شلومو، ومن قبله الخواجا ريخوشوفيتش ، قيّماً ووصيّاً أميناً على هذا الملك، فباعني حصة من هذا البيت حسب قوانين لا ادري كنهها "حماية المستأجر"، وفي أوائل التسعينات وقبل تلبيتي دعوة الرفيق الأعلى، بدأت التفاوض مع الخواجا شلومو لشراء حصتي كمالك لجزء من البيت الذي ورثته، إلا أن الأقدار شاءت أن أستمر في التفاوض معه هنا في الأعالي، وما زال النقاش مستمراً. مع العلم أنه وصلت مسامعي عن طريق ما تسمونه بالـ "ﭙلفون؟ ، بوساطة الأقمار الاصطناعية، أن شركة الخواجا شلومو تقدم تخفيضاً يصل الى 40% من سعر البيت..! على كلٍ يا عزيزي! سأخبرك بالمستجدات. عندنا الجميع في خير، إلا أن تلويث البيئة لديكم وصلنا ويؤثر على صحتنا.
وفي الختام لكم أحر السلامات من أحبائكم، أبناء حيفا: المطران حجّار، عبد الرحمن الحاج، د. عثمان الخمرة، المحامي أنس الخمرة، الدكتور حمزة، إبراهيم الجارحي، أحمد كيلو، رفعت عابدي، الياس صهيون، محمد علي دلول، جميل عصفور، ميخائيل توما، سليم سبيرو، سامي طه، الحاج طاهر قرمان وحتى من سهيل بن حسن شكري.
كما يَهديكم السلام الحار كل من: المحامي حنا نقارة، د. اميل توما، اميل حبيبي، علي عاشور، علي الخمرة، عصام عباسي، صليبا خميس، آرنا مار ؟ خميس، بولس فرح، شفيق وجورج وتسيبورا طوبي، د. إدوار الياس، ديب عابدي.. ولك سلام حار من الوالد والجدة.
ودُمت لجدّك
" ق "
أين أنتَ يا رشيد الحاج إبراهيم؟
منذ بضع سنوات أخذت على عاتقي كتابة نص واحد كل سنة في ذكرى نكبة عرب حيفا، على أن يصدر قريباً من تاريخ سقوطها في 22/4/1948.
وفي هذه المرة وجب علي أن أقول الصراحة بأنه لكثرة اهتمامي بالموضوع حسبت نفسي وكأنني عشت تلك الأيام، أيام العرب، حتى العام 1948، فبدأت أؤرخ الأحداث بقبل النكبة وبعدها، فأصبحت أقول بأنني وُلدت بعد النكبة بـ 12 عاماً، ووالدتي، أمد الله في عمرها، ولدت قبل النكبة بـ 14 عاماً وهكذا دواليك. ولكثرة ما سمعت عن ذلك الحدث من كبار السن، وكذلك عن الحياة ما قبل النكبة بدأت أتجول في مكان الحدث والحياة باحثاً عن اولئك الأشخاص الذين صنعوا التاريخ، اولئك الذين عاشوا يومهم الإعتيادي وخططوا للمستقبل الذي خانهم أيما خيانة، علماً أنه لم تكن في الموضوع أية صدفة.
كنت أتجول في وادي الصليب وموقع البرج حاملاً في ذهني صوراً عن الوثائق العديدة التي وقعت بين يدي بهذه الطريقة او تلك، أحمل الخرائط الانتدابية وأسماء الشوارع والمحلات والحارات وأسماء العائلات، أحمل سجل هذا الشعب ويومياته، فأصبحت أرشيفاً متنقلاً يحمل مقولتي الزمان والمكان يتنقل بينهما بأبعاد مكانية وزمانية تمتد من الماضي الى الحاضر والمستقبل. فلا مستقبل بدون ماض، وما هو ماضينا؟ يسألني سائل هل ما نطمح ونصبو اليه هو الرجوع الى الماضي؟ فأجيب ؟ كلا، انما لن نستطيع الخروج من هذه الدوامة طالما لم ندرك نحن، ابناء الجيل الثاني بعد النكبة، أبعاد وجوهر ما حصل في حيفا وغيرها من المدن والقرى. حقاً انها نكبة شعب، انها نكبة سياسية ؟ اقتصادية اجتماعية ؟ نفسية ما زلنا نحصد آثارها وتأثيرها في شتى مجالات الحياة.
كل هذه المناجاة راودتني في أثناء تجوالي في المكان والزمان. فالمكان موقع البرج قرب دار عبد الرحمن الحاج، رئيس بلدية حيفا الأسبق (عم جدي لأبي وعم جدتي لأمي) والزمان قبل النكبة وتبدأ القصة على النحو التالي:
من المعروف أنه حسب القوانين المساعدة للسلطات المحلية يجري الإعلان عن البنايات ذات القيمة الفنية ؟ الهندسية ؟ المعمارية والتاريخية كبنايات محمية، وعلى من يمتلكها ان يرممها حسب ما كانت عليه في الأصل. وما يقوم به المهندس المعماري هو إجراء "بحث الصيانة والحماية"، فإلى جانب الوصف الدقيق لحالة البناية لما كانت عليه، يقوم المهندس بالكشف عن مالكي البناية وكتابة نبذة تاريخية قصيرة عن الملكية. وهكذا تعرفت بالصدفة على مهندس شاب (اخينا من ابينا ابراهيم الخليل) أراد أن يجري بحثاً عن بناية قائمة في شارع البرج (معاليه هشحرور) رقم 9 ب. لم يعرف المهندس التفاصيل التاريخية عن البناية، إلا أنه تمكن من الدخول بإذن "المالك" الحالي الذي ابتاع البناية من شركة عميدار وكيلة دائرة أراضي اسرائيل، "الوصية" على أملاك الغائبين. وفي البحث عن "الحقيقة" التي لا يعرفها المهندس وجد "كنزاً" من الأوراق والكتب ظانا أنها تابعة للرئيس (عبد الرحمن الحاج، هكذا كانوا يدعونه في تلك الفترة). ومن نظرة ثاقبة في الوثائق يتضح أن البناية "كانت" ملكاً لرشيد الحاج ابراهيم من كبار رجالات حيفا، وحسب قول جدي لأمي، فقد كان الحاج ابراهيم "اكبر زعيم وطني في حيفا وأعضا كبير" والمقصود بذلك عضواً، فكلمة عضو مجلس أو أي عضو في هيئة إدارية عثمانية كان يدعى في التركية منقولاً عن العربية بـ "آزا" أي عضو، وبالتالي دخلت هذه الكلمة (اعضا) في البروتوكولات الرسمية وفي اللغة الشعبية. أما رشيد الحاج ابراهيم الذي نبحث عنه وعن نكبته فهو من مواليد حيفا في العام 1888 ويعتبر من القادة السياسيين وأرباب التجارة في حيفا. اشتق طريقه كموظف في سكة الحديد الحجازية ليصبح بعد عدة سنوات مديراً للمحطة. في بداية الثلاثينيات أدار شؤون البنك العربي في حيفا، وفي نفس الوقت بدأ نشاطه السياسي ؟ الاجتماعي الوطني حيث كان عضواً في اللجنة العربية ومن نشيطيها المتشددين. وفي العام 1930 عُين رئيساً للوقف الاسلامي وفي العام 1932 كان من مؤسسي حزب "الاستقلال"، وكان رئيسا لجمعية الشبيبة الاسلامية في حيفا ومن رؤساء التنظيم السري لمجموعات الشيخ عز الدين القسام.. وفي العام 1934 أصبح عضواً في المجلس البلدي مع عبد الرحمن الحاج. وفي نيسان 1936، استقال من العضوية معه ليشكل فيما بعد رئاسة اللجنة القومية في حيفا. يعتبر رشيد الحاج ابراهيم من مؤيدي المفتي الحاج أمين الحسيني. وفي العام 1938 نفي الى جزيرة سيشل وفي العام 1940 عاد الى وطنه فلسطين وشرع في تجديد نشاطه حيث استعاد نشاطه الاقتصادي ؟ الاجتماعي والسياسي وسعى لتشكيل قيادة عربية في حيفا. وأصبح رئيساً للغرفة التجارية الحيفاوية وبادر للتحضير للمؤتمر القطري للغرفة التجارية العربية في كانون الأول 1942. ومن نشاطه في هذه الفترة تفعيل "صندوق الأمة" حيث أصبح من الفاعلين في إدارته. وفي العام 1945 قلص من نشاطه السياسي ليتفرغ للمجال الاقتصادي حيث تعامل مع التجارة والبنوك ولا سيما في مجال التبغ.
أما في سنوات 1947 ؟ 1948 فقد كان رئيس "اللجنة القومية" في حيفا الموالية للمفتي ومسؤولا عن الدفاع عن المدينة، وفي نيسان 1948 اضطر لترك المدينة كغيره من السكان ليصل الى الاردن ويصبح مديرا لفرع بنك الأمة في عمان الى أن توفي في العام 1953. ويقال أن رشيد الحاج بدأ في كتابة مذكراته خلال النصف الثاني من الاربعينيات إلا أن مصيرها غير معروف.
هذا هو رشيد الحاج ابراهيم، من رجالات حيفا، وهذا ما تبقى منه، إلا أن وثائقه المستفيضة في الحياة ستبقى نصبا تذكاريا لجيل النكبة وجيل ما بعد النكبة. فمن جولة سريعة في الوثائق نصل للاستنتاج البسيط أنه في تلك الأعوام التي قبل الـ 48 كانت حياة اقتصادية ؟ اجتماعية ؟ سياسية ؟ عارمة بعكس ما ادعى "الختيار" بن غوريون والذي دعاه جدي لأمي "بلا غليون". وفي الوثائق العديد من الكتب المدرسية باللغة التركية كالجغرافيا والرياضيات، التي كانت تدرس في تلك الفترة حتى بعد انتهاء الاستعمار التركي في العام 1918. أما المميز في هذه الوثائق فهو دفاتر الحساب التي كان يديرها الحاج ابراهيم سواءً في اللغة العثمانية او العربية، لكنه كان حريصاً ان تكتب التقارير المالية والصفقات المالية باللغة التركية. ومنها دفاتر سجلات العمال واسماؤهم واسماء قراهم ومدنهم، فنجد بيروت وصيدا وصور، وطرعان وكفر كنا والناصرة وجنين ونابلس وكذلك العديد من القرى التي لم يعد لها أي ذكر.
طبعاً هنالك العديد من الاشياء الجديرة بالتحليل والبحث الاكاديمي ؟ المتحفي، إلا وجدتني في حيرة من أمري لأن تجوالي في تلك المنطقة قد "الاص" الأمور عليّ، ولا تسألوني ما معنى "الاص" لأن عائلتي الحيفاوية الجذور هكذا قالت ؟ على وزن "هكذا قالت العرب"!
سبق وذكرت لكم أنني أعيش الحياة اليومية لعرب حيفا ما قبل النكبة، ولهذا وجدتني اخترق بنظري جدران ما تبقى من البيوت القديمة في وادي الصليب باحثاً عن وثيقة ما تثبت لنا وجودنا، حتى انني بدأت أقلد المتشائل في مشيته، حيث كان يسير ملقياً نظره الى الأرض لربما وجد شيئا نفيسا. إن ما وجدته لم يعد لي... ولكن...
نعم هذه هي بنايتك يا رشيد الحاج ابراهيم، هذا هو برجك، هذه هي وثائقك، وخط يدك الذي لم يعد ملكاً لك ولنكبتك بل أصبحت ملكاً لنا جميعا ولنكبتنا، هذه هي حياتك التي أصبحت حياتنا. فاعلم يا رشيد افندي أن جيلنا يعرف كيف يدافع عن حقوقه ويدرك من اين تؤكل الكتف.
فنم قرير العين في ارضك وسمائك لأننا سنكمل الكفاح.
جدّي العزيز قاسم بن ديب
عطفاً على رسالتك التي كنت بعثت بها إليّ من أجوائك السماويّة هناك، أنقل لك تحية حارة من حيفا الى سمائك. كيف الحال والأحوال؟ عندنا الجميع بخير، إنتظرنا فنحن اللاحقون.
وبعد،
مرّت سنتان على رسالتك، ولا استطيع أن أحدّد، الآن، الأحداث وأرويها لك، إلا أنك ستراني استعرض بعضاً من احاديثك عن ذلك الزمان وذلك المكان، فهي فعلاً خواطر زمانيّة.
جدّي العزيز! أَتذكر طيّب الذكر رشيداً الحاج ابراهيم الذي وصفته بأنه كان "أعضا كبيرا"؟ راح الأعضا وراح بيته الذي كان قائما في شارع البرج 9، حيث هدم خلال شهر آذار الغدّار ولم يرف للبلدوزر جفن، حيث لا وجع ولا تنهّد. لم يرحموا التاريخ، فكيف سيرحمهم؟
أما افراد عائلتك من جميع أطرافها، فأصبحوا مزارا للباحثين من إخوتنا لأبينا الخليل، يأتون من مختلف الجامعات لتسجيل أصواتنا و "تطقيعنا" الصور الصامتة والمتحركة منها ليوثقوا ما كان علينا، نحن ؟ أبنا الجيل الثاني بعد النكبة ؟ توثيقه. يأتوننا وفي رؤوسهم تدوي دوامة الضمير على ما اقترفه أجدادهم بحقنا في حيفا، في موقع البرج "الهدار" وحواسة وبلد الشيخ. أَتذكر ما رويته لي من أحداث آذار ونيسان من ذلك العام؟ أتذكر كيف لملمت شهادات ميلاد أبنائك وكيف طردوك من بيتك، وكيف شققت طريقك في درب الآلام؟
وكيف قلت لي إنك تحملت العثمانيين والإنجليز وستتدبر أمورك مع اسرائيل؟! هكذا تمرّ الأيام ولا نعلم كيف تدبّرت الأمر في الزمن العصيب؟!
بالله عليك، يا جدّي! أجبني عن سؤال حيّرني جداً، هل كانت هنالك مجازر أم لم تكن؟ فقد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها حول هذا السؤال. أرادوا ويريدون التشكيك في روايتك ورؤياك، ويكذبونك في نكبتك. ومن تجرأ على إثبات المجازر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في الطنطورة، ساقوه الى المحكمة، ليس ليحاكموه هو ذاته، فقط، ليكون عبرة لمن اعتبر، بل ليحاكموك أنت الذي لم تفارق حيفا، حيث ولدت في أحشائها وداخل حارة الكنائس وعدت الى ربك مَرضياً من كفر سمير.
والآن، يا جدّي! يسألنا العقلاء منهم: وهل ستنتهي مشكلتنا فيما لو أعادوا الينا عقاراتنا وأطياننا؟ ونجيبهم بالسؤال: هل هذا هو حق العودة؟ هل هذا هو الحق الإنساني الذي ترونه مناسبا لحجم نكبتنا؟ وماذا فعلتم مع جدّي ومع آباء واجداد وامهات الآخرين القابعين والباقين في حيفا، أوَلا تذكرون كيف جمعتموهم ووضعتموهم في وادي النسناس وأغلقتم عليهم بالأسلاك الشائكة؟ ألم تنهبوا بيوتهم ومتاعهم؟ لماذا لم تتحدثوا إليهم؟ لماذا لم تعقدوا اتفاقيات "اوسلو" معهم؟ لماذا لم تضعوهم على طاولة المباحثات؟ أم أن تجنيسهم بالهوية الإسرائيلية كان الحل الأمثل والإنساني لنكبتهم؟!
أأحدثك يا جدّي! عن ذلك الشخص (ما بتعرف غيره) الذي "يحملنا الجميل تلو الجميل" حيث وجب علينا أن نعتذر اليه والى الصهيونية على سقوط 6000 مقاتل يهودي إبّان أحداث الـ 48، وعليك أن تقبّل يديه غير النظيفة على القفا والوجه؛ لأنه سمح لك بأن تبقى في حيفاك؟!
أم أحدثك عن ذلك الذي يسأل العربي الحيفاوي أبّا عن جدّ: من أية قرية أنت؟ على اعتبار أن لا عربي من أصل مدني والأنكى من ذلك انك حين تؤكد لهم أنك من حيفا يعودون بالسؤال "ومن أية قرية في حيفا انتم؟"
وأخيرا، يا جدّي! أطلب منك أن تقف يوم الحساب على قدميك متيناً شامخاًً أمام الملاكين الرحومين اللذين سيسألانك: ما اسمك وما دينك؟ فقل لهما بلا جزع أو خوف: حيفا مدينتي، وحاراتها مرتعي، جوامعها أذاني، كنائسها أجراسي، أناسها أخوتي، كرملها جبلي. وإنّني ولدت وعشت ومت على أنني "باق في حيفا".
وإلى اللقاء في نيسان القادم
حفيدك - (حيفا)
من نكبة إلى نكبة. من حيفا إلى رام الله
حفيدي العزيز!
عطفاً على رسالتك التي ارسلتها إليّ، سأحاول أن أردّ عليك ولو باقتضاب شديد؛ لأن ظروفنا السماويه لا تسمح لنا بالإطناب، وعلى الرغم من ذلك فأنا ملزم أن أقول لك:
ما أشبه هذا اليوم بتلك الأيام. ما يحدث اليوم كنا نتوقعه، علماً أننا لم نؤمن بأن ضحايا النازية سيرتكبون بحقنا تلك المجازر، ويمارسون ضدنا ما مورس على جلود وجثث آبائهم وأجدادهم في اوروبا المتحضرّة. كما لم نؤمن بأن "الحكام العرب"، ملوكاً وأمراء ورؤساء، سيعيدون الكرّة مرة اخرى ليؤكدوا لنا وللعالم خيانتهم وبؤس رجولتهم ومدى خَنَثهم.
لقد ودّعت حيفا أيام مؤتمر مدريد واستبثرت خيرأ، وزادني استبشاراً زيارة ابن البلد الأصيل، القائد الشيوعي توفيق طوبي ـ أمد اللّة في عمره ـ لتقديم التعازي لكم في بيتي آنذاك. وقد علمت انكم قمتم بزيارته في بيته، مما ترك فيكم عميق الأثر لما تداولتموه من أمور سياسية واجتماعية وتاريخية، ومن أهمها موضوعي أنا ؟ حيفا. فقد سبق وقلت لك إنني انا وحيفا توأمان. ارجو أن تكرروا هذه الزيارات لأبناء بلدنا وأن تتكاتفوا وتتكافلوا مع أبناء حيفا جميعهم. وعلى فكرة، متى ستقيمون جمعية عثمانية لأبناء حيفا؟ لكني أعيد وأكرر، انه إذا كان هنالك تاريخ لحيفا او ذاكرة لها فهما نحن ؟ أبناء ذلك الجيل.
إسمع يا حفيدي! انا على علم وإدراك أنه في مثل هذا الزمن العصيب لا وقت للرسائل، لا وقت للحديث ولا لإرسال التحيات، وكذلك ليس هو بالوقت المناسب للتحليل العلمي على الرغم من أمّيتي، وما دمت أميّا دعني أحلل لك ؟ مع احترامي لدراستك الأكاديمية ودرجتك العلمية في الاقتصاد السياسي ؟ أسباب ما يدور في بلادنا من أحداث دامية ومجازر شارونية. فهل تعلم أنه لا اقتصاد من دون سياسة وبالعكس؟ بالطبع تعلم، لكنك لم تدخل في عمق الأمور. فاعلم يا ولدي، أن اي نزاع يتأجج في الشرق الأوسط هو نتيجة لثلاثة أمور: اسعار النفط، بيع الأسلحة، وتنظيم حركة رأس المال. فقد ارتفعت مرة أسعار النفط من الدول المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط، وعلى رأسها ايران، بعشرات النسب المئوية، الأمر الذي أغضب الإدارة الأمريكية التي يقودها ؟ بالفعل ؟ ممثلو أكبر الاحتكارات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى، الملتفون حول بوش (من الجد الى الأب والى الحفيد) وهكذا، فكلما طرأت أية زيادة او اي احتمال لإرتفاع أسعار النفط العربي تزداد التوترات والانفعالات في الشرق الاوسط بإيعاز من الإنجليز (عفواً أقصد الأمريكان).
أما بخصوص الأسلحة والتسلّح والعسكرة، فعلى ما يبدو المسألة واضحة وضوح الشمس، إلا أنك لا تدري بما صرحه لي هنا في الأعالي السيد ريتشارد نيكسون، حيث قال لي ما معناه الويل ثم الويل للإدارة الأمريكية إذا اهملت مسألة إثارة النزاعات الإقليمية في العالم وإدارة الأزمات، لأنه في حالة الهدوء والركود النسبي لن يتم بيع الأسلحة، وسيكون وبالاً علينا إذا لم نبع الأسلحة الحديثة غير المجرّبة، وإذا ما اختزنت فستبلى. وبالتالي، لن نستطيع بيعها، وبالتالي فإسرائيل هي الأداة التي تجرب هذا السلاح على الشعوب العربية عموماً وعلى الفلسطينيين واللبنانيين خصوصاً، وعندها، فقط، نستطيع نحن والحركة الصهيونية في امريكا بيع هذا السلاح.
أما في ما يخصّ حركة رأس المال فأقول لك يا أيها الماركسي أنه طالما لم تنظم حركة رأس المال ؟ بغضّّ النظر عن شكل الانتقال، بمعنى الانتقال من بلد الى بلد أو من فرع الى فرع في الاقتصاد ؟ فاللجوء الى الوسائل الفاشية وارد في الحسبان، وهذا ما حصل في حركة التاريخ..
هل توافقني الرأي أيها الحفيد؟ قد تقول نعم وقد تقول لا.. لا يهمني.
كل ما يهمني هو كيف ستعمل انت ورفاقك لتخفيف العبء عن هذا الشعب. وأسألك بصراحة، كيف ستخرجني من نكبتي؟ قد أستبق الجواب لأقول لك إنه مهما فعلت ومهما قمت به من نشاطات فلن تستطيع إرجاع ما سُلب مني.. حقي في وطني، أرضي، مدينتي حيفا وأحيائها من وادي النسناس الى وادي الصليب ووادي الجمال ووادي روشميا؛ والحليصة وأرض البلان والزوارة والكروم والمرج والزيتون والحلقة والوردية وشاطئ الرمل و (أبو نصور) والعزيزية؛ وشوارع العراق والناصرة والجبل والراهبات والمخلّص وصلاح الدين واحمد شوقي والمامون والأخطل والفرزدق والصنوبر والأفغاني والملوك والبوتاجي، وغيرها مما استُبدلت اسماؤه.
لا اريد أن أقلل من أهميتكم، انتم ؟ الشباب ؟ في عملية ومهمة إرجاع حقوقي المسلوبة، لكني أود أن اؤكد لكم أن ما ارتكب بحقي وحق شعبي لا تستطيع عدسات الـ "سي.إن.إن" و "الجزيرة" وصفه. فما رأته عيناي في أثناء تهجير عرب حيفا في ذلك اليوم عجز عارف العارف عن وصفه.
يطلبون مني هنا في الأعالي أن أكف عن البكاء على الأطلال، والتوقف عن استرجاع التاريخ. كيف سأفعل ذلك ما دام اليهود قد استحضروا التاريخ من قبل 2000 عام وأعادوه، وأنا لا أستطيع أن أستعيده من 54 عاماً.
ودمت لجدّك
قاسم بن ديب عابدي
أين أنت يا دكتور عثمان حسن الصغير؟!
ويُسأل السؤال، لماذا نستلهم وحي النكبة؟ هل النكبة وحدها لا تكفي فنرفقها ونزيد عليها هذا الوحي؟ ثم أي وحي سيكون هذا، أهو وحي من غار حراء، أم من جانب الطور الأيمن، أم من بشارة الناصرة، أم من أجدادي الحيفاويين (الحيافنة)، أم هو آتٍ من غيلان وشياطين الشعراء في الجاهلية، ليمتد الى بلادنا فلسطين مع مسيرة الفاروق عمر بن الخطاب مع ناقته ليستقبله مطران الديار المقدّسة، أم هو وحيٌ آتٍ من بلاد الفرنجة والكلت والإنـﭽليز والقوط والآريين ممزوجاً بأرواح اخوتنا الساميين من تلك البلاد، أم، أم، وأم..؟
فهي نكبة، وهو وحي. وحي يذكّرنا جيداً بأننا ما زلنا نعيش النكبة، لكن بأشكال متطورة ومختلفة عمّا كانت عليه. لا تأريخ لهذه المدينة بعربها ويهودها يمكن بدؤه من دون النكبة، فهي نقطة الارتكاز لما قبلها ولما بعدها. وما جاء من بعدها من "نِعَم" وتحوّلات وتطورات لا يمكن أن يُنسينا ؟ ولو لحظة ؟ ما كان قبلها فالنكبة لا يمكن الحكم عليها فيما إذا قدّت من قبلٍ أو من دُبُر، فليس هذا هو الجوهر. كل ما أريد الإفضاء به ؟ أمام القارئ الكريم ؟ هو الإشارة والتذكير، وليس البكاء على الأطلال، علماً أن البكاء يحوي ؟ في طيّاته ؟ الألم والذكرى والذاكرة والتذكّر والأمل، أيضاً. فذكّر إن نفعت الذكرى.
لا اقصد بكتاباتي عن النكبة ووحيها استحضار الأرواح، لأستعطف وأستجدي أحاسيس قدامى الحيفاويين ممن كانوا قبل النكبة، من خلالها، ومن بعدها.
هاكم هذه القصة التي تدور أحداثها في فلك "ما قبل، في أثناء، وما بعد النكبة".
الدكتور عثمان حسن الصغير، ألا وهو الدكتور عثمان الخمرة (عم جدتي لأبي) كان من أوائل الأطباء العرب في المدينة، لا بل في فلسطين كلها.
تخرّج من جامعات جنيف وﭙاريس في تلك الفترة. الى جانب انتمائه الى عائلة حيفاوية عريقة، دُعيت ساحة المدينة الرئيسة على اسمها، فقد كان عضواً في المجلس البلدي من العام 1927 حتى العام 1934، أي خلال فترة المدعو "حسن بك شكري"، وفي العام 1934 لم يقدم ترشحه للانتخابات البلدية، بعدما تأكد من نوايا الاستعمار البريطاني وانتدابه المزعوم، تعيين رؤساء بلدية موالين لهم وللصهيونية. وقد انضم اليه ؟ في خطوته هذه ؟ كل من نصر الله خوري، الياس منصور، اسكندر برغش، عزيز ميقاتي، وجميل أبيض.
هذا الطبيب ورجل المجتمع آنذاك، قد أرخص عمره في سبيل المدينة والوطن. وحتى الآن، ما زال بعض السكان من قدامى الحيفاويين يذكرون له جميله في الطب والسياسة. قبل "الاستحلال" ؟ كما كان يقول جدي، توأم حيفا:- "كان الدكتور عثمان (وكانت تخرج من فمه لفظة الدكتور باستبدال خفيف للدال بالتاء، فكانت قريبة من التكتور مع مدّ الواو) ضليعاً في مهنته، انسانياً في تعامله، فكانت تكفيه نظرة عامة فاحصة على المريض مع التدقيق في وجهه وحلقه وأذنيه والضرب بعض الضربات على بطنه، لكي يصف حالته وليعطيه وصفة دواء ليقتنيها من الفرمشيّة (الصيدلية) من ساحة الخمرة، حيث كانت عيادته وصيدليته التي أدارها فتحي جرداني".
ويذكر من تلك الفترة (ما قبل النكبة) أنه جاءه مريض يهودي من أصل عربي (يهودي ابن عرب ؟ شفاعمري) في صيف العام 1931، حيث كانت الحرارة مرتفعة جداً على غير عادتها، يشتكي الإسهال الذي يعانيه، وخجلاً منه، من أن يذكر للطبيب كلمة إسهال، قال له إن "الإمّاي في المجاري فاضت"، (اتّبع ان يقال إن الإمّاي هي القناة الرئيسة للمجاري، ولن أتدخل في سبب التشبيه). وللدعابة حاول الدكتور عثمان، عضو المجلس البلدي، الإتصال بالجهات المختصة في البلدية لينقل لهم هذه المشكلة، إلا أن المريض حاول عبثاً أن يقول له إن "الإمّاي" هي في بطنه.
أما في أثناء النكبة، فقد انتكب الدكتور عثمان كغيره من أبناء حيفا، وأصبح لاجئاً في مخيم جنين (يا للمفارقة.. نعم مخيم جنين). نعم أصبح لاجئاً مع رقم مسجّل في "الأونروا" (وكالة الغوث) بدلاً من رقمه كطبيب.. فلم يطق، بل قل لم يُسلّم بالأمر الواقع، فعمل المستحيل ليعود الى وطنه ومدينته. عاد "متسللاً".. (مُستنناً) (في اللغة العبرية) عبر درب الآلام، كغيره من أبناء شعبه، ليطرق باب صديقه اليهودي من تلك العهود، ألا وهو دافيد هاكوهين. ودافيد هذا هو ابن لعائلة يهودية هاجرت في بداية القرن العشرين من روسيا الى فلسطين ومن القدس الى حيفا. وقد خدم دافيد في الجيش التركي ومن بعدها نهل العلم في بريطانيا، وكان نشيطاً في الحركة الصهيونية، وفي العام 1927 انتخب ؟ مع الدكتور عثمان الخمرة ؟ لعضوية المجلس البلدي في حيفا، وقد نمت علاقة صداقة بين الإثنين ارتكزت على المصالح المشتركة لعمران المدينة وازدهارها.
في العام 1950 خرج عثمان من مخيم جنين بعدما دبّر أمور أولاده وزوجته (من عائلة حبيشي العكاوية). وبعد ولادة ابنه بدر الخمرة (طبيب في العلاج الرياضي، يعمل في رام الله، حالياً)، خرج من المخيم ليصل الى حيفاه. وما كان على دافيد هاكوهين إلا أن يذكر اللقاء التراجيدي المثير من ناحية، والمنفر من ناحية أخرى، في كتابه "حان الوقت للحديث"، ففي صفحة 303 كتب يقول: "على ما أذكر، فإنه في ساعة متأخرة من الليل طُرق باب بيتي الكائن على جبل الكرمل. إنتصب أمامي رجل نحيل مرهق، غير حليق اللحية، يرتدي بدلة بالية ويعتمر قبعة، إنه الدكتور عثمان الخمرة، صديقي الأسبق في مجلس بلدية حيفا. إنفجر بالبكاء لحظة عناقنا وكاد يجثو (على ركبتيه)؛ فقد عبر الحدود من جنين الى جبال "الـﭽلبوع" وهبط الى الشارع الرئيس في مرج ابن عامر في الظلام، انتظر الحافلة ووصل الى حيفا، الى بيتي. إستعطفني كي أساعده على البقاء في البلاد، فقد تعب من وجوده في مخيم اللاجئين في جنين؛ لأنه كان طريداً، مهيض الجناح، لا يمارس مهنته، كما أنه كان ملاحقاً من قبل المتزمتين. وقد كان مستعداً لأن يتنازل عن كل شيء، عن أملاكه في المدينة وعن مجد عائلته، من أجل أن يسمحوا له بالبقاء معنا. جهّزت له الحمام ليغتسل، وقدمت له الطعام وواسيته لمأساته وفرشت له فراشاً مرفهاً. وفي الغد سافرنا معاً الى الناصرة قاصدين صديقي عضو الكنيست، سيف الدين الزعبي ، حيث طلبت منه أن يساعده. لم يخطر ببالي أن أسلمه للشرطة كمتسلل عبر الحدود من أرض العدو، حتى إنني لم أقدّم تقريراً بذلك".
لا يسعني هنا ؟ كإنسان نزل عليه وحي النكبة ؟ إلا أن أشكر لدافيد أفندي (حسب سجلات البلدية) مواقفه الإنسانية والمؤثرة جداً، والتي إن دلت على شيء، فهي تدل على عمق العلاقات الإنسانية التي سادت في المدينة، بغضّ النظر عن الانتماءات القومية والطائفية، وليشهد على ذلك شبتاي ليفي أفندي، أيضاً، حين قدم كلمة تعزية قبل ظهر يوم الأربعاء، الواقع في 6 شباط سنة 1946، في الجلسة الثالثة والستين للمجلس البلدي، والتي تغيّب عنها "العضو الخواجة دافيد هاكوهين" (هكذا)، حيث قدم كلمة لوفاة المغفور له عبد الرحمن الحاج (رئيس بلدية حيفا الأسبق 1920 ؟ 1927) جاء فيها: "ومن المعلوم أن المغفور له قام بمهمة رئاسة البلدية خلال سبع سنوات متوالية، وبعدها انتخب عضواً في المجلس البلدي، وكان عملنا معه ؟ خلال هذه السنوات الطويلة ؟ بكل تفاهم وتعاون؛ لأننا كنا نفكر دائماً في مصلحة المدينة وعمرانها بغض النظر عن الاعتبارات الجنسية أو الطائفية، ونرجو أن تدوم هذه الروح بين جدران هذه المؤسسة لخير مدينتنا وازدهارها..".
فعلاً، فعندما نبحث عن أسباب ما يسمى بالتعايش الحالي لربما نجد له مستنداً وثائقياً وشفهياً من المعاصرين، وبالتالي نستطيع القول إنه كان لهذه المدينة تاريخ مشترك.
إلا أنك يا دافيد تراني مجبراً على مراسلتك في السماء في إطار رسائلي السماوية الى جدي. وأعدك برسالة خاصة لأعبّر لك عن عميق شكري وامتناني لمشاعرك ولمساعدتك للدكتور عثمان الخمرة، الذي سرعان ما طردته السلطات مع أخيه المحامي أنس الخمرة، الذي دعي الى الرفيق الأعلى في العام 1996، وهو في حصرته كلاجئ في عمان.
وفي رسالتي القادمة لك ؟ إن شاء الله ؟ سأقول لك إن مذكراتك وذكرياتك من تلك الليلة وتعابيرك، تحمل ؟ في طيّاتها ؟ ليس علاقة الصداقة القديمة، فقط، بل علاقة السيد بالعبد، علاقة المنتصر والمنتشي بالنصر على المهزوم والمنكوب. أهكذا يستقبل "البطل" أعداءه ؟ أصدقاءه المهزومين؟ هل بالتشفي والشماتة؟!
وفي العام 1967 تمتزج النكبة بالنكسة لتصبح "نَكبَسَة"، ننكبس بها ونغوص في مفارقاتها. ففي العام 1981 قمت بزيارة عائلة "مُنكَبسَة" في أحد المخيمات، كانت انتكبت في العام 1948 ولجأت الى المخيم وانتكست في العام 1967، وبقيت في المخيم. لم أعرف العائلة، إنما كنت رسولاً لإبنها الذي درس معي في الخارج. بدأ أب العائلة باستدراجي ليعرف أصلي وفصلي. وكان حين ذاك قانون الإرهاب في أولى خطواته. وحرصاً منا على سلامتنا من السين والجيم وطائلة العقوبات، اتفقنا على أن لا نكاشف بأسمائنا. إلا أنني لم أصمد أمام فِراسة الأب؛ حيث عرف من لهجتي أنني من الشمال، وكلما نطقت أكثر زادت معارفه "فوقعت" في كلمة "عاهة ومندبة" (وتقال للشخص الذي لا ينفذ الأمور بالشكل المطلوب). عندها أصرّ على أنني من حيفا. ثم تفرّس في سمرة بشرتي ليطرح السؤال المباشر: هل أنت من آل الخمرة؟ فلم أصمد أمامه، فقلت: نعم. فكان العناق والبكاء ليقول لي إن الدكتور عثمان الخمرة عالجه في حينه، أما أخوه المحامي، أنس الخمرة، فدافع عنه في إحدى القضايا في محاكم الانتداب. ومن ثم اختتم الأب حديثه بالقول "أنا من نكبة الى نكسة، فهل من منقذ؟!"
والآن ليفهم سائلي ما سرّ هذا الوحي الذي أحاول جاهداً أن أفكّ رموزه! إنها نكبة وهو وحي.
عالنَّاصْري...
هكذا كانت تخرج تلك الكلمات من فم ذلك الرجل الذي كان يقف عند ساحة الخمرة (الحناطير) في الطرف الأيمن شرقاً عند زاوية شارع الخطيب ومطعم (العبد) على حدود حارة الكنائس، مرتع ذلك الجيل ؟ جيل إبراهيم عاقلة وديب عابدي وفريد فرح وغيرهم من الأولاد. نعم إنه ذاك الرجل بالقبعة الفرَنجيّة الرماديّة اللون، أو قل ليس لها أي لون لكثرة استعمالها. حيث كان شغله الشاغل حثّ المارة على السفر "عَ الناصري" بسيّارات الأجرة على نوعيها من "الشقر" و "الدوزوتو". كان صوته ثخيناً كصوت "الجاروشة"، تخرج الأحرف ليس من فمه، بل من حلقه مباشرة فتبرز شرايين رقبته منتفخة الى حدّ الإنفجار، وإن خرجت من فمه فإنك تبصر أسناناً لم يُترك لها لون للبياض.
نعم إنه ذلك الرجل الذي لا أعرف اسمه ولا كنيته، لكنني أعرف أنه كان يقف على مفترق هام جداً في حياة المدينة في ذلك الزمان وفي ذلك المكان ؟ "البلد"، إذ ليس بالصدفة، أن دعونا ذلك المكان بالـ "البلد" قبل وبعد نكبة البلاد كلها. ويُستخدم هذا المصطلح للدلالة على الرقعة الزمكانية (زمان ؟ مكان) الممتدة من البوابة الشرقية (عمود فيصل والمنطقة) وحتى البوابة الغربية (ساحة الخمرة) فطريق يافا. عرب حيفا ما زالوا ينطقون ويستخدمون "البلد" على نقيض من يستخدمون "البلدة السفلى او التحتا". فالبلد ؟ بالنسبة إلينا ؟ شيء عظيم، أما الآن، فقد أصبح أشبه بمدينة أشباح، عمارات شاهقة ومكاتب وأسماء مختلفة.. "بال يام"، "ناتانزون"، "كريات هممشلاه"، عوضاً عن شارع أمية وساحة الجرينة وحارة الكنائس و.. و.. و.. وفي البلد، نحن ؟ أبناء الجيل الثاني للنكبة ؟ اشترينا معظم ثيابنا للمدرسة وأيام العيد من عند التاجر أبي داوود (يهودي ابن عرب) بالتقسيط، الممل والمريح (من دون شيكات ومن دون فيزا) على البساطة والأمانة، فقط، التي عُرفت قبل الـ 48.. هيهات!! فالبلد بالنسبة إلينا ؟ ليس المدينة السفلى أو التحتا كما هو مكتوب على اللافتات، بل قطعة تاريخية اقتطعت من جسدنا بعدما تمّ محو المعالم حسب خطة "شيكمونا" خلال ايار ؟ آب 1948، حيث أتت الخطة على مساحة 250 دونماً كان بن غوريون طلب من رئيس البلدية ؟ في حينه، شبتاي ليفي ؟ تنفيذ أمر الهدم، إلا أن الأخير ادعى أن الأمر منوط بقرار عسكري وليس بقرار بلدي، وبالتالي فعلى الحكومة فعل ذلك. وفعلاً قام الجيش بتنفيذ الهدم. وفي هذا "البلد" وجدت المؤسسات المركزية والرئيسة للمجتمع العربي أساساً، منها الجوامع وأملاك الوقف والكنائس والمقابر والمدارس والأسواق والمقاهي والمحال التجارية، وإن نسينا فلن ننسى حانوت نعيم العسل في ساحة الجرينة، حيث كانت تحوي كل ما تبتغيه من بقالة وملبس وحاجيات بيتية.
إذاً، ما علاقة "عَ الناصري" بالبلد ؟ المدينة؟! إنها علاقة تاريخية تمتد من النكبة الى يومنا هذا، أولَم أقل لكم إن النكبة هي نقطة الإرتكاز؟ وفي هذا السياق، قد سبقني المحامي أيمن عودة، عضو المجلس البلدي، عن الجبهة، في مقالته "المدينة" في العدد السابق من صحيفة "حيفانا"؛ ليتحدث عمّا يسميه بالمدينية، استمراراً لما طرحه، سابقاً، حول انقطاع التطور المديني العربي للمدن العربية الفلسطينية قبل النكبة، وخصوصاً، مدينتي حيفا ويافا، وليخصّ بالذكر "العاصمة" و "المدينة" قاصداً بذلك الناصرة، العاصمة وحيفا، المدينة. وللتنويه، فقد سبق وطرحت هذا الموضوع، ولكن بالمنحى الفلسفي ؟ السياسي لعلاقة "عَ الناصري" بحيفا، وما سأطرحه الآن قد لا يمت بصلة مباشرة الى النكبة إلا أنه من وحيها. فالمدن الفلسطينية كانت ستتطور من دون نكبة، أو من دون دولة إسرائيل أسوة بباقي المدن في العالم. وكان للتجمع العربي الفلسطيني المدني في حيفا مواصلة دربه ليصل درجة الإرتقاء كباقي مدن الميناء في حوض البحر الأبيض المتوسط.
اليوم، نحن نشهد حركة اجتماعية ؟ اقتصادية ؟ سياسية نشطة في المجتمع العربي الحيفاوي، وهذا ما يثلج الصدور. فأنا ؟ كابن لهذه المدينة أباً عن جد- يسرّني أن تعاد اليها هذه الحركة. لكن من الملاحظ أن وتيرة التركز والتمركز فيها من قبل الجماهير العربية من خارج حيفا، هي في تسارع غير عاديّ.
وأقصد بذلك انتقال أو وجود معظم مقرات ومراكز الحركات السياسية والجمعية والثقافية فيها. وهذا الأمر، أيضاً، يثلج صدري ويجعلني أستعيد مجد الحركة النهضوية لمدينة حيفا من الصحافة والأدب والشعر ودور العرض (السينما) واللهو ومظاهر الحياة المدينية بكل معانيها وأشكال ظهورها. إذاً، ما الضرر في ذلك؟
جُلّ ما أخشاه أن كل ذلك يتم على حساب "عَ الناصري"، على حساب "قَرْيَنة" (من كلمة قرية) مدينة الناصرة وإفراغها من مضمونها كعاصمة الجماهير العربية الفلسطينية في اسرائيل، بإدعاء أنه ما زال يخيّم على مدينة الناصرة الفكر القروي الأبوي (البطرياركي) على شاكلة "نمط الإنتاج الآسيوي"، الأمر الذي يدعو الحركات الى الخروج منها، لربما!! لكن بالإضافة الى ذلك، فالمؤسسة الحاكمة ترحب بهذه العملية، تارة بالصمت وتارة بالتشجيع المعلن والمخفي منه. ويُسأل السؤال: هل من مصلحة الحكومة إفراغ مدينة الناصرة من جوهرها القومي والسياسي والإجتماعي والثقافي، حتى لا تسمع بعد الأصوات "المتطرفة" في واحة "القومية العربية" و "البنلادنية"؟! هل تقتضي مصلحتها إنتاج وإضافة آلاف عدّة من العرب للسكن في مدينة حيفا، الذين سيذوبون داخل 250 ألف يهودي من سكان المدينة، وبالتالي يتم تمريرهم من خلال مصفاة "الاسرائيلية" وتدجينهم بها؟! هل المقصود بالإفراغ النصراوي والإغداق الحيفاوي "بيتتة" (من بيت) العرب القادمين الى حيفا ومؤسساتهم والتقليل من "التطرف"، وبالتالي جعلهم مختلفين عن باقي شعبهم؟! لربما أنا على خطأ وأتمنى أن أكون كذلك.
فعلى الرغم من هذه التساؤلات، دعونا نطرح الحقائق ميدانياً، فما سينتج عندما نقارن مظاهرة ؟ على سبيل المثال لا الحصر ؟ تنطلق في الناصرة من "الكراجات" الى العين وتحمل الشعارات التي نعرفها ونرددها عن ظهر قلب، بمظاهرة تحمل الأهداف نفسها في حيفا، هل في اعتقادكم ستكون الشعارات مماثلة من حيث الشكل والتأكيدات، مع أن الجوهر واحد؟! فما نقوله في الناصرة ليس له أن يكون ؟ بالضرورة ؟ ما نقوله نفسه في حيفا ولو على سبيل التكتيك. وهاكم مثالاً حياً: الآن يقدمون لائحة اتهام ضد المحامي أيمن عودة لرفعه شعاراً خلال تظاهرة (رفع شعارات) وليس مظاهرة، يقول فيها "يا شارون يا قاتل.. الانتفاضة ستنتصر"، فهل كانت ستقدم بحقه لائحة اتهام لو رفع هذا الشعار في الناصرة؟!
ومما يزيد من التساؤل أنه حتى في داخل مدينة حيفا، ما نرفعه من شعارات في الكرمل يختلف (ليس جوهرياً) عما نرفعه داخل وادي النسناس، فكم بالحريّ ما رُفع من شعارات في "البلد" في ذلك الزمان وفي ذلك المكان؟! إننا على يقين من أن السلطة على دراية تامة بهذا الفصل وليس القول، وبالتالي ستكون مسرورة جداً باستيعاب الموضوع وتلك الحركات وتشجيعها معنوياً وربما مادياً من أجل حصر هذا "التطرف" الحاصل وسط "عرب اسرائيل" حسب تقرير "الموساد". وفي ما يخص الشعارات بين الناصرة وحيفا والكرمل ووادينا النسناسيّ، فنقول: نعم إنه من المعقول، لا بل من المطلوب، التأقلم مع البيئة السياسية والإجتماعية والضرب على الوتر الحساس واجتذاب النفوس، لكن ليس من المعقول إفراغ ناصرة البشارة من مضمونها وهدفها باسم هذا التكتيك أو حتى بادعاء أن المدينة قد أنهت دورها المديني ولنترك المكان فارغاً أمام "القروية". فإذا كانت النكبة في حيفا قطعت التواصل والإمتداد والتطور الطبيعي لمجتمعها العربي لأسباب نعلمها، فكيف لنا أن نقطع هذا التطور لمدينة الناصرة ومن دون نكبة تذكر. ففي نهاية المطاف نحن نصبو الى تطوير المدن والقرى العربية الفلسطينية في البلاد جميعها ؟ سواء أكانت الناصرة أم حيفا، فبغض النظر عن خصوصيات كل بلد وبلد، نأمل لحيفا تطوراً مزدهراً لعربها ويهودها وللناصرة ألف سلام.
وإن سألتني ؟ يا عزيزي القارئ، مرة أخرى ؟ ما علاقة "عَ الناصري" بحيفا ؟ البلد ؟ فسأقول لك إن ذلك الرجل ذا القبعة التي لا لون لها، وقف في مكان مفصليّ جداً، وهو في البلد، في ساحة الخمرة، في حارة الكنائس، وهو في الناصرة، رحمك الله يا رجل ورحم أجدادنا ومهما يكن من أمر فكلنا الى "عَ الناصري..".
فاطمة الزّعرة
نعم.. هي فاطمة الزّعرة، هذا هو اسمها وهذه هي كُنيتها. فرحلتنا اليوم، هي بإس (مبتدأ كل شيء) فاطمة المذكورة أعلاه. (وهنا لا يسعني إلا أن أستميح الفاطمات عذراً على هذه التسمية، لكنه، فعلاً، اسمها المَكنيّ) لن تتخطى "حدود البلد" ؟ رقعتنا الزمكانية ؟ وسنتمحور في الحياة الترفيهية وعوامل الحياة المدينية ومقوّماتها، لمدينة بحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط، هذا الحوض الذي يجمع مدن الشاطئ بروابط مشتركة بغضّ النظر عن الانتماء القومي، الحدود الجغرافية، العادات، وتقاليد كل شعب من الشعوب.
فالمدن التي يذكرها الكاتب العربي الكبير حنا مينا، في روايته الفذّة، "قصة بحّار"، وغيرها، هي المدن نفسها التي نتحدث عنها ومنها حيفا، طرابلس، اللاذقيّة، بيروت، أثينا، والإسكندرية.. ففي تلك الرقعة النكبويّة سكنت فاطمة، وللتدقيق أكثر، وحسب المسح الميداني الذي أجراه موظف البلدية في حينه، السيد جورج حزبون، حسب طلب بلدية حيفا الانتدابية عام 1945، فقد كانت مستأجرة في بلوك 10839/ قسيمة 98، ولم يكن في الإمكان التوصّل الى مثل هذه الدقة لوصف مكان سكناها من دون هذا المسح الميداني الذي أصرّت سلطات الانتداب البريطاني على تنفيذه تمشياً مع سياستها القاضية بشقّ الطريق واجتياز البلد تسهيلاً للحافلات العسكرية. كان هدفهم فحص إمكانيات الهدم بالتعاون المدروس مع المؤسسات الصهيونية لرسم مستقبل المدينة والبلد، فبفضل هذا المسح ذي الهدف المشتبه، استطعنا أن نعرف كيف، أين، ومتى سكن أجدادنا. الوثائق تشير الى العنوان (البلوك والقسيمة)، نوعية الحجارة، مساحة البيت، اسم المالك وورثته، المستأجرين، الجيل، العمل، القومية والدين. ومن اللافت للنظر أن اليهودي الذي سكن تلك المنطقة وُصف في الاستمارة تحت خانة الدين وليس القومية.
أما فاطمة ذاتها، فهي من أصل يافاويّ، أو ؟ كما اعتدنا أن نقول ؟ من يافة القدس. جاءت الى حيفا طلباً للرزق كغيرها ممن جار عليهم الزمن والزمان، لتصبح ؟ فيما بعد ؟ من كبيرات البطرونات في البلد. والبطرون لفظة لاتينية تعني حرفياً "المدافع" او "الحامي". قد اشتقت الكلمة، تاريخياً، من الحياة في روما. فكان البطرون عبارة عن مواطن حرّ ومتنفذ ومتساوي الحقوق يحمي مواطنين أحراراً أو مُعدمين. ثم تحوّل المصطلح الى مفهوم سياسي ؟ اجتماعي ؟ اقتصادي للدلالة على نوع من تنظيم، وصاية وحماية المتنفذين لمواطني (زبائن) روما وغيرها.
فاطمة ؟ بوصفها رمزاً من رموز حياة الترفيه في البلد، وكبديل للحياة البوهيمية، (البوهيمي: لفظة فرنسية تدل على الشخص الذي يخوض حياته من دون حسيب ورقيب ويترك نفسه عرضة للرياح) التي تميّزت في الثلاثينيات من القرن الماضي في حيفا كمدينة ميناء، وخصوصاً في الأحياء اليهودية، خدمة للضباط والجنود البريطانيين والبحّارة ؟ استطاعت أن تقدم خدماتها من خلال "العوالم" في قهوة (مقهى) "السنترال" في البلد. لربما كلمة "عوالم" مشتقة من اللفظة الساميّة (العبرية) ("עלמה" عَلْمه أي فتاة وעלם- عِلِمْ - غلام) لتنافس ما تقدمه الغانيات اليهوديات والأجنبيات في المقهى الواقع في مفترق شارع المفخرة (هرتسليا) وأنا فورتا (هنفيئيم) للزبائن الكرام.
فاطمة ؟ على الرغم من أفعالها كلها وأفضالها على من يذكرونها من أجيال النكبة، من أبناء حيفا وخارجها ؟ هي قصيرة القامة تتوسطها كرش، متوسطة الحجم، تخرج من أكمام قميصها المزركش زنود كزنود هرقل الجبّار لتتواصل مع أيد ممسوحة خالية من كل شعرة، تنتهي بحلى ذهبية من "الحيايا"، "السحّابات" و "المباريم" وصولاً الى الخواتم المرصّعة بفصوص ماسيّة وغير المرصّعة منها. أما خدّاها فتخالهما كيسين أحمرين لكثرة المساحيق، تتوسطهما دائرتان مرسومتان بشكل دقيق يعجز عنه المهندسون في الرسم والدقة. أما فمها ؟ فحدّث ولا حرج ؟ فلها فمان: الواحد طبيعي والآخر مرسوم؛ ففي تلك الفترة كانت تميل الشفاه المرسومة الى الحمرة القانية وفاطمتنا كانت تتفنن في ذلك. أما شعر رأسها فكانت تصبغه باللون الفاتح المائل الى "الشقار"، مرفقة به حلقاً من اللون نفسه، يتدلّى من أذنيها غير البارزتين.
وفاطمة ؟ بكونها بطرونة ؟ ذات تجربة في مثل هذه الأمور، كانت تجلب البنات الحسناوات من بيروت بإدعاء أنها تملك مشغلاً للخياطة. وشاءت الأقدار أن يدخل الى مقهاها غير المعلن ("كرخانة") الواقع قرب شارع البور (الميناء) شخص من بقايا النكبة ليلبّي رغباته، ليتفاجأ بوجود فتاة تستعطفه وتحدثه عن سبب وجودها في مثل هذا المكان، وتقصّ عليه قصتها المثيرة ومسيرتها من لبنان الى فلسطين طلباً للعمل في مشغل خياطة فاطمة الزعرة. فما كان من الرجل إلا أن يصدقها ويتعاطف معها، ومن ثم يكتب كتابه عليها. وما كان من المحكمة الانتدابية إلا أن تحكم بالعدل، خسرت فاطمة القضية، إلا أنها لم تخسر عملها و "مخيطتها".
قد كانت فاطمة قويّة ومدبّرة؛ فقبل المحكمة استأجرت خدمات كل من "زينب القرعة" و "زينب الهدروس" و "ماري الشورا" بثلاث تعريفات (العملة الفلسطينية قبل النكبة)، "ليردحن" لذلك الشخص ويبهدلنه أمام بيته. فقد كان ؟ في حيفا ؟ أربع نساء متخصصات بمجال "الردح" مقابل أجرة معينة. لا استطيع أن أشير الى الرابعة لأسباب الالتزام والنزاهة الصحافية. لكن ذلك كله لم يجد نفعاً؛ فالإقبال عندها كان مستمراً من جهة الرجال لتلبية الرغبات، ومن جهة النساء للعمل، فحتى بعض الحسناوات الحيفاويات عملن عندها، إحداهن كانت حيفاويّة من أصل جنوب لبناني.
وفاطمتنا هذه كانت تعاقر الخمرة، ولا سيما عرق "دكلوش". في إحدى الليالي ؟ بعدما شربت كمية لا بأس بها من ذلك العرق ؟ خرجت من "مخيطتها" سيراً على الأقدام لتصل الى بيتها في حارة الكنائس بمساعدة أحد معاونيها، وكان المعاون شاباً "أسود" تتعكز عليه في ترنحها، وصعدت بمساعدته الى سطح العمارة لتستنشق الهواء النقيّ الرطب. ومن كثر الحَم والحرارة طلبت منه أن "ينِش" عليها ليخفض قليلاً من درجة حرارتها ودرجة سكرها فكانت تقول له "نِش" يا "أخو الـ......." "و لك نِش"! وشمّرت فستانها لينِش عليها من أسفل! سُمع الشخير... شخير فاطمة الزعرة، إذ غطت في نوم عميق لتستيقظ في صباح 22/4/48 وتنتكب.
نعم، بكل بساطة.. حتى فاطمة الزعرة انتكبت، يرحمك الله يا فاطمة، ورحم زبائنك، فأنتِ ابنة البلد المنكوبة وجزء من "بانوراما" الحياة في ذلك المكان وذلك الزمان. ومهما يكن من أمر فهي نكبة وهو وحي...
مارغاروش
هل هنالك تراث حيفاوي خاص بأهالي حيفا؟ الجواب: نعم. إلا أنه غير مقطوع أو معزول عن مجمل التراثيات الفلسطينية وحتى العالمية. فتطوّر اللغة، مثلاً، أية لغة، هو عملية تاريخية معقدة مرّت بها كل الشعوب، حتى أن هناك تشابهاً في منطق ونهج إنتاج الحروف لدى العديد من الشعوب. وفي السياق نفسه والمسار تطورت التراثيات على أنواعها وتعدّديتها لدى معظم الأمم. فحيفا لم تكن بمعزل عن الحركة التراثية الفلسطينية والعربية والعالمية. فقد جمعت في داخلها تلك المكنونات والمكنوزات وجبلتها في أحشائها لتخرج الى النور فولكلوراً مميزاً لأهلها. لكن النكبة ووحيها ومن وقف ويقف من ورائها لم يمكنّوه من التطور أو حتى من الإنتشار داخل المجتمع العربي الحيفاوي بعد النكبة. فالبقية الباقية من عرب حيفا، الضائعة، الممزقة والمنكوبة، لم تستطع نشر هذا التراث، ليس لسبب سوى لإقترانه بالصدمة (تراوما). فالصدمة كانت قاتلة لدرجة لا يقدر المصدوم ؟ المنكوب بها على البوح بالكلمة على الرغم من أنه "في البدء كانت الكلمة". وكان لهذه الكلمة ؟ التراث أن يُنشر ويتطور بانسياب طبيعي. وبينما نتخبط بالإنسياب وغير الإنسياب فقد سبقنا أخوتنا لأبينا الخليل في البحث عن هذا التراث ليجعلوا منه أداة لحصولهم على هذه الرتبة العلمية الجامعية أو تلك. فذلك الأخ يبحث عن لهجة عرب حيفا الأصليين (وإنتو خلّيتوا أصليين؟!)، وتلك الأخت تبحث في اندماج العرب في بيئة جبل الكرمل قبل العام 1948! وذاك الأستاذ الجامعي يتخصص في نوع مأكولات عرب حيفا قبل النكبة! فنحن المقصّرون.
وما دمنا مقصّرين فلا بدّ من بداية ما، تلك البداية التي افتتحها ومهّد طريقها الأدباء أمثال اميل حبيبي وحنا أبو حنا والعديد ممن كتبوا سيرتهم الذاتية من خلال تطرّقهم الى حيفا المدينة وعائلاتها وشوارعها، وإلى أسماء رجالات صنعت تاريخ هذه المدينة أمثال جميل البحري، أبو سلمى، عز الدين القسّام، سامي طه، سليم الخوري، راجي صهيون، رشيد الحاج ابراهيم، حنا نقارة، حبيب صنبر، حنا عصفور، عبد الرحمن الحاج، المطران حجّار، نمر الخطيب، مصطفى باشا الخليل، محمود الماضي، نجيب نصار، وغيرهم الكثير ممن لا تستطيع الذاكرة تحمّل وزن أعمالهم وعطائهم للمجتمع الحيفاوي بشكل خاص، وللمجتمع العربي الفلسطيني بشكل عام.
ففي كل رقعة من أحياء حيفا ستجد تلك المؤثرات من الحجارة والشبابيك والأقواس والشرفات التي ستروي لك قصة ذلك المكان وذلك الزمان. إذن، فنحن بصدد بقع ورقع زمكانية متناثرة في تلك الرقعة الممتدة من ساحة الخمرة (الحناطير/ باريس) غرباً الى عمود الملك فيصل شرقاً. ففي هذه المساحة المنكوبة ما زال بعض من الحجارة القديمة تقاوم مخطط الهدم وسحق المعالم العربية. فجامع "الجرينة" الذي كان أطول عمارة في "البلد" أصبح قزماً أمام "عمارة الحكومة" يكاد يدخل قمقم سليمان الحكيم مع جانه أشمداي. أما "كنيسة السيّدة" التي أحياها ونفخ روح "ستنا مريم" فيها، من جديد، طيب الذكر، كميل شحادة، فقد اختفت عن الأنظار ليحجبها بنك "إيـجود" ومكاتبه المكيّفة. وفي "حارة الكنائس" تبخّرت مدرستان للروم الأرثوذكس، واحدة للبنين وأخرى للبنات. ومؤخراً هُدم بيت رشيد الحاج ابراهيم في شارع البرج (9) وكذلك المدرسة الإسلامية للبنات قرب "مقبرة الاستقلال".
ومع كل ذلك.. دعك من ذلك واقلب الصفحة في سفر النكبة!
ولنعد الى رقعتنا الزمكانية ذات الأزقة الملتوية وغير الملتوية التي كانت تفوح منها رائحة البخور والعطور وصابون الحمّامات والقصص والخرافات. فالفسحة المكانية كانت ضيّقة والبيوت متلاصقة والعتمة مخيّمة ومخيفة والإيمان غيبي والناس بسطاء، والأديان الثلاثة برجالها منتشرة بين الجوامع والكنائس والكُنُس. أضف الى ذلك عساكر الأتراك من اليوزباشي الى الزابطية (ضابط في العربية) بكلابكهم ("الكلبك"، قبعة الجندي التركي) وسيوفهم وطبنجاتهم المسلطة فوق رؤوس العامة. كل هذه الموجودات أدّت بالسكان الى إطلاق عنان أفكارهم للخيال وللإبداع، الموروث والمكتسب، ليحاكوا الجان والشياطين على أنواعها، وليؤلفوا قصصاً شيّقة تخرج معهم من الحمّام. فمن هو مارغاروش؟ إنه إسم من أسماء الجان. وجرت العادة أن نبسمل (أي قول بسم الله الرحمن الرحيم) قبل ذكر إسمه تماماً كما نذكر "الخضر أبو العباس" حيث نرفق ذكره بجملة "الدستور من خاطره". وعند كتابة هذه السطور بسملت كثيراً كي لا أُصاب بأذى منه. وعلى ما يبدو فمارغاروش، حسب إحدى الروايات، هو أحد أبناء ملك الجان أشمداي الذي تحدّى سليمان الحكيم. وفي رواية أخرى هو صهره لإبنته الجنية حشتماروش. ومهما يكن من أمر أصله وفصله. فمارغاروش أصبح بطلاً من أبطال جدّاتنا في بيوتهن وفي حماماتهن ؟ "حمام الباشا"، الذي ما زال قائماً في البلد مختفياً وراء عمارة "شركة الكهرباء"، التي بنيت على قطعة من أراضي "الوقف الإسلامي"، وكذلك "حمّام دار كُزبَر" الذي لا يبعد كثيراً عنه. وما دام مارغاروش هذا بطلاً فلا بد من تفصيل القصص من حوله على الرغم من قصر حجمه الذي كان يوصف عادة بطول العضو التناسلي الذكري حيث تقول الجدة "طوله طول الـ..". وبما أنه لم يكن إنساً فقد أضفوا عليه صفات لا تليق بالأبطال، فعدا عن قصر حجمه كان وجهه طويلاً وعيناه طويلتان غير مستديرتين يعتمر قبعة جنيّة مزركشة بأحرف غير معروفة وإشارات غريبة لكنها تحوي شارة خاتم سليمان! أما يداه ورجلاه فكانت ممتلئة بالعضلات تبرز منها شرايين منتفخة يسير فيها الدم الأزرق!! وقد عُرف مارغاروش لدى العامة والخاصة برشاقته وعدم "قلة خواصه" (أي أنه كان نشيطاً ولم يكن منزوحاً حسب لهجتنا)، إلا أنه كان مخيفاً وخاصة عندما كان يحرّك رأسه بسرعة يمنة ويساراً تاركاً شفتيه الغليظتين للحركة بحريّة فيخرج لسانه الطويل و "المرَوّس" ليُحدث صوتاً مرعباً مرفقاً هذه الحركة بحركة رهيبة بكلتا يديه المفتوحتين مع أصابعه الثلاثة من كل يد. وللغرابة فقد أجمعت العامة على أنه كانت له لحية طويلة بطول جسمة، أما الخاصة فقد نفت ذلك.
هذا هو مارغاروش. لكن ليست هذه هي القصة فهو بطل من أبطال قصة "أُم ضريطة" التي جرت أحداثها في البيت الفخم الواقع بين "جامع الجرينة" وبيت نايف الحاج ابن عبدالله محمد فرج. وللأسف لا نستطيع تبيانه حسب الخرائط الحالية لأنه لم يعد قائماً. ولكن على الرغم من ذلك نستطيع القول إن البيت الفخم يقع بين عمارة "بنك هـبوعليم" (العمال) الشاهقة وعمارة "تسيم" (شركة الملاحة الإسرائيلية) الشاهقة أيضاً، وبالتالي ففخامة ذلك البيت ستختفي أمام هذه الشواهق. ومهما يكن من أمر فيحكى أن امرأة من تلك المنطقة كانت ملحاحة على زوجها و "تنقّ عليه" ليل نهار بأن يشتري لها حلقاً لأُذنيها فوعدها بذلك فأخبرت الجيران وهيّأتهم. لكنه رجع بدون حلق. فزجرته، ويا لشماتة الجيران! فقال لها: "شو حلق ما حلق.. أنت أحسن لك الخلخال، حتى تضعيه في رجلك اليمنى العامرة" (أي التي لا عورة فيها). اقتنعت الزوجة و "فزّعت" الجيران ووعدت بأنها ستدخل الحمام استعداداً للخلخال. وفي ساعات الصباح المبكرة لفت "بقجتها" الحمّامية داسّة في داخلها كل ما يتعلق بالنساء من ملبس و "ميزر" وصابون وطيب وليفة. وشرّقت من بيتها نحو "حمام دار كُزبَر"، إلا أن الأمر كان في غاية الخطورة ؟ الرجال يستحمون في ساعات الصباح والنساء بعد الظهر. كيف ستخرج بطلتنا من هذا المأزق وهي في نشوة من "كيفها" بالخلخال الموعود. فما كان عليها إلا أن تأخذ سلة من القش وتضع فيها سكينة المطبخ ذات النصل الحاد، التي اقتنتها مؤخراً من دكان نعيم العسل (دكانجي، يقع حانوته قرب جامع "الجرينة" يبيع كل شيء من الملابس حتى المسامير)، فوصلت الى باب الحمام وهتفت "بريمو" (أي تريد الإستحمام بمكان خاص)1 فقيل لها ان لا مكان للنساء في ساعات الصباح، فأخرجت السكين وهددت: "سأقطع له إياه.. كل من سيعترضني".
فدخلت الحمام واستحمّت بمياهه الساخنة وبخاره المنعش. رجعت المرأة الى بيتها ولم يكن أي خلخال في انتظارها. وعلى ما يبدو فقد أراد الرجل التخلّص منها لأنه ضاق ذرعاً بها وبطلباتها. قال لها: "بدناش لا حلق ولا خلخال، بدي أودّيك على قصر، فبقرب بيتنا يوجد بيت فخم وهو لك". أما البيت إياه فهو مسكون بالعفاريت والجان ولا سيما مارغاروش. فقد كان الرجل مدركاً أن البيت مسكون، حيث قال لنفسه لأرسلنّها هناك وليأكلها مارغاروش. لم يستغرق إقناع المرأة سوى بضع دقائق حتى كانت على باب البيت المسكون فأدخلها زوجها وأغلق الباب بإحكام مستخدماً "الشنغل". دخلت المرأة الى البيت و "انبهرت" من فخامته ومن "عفشه"، فالرخام رخام وخشب المرينا مرينا والزان زان و "التريات" "إشي إشي" ودورة المياه افرنجية "آخر ألِسطة" و.. و.. إلا أن انبهارها لم يدم طويلاً.. دخل عليها مارغاروش بقبعته ولحيته ولسانه المدفوع الى الأمام، وبدأ في حركته اللاإرادية وهمهم: "هم..م..هم..م..م.. يا بتشغليني يا باكلك.. هم..م..هم..م..". تمالكت المرأة أعصابها بعدما "تمسمرت" في مكانها وزمانها وبعدما "دستَرَت" و "تفتفت" على اليمين والشمال. كيف لها أن تخاف وهي التي هدّدت الرجال في الحمام بقطع أعضائهم التناسلية. فعملت بحكمة عنزة "كليلة ودمنة" مع الأسد التي نذرت للإله "شيفا" أن تفترس عشرة أسود، وافترست تسعة منها وبقي لها أسد واحد. لكن امرأتنا لا تستطيع الإفتراس فعملت بنصيحة مارغاروش وشغلته، فأمرته: غسّل الصوف، فغسّل، كنِّس، أُشطف، مسّح، غسِّل البرادي، رتّب الكومودينا (خزانة صغيرة تستعمل إما للتحف أو للتخزين) فرتب، أُحفر.. فحفر (أُحفر يا فرفور!!) وعندما انتهى مارغاروش من كل هذه الأعمال التي أنجزها بدقّة متناهية، يعجز الإنس عن صنعها، توجّه إليها مرة أُخرى بهمهمة أكثر شراسة من المرة الاولى: "يا بتشغليني.. يا باكلك"! فاحتارت امرأتنا من أمر هذا الجان، خاصة أنه لم يبق لديها من أوامر تأمره بها لينفّذها، فشمّرت عن فستانها النيلي وخلعت سروالها الداخلي وأدارت مؤخرتها له وأمرته بـ "النش".. فبدأ ينش بسرعته الجنية حتى انتفخت ثم ضرطت فصّاً مريباً ناشفاً وحاد الصوت "فتزعفل مارغاروش بأربعته" ومات.
في أثناء كل هذه الأحداث من الأوامر وتنفيذها وكذلك النش والإنتفاخ كان الزوج قد جهّز لزوجته تابوتاً ظاناً بأنه عندما يُفتح الباب بعد الثانية عشرة من منتصف الليل - وهذه هي ساعات عمل الجان في حارة شارع أمية في البلد - سيرى زوجته ميتة و "مرمية" أمام البيت الفخم، لكنه عندما فتح باب البيت رأى زوجته والى جانبها مارغاروش إبن أشمداي مطروحاً على الأرض ميتاً من "النش" ورائحته الكريهة. فبدلاً من أن يضع زوجته في التابوت، وضع مارغاروش فيه ودفنوه رمياً في مياه بحر دار الصيقلي خوفاً من رجوعه. إلا أنه عاد وسيعود، لأنه جان ولأنه مارغاروش ولأنه بطل من أبطال حارة الكنائس والبلد وشخصية من شخصياتنا الإنسانية. نعم هذا هو مارغاروش. أما "حمّام الباشا" فقد استمر في قصصه وخرافياته المعهودة والتي قد تضاهي قصص حمامات عكا ودياميسها التي تنقلها لنا بمشاهدها المسرحية الممثلة، ابنة زواريب عكا، سامية قزموز ؟ بكري. فلا عجب في تلاؤم وتوافق الروايات بين عكا وحيفا. فحيفا هي نسخة تاريخية عن عكا وبالتالي فسأعفي نفسي من رواية قصة الولد في الحمام والعروس ذات البدلة المحروقة من طرفها الأيسر أو الأيمن. فرواية حيفا يسرى ورواية عكا يمنى.
قصص تلك الرقعة الزمكانية لا تنتهي ولا تنتهي أيضاً روايات حماماتها حيث ظهر الجان في الحمام لأحد العرسان من دار السهلي و "لوى نيعه" لأن أبا العريس لم "يعبّرهم" ولو بقطعة شوكولاطة واحدة، حسبما طلبوا، وذلك عبدالله كيّلو الذي عاد الى زوجته "مشطبّاً" في كل أنحاء جسده العلوي وقليلاً بجزئه السفلي مضافاً الى "نيعه" الملتوي ولسانه الذي "يلتّ"، حيث قال لزوجته زينب إن الجان اعترضوه وهو راجع الى بيته وبنوا حيطاً مانعاً حال دون عبوره للزقاق فعاركهم وكانوا سبعة أقزام ذوي لحى حمراء يتوسّطهم مارغاروش. هذه هي الرواية بينما الحقيقة التي جمعناها شفهياً وكانت هناك صعوبة جمّة في ربط أطرافها تقول بأن عبدالله كيّلو كان سكراناً "طيخة" خرج لتوه من "العوالم" في "قهوة السنترال" ؟ معقل دار فاطمة الزعرة الباطرونة ليعود الى بيته فعلق بـ "طوشة" عمومية ليس إلا.
إن ما يميّز تراثيات تلك الرقعة هو عمق الخيال ومزجه في الواقع وتأثيره على الحياة اليومية وكأن همّ أهالي حيفا من تلك الفترة هو تفادي أذى الجان ومارغاروش والإستعاذة منهم ومن شرورهم، فغطوا المرايا في الليل خوفاً من الإنعكاسات وظهور العفاريت، وتفادوا القطط السوداء ليلاً ولم يتركوا المقصّات مفتوحة الأذرع تحسّباً من أن يستخدمها مارغاروش وعائلته، وأكثروا من استعمال الحجب والفتح بـ "المندل" ووضع الحجارة المقدسة من الحج على الصدور كي "لا يكبسوا" فلاناً بإصابة العين. فلم يعد مارغاروش مجرد عفريت مخيف بل أصبح شخصية قرينة وملازمة للمجتمع العربي الحيفاوي وبطلاً من أبطالها نستطيع إضافته الى "سعيد المتشائل" وفاطمة الزعرة، وغيرهما، من الخيال والواقع، بل أصبح أكثر من ذلك إذ تحوّل الى مثل يُتداول فقط في حلقات خاصة من أهالي حيفا الأصليين حين يقول الزوج لزوجته: "رايح أعملك مارغاروش". للدلالة على استعداد الرجل للقيام بالأعمال المنزلية عوضاً عن زوجته، وليس للإخافة ودبّ الذعر والرعب.
هل شاءت الأقدار أن يموت مارغاروش وتتبخّر هذه الشخصية مع ما سحق وهدم من بنايات وحكايات "البلد" التي تدعى بلغة اليوم "البلد السفلى" أو "التحتا". كلا. فحتى أفلام الرعب والخيال لا يموت أبطالها. حتما سيخرج مارغاروش المكبّل بالسلاسل والجنازير من بحر دار الصيقلي أو أبي نصور أو من بحر العزيزية ليستقر في مكانه وغير زمانه في عمارات الحكومة في تلك الرقعة ليظهر لهم ويخيفهم ويذكرهم بأرضه، مرتع صباه وبيئته، من أهالي حيفا، كالزعبلاوي والخطيب والكنفاني والخمرة وحبايب وعابدي والماضي ومنصور ونفاع ونقارة وكيّلو والشيتي والبوتاجي وغيرهم. وسيبقى بطلنا راسخاً في رقعته شاهداً على نكبتنا ولربما كرّمناه بنصب تذكاري نكتب عليه:
"رحمك أشمداي يا مارغاروش ورحم الله أمواتنا". ومهما يكن من أمر فنَم أو قم يا مارغاروش قرير العين، فما أنت سوى منكوب إبن منكوب، ومع كل ذلك فليلعنك الله الى يوم الدين لأنك جن وليس بإنس، ولأنك وحيٌ وهي نكبة.
رسالة إلى العبرانيين
فصل أليم من بشارة النكبة الى أهل حيفا العبرانيين. إخوتي لأبي إبراهيم الخليل، إنها رسالة ننقلها لكم من أخوتكم المهجّرين من رقعتهم الزمكانية من "البلد" وأبطاله من الإنس والجان وقصص الحمّام. رسالة ننقلها لكم باسم التراث العربي الفلسطيني الحيفاوي وباسم كل من مسّته النكبة ووحيها من قريب أو بعيد.
وبعد، أيها الأحبّة، حان الوقت للمصارحة الأبدية المجبولة بعرق اولئك الناس السرمديين، حان الوقت لقصّ روايتنا كما هي، من دون زيادة أو نقصان.
هذه رسالة باسم الذين لا يكتبون ولا يتكلّمون، ليس بسبب أًُميّتهم وجهلهم، بل بسبب انقطاعهم القسري عن الحياة العادية، ذلك الانقطاع الذي بلغ ذروته في سِفر دهور النكبة من العام 1948. اولئك، ما زلنا نبحث عنهم وعن حياتهم بين الأنقاض في وادي الصليب وحارة الكنائس، فقد نجد وريقة صفراء مغبّرة تثير الحساسية في الرئتين المسمّمتين والملطّختين بالنيكوتين وغازات "الريفاينري" . نبحث عنهم ونحن مطأطئي الرأس، كما كان يمشي سعيد أبي النحس المتشائل في شوارع وادي النسناس بأمرٍ من سيده سفسارشيك .
نرسل هذه الرسالة من صميم الحياة اليومية التي كانت سائدة في ذلك المكان، "البلد"، تلك الحياة التي كانت ستستمر بحلاوتها ومرّها لولا مياه البحر والرياح العاتية التي نشبت في نيسان من ذلك العام فأين انتم يا أخوتي، يا من سكنتم تلك البيوت وسط الفسيفساء البشري والمعماري في "البلد"، يا من طليتم بيوتكم باللون الأزرق "النيلي" للدلالة على يهوديتكم، أمن المعقول أنكم قد نسيتم تلك البساطة التي دفعتكم للمشاركة في حياة العامة؟! أوتذكرون كيف كنتم تلجأون للمحكمة الشرعية الإسلامية للاحتكام في قضاياكم لتنالوا من سعادة القاضي حكماً عادلاً يرضيكم ويرضي إلهكم ؟ إلهنا؟ ماذا ستقولون حين نأتيكم بالخبر اليقين حول ابراهيم ابن آسا وكيل وقفكم، وكذلك بأخبار ابراهيم ابن شبتاي من أصحاب السيادة في الفترة العثمانية، ولن ننسى سلمون فرحي أمين صندوقكم، ويعقوب ليفي مختاركم ومن بعدهم نسيم مزال ؟ طوف وإسحاق ليفي وإبراهيم منصور وإبراهيم حلفون، الذي حوّر اسمه الى خلفون، ويا للمفارقة.. أو يا للتاريخ. ففي أواخر السبعينيات قررت مجموعة شابة من عرب حيفا أو قل من بقايا النكبة، أن تبني لها بيتاً خاصاً في حي الزيتون المتاخم لشارع الدير. وكان أن قدّم هؤلاء الشبان طلباتهم المرفقة بالخرائط والوثائق المفصّلة. واتضح فيما بعد أن الأرض كانت ملكية خاصة لوالد أحد أعضاء المجموعة، ذلك الوالد الذي ورثها عن عمته شرعاً وقانوناً. لكن شاءت الأقدار أن تختفي هذه المفارقة، مفارقة الضعيف، لتحلَ محلها مفارقة القوي ولتفرض بلدية حيفا في حينه اسم الراف خلفون مع التشديد على الخاء. فبين الحاء والخاء "خففتمونا" أيها الأخوة.
وللتخفيف عن همومنا لا بد من التذكير بأحلام ذلك الجيل من أهل "البلد"، حيث لم يخطر ببالهم ولا حتى في أحلامهم الأكثر ورديّة من الورود أن يحلّ بهم ما حلّ من انقطاع الحلم الممتدّ من بحر العزيزية وحتى بوابة عكا التي لا تشبه "بوابة مندلباوم3" إلا في مفارقاتها.
إذ نخطّ لكم هذه الرسالة نودّ تذكيركم بقبورنا التي نبشتموها في مقبرة القسّام والاستقلال وسلبتم أسلافنا متعة الانتماء ولذّة العزاء وصيرورة الذاكرة والتذكير. فلم تبقوا شاهداً من شواهد قبورنا الرخامية والحجرية العارية إلا أخذتموه. تلك الشواهد التي تحمل أسماءنا وتاريخ ميلادنا ووفاتنا "فسلام علينا يوم ولدنا ويوم نموت ويوم نبعث أحياء"، نعم سنبعث أحياءً لنقضّ مضاجعكم ليس لسبب كرهنا لكم، بل لتذكيركم بذلك الزمان وذلك المكان.
إخوتنا، لماذا كان علينا أن نسير في درب الآلام؟ لماذا كُتب علينا أن نكون ضحية الضحية؟ لماذا كتبت عليكم الصدمة من الكارثة، وكتبت علينا الصدمة من النكبة؟ هل كان اقتلاعنا من ذلك المكان وذلك الزمان "كتاباً موقوتاً" وسياقاً تاريخياً محتوماً كما تدّعيه "الحتمية التاريخية"؟ وهل استطيع أن أقنع جدي "ق" المنكوب بهذه الحتمية التي كان يلعنها صباح مساء، ذهاباً وإياباً في تجواله في مكان مرتع صباه، حيث كان يلعن وعد "واحد من فوق" (وعد بلفور) مضيفاً لعنة على "حرامية التاريخ" (الحتمية التاريخية).
هل كانت حيفا وعربها الحل للاجئيكم وقادميكم من أقاصي الدنيا؟ هل كانت خطة "شيكمونا" وخطة "المقصّ" (الخطة التي قضت بحصر العرب في وادي النسناس ووادي الصليب في العام 1948) تتضمن فيما تتضمنه قطع الأحلام والآمال وفسخ الأحبة والأزواج عن بعضهم البعض؟!
أولم نتحدث فيما بيننا عن ذلك العربي "م" ذي الطربوش الذي أحب فتاة يهودية "ر" ذات الجديلة الملساء وتزوجها ليس على سنة الله ورسوله، وليس على سنة المجتمع وأحكامه. فقد عاش "م" و "ر" في رغد من العيش واستأجرا بيتاً على تخوم شارع ستانتون (على اسم الضابط البريطاني، والآن "شيفات تسيون"، أي عودة صهيون) وشارع البرج (حالياً "معاله هشحرور"، أي تلة التحرير). وكانت لـ "م" و "ر" علاقات غرامية تخطّت جميع المخططات والمؤامرات، وحتى العفريت "مارغاروش" لم يستطع التدخل في مثل هذه الأمور لإفشالها.
كما أننا تحدثنا فيما بيننا عن "ص" من عائلة القلعاوي، الذي كان على علاقة غرامية تضاهي علاقة روميو بجولييت مع سارة الملقبة تحبباً بـ "سيرينا"، حيث أنجبا طفلة خارج الزواج ما زال اسمها في طيّ الكتمان. فقد كانت سيرينا معروفة في كل "البلد" بلقبها "الحلوة" بنت الخواجات، التي كانت تتقن اللغة العربية باللهجة الفلسطينية الحيفاوية فتفتح ما قبل التاء المربوطة (كالطاولة والمعكرونة وليس الطاولي والمعكروني) وتشدّد على واو "البقدونس" وتمدَ واو "الثومي" وتستخدم الألفاظ الحيفاوية المحضة كقولها "إحنا بضُلا4" و "عاهة مندبي"5، وتكثر من لفظة "يا صباح الشوم" و "يا صباح الهنا"6. والأنكى من ذلك أنها بالغت في استخدام كلمة "يو.. يوه.."7، حيث يتطلب الأمر معرفة استخدامها زمانياً ومكانياً وظرفياً وكذلك دراية تامة بلفظها حين تُزَمّ الشفاه وتندفع الى الأمام. إن كل هذه المواصفات تدلّ على مدى تفاعل سيرينا وانخراطها في ذلك العالم النكبوي، الذي انقطع دون علم من "ص" ومن سيرينا. فقد انتكب "ص"، هكذا. ووجد نفسه في مخيم صيدا للاجئين، وانتكبت سيرينا إلا أنها وجدت نفسها في عالم غير عالمها ؟ في دولة اسرائيل. أما ابنتها المجهولة الاسم فقد تزوجت شابا من ابن جلدتها على حساب "ص" قبل النكبة بعام ونيّف. حيث أقام لها حفلة على نفقته دون علمها وعلم الراب والربانيين لأنه "ﭽوي" (غير يهودي) "إبن ﭽوي" ليصبح فيما بعد "ميعوطي ابن ميعوطي" (أقلية ابن أقلية)، هذه الإبنة وجدت نفسها امرأة بالغة، عاقلة، تقطن في وادي الصليب لتستقبل أقارب أبيها "غير الشرعي" وتتعرف عليهم وتعترف بهم أيما اعتراف. و "بالعلامة" (أي للدلالة) أنكرت إبنها الذي كان يخدم في صفوف "جيش الدفاع الإسرائيلي" تحسساً منها لمشاعر أقارب أبيها القادمين لتوّهم ولفترة قصيرة من عالم اللجوء والتشرّد. هكذا.
إخوتنا.. نقصّ عليكم هذه الروايات ليس فقط من أجل أن تنصفونا أو أن ترحمونا، أو أن تُتمتِموا علينا بالإيديش (لغة اليهود الأشكناز) "سوت نيشت جيدافت باسيرن!" (أي: ما كان هذا الأمر ليحدث) كمن يترحّم على ذبيحته عند تقديم القرابين في يوم الغفران أو في عيد الأضحى. نروي لكم حكايتنا لكي تعترفوا ولكي تفسّروا لنا كيف أُفرغت المدينة من عربها في ذلك العام، وكيف دخلتم الى بيوتنا من دون إذن منّا لتنهبوا ما شئتم من متاع ومن وثائق ومن هويّة! لماذا نكثتم العهد كما نكثتموه مع نبيّكم ونبيّنا موسى عليه السلام حين عبدتم العجل؟ لم نطلب منكم ذلك. كل ما أردناه منكم فقط هو أن تحفظوا العهد والناموس الذي تعاقدنا عليه معكم في حينه!
إخوتنا لأبينا... أولم نتفق معكم على صيانة عماراتنا وأطياننا في جميع أحياء المدينة في وادي الصليب والمحطة ووادي رُشميا وحتى حارة اليهود؟ أولم نتعاهد على إبقاء بيت آل توما والخمرة والحاج وسقيرق وجرار والقط والحاج إبراهيم وطوبي لتكون شاهداً من شواهد حياتنا المشتركة؟!
لماذا هذا الإخلال بالوعد؟ لقد خيّبتم أملنا ونحن ما زلنا نعتقد بأن حيفانا هي مشتركة.. أونسيتم أنه في العشرينيات حين كان عددكم بالكاد يتجاوز منزلة المئات حرصنا على أن يكون لكم ممثل في المجلس البلدي! طبعاً هذه ليست منّة منّا عليكم، بل واجب ولربما حق.. والآن أيها الأخوة، ماذا جرى لكم؟ لماذا تنكرون التاريخ وتغيّرون أسماء تلك الشوارع التي عبرنا فيها سوية كما عبرها "ص" وسيرينا و "م" و "ر"؟ لماذا قطعتم تلك الأحلام؟
لنصارحكم بأكثر من ذلك، فنحن الذين لا نكتب ولا نتكلم نقول لكم إن "البلد" بلدنا والحمّامات حماماتنا وحتى الجان ؟ العفريت مارغاروش ؟ فهو من جاننا، والذي أقسم أغلظ الإيمان بأن يدافع عن حقوقنا حتى في هذه الأيام. فعلى ما يبدو لم يعد مجدياً مخاطبة الإنسان، فلجأنا الى الجان.. ومهما يكن من أمر النكبة فنحن لا نستطيع الخروج من دوامتنا ودوامتكم لأن قصتنا معكم طويلة..
المدام كلير والحاج نايف
سأله سائل، هل انت من حيفا؟ (ولم تُلفظ حيفا بفتح الحاء وتسكين الياء) وهذا ما اقعده عن الاجابة، فانكتم عن الكلام المباح ريثما يتأكد من كسر الحاء، وما كان إنكتامه سوى تعاملاً مع عادة ام جدته "حليمة" القلعاوي، الصيداوية الأصل حينما كانت تمتنع عن الكلام وتصوم ثلاثة أيام، لأنها اقسمت اليمين والأيمان كقولها "كسر الهاء وعقد اليمين والذي أعظم منه عظيم". ولحسن حظه لم يك بحاجة لذلك القسم، لأن السائل، وهو شيخ غير مشقق الوجه توجه اليه جازماً "إنتِ حيفاوي" فيجيبه "أيوَه، نعم". فتأمله ذلك الشيخ برهة ليخرج باستنتاج بأنه حجّاوي، أي من دار الحاج، حيث قال له "ولَك إنتِ حجّاوي يا ولد". فراقت وطابت له كلمة ولد دون الحجّاوي.
كان ذلك في عاصمة معشر البلغار صوفيا حين التقى ذلك الولد الشيخ الحيفاوي من آل سقيرق من "الملاكين"، الذين مُحيت اطيانهم في طوفانٍ ليس من طوفان نوح عليه السلام، بل من طوفان شهر نيسان.
هذا هو المشهد الرمادي للقاء الأجيال من الداخل والخارج في عواصم أجنبية، حين يشمشمون أبناء البلد الواحد، لا بل أبناء الحارة الواحدة بعضهم بعضاً مبتدئين لقاءهم بكلمات السر والرمز، التي أصبحنا ندعوها "بالكود"، فكلمة السر كانت حيفا بكسر الحاء. فقد اصبحت "الحيفاوية" سلعة نادرة نتداول سرّ أصلها وفصلها، ونتأملها من قريب ومن بعيد، من أسفل ومن علٍ، متجاهلين على مضض ما حلّ بتلك السلعة من نكبة ومن نكسة، ونستمر في فحصها لعلها كانت مزيفة او خاطئة كفاطمة الزعرة لنرجمها بحجر من حجارة المجدلية أو من حجارة وادي الصليب المهزوم والمهدوم.
التعصب للأصالة الحيفاوية ما هو إلا تعصّب للجذور والإنتماء، فسكان حيفا الأصليين، الأحياء منهم والأموات ما زالوا يذكرون تلك القصص و "الخراريف" التي ستدخل في طيّات صفحات التاريخ المكتوبة وغير المكتوبة، سواء كانت من الحمام ام من نسج خيال الجدّات ذوات التجاعيد من الجبين الى أخمص القدمين مروراً بالبطن وما تحته. فاولئك الجدّات "الستّات" او قل "المدامات" كان لهن مقامهن ومكانتهن في المجتمع الحيفاوي دون أن ندري، فكنّ يدخنّ النارجيلة على "كيفهن" وعلى مزاجهن دون إذن من "بعولهن" من على بلاكين ومن ساحات البيوت في محطة الكرمل ووادي النسناس. فالنارجيلة واستخدامها لم تكن عادة نكراء كما يحاول البعض تصويرها. فقد كانت طقسا من الطقوس المرفهة، تجتمع فيه السيّدات من العامة ومن الخاصة كل على طريقتها لتلخيص الأمور العامة من السياسة والإجتماع والإقتصاد. ففي الانتخابات للمجلس البلدي في حيفا من العام 1928 كان لاولئك السيّدات دوراً خاصاً من الدعاية "الحزبية" غير المكتوبة. ففريق منهن أيّد حسن بك شكري سيء الصيت وفريق آخر أيّد عبد الرحمن الحاج المؤيد للحسينيين.
وكان أن نشب خلاف من على بالكونة مدام عطالله في حي محطة الكرمل المزدهر ببساتينه الخضراء المليئة بشجر البيلسان الذي انتكب واختفى كغيره من النبات عن الوجود. فكان الجدال مستعراً بين "النساوين" المجتمعة حول "سكَملةِ" مدام عطالله، التي امتلأت بالتبولة وبعض من عرق "دكلوش" ودخان النارجيلات يتصاعد بكثافة عالية جداً من افواههن الملطخة بحمرة قانية. وكانت مدام عطاالله السبّاقة في طرح فكرها السياسي على "النساوين" لأنها كانت المضيفة، ولأن جذورها غير العربية مكّنتها من ذلك. فتلك المدام كانت تجيد العربية والفرنسية في ذلك العصر، وبالتالي فقد طرحت تأييدها للمرشح حسن بك على الرغم من اختلاف الإنتماء الديني الذي كان يلعب دوراً هاماً. وما كان على "المدامات" سوى أن يبقبقن ويتفاخرن في نفث دخان نارجيلاتهن، ومن خلال ذلك تشجعت إحدى "الهانمات" لتعارض "المدام" المذكورة أعلاه وبجدّة. تبيّن فيما بعد بأنها على صلة قرابة من البطن الأول بالرئيس المرشح المغاير لمرشح "المدام". نشب الخلاف وتعالت الأصوات ولا سيما صوت "عبد الرحمن خانم" الذي امتازَ بالتأتأة، المرفقة بلثغة خلطت بين حرف الراء والسين، مما جعلها تبدل المعاني السليمة بمعانٍ لها صلات "بكلمات العيب".
وعلى الرغم من ذلك فقد أبدت كل "هانم" رأيها... وفترة صمت... صمت رهيب أصاب ذلك المجلس من على بالكونة مدام عطالله. فقبل برهة كانت الأصوات النسائية تتعالى، حتى أن أحدى المدامات بُحّ صوتها فوصفوا لها الزنجبيل وصفة... ..
إستمر الصمت... حتى بقبقات النارجيلات انكتمت...
فما الخطب إذن؟ اتضح فيما بعد أنه في الغرفة المجاورة لبالكونة مدام عطاالله كانت ابنة المدام "بريدانس" تعاني الأم المخاض. وفي هذه اللحظة الخطيرة، لحظة انخفاض صوت النارجيلات ثار جدل عسير بين "الهوانم" ؟ فأية داية ندعو؟ أداية إفرنجية أم عربية؟ فمن العربيات كانت الداية سنية الغزاوي و "الحِدئَة" من عكا وعزيزة الخمرة، وقيل عنهن أن إيديهن "دِيّة" وخلفهن "صبيان ؟ ذكور". أما من الفرنجيات فكانت الدّاية لطفية كنعان، حيث قالت العامة "جيبي لك دايي فرنجية، ومش عربية، لأنها متعلمة عند الإنكليز ومعها السرتيفيكات؟!". لكن الموقف كان يتطلب غير ذلك النقاش فصرخت "عبد الرحمن خانم" "سرتيفيكات ومش سرتيفيكات لتقم الداية بمهامها لإخراج الطفل الذكر". ولم يخرج في تلك الليلة من شهر نيسان في العام 1927 سوى إنخراس صوت البقبقات والخرافات من تلك النسوة ومن تلك "القعدة" عند المدام عطاالله. ومرة اخرى صمت يتلوه صمت آخر. وعندها عرف أن النتيجة ولادة انثى. وهكذا عرفنا أنه عندما تسود فترة صمت في مجلس من مجالس "المجموعات" يقال "شو السيرة، كِنّو (وكأنه) وُلدت بنت؟!".
وبعد خروج تلك "الأنثى" الى العالم النكبوي الذي سينتظرها تبادلت النساء من على بالكونة مدام عطاالله التبريكات والتهاني بقولهن "الحمدلله على السلامة؛" فتأتي الأخرى لتقول "وما لها الحمامة والسلامة!"
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فعلى الرغم من ولادة الطفلة البريئة، التي دعيت فيما بعد جميلة العبدالله، أُقيمت الحفلة في باحة شارع ابن الأثير في محطة الكرمل ليحضرها البشوات والبكوات وأصحاب السيادة ذوي الطرابيش الحمراء مع نسائهم، وكما قيل فقد "بدّعَت" "المدامات" في الرقص على انغام الدربكة والعود والحان رقصة "الهوانم" ورقصة "سِتّي". ويُذكر من تلك الحفلة ان المدام "كلير" من حي الزيتون كانت مرتدية "كل أواعيها" (كل ثيابها) المتناسقة الألوان، الجاكيت الأحمر ذو الأزرار "المجيديّة" و "الأبى" ، فالبلوزة الخضراء، فالتنورة الكحلية، التي يبعد آخرها عن كرسوع القدم مسافة شبرين تفصلهما جرابات شفافة تُظهر مهارة "سالخة الشعر" من "حفلات النتف" لتريك ساقين ملساوين، متعة للناظرين. تلك المدام ولقربها من أهل الفرح كان لزاما عليها إظهار ما يمكن إظهاره من النشاط المطلوب في مثل هذه المناسبات، وحسب عادات تلك الفترة ؟ فترة اللعب واللهو، بينما الأعادي ساهرون. إلا أن المدام كانت من النوع الخجول جداً، وهذا ما ادخلها في وضع خطير لا تستطيع الخروج منه، إلا بقدرة قادر، لحظات والفرج آتٍ. فها هي النساء تتوجه نحوها داعية إياها باستعطاف جمّ لتقوم بمشاركتهن بالرقص. وفي مثل هذه الحالات تُمسك إحدى النساء بيد المدعوّة لتقيمها عن مقعدها، وبالتالي تُجابَه بالرفض في المرة الأولى، فالثانية والثالثة "ثابتة"، حيث يُحلف أغلظ الإيمان، عندها تقف المدعوّة الخجولة على رجليها. وفي حالة المدام كلير لم تكن خروقات عن المالوف سوى زيادة خجلها الذي بان حين وثبت على ساقيها مستهمة للرقص حيث امتقع وجهها إحمراراً فكادت وجنتاها المتدليتان تسقطان على كتفيها الضّيقتين، فكانت تحركهما من اسفل الى اعلى وكأنها تبغي رفع وجنتيها حرصاً على سلامتهما. واخيراً وقفت المدام..... ورقصت حتى انها كانت "تَقصَع" الى وراء ومع كل "قصعة" الى الخلف كانت تنسحب معظم ثيابها الى وراء فيطول الجانب الخلفي ويقصر الجانب الأمامي من ثيابها ليتبين بين الفينة والأخرى الجزء السفلي من سروالها الطويل... و في أحد "القصعات" فقدت توازنها وانقلبت الى الخلف فخرّت على الأرض... وهنا الطامة الكبرى... لم تستسلم المدام... فرفضت المساعدة واستعادت نشاطها لتواصل الرقص "حتى انخلع باطها" دون كلل أو ملل ولم تكن أيّة قوة تستطيع ردعها من اداء واجبها المفرط، كلا... حتى زوجة مختار الحارة "الست ام جورج" لم تستطيع تهدئة هذا الرقص الجامح.....
هذه هي قصة المدام كلير... بينما قصتنا، لا بل قضيتنا تتطلب أن نروي المزيد عن أبطالنا من تلك الفترة وتلك الرقعة. فإذا كانت "المدام" كلير في روايتنا هي بطلتنا من محطة الكرمل فسنشق طريقنا بحنطور السائس "الـجيسي" مروراً بالشاطئ الواصل بين تلك المحطة ومركز مدينة حيفا لنتوقف قليلاً بجانب "ساحة الخمرة" وللتدقيق في شارع أمية، لنقرع باب بطل آخر هو الشيخ نايف من الطابق الثاني من البناية، الذي عُرف عادة بخفة دمه ونخوته، لكنه بالتعريف غير العادي وُصف ببخله وبعدم تعصبه للدين وولعه بخرافات الجن وقصص النساء. فالشيخ نايف، الذي وصفته جارته "صفية بنت محمود" بالشيخ المستنير، هو من "أصايل حيفا"، ابن لعائلة ملاّكة، كثرت أطيانها في حيفا وكفر لام (مستوطنة هبونيم حاليا قرب حيفا)، طويل القامة والأنف يتملك عينين "مُجوّرتين" تطلان من حفرتين محفورتين داخل جبينه العريض. وكان يعتمر الطربوش الملفوف بالشال ويلبس الشروال والشملة الملتفة على وسطه، حيث كان يدسّ بها خلسة "رُبعية" العرق على الرغم من حجته وضلوعه بالفقه وبالأحاديث. وحتى تكتمل الصورة علينا أن نقول بأن نايف هذا خدم في "السفربلك" في اليمن مدة 12 عاما، حيث تعلم اصول التنجيم حسب كتاب "شمس المعارف" وعاد الى حيفاه لتستقبله زوجته "حليمة" وابنته "هدية" التي لم يرها قط. ويقال أنه عرفها عند بوابة الميناء من سحنتها القريبة جداً الى ابيه عبدالله محمد فرج جليس المحكمة الشرعية آنذاك.
ولكي يستعيد نايف حياته المدينية كان عليه أن ينخرط من جديد في نمط تلك الحياة ؟ حياة العوام والخواص ؟ من تلك الحقبة الزمنية ليدخل دوّامة الانتقال من حكم الأتراك الى حكم الإنكليز، الذين وصفهم "بأولاد البرنيطة والتنانير" ، فلغته التركية لن تطعمه الخبز، فأطلق العنان لهواياته ليمارس فيما بعد فن التنجيم وليقارع النساء وقصصهن مع بعولهن، لأنه آثرهن عن دون خلق الله في عملية كتابة الحجب نظراً لإيمانهن المتعصب والغيبي بإنجازات ونجاحات هذا اللون من "الفنون". وفعلاً فقد لاءم الحاج نايف نفسه لوضعه الجديد آخذاً بعين الاعتبار موقع منزله في "البلد" بقرب الجوامع والكنائس والمدارس، ومحطة الحناطير اضافة الى الخمارات و"الكراخانات" ، خاصة "ورشة الخياطة" التابعة لباطرونة البلد المدعوة "فاطمة الزعرة". فما أن أعلن عن خطبه حتى توافدت على باب منزله عشرات النساء من المدينة ومن القرى المجاورة ولا سيما قرية الفريديس التي وصفها قائلاً "آه منك يا الفريديس يا ام التعاريص" . ومن نجاح الى نجاح في كتابة الحجب وطرد العفاريت على أنواعها (علماً أنه لم يستطع التغلب على العفريت المدعو "مارغاروش") اشتهر اسمه وعرف بتخصصه بقضايا الغرام وجمع الأحباب. فكان أن أتت اليه ثلاث نساء من قرية لا تبعد كثيراً عن قرية املاكه كفر لام هي قرية إجزم التي لم يحبها ولم يطق ساكنيها نظراً لبخلهم واطنابٍ في شُحّهم، حيث وصفها بقوله "اجزم ؟ احمل فرشتك وانهزم" هكذا قيل. لكن التاريخ لم يثبت هذا الأمر. فأتت اليه النساء الثلاث وفي ايديهن "بقجات" جمعن بها ما طاب من المواد الغذائية والسكاكر التي إقتنينها من جوال المنطقة "أبو هِجرس". ففي تلك الفترة كان الدفع مقابل هذه الخدمات ليس بالمال بل بما يسمى "الناتور" (على الطبيعة ؟ بالمقايضة)، فما أن استقبلهن الشيخ نايف حتى عرف مبتغاهن ؟ تقريبهن من بعولهن. وبعد السؤال واقسام ضئيلة من الجواب وتبادل الكلام طلب منهن أن يقمن بفعل غريب من نوعه. فقد كان عليهن قياس اعضائهن الحساسة بخيوط ملونة يقدمنها له ليتابع عمله ونشاطه وتأثيره الربّاني والجنيّ. فكان له ذلك فأخذ الخيوط الثلاثة ووضعها في "النملية" بطريقة آية في الترتيب ليعود اليها بعد سبوع كامل حفاظاً على الرقم 7 ذي الصفات المقدسة والسحرية. وفي اليوم الثامن عاد الشيخ الى تلك الخيوط فلم يجد سوى خيطين بدلاً من الثلاثة في ذلك المكان الذي حرص على ضمانته وسلامته من أي أذى. يا للهول، ويا للمصيبة.... استشاط غضباً على زوجته "حليمة". "فانعقد صباحه" واصطفت تجاعيد جبينه العريض صفاً صفاً، وازدادت عدداً، وتوسعت عيناه القابعتان في محجريهما وتراقص أنفه الطويل.
فما أن رأت زوجته هذا المنظر حتى أدركت ما سينتظرها في مثل هذه الحالة. فاستلّ ربعيته من خصره وعَبّ منها جرعة طويلة النفس ليهدئ روعه من صاعقة الحدث إلا أن هذه الجرعة أخرجته عن إتزانه مما زاد غضبه فارتفع صوته وجفّت شفتاه حتى خرج "الزبد" على جانبيها ولم يعد يدرك ما يقوله لتنتابه البلبلة بين الخيوط وجوهر قياسها ليقول لها "وِلك وضعت ثلاث.... أينهم؟" "وين راح الـ ... الثالث"؟ ....صراخ يتلوه صراخ، لكن دون جدوى،لأن زوجته قد "عزّلت" النملية ونظفتها. وبما أن الشيخ نايف مبدئي في مسلكه ومهنته فرض على زوجته قياس ما "عندها" تعويضاً عن "الخيط" الضائع. لم تستطع "حليمة" رفض هذا الطلب، لأن رفضها سيعني الطلاق، كُن فيكون.
إرتاح الشيخ نايف كعادته بعد كل "فصّ أو فصلٍ أو شرّ" يفعله. فأشعل لفافة من التبغ الإنكليزي وبدأ يغني أغنيته التي لا يعرف اغنية سواها:
يا لَدَن يا لَدن آه يا لداني يا سيدي أُوف حُبّك ملاني
صَفَّت العساكر عساكِر بسلاحها اللي بتلالي يا فيصل
وفيصل عَ حصانه راكب عسكره هجم على الدوشمان
امان...... امان
إنطفأت أضواء المصابيح غير الكهربائية وزاد الليل من حلكته في حارة الكنائس، فاشعل الشيخ نايف شمعته السحرية ليتمتم على "خيوطه" ما شاء وطاب من كتاب "شمس المعارف" وليكتب الحجب اللازمة مع الإشارات الغريبة، حيث النجمة السداسية والأشكال الهندسية المختلفة والأبجديات والخطوط الواصلة بينها وكذلك الأسماء الغريبة مثل سخروش وإسرافيل وبَهروش ولا سيما "إستَكهَنبَر مَهمَمنَتَباش" هذا اللفظ الذي طالما تفاخر به ولفظه بطلاقة يُحسد عليها حتى أنه كان يلفظه تارة من اليمين وتارة من اليسار. وعلى ما يبدو هذا هو السحر بعينه وربما زوّده بالرمز "الكود" الذي يدعى 8 ؟ 4 ؟ 9 ؟ 1 ؟ 4 ؟ 2 ؟ 2. وبالإضافة الى الكتابة "المهنية" فقد أضاف من عنده أقوالا لا نستطيع كتابتها حرفياً لأنه دوّنها بالتركية.
كُتبت الحجب وَدُسّت في سراويل البعول من تلك القرية وسرى مفعولها لتعود تلك النسوة محمّلات بحاجات تفوق حمل حاملات الطيب للمسيح ابن مريم لتشكرن شيخنا، بل بطلنا من شارع أميّة. فأغدقن عليه ما تيسّر من المؤن ومن الدعوات ثم عُدن الى بلدهن. نادى الحاج نايف حليمته ليسألها "أوَتذكرين تلك الفلاحات من إجزم؟" فأومأت بالإيجاب، إذ كيف ستجيبه بالسلب بعد ذلك الفصل الذي سمّته "فصل الأعضاء الملونة؟" فأردف قائلاً: "لقد نجحن في جذب أزواجهن. أوَتدرين ما كتبت لهن؟ كتبت فيما كتبت "إن حَبِّك، حَبِّك وإن ما حبِّك فـ ........؛" لم تبتسم زوجته، فأدرك الحاج أن نغاشته ليست بمكانها. وعلى الرغم من ذلك فكل حارة الكنائس والحارات الأخرى تحدثت عن هذه الطرفة بمزيج من التحبب والهزل، الأمر الذي زاد من شعبية الحاج، التي إستغلّها فيما بعد اخوه في دعايته الإنتخابية لرئاسة بلدية حيفا.
هذه هي قصة الحاج نايف بينما قصتنا وقضيتنا هي ...........
)(
الزيتون الأشقر و" أبو جميلة"
ولدت بالصمت وجئت من عالم الصمت الى عالم الضجيج والحياة الصاخبة والزاخرة بالمفاجآت والمليئة بالمفارقات. لا أحد يعلم من أنا ومن أكون، وما هو أصلي وفصلي، حسبي ونسبي. أتيت الى هذه الدنيا ووجدت نفسي قابعاً في مسرح "الفنون" أعمل في الصيانة المهنية، أفعل ما اؤمر به، أنفذ التعليمات، أُكثر من الأفعال وأقتصد في الكلام.
الكل يجهل حضوري ولا يقيم لي وزناً يُذكر، علماً أنه لي من البدانة باع ومن العضلات صاع ومن الذراع ذراع، لكن ما العمل فهذا هو الواقع.
ابدأ عالمي اليومي قبل طلوع الفجر لأنهيه في عالمي الليلي من يوم آخر، وهكذا دواليك.. ليست لي امنيات ولا مواهب، فأنا سراب وطلسم من طلاسم ايليا أبو ماضي. لا أكره ولا أحب، وصفت نفسي "بأرقش" ميخائيل نعيمة. فقسمت العالم الى صامتين وغير صامتين.
حتى أن صاحبة المسرح الشقراء وصفتني بـ "العدم" وكانت تناديني بهذا اللقب ؟ تعال يا عدم واذهب يا عدم، فاستلطفت هذا الاسم الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ مني ومن شخصيتي العدمية. الأمر الذي حدا بشقراء المسرح، التي كانوا يدعوها معشر الممثلين المتملقين لها بـ "البيـچ بوس"، و غير المتملقين "بأم البيضات" تحويلي الى كائن حي، يأكل، يعمل وينام وطيع إشارة من إصبعها. والآن لا استطيع التعليق على مثل هذه الأمور غير الجدية بالنسبة لعدميّ مثلي. ولكن في مقدوري وصف معلمتي شقراء المسرح كوني الانسان الصامت الأقرب الى الواقع ؟ واقع الكواليس، واقع الأقنعة التي توضع على وجوه الناس من على خشبة المسرح ومن خلالها الى العالم ؟ الواقع. فمعلمتي هذه تغازل الستين من عمرها وما زالت تحمل بقايا الجمال العربي المتدلية على وجنتيها ذاتي الأصل الأسمر، بل الأسود، لأنها فعلا ليست بالشقراء. فالصبغة المصنعة "رقم 26" ما زالت طاغية على شعرها الأشعث والكث، الذي اكتوى من زيارة "الكوافيرات" ؟ هذه المعلمة ما زالت تحمل في تركيبتها النفسية انتماءها القروي الذي طمسته عميقاً في لا وعيها ظانة أن ذلك سيمكنها من الدخول الى المجتمع الراقي في المدينة، والدليل على ذلك أنها سكنت المنطقة العليا منها، علماً أن اغلب سكان تلك المنطقة لا يمتون للمدينة بجذور انتمائية تذكر وعلى ما يبدو ايضاً فأنهم يرتبطون بالحضارة المدينية من خلال ألقابهم المهنية ورواتبهم الشهرية فقط لا غير!! فإن سألتهم عن تاريخ المدينة وأهلها كما سألتهم معلمتي فيجيبون بكل ما علموه عنها متطرقين الى نكبتها من العام 1948 كما ورد في كتب التاريخ مزايدين على أبناء هذه المدينة في حرقة الانتماء وحسن معرفة في التاريخ، فمعلمتي، وعلى ما يبدو وبناء على ما ذكر أعلاه هي ضحية هذه الأوهام التي وصفتها باللغة الأجنبية "ارلوزيا" التي هي "ايلوزيا". وما دمنا في باب المصطلحات التي تستخدمها الشقراء ظانة أنها ستكون بما يسمى "IN" في داخل ما يسمى بالمجتمع "الراقي" فقد وقعت في اخطاء لا تعد ولا تحصى فكلمة اوركسترا ؟ اوكسترا، سكرتيرة ؟ سكتيرة والحبل على الجرار. فأنا "البهيم" حسب اقوال بعض الممثلين "الحوَش واللمم" استطعت إدراك المشكلة الإجتماعية لشقرائي التي ستشكرني فيما بعد على ذلك.
طبعاً المسرح لا يعتمد فقط على هذه المعلمة ؟ فهنالك معشر الممثلين والممثلات الذين واللاتي ينتمون الى شتى الإنتماءات فمنها الحزبية واللاحزبية، الإجتماعية واللاإجتماعية وأهمها الحرفية واللاحرفية. وهنا لن اوفر احدا من اولئك. فأنا اللاشيء اُهنت كثيراً من قِبلهم. سبق وقلت لكم انني غير ملموس، على الرغم من اهميتي، فأنا الذي أحضر لهم القهوة والشاي وأحضر الديكور واهتم بالقاعة وبالكراسي وبمكبر الصوت وبالإضاءة وكل الأمور الضرورية للتمارين وللعرض المسرحي في يوم العرض. فعلى الرغم من ذلك واسترقت السمع للأحاديث التي كانت تدور بين المعلمة الشقراء ؟ معلمتي ابنة الستين وبين ذلك المعشر من الممثلين، الذين قسمتهم الى عدة مجموعات، وبكوني ذلك الشخص الصامت سأحاول رغم بخلي في الكلام أن احدثكم الكثير الكثير عما يجري دون أن تدري المعلمة والممثلون.
ففي احد الأيام من شهر نيسان من ذلك العام هطلت امطار غزيرة ذكرتني بذلك الهطول ايام نكبة هذه المدينة وتحديداً نيسان. وإن أنسَ فلن انسى تلك المفارقة مع ذلك الفنان ؟ الضيف اليهودي الذي ذكرته بهذا التاريخ حين قلت له "أنه الـ 22 من شهر ابريل" حيث استغرب من التاريخ ذاته. طبعاً لن الوم هذا الفنان او تلك الفنانة طالما لم يبالوا بوجودي اصلاً، كما يُقال "فإنهم مش شايفيني من 2 سنتمتر" فكم بالحري معلمتي التي بدأت اولع في حبها.
يصرخون علي، يفرغون غضبهم عن طريق هذا الصراخ، ينادونني وينعتونني بشتى الأوصاف القذرة، ألبّي الطلب والبسمة تعلو على شفتي، بينما حريق ونار جهنم في صدري تشتعل دون أن احترق. أفهمهم واتفهمهم لكنهم حين يتجاوزون الخطوط الحمراء احاول ان اتصدى لهم بطريقتي الخاصة، طريق الصمت، لأنني أنتمي الى عالم الصمت.
صمت... صمت... صياح ودوي قذائف الشتائم المتبادلة تعلو من مكتب سيدتي الملطخة بالصفار المزيف، فما الخطب إذن؟ إنه جدال "عادي" بين "ام البيضات" وأحد الممثلين. لم اكن بحاجة لإستراق السمع والتنصت كما جرت العادة في كل مسارح العالم. بمعرفة صوت ذلك الممثل ادركت كنه المعركة غير المبدئية. فعلام الخلاف؟ سأبدي رأيي جازماً بأن الممثل "ع" رفض امر السيدة على اساس مهني، حيث طلبت منه أن يقوم بدور "س" فرفض.
طبعاً ليس هذا هو بيت القصيد. فداعيكم "ابو الصمت" يعرف بواطن الأمور. الخلاف لم يكن مهنياً فشقرائي المبتذلة لاحظت أن الممثل "ع" يميل الى تمثيل الأدوار الشعبية والمستضعفين "اكثر من اللازم" فأرادت بطبيعة الحال تحجيم "ع" على الرغم من عينيه الزرقاوين الواسعتين اللتين لا تمتزجان بلونهما مع لون عيون وهموم الأحياء الشرقية من البلد. وما كان على الممثل "ع" سوى الغضب وشتمها بشتى الشتائم التي أسمعها لأول مرة ؟ فعورة الأم أعرفها، إلا أنه استخدم عورات أخرى. وبطبيعة الحال فكل الغضبانين والمغضوب عليهم يأتون إلي ويفرغون أعصابهم داخل غرفتي الصغيرة التي يدعونها تحبباً با "الصومعة". وكنت ادعوهم الى صومعتي مستخدماً كلمة عيسى ابن مريم عليه السلام "دعوا الاولاد يأتون إليّ" لأنهم بالفعل اولادي وبعد الاستماع الى ذاك الولد ؟ الممثل عرفت السبب الأساسي والرئيسي للمشكلة، فسيدتي الشقراء ما زال "منخارها" مرفوعاً الى أعلى وكما يصفها بعض من الممثلين فهي "متعجرفة" وبما انني انا الصامت ادرك هذه الأمور، واعرف مديرة المسرح من حيث الحسب والنسب فقد تضامنت مع هذا الممثل، وبما أن هذه السيدة ليس لها علاقة بهذه المدينة لا من قريب ولا من بعيد فقد اقترحت على هذا الولد أن يراقبها في شهر ايلول وأن يراقب سر اختفائها لبضعة ايام!! ما هي إلا ايام حتى اكتشفنا أن تلك السيدة تتحول الى فلاحة بكل معنى الكلمة.
فالشعر الأشقر المرفوع الى الوراء يتحول وبقدرة قادر الى شعر بني مع قمطة، وتلك الأنامل المنتهية باظافر مقلمة ونظيفة تتحول الى اصابع ذات اخاديد وقنوات، وذلك القد الممشوق يصبح بدون اي شكل هندسي فحتى السيقان الناعمة تتحول الى أرجل تشبه بتشوهاتها أرجل "حمير الحجارة" حيث الجروح والخدوش وذلك الصوت العذب والانثوي والجنسي الذي كان يذوبني حين كانت تنادي "بالعدم" يتحول الى صوت "ام العبد" من تلك القرية.. نعم انها ايام قطف الزيتون.
ففي مدينتي هذه مدينة "ام الغريب" والكل فيها غرباء من الجليل والمثلث ابناء هذا الوطن يتحول يوم "قطف الزيتون" الى يوم الجذور والانتماء. حتى اشجار الزيتون الباقية في المدينة من تلك العهود والمنتشرة في "حي الزيتون" (شارع اللنبي) تلامسها ايادي الجذور لتمرط منها حبات الزيتون السوداء والخضراء، مما جعل اخوتنا من ابينا الخليل يتخوفون لدرجة "الهسترة" ظانين أن ايادي الجذور تستولي على املاك الدولة. لكن لا ضير.
فشقرائي قادرة على مواجهة ذلك من خلال مسرحها ومسرحتها للواقع ضاربة بعرض الحائط كل القيود والقوانين، فخلافاتها مع الممثلين تتقزم امام عزمها للنهوض في واقع ابناء هذه المدينة ليصبح مسرحها هو الواقع ذاته.
اما انا فقد كنت احاول كثيراً عن طريق صمتي غير الممسرح تشجيعها للمضي قدماً في هذا النهج ؟ نهج الخيال والواقع حتى اصبح مسرح "الفنون" مدينة تضم مجتمعاً مدينياً طور التكوين يحمل في طيّاته القديم والجديد، القروي ؟ الفلاحي والمديني، الأصيل والمبتذل، وكل هذه المكونات تتربع على عرش تاريخ هذه المدينة وما حل بها وبأهلها من احداث قبل خمسة وخمسين عاما.
اذن، كيف ستدير "البيـج بوس" هذا المسرح ؟ المجتمع من خلال تلك المركبات المعقدة مضيفاً الى ذلك ما يسمى بـ "مجمل القضية"؟ لم يك لدي اي جواب، ولم احاول حتى التفكير في الاجابة. كل ما اعلمه أنه في احدى الليالي سهرت كعادتي في خمارة البلد التي ادعوها تحبباً "بخمارة غوركي" في النهار وفي الليل ادعوها "خمارة جان فلجان" وتسامرت على غير عادتي مع نديم يدعى "ابو جميلة" (بلفظ الجيم المصرية) من بقايا ذلك العصر، أنه كهل عريض المنكبين، غليظ الشفتين تحسبهما "شفاطة"، سواد لون بشرته يضاهي كحل العيون، صوته ثخين يناسب حجم رقبته، فإن حاولت خنقه تطلب الأمر المزيد من الأيادي. اما العلامة المميزة له فهي شعرتان تعلوان صدره الرحب. وعلى الرغم من كهولته ما زال ذلك الشخص الذي عرفته. جاء من السودان طلباً للرزق في هذه المدينة فعمل عتالاً يحمل الحقائب وكل ما توجب حمله، وحين التقيته لأول مرة في "البلد" عند قريب لي بقرب "السوق الأبيض" قال لي: "اسمع يا ولد، انا صحيح أعتل، لكني احمل على ظهري كل هموم هذه الدنيا، وما دامت الحياة مسرحا فأنا خير ممثليها". كلمات سمعتها اصبحت واقعاً.
نعم أنه "ابو جميلة" هكذا عرفته كما عرفت أنه سكن في حينه ولفترة وجيزة تحت عمارة "فاطمة الزعرة" ؟ باطرونة البلد..! وعرفته ايضاً من سينما "الانشراح"، حيث عُرض فيلم لعبد الوهاب "رصاصة في القلب" على ما اذكر ودخلت متأخراً الى القاعة الدامسة الظلام فبحثت عن مكان لأجلس عليه، فجلست. قام الصراخ لاتبين فيما بعد انني جلست في حضن "ابو جميلة" وقد تأكدت من ذلك حين ابتسم كل ذلك الصف من الجالسين من اصدقائه فبانت وبرزت اسنانهم البيضاء فقط!؟!
أما سر اسمه فيقال أنه أحب فتاة تدعى جميلة من وادي النيل فهام على وجهه بحثاً عنها عندما اختفت ولم يعد بالإمكان رؤيتها فردد جملته "سبع سنين في الجبالا من شان جميلة" وكنت احب الاستماع الى لهجته السودانية التي استبدلت العين بالهمزة والقاف بالغين والحاء بالهاء، ولا سيما حين عمل في بيع البوظة "الدندرمة" فكان يردد جملة موسيقية راقصاً على انغامها رقصة سودانية "دندر البوظة يا سئيدة؟ (استبدل العين بالهمزة وسعيد هو اسمه)، وعندما يمر عليه يوما مشؤوم كان يدخل خمارة فاسيليوس اليوناني في شارع البور ويخمر، وعند خروجه كان يصيح بأعلى صوته "إهنا أبيد من السودان نضرب ضربة في البيضان "قاصداً" نحن عبيد من السودان..." فكما قلت فإن هذه هي مدينة الغريب أوت العديد من العرب الذين لجأوا من البلدان العربية المجاورة ولا سيما من جنوب لبنان حيث اختلطت اللهجات في هذه المدينة لتصبح خليطاً من المصرية والشامية.
تسامرت وتنادمت مع "ابو جميلة" ورفعنا الأنخاب لذكرى "الحبيب والمنزل" وسكبنا الدموع، إلا أن دموعه توقفت حين ذكرت له اسم حبيبته الثانية "جميلة الحلبية" التي تشبه معلمتي في عهودها الأولى، تلك "الـجميلة" الثانية التي هام في حبها لدرجة السير على الأقدام من يافا الى حلب برهاناً على حبه ووفائه وإخلاصه لها!! بيد أن القضية لم تتوقف عند هذا الحد "فأبو جميلة" يعتقد أن صاحبة المسرح هي نفسها جميلة الحلبية. فهنا كانت الطامة الكبرى. كيف سأفسّر له هذه المفارقة المجردة وقد شرب ما تيسر من الكونياك الرخيص الذي دعوناه با "الأمونياك"؟! فسكرة "ابو جميلة" "عاطلة" جداً! فما العمل؟! بدأت "ادندن" له بعض من الأغنيات السودانية التي لقنني إياها "ايام العرب"، إلا أنها لم تدخل مزاجه. توقفت. أفاق من سكرته ليذكرني بفلسفته في الحياة، التي حفظتها عن ظهر قلب ؟ فهي تتلخص بحبه للناس "من تحت" ولحياة الدراويش والبساطة المتناهية لدرجة الإحتراف وكرهه للناس "من فوق"، ففي السابق كان "التحت" البلدة القديمة و "من فوق" موقع البرج ووادي النسناس أما اليوم فكل ما كان "من فوق" اصبح "من تحت" فلذلك يحبهم لأنهم الأقرب الى قلبه. أما انا فأقسم الناس الى "ذوي اللسان" والى "ذوي الأذنين". وعلى الرغم من هذا التقاطع فقد صحونا نحن الاثنين وأيادينا السمراء والسوداء متشابكة وأضواء المسرح القوية مسلطة على كلينا لتبرز اسمالنا البالية من عهود النكبة لنردد امام مشاهدينا في مسرح "الفنون" مقاطع من اغنية سيد درويش "مصر والسودان":
جالت لي هالتي ام أهمد ...........كـلـمايــة فـي متلايــة
سرجوا الصندوج يا مهمد ...........لـكـن مـفـتاهــه مآيــة
ما فيش هاجـه اسمه مصري ........... ولا هاجـة اسمه سوداني
بهر النيل راسه في ناهية ........... ورجليه في الناهية التاني
**** **** **** **** ****
أسود أبيض يا بو رامه ........... آيشـيـن ويـا باضـيـنـا
سوداني فيه إنده كرامه ...........مصري طول امره أهينا
**** **** **** **** ****
الشـجل بـتـأنـا تـأب ...........بواب في بـيت الـبـاشـا
يوم فاصوليا وبـجـلاوة ........... يوم ملوخية وشوكلاطة
**** **** **** **** ****
يا اوروبا خليك شاهد ...........عَ الـبولـيتـكة الترلـلـي
الـرايـة بـتـأنـا واهــد ...........لازم يستـنى المـتـولـي
تصفيق حاد من الجمهور ؟ مجتمع المسرح ومسرح المجتمع ؟ الصامت وغير الصامت، "من فوق" و "من تحت"، منكوب وغير منكوب، لتنهض جميلتنا المشتركة من خلال هذا الجمع ؟ المجتمعي كبركان نَشِط لتوه ليفجر جميع القيود ناثرة في القاعة ؟ المدينة سهامها المشعة، صارخة:
" يا هـبـيـبـي أود لـي تـانـي أنـا أهـبّ الأسمراني"
فلم ندرك انا و "ابو جميلة" لمن "الأودة" ("العودة") أللأسمر الصامت أم للأسود السوداني؟!
عفواً! هل جميلتنا هي سرايا بنت الغول؟
عفواً! هذه هي مسرحيتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم بخيال آخر!
عفواً! هل هي حيفا التي تستبقي أبناءها؟
أسدل الستار!


 صور
صور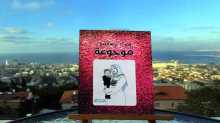 صور
صور